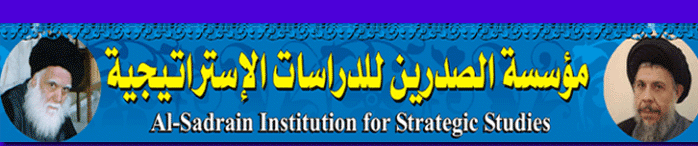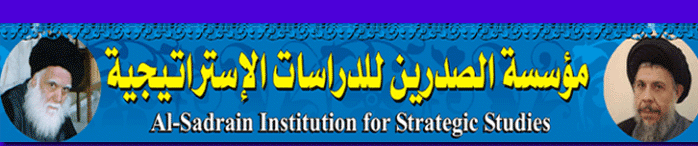وجوب السلبية :
وتكون العزلة والسلبية واجبة ، عندما يكون ترك العمل الإسلامي واجباً ، والمبادرة
إليه حراماً . وذلك في عدة حالات :
الحالة الأولى :
القيام بالجهاد الاسلامي بدون إذن الامام أو القائد الاسلامي أو رئيس الدولة
الاسلامية ... فان ذلك غير مشروع في الاسلام ، كما ينص عليه الفقهاء ، سواء
كانالقائد غافلاً أو ملتقياً ... فضلاً عما إذا كان العمل موجهاً ضد الامام أو
الدولة ، سواء كان عسكرياً أو غيره .
ونحن نفهم بكل وضوح ، المصلحة المتعلقة بهذا الاشتراط . فان القائد الاسلامي أبصر
بمواضع المصلحة وموارد الحاجة إلى الجهاد من الفرد الاعتيادي ، بطبيعة الحال وبذلك
يكون عمله أدخل في التخطيط الالهي العام لهداية البشر ، من عمل غيره . بل قد يكون
عمل غيره هداماً مخرباً ، كما سيأتي في الجانب الثاني من هذه النقطة الثانية .
الحالة الثانية :
القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فيما إذا لم يكن يحتمل التأثير ، وكان
مستلزماً مع الضرر البليغ أو إلقاء النفس في التهلكة . فان هذا الأمر والنهي يكون
محرماً وحرمته مطابقة مع القواعد العامة ، فان معنى الاشتراط بعدم الضرر، هو سقوط
الوجوب معه ، فلا تكون هذه الوظيفة الاسلامية بلازمة . فان كان الضرر بليغاً ن كان
المورد مندرجاً في حرمة القاء النفس في التهلكة أو حرمة التنكيل . فيكون محرماً
.وإذا حرم الأمر بالمعروف، كانت العزلة والسلبية المقابلة له واجبة .
صفحة (326)
وهذا التشريع واضح المصلحة بالنسبة إلى الممحصين وغيرهم . أما الممحصين فباعتبار أ،
التضحية وتحمل الضرر في مورد يعلم بعدم ترتب الأمر أو تغيير الواقع ، تذهب هذه
التضحية هدراً ، بحيث يمكن صرفها في مورد أهم من خدمات الاسلام . وأما بالنسبة إلى
غير الممحصين فلنفس الفركة ، مع الأخذ بنظر الاعتبار ضحالتهم في قوة الارادة وضعفهم
في درجة الايمان .
الحالة الثالثة :
فيما إذا كانت العزلة أو السلبية ، تتضمن مفهوم المقاومة أو المعارضة أو الجهاد ضد
وضع ظالم أو أساس منحرف ... فأنها تكون واجبة بوجوب الجهاد نفسه .
وتكون في واقعها عملاً اجتماعياً متكاملاً ... ولكن أن تكون مخططاً مدروساً وطويل
الأمد ، يختلف باختلاف الظروف والأهداف المتوخاة من وراء هذه العزلة .
وتندرج هذه السلبية ، بالرغم من مفهومها السالب الخالي عن الحركة ، تحت أهم أعمال
الجهاد . قال تعالى: ﴿ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة ف يسبيل الله ،
ولا يطؤن موطئاً يغيط الكفار ، ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح .
ان الله لا يضيع أجر المحسنين﴾(1) . إذن فالمراد في صدق مفهوم الجهاد والعمل الصالح
، هو إغاضة الكفار والنيل من أعداء الحق ، سواء كان ذلك بعمل إيجابي حركي أو بعمل
سلبي ساكن .
كما قد تندرج السلبية في مفهوم الأمر بالمعروف أو النهي عن المننكر ... إذا كانت
مما يترتب عليها الاصلاح في داخل المجتمع الاسلامي أو تقويم المعوج من أفراده ،
فتكون واجبة بوجوب هذا الأمر والنهي .
ولعل من أهم أمثلة قوله تعالى : ﴿واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن ، واهجروهن في
المضاجع﴾(2) . فان هذا الهجران نوع من السلبية لأجل نهي الزوجة العاصية الناشز عن
ما هي عليه من العمل المنكر ضد زوجها .
وكم قد عملت السلبية في التاريخ أعمالاً كبرة وبعيدة الأثر ، قد تعدل الأعمال
الايجابية ، بل قد تفوق بعضها بكثير . _____________
(1) التوبة : 9/120 . (2) النساء : 4/34 .
صفحة (327)
الحالة الرابعة :
ما إذا خاف الفرد على نفسه الانحراف ، واحتمل اضطراره إلى الانزلاق تحت إغراء مصلحي
أو ضغط ظالم أو اتجاه عقائدي لا إسلامي .
فأنه يجب على الفرد – في مثل ذلك- أن يجتنب السبب الموجب للانحراف ، يعتزل عنه ،
لكي يحرز حسن عقيدته وسلوكه.وتكون الحالة إلى هذه العزلة ملحة ، فيما إذا لم يجد
الفرد في نفسه القوة الكافية لمكافحة التيار المنحرف أو التضحية في سبيل العقيدة .
إلا أن هذه العزلة لا يجب أن تكون كلية ومطلقة ، بل الواجب هو اعتزال التيار الذي
يخاف المكلف من هعلى نفسه أو دينه . وأما اعتزال المجتمع بالكلية ، فهذا غير لازم
بل غير جائز إسلامياً ، إذا كانت هناك فرص للعمل الاسلامي الواجب ، من جهات أخرى .
جواز السلبية :
وأما موارد اتصاف السلبية بالجواز ، فهو كل مورد كان العمل الاجتماعي الاسلامي
جائزاً أو كان تركه جائزاً أيضاً. فيكون للمكلف أن يقوم به ، أو أن يكون معتزلاً له
وسلبياً تجاهه .
إلا أن الغالب هو عدم اتصاف العمل الاسلامي بالجواز ، بل يكون-عند عدم اتصافه
بالوجوب- راجحاً أو مستحباً . فتكون العزلة المقابلة له مجرومة ومخالفة للأدب
الاسلامي العادل .
وعلى أي حال ، فقد استطعنا أن نحمل فكرة كافية على صعيد الفقه الاجتماعي ،عن العمل
والعزلة في نظر الاسلام، من حيث الوجوب والحرمة والجواز . وبذلك ينتهي الكلام في
الجانب الأول .
* * *
الجانب الثاني :
من الحديث عن العزلة أو الجهاد ، في ارتباط هذه الأحكام الاسلامية بالتخطيط الالهي
العام للبشرية ، وبقانون التمحيص الالهي .
عرفنا فيما سبق ، ما للظلم ولظروف التعسف التي يعيشها الأفراد ، من أثر كبير في
تمحيصهم وبلورة عقيدتهم ، ووضعها على مفترق طريق الهداية والضلال .
صفحة (328)
وينبغي أن نعرف الآن ، أن الظلم لا يحدث ذلك مباشرة ... كيف وان مدلوله المباشر
ومقصوده الأساسي ، هو سحق الحق وأهله . وإنما يوجب ذلك باعتبار الصورة التي يحملها
الفرد المسلم في ذهنه عنه ورد الفعل الذي يقوم به تجاهه نفسياً أو عملياً . ويكون
ذلك على عدة مستويات :
المستوى الأول :
أخذ العبرة من الظلم عقائدياً وتطبيقياً . والنظر إليه كمثال سيء يجب التجنب عنه
والتحرز عن مجانسته .
فان الظلم بما فيه من فلسفات وواجهات ، وبما له من أخلاقية خاصة وسلوك معين ، سوف
لن يخفي نفسه ولن يستطيع ستر معايبه ونقائضه . بل سوف تظهر متتالية نتيجة للتمحيص
... أساليب الظلم والاعيبة وما يبتني عليه من خداع ونقاط ضعف .
وحسبنا من واقعنا المعاصر أن نرى أن صانعي هذه المبادئ ، يحاولون تطويرها وتغييرها
، وإدخال التحسينات والترميمات عليها من بين حين وآخر ، حتى لا تنكشف نقائصها ، ولا
تفتضح على رؤوس الاشهاد . إذن فأي مستوى معين من الفكر المنحرف لو بقي بدون ترميم
لكانت التجربة والتمحيص ، أو تطور الحضارة البشرية- على حد قولهم- كفيلاً في فضح
نقائضه وإثبات فشله .
المستوى الثاني :
إتضاح فساد الأطروحات المتعددة التي تدعي لنفسها قابلية قيادة العالم وإصلاحه ...
اتضاحاً حسياً مباشراً . ولا زالت البشرية تتربى – تحت التخطيط الالهي – وتندرج في
هذا الادراك ، وإن بوادره في هذا العصر لأوضح من أن تنكر ... بعد أن أصبح الفرد
الاعتيادي يائساً من كل هذه المبادئ من أن تعطيه الحل العادل الكامل لمشاكل
البشرية.
وقد أشير إلى ذلك في الأخبار بكل وضوح . روى النعماني(1) بسنده عن هشام بن سالم عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ما يكون هذا الأمر "يعني دولة المهدي (ع)" حتى
لا يبقى صنف من الناس إلا وقد ولوا من الناس "يعني باشروا الحكم فيهم" حتى لا يقول
قائل : إنّا لو ولينا لعدلنا. ثم يقوم القائم بالحق والعدل .
___________________________
(1) الغيبة ص 146 .
صفحة (329)
وفي رواية أخرى(1) : إن دولتنا آخر الدول . ولم يبق أهل بين لهم دولة إلا ملكوا
قبلنا ، لئلا يقولوا إذا رأوا سيرتنا ، لو ملكنا سرنا مثل سيرة هؤلاء . وهو قول
الله عز وجل : ﴿والعاقبة للمتقين﴾ .
وسنشبع هذه الجهة بحثاً في الكتاب الثالث من هذه الموسوعة .
المستوى الرابع :
ما يترتب على هذا اليأس من إدارك وجداني متزايد ، للحاجة الملحة العالمية الكبرى
للحل الجديد والعدل الذي يكفل راحة البشرية وحل مشاكلها .
وهذا شعور موجود بالفعل ، بين الغالبية الكبرى من البشر على وجه الأرض ، بمختلف
أديانهم ولغاتهم وتباعد أقطارهم . فانظر إلى التخطيط الالهي الرصين الذي ينتج
الانتظار للحل الجديد ، من حيث يعلم الأفراد أو لا يعلمون.
المستوى الخامس :
إدراك مميزات العدل الاسلامي والعمل الاسلامي والقيادة الاسلامية ، عند مقارنة
نقائه وخلوصه وشموله بالمبادئ المنحرفة والاتجاهات المادية . فيتعين أن يكون هو
الحل العالمي المرتقب .
ويزداد هذا الادراك وضوحاً ، كلما تعلق الفرد بالمقارنة والتدقيق والتقيد العلمي .
فتبرهن لديه بوضوح أن الأطروحة العادلة الكاملة الضامنة لامتلاء الأرض قسطاً وعدلاً
، هي الاسلام وحده . وللتوسع في هذه البرهنة مجالات أخرى غير هذا الحديث .
المستوى السادس :
الدربة والتربية على الاقدام على التضحية في سبيل الحق ...ذلك الذي ينتجه العمل
الاسلامي ، كما سبق أن أشرنا، عن طريق التمحيص الاختياري والاضطراري للأفراد ،
وانتقال التمحيص عن طريق قانون تلازم الأجيال .
_______________
(1) أعلام الورى ص 432 .
صفحة (330)
إذا عرفنا ذلك ، فيحسن بنا أن نرى أن أحكام العزلة والجهاد والأمر بالمعروف التي
عرفناهنا ، ماذا تؤثر في هذا التخطيط ، على تقدير إطاعتها ، وعلى فرض عصيانها ،
وهذا ما نعرض له فيما يلي :
أما الفرد المسلم الذي له من الاخلاص والايمان ما يدفعه إلى إطاعة أحكام الاسلام
وتطبيقها في واقعه العملي ، فيندفع حين يريد منه الاسلام الاندفاع إلى العمل ويعتزل
حين يريد منه الاسلام السلبية والاعتزال .
... فهذا هو الفرد الذي سيفوز ، بالقدح الأعلى والكأس الأوفى من النجاح في التمحيص
الالهي ، ويشارك في إيجاد شرط الظهور في نفسه وغيره .
فإن هو اتصل بالمجتمع ، فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ، وحاول الاصلاح في أمة
الاسلام ... فانه سيشعر عنكثب بفداحة الظلم الذي تعيشه هذه الأمة خاصة والبشرية
عامة . وسينقل هذا الشعور إلى غيره ، ويطلع الآخرين بأن أفضل حل لذلك هو تطبيق
الأطروحة العادلة الكاملة المتمثلة بالاسلام .
وإن هو جاهد ، عند وجوب الجهاد أو مشروعيته .. فهذه الوظيفة الاسلامية الكبرى ،
تحتوي – كما عرفنا – على جانبين رئيسيين : جانب تثقيفي وجانب عسكري .
فإذا عرفنا أن الجانب التثقيفي ، ليس هو مجرد طلب التلفظ بالشهادتين ، من غير
المسلمين . بل هو متضمن – على ما ينص عليه الفقهاء – عرض محاسن الاسلام ، بمعنى
إظهار جوانب العدل فيه واثبات أفضليته من النظم الأخرى سياسياً وعسكرياً واقتصادياً
وعقائدياً واجتماعياً وأخلاقياً ... ونحو ذلك ... إذا عرفنا ذلك ، استطعنا ان نفهم
كيف أن الفرد المخلص لدى الجهاد التثقيفي وإن المفكر الاسلامي لدى البحث عن بعض
جوانب الاسلام ... يندفع في تطبيق التخطيط الالهي من حيث يعلم أو لا يعلم .
فإن المفكرين الاسلاميين ، يسيرون بأنفسهم نحو الكمال ... أولاً .
ويثقفون غيرهم من أبناء أمتهم الاسلامية ... ثانياً . ويطلعون غير المسلمين على
الواقع العادل للاسلام ...ثالثاً . وينفون الشبهات الملصقة بالاسلام ...رابعاً .
ولك ذلك مشاركة فعالة فعلية في التخطيط الالهي وفي إيجاد شرط الظهور . فان لهذا
الجو الثقافي الاسلامي الأثر الكبير في فهم المسلمين لأطروحتهم العادلة الكاملة ،
واستعدادهم للدفاع عنها ، ونجاحهم في الصمود تجاه التيارات المنحرفة وحصولهم على
الاخلاص الممحص في نهاية المطاف .
صفحة (331)
وأما العمل العسركي ، فقد ذكرنا أن ما يمت إلى جهاد الدعوة بصلة لا يشرع وجوده في
أيام التمحيص وفقدان الامام . كيف وهو لا يقوم به إلا الأفراد الممحصون ، كما عرفنا
. إذن فهذا الجهاد لا يكون إلا نتيجة للتمحيص ، فلا يمكن أن يكون مقدمة له وسبباً
لوجوده .
وأما العمل العسركي الدفاعي ، فهو بوجوبه على غير الممحصين الواعين ، يعطيهم درساً
قاسياً في تحمل الضرر من أجل الاسلام ، والتضحية في سبيل الله ... ويربيهم عن طريق
هذه التجربة تربية صالحة . من حيث أن فكرة وجوب حفظ بيضة الاسلام وأصل كيانه ،
واضحة في أذهانهم .
كما أنه يكون محكاً لامتحان الآخرين الذين يتخاذلون عن الدفاع عن الاسلام ويعطون
الدنية من أنفسهم للمستعمر الدخيل ، أو يحاربون تحت شعارات لا إسلامية ... فيفشلون
في التمحيص الالهي فشلاً مؤسفاً ذريعاً .
فإن أفاد الدفاع وانحسر المد الكافر ، فقد انتصرت التضحية في سبيل الله تعالى ،
وتكلل العمل الاسلامي الكبير بالنجاح . وإن خسرت الأمة ذلك وسقطت بين المستعمر
الدخيل ، بدأت سلسلة جديدة من حوادث التمحيص والاختبار الالهي ، التي تتمثل بما
يقوم به المتسعمر من ظلم وتعسف وما يدسه من تيار فكري ونظام اقتصادي غريب عن
الاسلام . وما يكون لأفراد الأمة من ردور فعل تجاه هذا الظم الجديد . فقد ينجح في
التمحيص أقوام وقد يفشل آخرون . طبقاً للقانون العام ...
وعلى أي حال ، فالعمل الإجتماعي الاسلامي بقسميه الرئيسيين : الجهاد والأمر
بالمعروف ، مشاركة فعالة في التخطيط والتمحيص الالهيين . وهما المحك فشل أعداد
كثيرة من المسلمين يتخلفون عن هذا الواجب المقدس وتتقاعس عنه ، فشل في الامتحان
وتخرج عن غربال التمحيص ... فتبوء بالذل والخسران .
وأما العزلة ، فإن كانت تتضمن تركاً للعمل الاجتماعي الواجب في الاسلام ، فهي
العصيان والانحراف بعينه . وبها يثبت فشل الفرد في الامتحان الإلهي وأما إذا كانت
العزلة ، منسجمة مع التعاليم الاسلامية ، واجبة أو جائزة ... فتكون داخلة ضمن
التخطيط الالهي لا محالة ، باعتبار ان إدخالها في التشريع يراد به جعلها مشاركة في
تنفيذ هذا التخطيط الكبير . وتكون مشاركة الفرد فيها منتجة لعدة نتائج مقترنة
مترابطة .
صفحة (332)
النتيجة الأولى :
انسجام عمل الفرد مع متطلبات التخطيط الالهي ومصالحه .فان العزلة إنما شرعت لمصالح
تعود إلى هذا التخطيط، فيكون امتثال المكلف لوجوبها مشاركة حقيقية ، فيما يراد
انتاجه من المصالح في إيجاد شرط الظهور .
بخلاف ما لو لم يعتزل ، كما لو جاهد بغير إذن أو أمر بالمعروف مع احتمال الهلاك ،
فانه يكون من الفاشلين في التمحيص ، فيسقط رقمه من المخلصين الممحصين ... من حيث
أراد العمل الاسلامي .
النتيجة الثانية :
النجاح في التمحيص ، فان المعتزل للعمل حين يراد منه الاعتزال ، يكون قائماً
بوظيفته العادلة الكاملة ، ويكون ذلك سبباً لنجاحه في التمحيص ، من حيث كونه صابراً
على البلاء محتسباً عظيم العناء .
لكننا يجب أن نلاحظ في هذا الصدد نقطتين مقترنتين :
الملاحظة الأولى :
إن العزلة ، وإن كانت مطابقة للتعاليم والتخطيطات الالهية عند مطلوبيتها ، إلا أن
أثرها في إيجاد الاخلاص العالي والواعي في نفس الفرد ، لا ينبغي أن يكون مبالغاً
فيه . فان العزلة ، على أي حال ، تعني السلبية والانسحاب ، والسلبية – في الأعم
الأغلب – تعني الراحة والاستقرار . ومن الواضح جداً أن الفرد لا يتكامل إخلاصه
ووعيه الاسلامي ، إلا بالعمل والتضحية ومواجهة الصعوبات ، لا بالراحة والاستقرار .
أو على الأقل ، سيكون تكامل الفرد في حال السلبية أبطأ منه في حال العمل ... في
الأعم الأغلب .
ومن هنا نرى الاسلام يمزج في تشريعه بين العزلة حيناً والعمل أحياناً . لكي تكون
إطاعة المكلف على طول الخط سبباً لتمحيصه ... عاملاً او معتزلاً .فان العزلة مع
استشعار كونها طاعة لله ومع استعداد الفرد في أي وقت للتضحية والفداء ... تشارك
مشاركة فعالة في نجاح الفرد في التمحيص .
صفحة (333)
الملاحظة الثانية :
إن العزلة عند مطلوبيتها ، تكون منتجة للتمحيص بالنسبة إلى الفرد المنعزل خاصة دون
غيره . بخلاف العمل ، حين يكون مطلوباً ، فانه ينتج تمحيص الفرد القائم بالعمل
وغيره .
ومن هذا الفرق إلى الفرق بين المفهومين ، في أنفسهما ، فان العمل حيث يعني الاتصال
بالغير بنحو أو بآخر ، فأنه يجعل كلا الطرفين تحت التمحيص ، ليرى من يحسن السلوك
فينجح ومن يسيئوه فيفشل .
وأما العزلة ، فحيث أنها لا تتضمن طرفاً آخر ، بل تقتضي الابتعاد عن الغير ، في
حدودها ، فلا تكون منتجة للتمحيص إلا للفرد المعتزل نفسه .
النتيجة الثالثة :
حفظ النفس عن القتل من دون مبرر مشروع . كالذي يحدث فيما لو جاهد في مورد النهي
الشرعي عن الجهاد ، أو أمر بالمعروف في مورد الضرر البليغ ... أو تابع المنحرفين
فأدى به انحرافه إلى القتل ... أو غير ذلك .
ومن المعلوم ما في حفظ النفس من الأهمية ، لا باعتبار أصل تشريعه ، وإن كان مهمّاً
جداً ، بل باعتبار دخله في التخطيط الالهي لليوم الموعود . فان قوانين التمحيص إنما
تكون مطبقة في العالم عند وجود الأفراد وقيامهم بالسلوك المعين الذي يربيهم ويحملهم
على التكامل . وأما إذا أهلك الفرد أو عدد من الأفراد أنفسهم في غير الطريق الصحيح
، فمضافاً إلى أنهم سيبوءون بالفشل في التمحيص ، فأنهم يتسببون إلى قلة الأفراد
الممحصين ، ومن ثم الناجحين في التمحيص منهم .
إذن فلا بد من الحفاظ على النفس ، لكي تتعرض للتمحيص ، فلعلها تكون من الناجحين ،
وتشارك في إيجاد شرط الظهور .
وهذا هو المفهوم الواعي والغرض الأعمق للتقية الواجبة ، المنصوص عليها في القرآن
وفي أخبار أهل البيت عليهم السلام . وسنعرف عنها بعض التفصيل في النقطة الثالثة
الآتية .
صفحة (334)
* * *
وبهذا استطعنا أن نلم بمفهوم العزلة ونتائجه .وعرفنا أن المراد منها ليس هوالانصراف
التام عن المجتمع والاعتكاف في الزوايا ... كيف وان العمل الاجتماعي قد يكون واجباً
في الاسلام ،فتكون هذه العزلة من المحرمات.
بل المراد منها اعتزال العمل الاجتماعي غير الواجب او العمل المحرم . والعزلة في
موارد مطلوبيتها تشارك في المنهج العام للتخطيط الالهي لايجاد شرط الظهور . كما سبق
أن فصلنا .
وعلى أي حال ، فالاندفاع في أي من المسلكين : العمل والعزلة ، إلى نهاية الشوط غير
صحيح ، وإنما الصحيح هو قصر السلوك على مقتضيات العدل ومتطلبات الاسلام فان كان
العمل واجباً كان على الفرد أن يعمل وإن كانت العزلة واجبة كان على الفرد أن يعتزل
، ليكون بهذا السلوك ناجحاً في التمحيص محققاً في نفسه شرط الظهور .
وبهذا انتهى الكلام في النقطة الثانية ، فيما تقتضيه القواعد العامة من الالتزام
بالجهاد أو بالعزلة .
النقطة الثالثة :
فيما دلت عليه الأخبار الخاصة من التكليف خلال الغيبة الكبرى ، تجاه ما يكون فيها
من الانحرافات وأنواع الظلم والفساد .
وأكثرها – كما أشرنا فيما سبق – دال على لزوم العزلة والابتعاد عن الناس وترك
الأقوال والنشاط على المستوى الاجتماعي .وسنرى فيما يلي مقدار مطابقتها للقواعد
العامة التي عرفناها . فان استطعنا أن نفهم لها وجهاً صحيحاً منسجماً مع ما سبق
أخذنا بها ، وإلا اضطررنا إلى ترك الرواية المخالفة للقواعد ، وخاصة بعد التشدد
السندي الذي التزمناه .
صفحة (335)
القسم الأول :
وهذه الأخبار ذات مضامين ومداليل مختلفة ، فنقسمها بهذا الاعتبار إلى أقسام
في الفتنة التي فيها القاعد خير من القائم .
أخرج الصحيحان(1) بلفظ واحد عن رسول الله (ص) أنه قال : ستكون فتن القاعد فيها خير
من القائم والقائم خير من الماشي ، والماشي فيها خير من الساعي . من تشرف لها
تستشرفه . ومن وجد فيها ملجأ فليعُذ به . وذكر كل من الشيخين لها أكثر من سند واحد
.
وأخرج مسلم (2) عنه (ص) : أنها ستكون فتن . الا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من
الماشي فيها والماشي فيها خير من الساعي إليها . الا فإذا نزلت أو وقعت ، فمن كان
له أبل فليلحق بابله ، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بارضه
.. الحديث . وذكر له سندين .
وقد أخرج غيرهما من أصحاب الصحاح ، هذا المضمون غير أننا نقتصر عليهما فيما أخرجاه
. وهو مضمون اقتصر إخراجه على مصادر إخواننا أهل السنة ، ولم نجد في المصادر
الإمامية له ذكراً .
ولفهم هذه الأخبار أطروحتان ، بعد العلم أن الفتن قد يراد بها التمحيص والإختيار ،
وقد يراد بها النتيجة السيئة للتمحيص أعني الكفر والإنحراف . وكلاهما من معانيها
اللغوية . وقد جاء طبقاً للمعنى الأول قوله تعالى : "وفتناك فتوناً "(3) وقوله :
"وظن داود إنما فتناه" (4) . وطبقاً للمعنى الثاني قوله تعلى : "واحذرهم أن يفتنوك
عن بعض ما أنزل الله إليك "(5) . وقوله:"إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم
يتوبوا فلهم عذاب جهنم" (6).
____________________
(1) أنظر البخاري ، جـ 9 ، ص 94 . ومسلم ، جـ 8 ، ص 168. (2) جـ 8 ، ص 169 . (3) طه
. 20/40 .
(4) ص 38/24 . (5) المائدة : 5/49 . (6) البروج : 85/10 .
صفحة (336)
ولكن المعنى الأول ن غير مراد من هذه الروايات جزماً ، إذ لا معنى للتخلص والإنعزال
عن التمحيص ، بعد كونه قانوناً منطبقاً على كل البشر ، في التخطيط الإلهي . فيتعين
أن يراد بالفتن المعنى الثاني ، وهو الكفر والإنحراف . وطبقاً لهذا المعنى يكون في
فهم هذه الروايات أطروحتان :
الأطروحة الأولى :
أن النبي (ص) يشير غلى زمان مسقبل بالنسبة إلى عصره ، تحدث فيه الفتن .
وينصح المسلمين بالإنصراف عنها والإنعزال عن تيارها والقعود عن العمل معها أو ضدها
.. بل اللازم هو اللجوء إلى ملجأ أو الخروج إلى البوادي والأطراف هرباً من التدخل
في الفتنة .
وإذا صحت هذه الأطروحة ، تكون هذه الأخبار ، موافقة للقواعد العامة التي عرفناها
عند وجوب العزلة ، ومخالفة لها عند وجوب العمل والجهاد حيث نرى هذه الأخبار تأمر
بالعزلة على كل حال .
الأطروحة الثانية :
أن النبي (ص) يشير غلى الفتن نفسها ، بقوله : ستكون فتن . لا إنه يشير إلى الزمان
الذي تقع فيه ، كما هو الوجه في الأطروحة الأولى . فإنه لا ذكر للزمان في هذه
الروايات أصلاً . فيكون المراد : أن القاعد عن تأجيج الفتن وإثارتها والمشاركة فيها
خير من القائم والقائم خير من الساعي ، كلما كانت أقل ، كان أفضل .
ومعه يكون مضمونها صحيحاً ومطابقاً للقواعد . فان المشاركة في الفتنة مستلزم
للإنحراف والفساد لا محالة ، وهو مما لا يرضاه النبي (ص) لأمته ، وينصح بالتجنب عنه
. وهذا في غاية الوضوح . ومعه تخرج هذه الروايات عن كونها آمرة بالعزلة . وإنما هي
تأمل بالإنعزال عن الفتن بل على وجوبه . فإن هذا العمل قد يكون هو الملجأ الوحيد
للتخلص من الفتن . وقد أمر (ص) أن : "من وجد فيها ملجأ فليعُذ به" .
صفحة (337)
وعلى هذه الأطروحة عدة قرائن مرجحة لها من عبائر هذه الأحاديث الشريفة :
القرينة الأولى :
قوله (ص) : من تشرف لها تستشرفه .
فإن المراد أن من تعرض للفتن أثرت الفتن عليه وجرفته بتيارها . يقال : تشرف للشيء
إذا تطلع إليه . واستشرف : إنتصب . ومن المعلوم أن الغالب من أفراد الأمة ، ممن لا
عمق له في التفكير ، ولا دقة في النظر ، بمجرد اطلاعهم على المذاهب والفلسفات
اللاإسلامية ، تنتصب هذه المذاهب في أذهانهم ، بمعنى أنهم يرون لها هيبة وهيمنة
،ويكونون في طريق الإعتراف بها والتصديق بمضمونها .. فيؤدي ذلك بهم إلى الإنحراف عن
الإسلام.
وأما العمل الذي يعطي للفرد والآخرين المناعة عن الفتن الكافية للإضطهاد ومناقشتها
، فهو من أعظم الأعمال الإسلامية ، ومما لا تنفيه هذا الروايات ، طبقاً لهذه
الأطروحة .
القرينة الثانية :
قوله : الساعي إليها .
فان السعي إليها منضمن للتعرض لها والسير في ركابها . ومنه نعرف أن المراد مما سبقه
من القيام في الفتنة والمشي فيها هو ذلك أيضاً . ومعه لا يكون لها أي تعرض للنهي عن
العمل ضدها أصلاً .
القرينة الثالثة :
قوله : من وجد فيها ملجأ فليعُذ به ، بعد أن تفهم أن (في) بمعنى (من) فكأنه قال :من
وجد منها . ولا شك أ، المراد هو ذلك على أي حال .
والوجه في هذه القرينة : أن الملجأ لا ينبغي أن نفهم منه خصوص المكان المنزوي أو
البعيد ، بل نفهم منه كل منقذ من الفتنة وما هو مبعد عنها . ومن المعلوم أن
الإرتباط بأهل الحق ، واتخاذ العمل الإسلامي ، خير ملجأ ضد تيارات الفتن والإنحراف
.
نعم ، لو انحصر حال الفرد في النجاة من الفتنة أن يفر عنها ويبتعد منها ، وجب عليه
ذلك ، بأن يلحق بالأرياف إذا كان له فيها غنم أو إبل ! بتعبير الرواية .
صفحة (338)
ولعل سبب التركيز على هذا الشكل من السلوك ، في هذه الأحاديث . هو أن أغلب أفراد
الأمة الإسلامية في أغلب عصور الغيبة الكبرى ، جاهلون بتفاصيل الشرع الإسلامي وعدم
العمق فيه عمقاً يعطي المناعة الكافية عن الإنحراف والتأثر بالمبادئ الغريبة
والآراء المريبة . إذن يكون الواجب على الفرد إذ يشعر بمسؤولية صيانة نفسه من ذلك
كله .. أن يعتزل المجتمع ويضحي بالغالي والنفيس في سبيل دينه .. وإن ألقى به
الإعتزال في الريف . وهذا حكم صحيح على القاعدة ، كما ذكرنا في الصورة الرابعة
للعزلة .
وهذا لا يعني ، أن الفرد المسلم الذي يجد من نفسه قوة في الصمود وقابلية على مجابهة
التيار الظالم ، يجب عليه أيضاً أن يعتزل . كلا . بل يجب عليه أن يعمل وأن يخطط
لأجل إعلاء كلمة الله وترسيخ الفهم الإسلامي في نفوس الآخرين .
القسم الثاني :
ما دل من الأخبار على عدم المشاركة في القتل ، بل تحمله من الغير ، وإن كان قاتلاً
ظالماً .
أخرج إبن ماجة (1) وأبو داود (2) عن أبي ذر ، بلفظ متقارب واللفظ لإبن ماجة في حديث
قال : قلت : يا رسول الله، أفلا آخذ بسيفي فأضرب به من فعل ذلك ؟ قال : شاركت القوم
إذن ! ولكن أدخل بيتك . قلت يا رسول الله ، فإن دخل بيتي ؟ قال : إن خشيت أن يبهرك
شعاع السيف فألق طرف ردئك على وجهك ، فيبوء بإثمه وإثمك ، فيكون من أصحاب النار .
وأخرجا(3) أيضاً بلفظ متقارب واللفظ لإبن ماجة ، قوله في حديث عن الفتن : فكسروا
قسيكم وقطعوا أوتاركم وأضربوا بسيوفكم الحجارة . فإن دخل على أحدكم ، فليكن كخير
ابني آدم .
_______________________
(1) جـ2 ، ص1308 . (2) جـ2 ، ص 417 . (3) ابن ماجة ، جـ2 ، ص 1310 ، وأبو داود ،
جـ2 ، ص 416 .
صفحة (339)
وأخرج الترمذي (1) في حديث بنفس المضمون قال : أفرأيت إن دخل على بيتي وبسط يده
ليقتلني ؟ قال : كن كإبن آدم .
وفي هذه الأحاديث إشارة واضحة إلى قوله تعالى : (واتل عليهم نبأ إبني آدم بالحق ،
إذ قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر . قال : لأقتلنك . قال : إنما
يتقبل الله من المتقين . لئن بسطت إلى يدك لتقتلني ، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك
، إني أخاف الله رب العالمين . إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك ،فتكون من أصحاب
النار، وذلك جزاء الظالمين )(2) .
لم نجد هذا المضمون ، في الصحيحين ، ولا في أخبار المصادر الإمامية .
والمدلول العام لهذه الروايات ، هو وقوع القتال في داخل المجتمع المسلم بعد رسول
الله (ص) نتيجة للفتن والإنجراف . فيكون من وظيفة المسلم يومئذ ، عدم المشاركة في
القتال إلى جنب أي من الفريقين . بل يجب عليه أن يعتزل ويدخل بيته . فإن دخل عليه
المقاتلون في جوف بيته ، وجب عليه أن يستسلم للقتل من دون مقاومة . ويكون حاله حال
المقتل من إبني آدم الذي يبسط يده لقتل أخيه . وقد مدحه الله تعالى في محكم الكتاب
.
إلا أنه لا بد لنا من رفض هذا المضمون جملة وتفصيلا ، لمعارضته لضرورة الشرع والعقل
.
_______________
(1) جـ3 ، ص 329 . (2) المائدة : 5/27-29 .
صفحة (340)
فإن الفرد المسلم إذا رأى الحرب قائمة في المجتمع المسلم بين فئتين مسلمتين .. فإن
حاله من حيث الإقتناع الوجداني النابع مما يعرفه من قواعد الأمر الأول :
أن يعمل ان أحد الفريقين إلى جانب الحق والآخر إلى جانب الباطل . كما لوكان الرئيس
الشرعي للدولة الإسلامية، يحارب فئة باغية عليه منحرفة عنه .. ففي مثل ذلك يجب على
المكلف الإنضمام إلى طرف الحق ضد الباطل . طبقاً لقوله عزمن قائل : (وإن طائفتان من
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي
حتى تفيء إلى أمر الله )(1) .وإنما يتحقق البغي فيما إذا كان أحد الطرفين
المتحاربين يستهدف هدفاً باطلاً. ومن ضرورة الشرع والعقل وجوب محاربة الباطل وحرمة
نصرته.
الأمر الثاني :
أن يعلم الفرد أن الحق مجانب لكلا الفريقين ، وأن كليهما ينصر مذهباً باطلاً ويدافع
عن هدف منحرف ، أو – على الأقل – يشك في ذلك ويحتمله احتمالاً . وفي مثل ذلك لا
يجوز له نصرة أي من الفريقين ، كما هو واضح . فان نصرة أي منهمانصرة للإنحراف
والضلال ، يقيناً أو احتمالا ... وكلاهما محرم في الإسلام .
ومدلول هذه الروايات ، من حيث وجوب الإعتزال عن كلا الفريقين ، لو حمل على ذلك
بالخصوص ، لكان أمراً صحيحاً . ولعل هذا هو مراد النبي (ص) من قوله : شاركت القوم
إذن .يعني في الباطل والإنحراف.إلا أن شمول الرواية لصورة الأمر الأول يبقى نافذ
المفعول،وهو أمر غير صحيح .
كما أن الأمر بتحمل القتل لو دُخل في بيته ، أمر لا يمكن قبوله ، لأنه مخالف لضرورة
العقل والشرع معاً في وجوب الدفاع عن النفس ، وفي كون المستسلم للقتل قاتل لنفسه ،
في الحقيقة فيبوء بإثم نفسه ، لا أن القاتل يبوء بالإثمين معاً . ويكون كلاهما
مشمولاً لقوله تعالى : (ومن يقتل مؤمناً متعمدا ًفجزاؤه جهنم خالداً فيها ، وغضب
الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيما) (2) .أما إثم القاتل لمباشرته القتل. وأما
المقتول فلأنه سبب إلى قتل نفسه .
وقد يخطر في الذهن : أن الفرد إذا كان أعزل عن الأسلحة تماماً ، يكون الدفاع
متعذراً عليه . ومعه يكون الأمر بتحمل القتل منطقياً بالنسبة إليه .
وجوابه : أن هذا صحيح بالنسبة إلى الأعزل ، لكنه غير صحيح بالنسبة إلى هذه الروايات
، فإنها واردة في غير العزََّل ، تأمرهم أن يكسروا قسيّهم ويقطعوا أوتارهم وأن
يضربوا بسيوفهم الحجارة . فإذا تلفت أسلحتهم وجب عليهم تحمل القتل طواعية.. وهذا
مضمون مستنكر في العقل والشرع.. تعلم بعدم صدوره عن النبي(ص).
______________________
(1) المائدة : 5/27-29 . (2) النساء : 4/93 .
صفحة (341)
وأما ما ورد في أخبار الفريقين من أنه إذا التقى المسلمين بسيفيهما، فالقاتل
والمقتول في النار، فهو خاص بغير الدفاع عن النفس جزماً. فإنه إذا كان الفرد
مدافعاً عن نفسه يكون محقاً وحربه عادلاً! بضرورة العقل والشرع.
ومن هنا نعلم سلامة موقف "ابن آدم" المقتول. فإنه لادلابلة في الآية على أنه لم
يدافع عن نفسه، وإن لم يكن في نيته أن يقتل أخاه. وإنما سيطر عليه أخوه بقوته
فقتله. بخلاف ما تدل عليه هذه الرويات، من السلبية المطلقة حتى عن الدفاع عن النفس.
إذن، فلا سبيل إلى الأخذ بهذا القسم الثاني من الروايات. وخاصة طبقاً للتشدد السندي
الذي مشينا عليه.
ويكفينا أن نعرف أن كثيراً من الأخبار وضعت ودسّت في أخبار الإسلام، نصرة للجهاز
الحاكم المنحرف، الذي كان يحاول أن يسبغ صفة الشرعية على تصرفاته، فيمنع من مجابهة
ظلمة ومقابلته بالسيف، لكي تستقيم له الحال، ويهدأ منه البال، منطلقاً من أمثال هذه
الأخبار.
القسم الثالث: في الأمر بلزوم البيت
لم نجد هذا المضمون في الصحيحين، ولكن أخرج أبو داود(1)- في حديث عن الفتنة- عن
رسول الله (ص): قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم.
وأخرج ابن ماجة(2) عنه (ص) أنه قال: إنها ستكون فتنة وفرقة وإختلاف، فإذا كان كذلك،
فأت بسيفك أحداً فاضربه حتى ينقطع. ثم إجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو منية
قاضية. وصحح سنده.
وأخرج الصدوق في إكمال الدين(3) عن الإمام الباقر علييه السلام حتى يسأله الراوي:
فما أفضل ما يستمله المؤمن في ذلك الزمان – يعني زمان الغيبة – قال: حفظ اللسان
ولزوم البيت.
ـــــــــــــــــ
(1) جـ2، ص 417. (2) جـ2، ص 1310. (3) أنظر المخطوط.
صفحة (342)
وأخرج النعماني(1) في الغيبة عن الإمام الباقر عليه السلام – في حديث – قال: وإذا
كان ذلك، فكونوا أحلاس بيوتكم.
وأخرج الشيخ في غيبته(2) عن الإمام الصادق (ع) أنه قال: فإذا كان ذلك فالزموا أحلاس
بيوتكم، حتى يظهر الطاهر بن الطاهر ذو الغيبة.
والمردا من هذه الرواية، كسابقاتها، لزوم البيت، يقال حلس وتحلّس بالمكان لزق.
ويقال: فلان حلس بيته إي ملازق لا يبرحه. وأحُد وهو الجبل المعروف قرب المدينة
المنورة. والمراد يضرب السيف بعد إتلاف السلاح وكسره.
فيكون المراد الإنعزال والإبتعاد عن المجتمع الذي تسوده الفتنة، فيشمل ما إذا اتصل
الفرد به لأجل إصلاحه وتقويمه. ويكون ذلك منهياً عنه في هذه الروايات، خلافاً للحكم
الشرعي الإسلامي وقواعده العامة، إلا أن تحمل على خصوص بعض مبررادت العزلة التي
ذكرناها، كما لو خاف على نفسه من الإنحراف أو غير ذلك.
القسم الرابع: الفرار من الفتن
أخرج البخاري في موضعبن من صحيحه(3) عن أبي سعيد الخدري عن النبي (ص) يقول: يأتي
على الناس زمان خير مال الرجل المسلم الغني يتبع بها شَعَفَ الجبال ومواقع القطر،
يفر بدينه من الفتن. وأخرجه أبو داود(4) وابن ماجه(5) بنصه.
ـــــــــــــــــ
(1) ص 102. (2) ص 103. (3) أنظر جـ8، ص 129، وجـ9، ص 66.(4) جـ2، ص 418. (5) جـ2، ص
1317.
صفحة (343)
وأخرج ابن ماجة(1): تكون فتن، على أبوابها دعاة إلىالنار. فأن تموت وأنت عاض على
جذع شجرة خير لك من أن تتبع واحداً منهم.
وشعف الجبال رؤوسها، وجذع الشجرة أصلها. والمراد من العض عليه زيادة ملازمته
والإلتصاق به.. وفيه دلالة على الخروج إلى الأرياف والأطراف.. يسكن الفرد البساتين
ويجاور الأشجار أو قمم الجبال، لينججو من مجاورة الفتن واتباع دعاة الباطل.
وهذه الروايات، وإن كانت بسعة مدلولها، مخالفة للقواعد العامة التي عرفناها، إلا
أنه بالإمكان تقييدها كما عملنا في سابقاتها، فتبقى خاصة بصورة وجوب العزلة
والسلبية شرعاً.. وأما مع حرمتها، يكون الواجب هو العمل الإسلامي الإجتماعي المنتج.
وفي هذت القسم من الأخبار ما يؤيد هذا التقييد، حيث نجدها تحث على الجهاد إلى جنب
النصح بالفرار من الفتن. بل تخص وجوب الفرار بالعاجز عن الجهاد، ويكون للجهاد
الرتبة المقدمة على غيره، كما هو الصحيح في قواعد الإسلام العامة.
أخرج ابن ماجه(2): أن النبي (ص) قال: خير معايش الناس لهم، رجل ممسك بعنان فرسه في
سبيل الله، ويطير على متنه، كلما سمع هيعة أو قزعة طار عليه إليها، يبتغي الموت أو
القتل، مظانة. ورجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعاف، أو بطن واد من هذه
الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه، حتى يأتيه اليقين. ليس من الناس إلا
في خير.
وأخرج أيضاً(3) عن أبي سعيد الخدري: أن رجلاً أتي النبي (ص) فقال: أي الناس أفضل؟
قالك رجل مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قال: ثم من؟ قال: ثم أمرأ في شعب من يعبد
الله عز وجل، ويدع الناس من شره.وللترمذي(4) حديث آخر بهذا المضمون.
ـــــــــــــــــ
(1) جـ2، ص 1318، وأنظر نحوه في صحيح مسلم، جـ6، ص 20. (2) جـ2، ص 1316.
(3) جـ2، ص 1317. (4) جـ3، ص 320.
صفحة (344)
إذن فالتكليف الإسلامي في عهد الفتن وافنحراف، منقسم إلى قسمين، لا ثالث لهما. فإن
المسلم الشاعر بالمسؤولية تجاه دينه.. أما أن يكون قادراً على الجهاد أو العمل
المنتج لتقويم المعوج والكفكفة من التيارات الكافرة. وأما أن لا يكون قادراً على
ذلك. فإن كان قادراً على العمل وجب عليه ذلك لا محالة. وأن كان عاجزاً عنه فخير له
أن يعتزل الفتنة وأهلها. وأما معايشة المنحرفين مع الضعف في الإيمان والإرداة،
فتؤدي إلى مالا يحمد عقباه في الدين والدنيا.. كما هو واضح ومُعاش للناس يومياً.
القسم الخامس:
الأمر بالصبر، مع بيان صعوبة تحققه للمسلم المخلص، في مجتمع الفتن والإنحراف.
أخرج الشيخان(1) عن ابن عباس عن النبي (ص) قال:
من رأي من أميره شيئاً يكرهه فليبصر عليه، فإنه من فارق الجماعة شهراً، مات إلا مات
ميتة جاهلية. وفي نسخة مسلم: فميتة جاهلية.
وأخرجا(2) عن رسول الله (ص): إنكم ستلقون من بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني – وزاد
مسلم:- على الحوض.
وأخرج مسلم (3) عن حذيفة بن اليمان في حديث له مع رسول الله (ص) قال (ص): يكون بعدي
أئمة لا يهتدون بهداي ولا يسنّون بسنتي. وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في
جثمان أنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير،
وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فاسع وأطع.
وأخرجت جملة من الصحاح الأخرى مثل هذه المضمون، ولكننا نقتصر على ما أخرجه الشيخين،
فيما أخرجناه
فهذه هي الأخبار التي تأمر بالصبر.
ـــــــــــــــ
(1) البخاري، جـ9، ومسلم جـ6، ص 21. (2) البخاري، جـ9، ص 60، ومسلم، جـ6، ص 19. (3)
جـ6، ص 20.
صفحة (345)
وأما الأخبار الدالة على صعوبة الصبر:
فما أخرجه أبو داود(1) عن المقداد بن الأسود، قال: أيم الله قد سمعت رسول الله (ص)
يقولك إن السعيد لمن حنّب الفتن. وإن السعيد لمن جنّب الفتنة. إن السعيد لمن حنّب
الفتنة. ولمن ابتلى فصبر فواها.
وما رواه النعماني في الغيبة(2) عن الإمام الباقر عليه السلام في حديث: ولا والله
لا يكون الذي تمدون إليه أعناقكم إلا بعد أياس.
وعنه عليه السلام في حديث(3) عما يصيب الناس الشر قبل خروج المهدي (ع)، قال: فخروجه
إذا خرج يكون عند اليأس والقنوط.
وروى الصدوق(4) عن منصور قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا منصور إن هذا
الأمر، لايأتيكم إلا بعد يأس.. الرواية.
وأخرج ابن ماجه(5) عن النبي (ص) قوله: حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً، ودنيا
مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ورأيت أمراً لا يدان لك بهن فعليك خويصة نفسك، فإن
من ورائكم أيام الصبر فيهن على مثل قبض الجمر.. الحديث.
وأخرج الترمذي(6) عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله (ص): يأتي على الناس زمان
الصابر على دينه، كالقابض على الجمر.
(1) جـ2، ص 417. (2) ص 111. (3) غيبة النعماني، ص 135. (4) إكمال الدين المخطوط.
(5) جـ2، ص 1331.
(6) جـ3، ص 359.
صفحة ( 346)
صفحة (345)
ويقع الكلام في هذا القسم من الأخبار، ضمن أمرين:
الأمر الأول:
أن الأمر بالصبر مع الحاكم المنحرف وتحمل ظلمه وتعسفه بالسكوت، غير مطابق للقاعدة
الإسلامية، والأخبار الدالة عليه لايمكن قبولها بحال. وذلك: لأنها تعانب من الطعن
في صدورها عن النبي (ص) وفي دلالتها على المطلوب أيضاً.
اما الطعن في الصدور، فهو وضوح إن هذه الأحاديث تتم في مصلحةالحكام الذين تزعموا
على الأمة الإسلامية باسم الإسلام واستبزوا منها دماءها وخيراتها.. فقد أرادوا بوضع
هذه الأحاديث أن يأمروا المسلمين بالرضوخ لهم والصبر على جورهم، وينسوا ذلك إلى
رسول الله (ص).
فإن قال قائل: كيف تكون هذه الأخبار موضوعة، مع أنها تندد بهؤلاء الحكام، وتصفهم
بالفضائح.
أقول: لاتنافي بين الأمرين، إنطلاقاً من إحدى زوايا الثلاث:
الزاوية الأولى:
أن يكون وصف الحكام صحيحاً صادراً عن النبي (ص)، وهو لشهرته، لم يستطيعوا مكابرته
وإنكاره، وإنما أضافوا عليه وجوب الطاعة للحاكم المنحرف. فأصبح بعض الواية صحيحاً
وبعضها مدسوساً. وهذا هو المظنون بالظن الغالب.
الزاوية الثانية:
أن الحكام استطاعوا في هذه الزوايات أن يعرضوا أضخم صور للظلم ((وإن ضرب ظهرك وأخذ
مالك)) وزعموا أن الطاعة تكون واجبة بالرغم من ذلك. إذن فكيف الحال في الظلم الأخف
من ذلك؟.. أن الطاعة ستكون ألزم على الفرد بطبيعة الحال. إذن فليس هناك صورة من
الظلم إلا وتجب فيه الطاعة، للحاكم المنحرف.
الزاوية الثالثة:
أن الظلم في العصور المتأخرة عن صدر الإسلام كان واضحاً جداً لايمكنمكابرتهن ومن
هنا لم يكن هناك أي غضاضة أو كشف لسر غامض حين صرح الحكام بذلك. وإنما صرحوا به
إستطراقاً إلى غرضهم من ذبك وهو إثبات الأمر بالطاعة منسوباً إلى رسول الله (ص).
صفحة (347)
واما الطعن في دلالة هذه الأخبار، فهو معارضتها بأخبار أخرى رواها الشيخان في
الصحيحين، تدل خلاف مضامينها، وتكون أقرب إلى القواعد الإسلامية العامة.
أخرج الشيخان حديثاً(1) بلفظ متقارب واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عمر عن النبي
(ص) أنه قال: السمع والطاعة على المرء المسلم، فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية،
فإذا أمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة.
وأخرج مسلم(2) عنه (ص): إنما الطاعة في المعروف.
وأخرج أيضاً(3) عن عبد الله بن عمرو بن العاص في حديث عن معاوية. قال: فسكت ساعة..
ثم قال: أطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله. إلى غير ذلك من الأخبار.
إذن فتكون هذه الأخبار قرينة على تقييد تلك الأخبار بما إذا لم يأمر الحاكم بمعصية
لله أو يشرع قانوناً منحرفاً، أو يؤسس عقيدة باطلة، فإن فعل شيئاً من ذلك فلا طاعة
له. ومن المعلوم أن تقديم الخاص على العام من اوضح ما تقتضيه القواعد العامة.
غير أن هذا التقيدد، ينتج وجوب طاعة الحاكم المنحرف، إذا أمر بطاعة الله عز وجل.
وهو حكم غير صحيح في شريعة الإسلام، فإن وجوب الطاعة خاص بالحاكم الشرعي العادل.
وعلى ذلك يمكن حمل بعض هذه الأخبار السابقة.. مع طرح ما خالف القواعد العامة منها.
هذا. وأما الأخبار الدالة على صعوبة الصبر في مجتمع الفتن والإنحراف، فهو أمر صحيح
واضح.. إذ ما ظنك بفرد صادق بين كاذبين وأمين بين خائنين ومسالم بين معتدين.. كذلك
يكون حال المؤمنين بين المنحرفين. وهذا هو طبع التمحيص والتخطيط الإلهي على طول خط
الغيبة الكبرى.
ــــــــــــــــــ
(1) البخاري، جـ9، ص 78، ومسلم، جـ6، ص 15. (2) جـ6، ص 16. (3) جـ6، ص 18.
صفحة (348)
الأمر الثاني:
أن الأخبار الدالة على وجود الياس والقنوط، ذات مضمون صحيح، ومطابق للتمحيص.
فإن طول عصر الغيبة بنفسه حلقة من حلقات التمحيص الإلهي. إذ يزداد فيها الظلم، حتى
يكتسب الهيبة النفسية على ضعاف النفوس والإدارة، فيظنون قدراً حتمياً ووضعاً
أبدياً.. فيحصللديهم اليأس والقنوط.
كما أن امتداد غيبة الإمام المهدي (ع) سوف تنكشف في الضمائر المهلهلة والعقائد
المادية عن الشك أو الإنكار.
وحيث يكون وضع النفوس، هو الغالب في كل جيل إذن فسيكون الإتجاه العام للمجتمع، لدى
الفاشلين في التمحيص الإلهي، وهم الأغلب من البشر، كما عرفنا، سيكون هو اليأس
والقنوط، كما نطقت به هذه الروايات.
القسم السادس:
الأمر بكف اللسان في الفتنة.
سمعنا ما أخرجه الصدوق في إكمال الدين عن الإمام الباقر عليه السلام في أفضل ما
يتستعمله المؤمن في ذلك الزمان – يعني زمان الغيبة – قال: حفظ اللسان ولزم البيت.
وأخرج أبو داود(1) عن رسول الله (ص) قال: ستكون فتنة صماء بكماء عمياء(2) من أشرف
لها استشرفت له. واشراف اللسان فيها كوقوع السيف.
ــــــــــــــــ
(1) جـ2، ص 417. (2) وصف الفتنة بهذه الأوصاف بأوصاف أصحابها، أي لايسمع فيها الحق
ولاينطق به ولايتضح الباطل عن الحق. هامش السنن.
صفحة (349)
وأخرج الترمذي: تكون فتنة... اللسان فيها أشد من السيف(1) وأخرجه ابن ماحه أيضاً(2)
كلاهما عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله (ص):
وأخرج ابن ماجه(3) عنه (ص): أياكم والفتن. فإن اللسان فيها مثل وقع السبف.
ولفهم هذا القسم من الأخبار أطروحتان:
الأطروحة الأولى:
إن المراد كف الللسان والإجتناب عن الكلام، في عصر الفتنة، سواء فيما يذكي أوار
الفتنة أو فيما يضادها، ويكفكف من جماحها ويخفف من ضررها.
وهذا هو المفهوم من الإطلاق وسعة المدلول في هذه الأخبار، وخاصة الخبر الأول منها.
ولإذا كان هذا هو المفهوم، فلا بد من تقييده، بمقتضى القواعد العامة، التي تبرر
العزلة والسكوت أحياناً وتوجب العمل الإجتماعي تارةً أخرى. فيختص وجوب السكوت، بترك
الكلام الذي يكون مشاركة في الفتنة وإذكاء لأوراها. ويبقى الكلام المضاد للفتنة
مسكوتاً عنه في هذه الروايات، نعرف أحكامه من الأدلة الأخرى في الإسلام.
الأطروحة الثانية:
أن يكون المراد: وجوب كف اللسان عن المشاركة في لفتنة نفسها. فإن هذه المشاركة من
أشد أشكال الإنحراف، ومستلزم للفشل في التمحيص الإلهي لامحالة. ومعه تبقى المشاركة
بالقول والعمل في إزالة الفتنة أو تخفف شرها، أو مناقشة اتجاهاتها، واجبة في
الإسلام، طبقاً للقواعد العامة التي عرفناها. من دون أن تدل هذه الروايات على نفيه.
(1) جـ3، ص 320. (2) جـ2، ص 1312. (3) المصدر والصفحة.
صفحة (350)
وتؤكد هذه الأطروحة قرينتان
القرينة الأولى:
تشبيه اللسان بالسيف، في الرويات. ومن المعلوم أن استعمال السيف بالشكل المستنكر
المحرم في عصر الفتنة. إنما هو فيما يوجب تأييدها وتشديدها، لا فيما يكون ضدها، مع
اجتماع الشرائط. ومعه يكون استعمال اللسان بالشكل المحرم خاصاً بذلك أيضاً.
ولعل المراد من هذا التشبيه: هو استعمال اللسان في خضم الفتنة موجب – في نهاية
الشوط – لهلاك الكثيرين عقائدياً أو حياتياً، فيكون فعل اللسان كفعل السيف من هذه
الجهة. ومن المعلوم إسلامياً: أن الكلام الذي يوجب الهلاك هو الكلام الذي يتضمن
تأييد الفتنة والسير مع ركب الإنحراف. وأما الكلام الذي يردا به إطفاء الفتنة
ومناقشة الأراء المنحرفة، ونحو ذلك، ففيه سعادة الدارين وعز النشأتين ومواكبة العدل
الإسلامي الصحيح، فلا يمكن أن يقال عنه: إنه موجب للهلاك.
فنعرف من قرينة التشبيه في هذه الأخبار، أن المراج هو السكوت عن الكلام الذي يكون
إلى جانب الفتنة.
لقرينة الثانية:
الأخبار الأخرى الواردة في هذا الباب، الدالة على ان المراد من حفظ اللسان ترك
الكلام السيء الموجب لعصيان الله تعالى وغضبه.. وهو معنى ما قلناه من أنه يوجب
المشاركة في تأييد الفتنة والإنحراف. ومعه يبقى الكلام ضد الفتنة جائزاً بل واجباً
في الإسلام.
أخرج ابن ماجه(1) عن رسول الله (ص) أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل
خيراً أو يسكت. وعنه (ص) أيضاً: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله، لايرى بها
بأساً. فيهوى بها في نار جهنم سبعين خريفاً. وفي حديث آخر أيضاً: وإن أحدكم ليتكلم
بالكلمة من سخط الله، ما يظن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى
يوم يلقاه.
* * *
ـــــــــــــ
(1) جـ2، ص 1313
صفحة (351)
القسم السابع:
الأمر بالتقية في عصر الغيبة الكبرى.
وهذا المضمون مما اقتصرت عليه أخبار الإمامية، دون غيرهم. فقد أخرج الصدوق في إكمال
الدين(1) والشيخ الحر في وسائل الشعيعة(2) والطبرسي في إعلام الورى(3) عن الإمام
الرضا عليه السلام، أنه قال لادين لمن لاورع له، ولا إيمان لمن لا تقية له. وإن
أكرمكم عند الهه أعلمكم بالتقية قيل: يا ابن رسول الله: إلى متى؟. قال: إلى قيام
القائم، فمن ترك التقية قبل خروجنا قائمنا، فليس منا.. الحديث.
وفي الوسائل(4) عن معمر بن قلاد، قال: سألت أبا الحسن (ع) عن القيام للولاة. فقال:
قال أبو جعفر (ع): التقية ديني ودين آبائي، والا إيمان لمن لا تقية له.
وعن أبي عمر الأعجمي قال: كان أبي يقول: وأي شيء أقر لعيني من التقية؟ إن التقية
جُنَّةُ المؤمن!.
ومن طرائف ما ورد في التفسير(5) ما روي عن جابر عن أبي عبد الله (ع). قال: أجعل
بيننا وبينهم سداً، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاوا له نقباً. قال: هو التقية.
وعن المفضل(6) قال سألت الصادق (ع) عن قوله تعالى: أجعل بينكم وبينهم ردماً. قال:
التقية. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقباً. قال: إذاً عملت بالتقية لم
يقدروا لك على حيلة، وهو الحصن الحصين. وصار بينك وبين أعداء الله سد لا يستطيعون
له نقباً. قال: وسألته عن قوله: فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. قال: رفع التقية عن
الكشف، فانتقم من أعداء الله. أقول: المراد بالكشف ظهور المهدي (ع) في اليوم
الموعود.
(1) أنظر المصدر المخطوط. (2) جـ2، ص 545. (3) ص 408. (4) أنظر الأخبار، الثلاثة
الآتية في الوسائل، جـ2، ص 544.
(5) و (6) المصدر السابق، ص 545.
صفحة (352)
إلى غير ذلك من الأخبار، وهي من الكثرة إلى حد الإستفاضة بل التواتر.
ومدلولها الإسلامي الصحيح أمران مستشرفان:
الأمر الأول:
المحافظة على النفس من الإضرار التي لا مبرر لتحملها شرعاً.. إبتداءً بالقتل
وانتهاءً بما دونه. لا حرصاً على الحياة، بل لأجل الحفاظ على المعتقدين بالحق
الواقعي من المسلمين. والحد من نقصان عددهم بالقتل الذي يقع عليهم من قبل المنحرفين
الظالمين.. لو واصلوا الأعمال المثيرة لهم واعلنوا الجهاد ضدهم.
الأمر الثاني:
إخفاء الأعمال الإحتماعية الصالحة، التي يكون في كشفها نقصان لنتائجها أو إجتثات
لجذورها.
وعن هذا الطريق استطاع الأئمة المعصومون عليهم السلام أن يسندوا الثورات الحاصلة في
عصرهم والداعية إلى الرضا من آل محمد (ص).. من دون أن يدعوا أي مجال للآخرين
للإطلاع على مستندات هذا الإسناد. كما أشرنا إلى ذلك في التاريخ السابق.
وكلا هذين الأمرين منطلق من منطلق عقلاني عام. وهو واضح لدى كل من يعمل عملاً
سياسياً أو عقائدياً، أو غيره. أما الأمر الأول فباعتبار وضوح أن الفرد – مهما كانت
عقيدته وعمله – ليس على استعداد أن يضحي بحياته أو بأمنه بلا موجب. أو بموجب ضئيل
لا يستحق التضحية. وأما المر الثاني: فباعتبار وضوح قيام العقائد في العصر الحديث
على الحياة الحزبية، التي يغلب عليها طابع السرية والتكتم. طبقاً لما قلناه من أن
كشف حقائقها وتفاصيلها قد يكون سبباً لنقصان نتائجها أو إجتثاث جذورها.
صفحة (353)
ومن ثم يكون عدم الأخذ بالتقية، مؤدياً – على أقل تقدير – إلى بطء وجود العدد
الكافي من المخلصين الممحصين، الذين يشكلون وجودهم أحد شرائط الأساسية للظهور،
ليتكفلوا مسؤولية نشر القسط والعدل في العالم تحت قيادة المهدي (ع). فإن من يقوم
لالجهاد – عادة - في كل عصر، ليس إلا النخبة من المخلصين الذين يؤمل فيهم وصول
التمحيص إلى نتائجه النهائية الصالحة. فإذا لم يكن الأمر بالتقية موجوداً، لوجبت
المبادرة إلى الجهاد، وكان اول المطيعين لهذا الوجوب والمطبقين له، هم المخلصون في
كل عصر، ومعه، يتسبب الجهاد إلى إستعصائهم أو أكثرهم، مما يؤدي إلى بطء وجود شرط
الظهور أو تعذره، فيمتنع تحقق الغرض الإلهي الكبير في هداية العالم.
ولا داعي للإستعجال بالجهاد، فإنه مضافاً إلى عدم تأثيره العاجل بالنحو المطلوب،
يكون معيقاً عن إصلاح العالم في اليوم الموعود. وإذا دار الأمر بين الجهاد المستعجل
في جزء من العالم وبين الجهاد المؤجل في كل العالم.. يكون الثاني هو انافذ طبقاً
للتخطيط الإلهي، باعتباره منسجماً مع الهدف الأسمى من خلق البشرية، الذي عرفناه.
فإن قال قائل: إذا جاهد البعض يبقى البعض الآخر من المخلصين، مذخوراً لتحقيق شروط
الظهور.
قلنا له: لو لم يكن الأمر بالتقية موجوداً، وكان الأمر بالجهاد نافذاً، لوجب الجهاد
على كل المسلمين.. ولكان تركه عصياناً منافياً للإخلاص، فيجب على كل المخلصين في
العالم التصدي له والقيام به، فيؤدي ذلك – تدريجياً – الى استئصالهم جميعاً في كل
جيل. لما عرفناه من كونه قله بازاء الكثرة الكاثرة من المنحرفين والكافرين. فينتج
تعذر وجود شرط الظهور.
إذن، فالمفهوم الواعي الصحيح للتقية، وهو بعينه المفهوم الصحيح الذي استخلصناه من
الأمر بالعزلة وكف اللسان الذي استفاضت به أخبار المصادر العامة. وليس أمراً زائداً
ولا جديداً بالنسبة ليكون مثاراً للإستنكار والإستغراب من قبل العامة وأهل السنة.
فإن الأمر بالعزلة وكف اللسان، مع جعله منسجماً مع القواعد العامة، يكون مؤدياً إلى
عين النتيحة التي يؤديها الأمر بالتقية، وهو الخفاظ على المخلصين، لتحقيق شروط
الظهور.. الحفاظ عليهم عقائدياً وحياتياً.
صفحة (354)
فإن قال قائل: إن أهل السنة والجماعة، لا يؤمنون بغيبة المهدي (ع). فكيف يؤمنون
بشرط الظهور؟
قلنا: إن شرط الظهور إنما خطط الله تعالى لوجوده، باعتبار استهداف نشر القسط والعدل
في العالم في اليوم الموهود. سواء كان القائد المهدي (ع) غائباً قبل ظهوره أو لم
يكن. وتكون فكرة شرط الظهور، من الزاوية غير الإمامية لفهم المهدي، أن الله تعالى
قد خطط لليوم الموعود، قبل ولادة المهدي (ع). ثم إنه عز وجل سوف يوجد المهدي (ع)
عند علمه بنجاز الشرائط المطلوبة. لإذن فبقاء المخلصين ذخراً، امر صحيح من كلتا
الزاويتين الإمامية وغيرها، لفهم المهدي (ع).
بل أننا لو تأملنا قليلاً، لوجدنا أن القعود والعزلة وكف اللسان، مساوق مع التقية،
من الناحية العملية على طول الخط. فإنه لا يراد من التقية، إلا إتقاء شر الأشرار
وتجنب إثارتهم ضد المخلصين وما قد يقومون به من أعمال. إذن فالتقية لا تتحقق إلا
بالقعود عن المجابهة وكف اللسان عن المنحرفين. كما أن القعود وكف اللسان محقق
للتقية... إذن فقد اتفقت أخبار العامة والخاصة على شيء واحد، أو متشابه.
ومن هذا الذي قلناه، نفهم عدة أمور:
الأمر الأول:
أن العمل الإسلامي الإجتماعي، لكي يكون مواكباً مع التخطيط الإلهي، يجب أن يتحدد
بحدود التعاليم الإسلامية.. بدون أن يزيد عليها أو ينقص عناه. ويمثل كل من الزيادة
أو النقصان إنحرافاً عن الشريعة الإسلامية.
أما الزيادة، بمعنى إيجاد العمل الإجتماعي في موارد عدم وجوبه أو عند النهي عنه..
فباعتبار كونه موجباً لاستئصال المخلصين، ومعيقاً عن إيجاد شروط الظهور، كما عرفنا.
وأما النقصان: بمعنى ترك العمل مع الأمر به في الشريعة، فباعتبار كونه عصياناص
وانحرافاً.
صفحة (355)
ومن ثم يبدو بوضوح: إن الإحتجاج بأخبار التقية وغيرها مما سبق، لإهمال العمل
الإجتماعي الإسلامي، وتركه في موارد وجوبه.. حجة باطلة، ووجه غير وجيه. حيث عرفنا
أن هذه الأخبارـ وإن كانت ذات مدلول واسع بطبيعته، إلا أنها مقيدة لا محالة، بقيد
موارد وجوب العمل مع اجتماع شرائطه التي عرفناها. إذ مع وجوبهن تكون التقية والعزلة
وكف اللسان عصياناً وإنحرافاًز
الأمر الثاني:
أن الأمر بالتقية وترك العمل الإسلامي، بالشكل الذي فهمناه.. خاص بعصر الغيبة، أو
بعصر ما قبل الظهور. لما عرفناه من كونه دخيلاً في تحقيق شرط الظهور وقد حدد في
الخبر السابق عن الإمام الرضا (ع) بذلك، حيث قال: إلى قيام القائم، فمن ترك التقية،
قبل خروج قائمنا فليس منا.
وأما في عصر ما بعد الظهور، فمن المعلوم لدى كل من يؤمن بالمهدي وباليوم الموعود من
المسلمين، بل من سائر الأديان، أن تطبيق العدل في العالم، لا يكون إلا باستعمال
السلاح والجهاد وترك مجاملة الكافرين والمنحرفين. ويمون حكم التقية وكف اللسان
مرتفعاً. ومن هنا سمعنا المهدي (ع )نفسه، خلال عصر غيبته الصغرى يقول – فيما روي
عنه -: والله مولاكم أظهر التقية، فوكلها بي. فأنا في التقية إلى يوم يؤذن لي
بالخروج(1).
ومن هنا أيضاً عُبِّر في بعض الأخبار عن العصر السابق على الظهور، بعصر الهدنة..
كالذي روي عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، قال: سمعته يقول،
وسئل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أواجب هو على الأمة جميعاً؟ فقال: لا.
فقيل له: ولم؟ قال: إنما هو على القوى المطاع العالم بالمعروف من المنكر. إلى أن
قال: وليس على من يعلم ذلك في الهدنة من حرج، إذا كان لا قوة له ولا عدد ولا
طاعة(2).
ـــــــــــــــــ
(1) أنر تاريخ الغيبة الصغرى، ص 583، وغيبة الشيخ الطوسي، ص161. (2) وسائل الشيعة،
جـ2، ص 534.
صفحة (356)
وفي خبر آخر: عن حبيب بن بشير عنه عليه السلام، قال: سمعت أبي يقول: لا والله، ما
على وجه الأرض شيء أحب إلي من التقية.. إلى أن يقول: يا حبيب، إن الناس إنما هم في
هدنة... الخبر(1).
وسترتفع هذه الهدنة، مع الكافرين والمنحرفين، مع يزوغ فجر الظهور. ويكون بينهم وبين
الإيمان بالحق، حد السيف ووقع السلاح، ومناجزة القتال. وسنسمع تفاصيل ذلك في
التاريخ القام إن شاء الله تعالى.
الأمر الثالث:
إن ما يعتقده الكثيرون من الإمامية وغيرهم، من اختصاص حكم التقية، في اتقائهم أهل
المذاهب الإسلامية الأخرى... باطل غاية البطلان. بل الحكم مشترك بين سائر المسلمين،
في اتقاء بعضهم شر بعض، وفي اتقائهم من غير المسلمين، عند عدم وجوب العمل. فإن
المحافظة على المخلصين تكون بترك التعرض للقتال، على كلا المستويين، كما هو معلوم.
بل أن القتال بين المسلمين لأعظم شراً وأفدح أثراً من القتال مع غيرهم. وحسبنا منه
أن نفهم أن وقوعه بين المسلمين، يصدّع جمعهم ويشتت شملهم ويطمع بهم عدوهم ويسهل
دخول المستعمر إلى بلادهم، كما حدث بالفعل خلال القرون المتأخرة.
فإن قال قائل: إذن فلماذا ورد الأمر بالتقية في أخبار الإمامية دون غيرهم. قلنا: إن
المضمون الواعي الصحيح متحصل من أخبار كلا الفريقين. وإنما هو اختلاف في الاصطلاح،
فقد اصطلح عليه كل فريق باسم مستقل، فسمي في أخبار الإمامية بالتقية، وسمي في مصادر
أهل السنة بالعزلة. إذن فلم يختص الإمامية برواية المضمون، وإن اختصوا بالاصطلاح.
فإن قال قائل: إن بعض الأخبار طبقت وجوب التقية، على اتقاء الإمامية من غيرهم من
المسلمين. وهو يدل على اختصاص هذا الحكم بخصوص هذا المورد، ويكون قرينه على أن
المراد من كل أخبار التقية هو ذلك؟
ـــــــــــــــــ
(1) المصدر السابق، ص 544.
صفحة (357)
قلنا له: صحيح، ان هذا التطبيق موجود في أخبار الإمامية ووارد عن الئمة عليهم
السلام. ولكنه من باب تطبيق الحكم العام على بغض موارده... باعتبار اقتضاء المصلحة
له ف يعصر الأئمة عليهم السلام . لأجل ما كانت تعيشه قواعدهم الشعبية من اضطهاد
وتعسف من قبل الحكام في ذلك الحين . فكان الأئمة (ع) ، لأجل أن يضمنوا من أصحابهم
عدم التسرع والتطرف في رد الفعل تجاه ذلك ، مما قد يسبب الوصول إلى نتائج وخيمة هم
في غنى عنها ... فكان الأئمة (ع) يذكرون حكم التقية مطبقاً على هذا المورد المشار
إليه . ومعه لا تكون هذه الأخبار قرينة على الاختصاص .
وإن أوضح دليل ، على شمول حكم التقية لجميع المسلمين من ناحية ، وان الطرف المتقي
منه قد يكون من غير المسلمين أيضاً ، من ناحية أخرى ... قوله عز من قائل : ﴿ لا
يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء
، إلا أن تتقوا منهم تقاة ﴾(1) . حيث دلت على جواز تقية المسلمين من الكافرين .
وقصة عمار بن ياسر رضوان الله عليه ، مع المشركين في ذلك معروفة مشهورة ، وإنما
كانوا يحملونه على البراءة من الاسلام ، لا من مذهب معين !! . هذا ، وشمول الحكم
القرآني ، لجميع المسلمين ، يعتبر من ضروريات الدين .
الأمر الرابع :
في فهم أخبار التقية ، بمفرداتها وتفاصيلها . على ضوء ما أسلفناه من الفهم العام .
ويكون ذلك ضمن فقرات :
الفقرة الأولى :
"إن التقية جنَّة المؤمن " بمعنى أنها تستره وتحرسه . والمجن هو الترس الذي يجن
صاحبه .
قال عز وجل : اتخذوا إيمانهم جنة . وفي الحديث : الصوم جنة (2) . وكله من الحماية
والحراسة من الشر باعتبار اللجوء والتستر تحت السبب الموجب للحماية ، وهو الترس أو
الإيمان أو الصوم .
_____________________
(1) آل عمران : 3/28 . (2) مفردات الراغب الاصبهاني ، ص 98 .
صفحة (358)
ومن المعلوم ما للتقية في موارد جوازها أو وجوبها ، من أثر بالغ في حماية الفرد عن
كيد الأعداء , وإنحراف المنحرفين , في العقيدة والحياة والعمل . وليس على الفرد ـ
في سبيل نيل ذلك ـ إلا أن يسكت عن القول والعمل الذي لا يكون مشروعاً في الإسلام .
ومن هنا قال الصادق (ع) , فيما سمعناه من الرواية ,في تشبيه التقية بالسد الذي بناه
ذو القرنين , قال : إذا عملت بالتقية لم يقدروا لك على حيلة . وهو الحصن الحصين .
وصار بينك وبين أعداء الله سد لا يستطيعون له نقباً ... لأن الفرد إذا اتقاهم لم
يستطيعوا أن يجدوا ضدة مستمسكاً أو ذريعة لانزال الشر عليه .
الفقرة الثانية :
" إن من لا تقية له لا دين له " أولا إيمان له . وإن " تسعة أعشار الدين في التقية
" .
وهذا واضح المقصود بعد الذي عرفناه , من استلزم ترك التقية استئصال المخلصين , من
دون مبرر شرعي . فأي دين يمكن أن يبقى لتارك التقية بعد ذلك ؟! .
وذلك : أننا لم نفهم من التقية , فيما سبق , إلا ترك المقدار غير المشروع من الجهاد
والامر بالمعروف , مما يؤدي إلى إيقاع الخطر الكبير على المخلصين . وليس لأدلة
التقية مؤدى أكثر من ذلك . إذن فترك التقية يعني ارتكاب العمل غير المشروع . فإذا
كان هذا العمل موجباً لهلاك بعض المخلصين , كان محرماً , بل من أشد المحرمات في
الشريعة , فيكون فاعله ,بعيداً عن الدين والإيمان كل البعد . كما نطقت به الروايات
.
وهذا واضح على مستوى سائر الأخيار , سواء منها الواردة عن طريق العامة , أو الواردة
عن طريق الخاصة , بعد إعطاء الفهم الموحد السابق لها الذي سمعناه .
الفقرة الثالثة :
قول الإمام الرضا (ع) ـ في الرواية : إن أكرمكم عند الله أعملكم بالتقية .
فقد فسر عليه السلام قوله تعالى : أتقاكم . بمعنى أعملكم بالتقية وأشدكم تمسكاً بها
.
صفحة (359)
وهذا أيضاً مما لا غيار عليه ,بعد الذي عرفناه , وما دلت عليه اللغة من أن اتقاه
بمعنى حذره وخافه وتجنبه , أي وقى نفسه وحماها عن شره . ومن هنا كان المتجنب عن
عذاب الله تعالى متقياً , والعمل المؤدي إلى النجاة منه تقوى . وكذلك المتجنب من شر
الأشرار وكيد المنحرفين يكون متقياً , والفعل المؤدي إلى النجاة منه " تقية "
ومن هنا , يمكن أن نفهم من الآية , الشمول لكلا المعنيين ... بعد أن وافقت اللغة
على ذلك . فيكون المراد : إن أكرمكم عند الله أتقاكم من الله ون الناس . وتفسير
الإمام الرضا (ع) لها بأحد القسمين , وهو اتقاء شر الناس , لا يعني اختصاصها به ,
ليكون أمراً مستغرباً . وإنما ذكر أحد القسمين لمصلحة اقتضت ذلك , كمصلحة التوضيح
باعتباره معنى خفياً ... مع إبقاء القسم الآخر على فهم السامع وحكم اللغة .... وهو
تقوى الله تعالى .
لكن لا يخفى أن المتقي للناس , العامل بالتقية , إنما يكون كريماً عند الله عز وجل
, فيما إذا كانت التقية واجبة أو جائزة شرعاً . إذ تكون تقية الناس من تقوى الله عز
وجل , وأما في موارد حرمتها ,وهي موارد وجوب العمل الإسلامي العام , فالتقية , تكون
معصية مبعدة عن الله عز وجل , منافية مع التقوى , بكل تأكيد .
القسم الثامن :
من الأخبار الدالة على التكليف في عصر الغيبة : مادل على وجوب الإنتظار الفوري
,وتوقع الظهور في كل وقت , بالمعنى الذي سبق أن حققناه .
أخرج الطبرسي في الإعلام (1) والكليني في الكافي والصدوق في الإكمال (2) عن الإمام
الصادق عليه السلام في حديث عن الغيبة أنه قال : فعندما توقعوا الفرج صباحاً ومساء
.
وقد سبق أن سمعنا ما قاله المهدي (ع) للشيخ المفيد في رسالته إليه ـ برواية الطبرسي
في الاحتجاج (3) ـ من قوله : فليعمل كل امرء منكم بما يقرب به من محبتنا ، ويتجنب
ما يدنيه من كراهتنا، وسخطنا، فان أمرنا بغتة فجأة . الخ الرسالة .
ـــــــــــــــــــ
(1) إعلام الورى , ص 404 . (2) انظر المصدرين المخطوطين . (3) جـ 2 , ص 324 .
صفحة (360)
وروي عن الامام الصادق (ع)(1) أنه قال : وهو يعدد الدين الحق : الورع والعفة
والصلاح ... إلى قوله : وانتظار الفرج بالصبر .
وعن أمير المؤمنين(2) : انتظروا الفرج ، ولا تيأسوا من روح الله ، فان أحب الأعمال
إلى الله عز وجل ، انتظار الفرج .
وفي الاكمال(3) عن النبي (ص) ، قيل له : يا رسول الله ، منتى يخرج القائم من ذريتك
. فقال : مثله مثل الساعة لا يجليها لوقتها إلا الله عز وجل . لا تأتيكم إلا بغتة .
وفي منتخب الاثر (4) عن اكمال الدين أنه أخرج عن الامام الرضا (ع) قوله : ما أحسن
الصبر وانتظار الفرج . أما سمعت قول الله عز وجل : فارتقبوا اني معكم رقيب ...
فانتظروا اني معكم من المنتظرين ... فعليكم بالصبر ، فإنما يجيء الفرج على اليأس .
وأخرج الترمذي(5) عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : سلوا الله من فضله ، فان الله يحب أن يسأل . وأفضل العبادة انتظار الفرج .
وفي الكافي(6) عن أبي الجارود قال : قلت لأبي جعفر : يا ابن رسول الله ، هل تعرف
مودتي لكم وانقطاعي اليكم وموالاتي إياكم . قال : فقال : نعم ... إلى أن يقول :
والله لأعطينك ديني ودين آبائي الذي ندين الله ندين الله عز وجل به : شهادة أن لا
إله إلا الله وأن محمد رسول الله ... إلى أن يقول : وانتظار قائمنا والاجتهاد
والورع .
__________________
(1) منخب الأثر ، ص498 . (2) نفس المصدر والصفحة . (3) أنظر المصدر المخطوط . (4) ص
496 . (5) جـ 5 ، ص 225 .
(6) أنظر المصدر المخطوط .
صفحة (361)
وفيه أيضاً عن الامام الباقر عليه السلام ، في ذكر الدين الذي يقبل فيه العمل . قال
: شهادة أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ... إلى أن يقول : والورع والتواضع ،
وانتظار قائمنا . فان لنا دولة ، إذا شاء الله جاء بها .
إلى غير ذلك من الأخبار ، وسيأتي فيما سنسمعه من الأخبار الناطقة بفضل الانتظار
والمنتظرين ، خلال عصر الغيبة ، ما يدل على ذلك أيضاً .
وقد سبق أن تكلمنا عن المفهوم الصحيح للانتظار ، وها قد سردنا الأخبار الدالة على
ذلك . وأما السؤال عن منافاة مفهوم الإنتظار مع العلامات المجعولة للظهور ، أو عدم
منافاتها معه ، فقد سبق أن ناقشناه . وسيأتي تفصيل ذلك ، في القسم الثالث من هذا
التاريخ .
وقد يقول قائل : إن أغلب هذه الأخبار ، لم تنص على أن المراد هو انتظار ظهور المهدي
(ع) أو اليوم الموعود . فلعل المراد هو انتظار الفرج بعد أي شدة .
فنقول في جوابه : أنه يمكن الانطلاق إلى اثبات اختصاص هذه الأخبار بانتظار ظهور
المهدي (ع) من زاويتين :
الزاوية الأولى :
الاستفادة من الأخبار المصرحة بذلك ، مما ذكرناه ...وجعلها قرينة على أن المراد من
الأخبار الأخرى هو ذلك أيضاً.
وليس في ذلك ما ينافي كلا الأطروحتين : الامامية وغيرها في فهم المهدي (ع) . فان
انتظاره على كل حال من أفضل العبادة ... سواء كان المهدي (ع) موجوداً غائباً أو لم
يكن .
الزاوية الثانية :
إن انتظار الفردج الذي يكون مهماً إلى هذا الحد ، ومشدداً عليه في لسان المعصومين
عليهم السلام بهذا المقدار ...حيث نسمع أنه أحب الأعمال إلى الله عز وجل ، وأنه
أفضل العبادة ، وأنه أساس من أسس الدين ... هذا لا يمكن أن يكون انتظار الفرج من
مشكلة معينة أو صعوبة فردية . فان غاية ما يطلب من الفرد إسلامياً خلال المصاعب هو
الصبر ، وعدم الاعتراض على الله في ذلك . وأما انتظار ارتفاع الصعوبة ، فلا يعطي
مزية زائدة بحسب ما هو المفهوم منالقواعد العامة في الإسلام .
صفحة (362)
وإنما هذا الانتظار الكبير ليس إلا انتظار اليوم الموعود ، باعتبار ما يستتبعه من
الشعور بالمسؤولية والنجاح في التمحيص الالهي ، والمشاركة في إيجاد شرط الظهور ، في
نهاية المطاف ...كل ذلك لمن يشعر بهذا الانتظار ويكون على مستوى مسؤوليته ، بخلاف
من لا يشعر به ، بل يبقى على مستوى المصلحة والأنانية ...فانه لن ينال من هذه
العبادة الفضلى شيئاً .
ونستطيع بكل وضوح أن نعرف أنه لماذا أصبح هذا الانتظار أساساً من أسس الدين ...
لأنه مشاركة في الغرض الأساسي لايجاد البشرية ، ذلك الغرض الذي شارك فيه ركب
الأنبياء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً .
إذن فهذه الأخبار ، لا يمكن أن يكون لها معنى ، إلا المشاركة في هذا الهدف الكبير .
* * *
الجهة الخامسة :
في فضل الانتظار والمنتظرين ، خلال عصر الغيبة الكبرى ... والصابرين على البأساء في
عهد الفتن والانحراف .
وننطلق إلى الكلام في ذلك من ناحيتين :
الناحية الأولى :
فيما تقتضيه القواعد العامة الاسلاميةمن ذلك :
يقوم الفرد المسلم المخلص في عصر الغيبة الكبرى بعدة مهام إسلامية ، لها أكبر الفضل
وأعظم الأثر في تربية الفرد وتكامله ، وقربه من تعاليم ربه ورضاه .ويفضل في ذلك –
احياناً – حتى على عصر النبوة وعصر الظهور. وتتلخص تلك المهام في عدة أمور :
الأمر الأول :
الإيمان بالغيب . فان الفرد المسلم في هذا العصر ، يختلف حاله عن المسلمين في عهد
النبي (ص) من حيث وضحوح الاعتقاد بالعقائد الاسلامية ، وقربها إلى الحس ، طبقاً لما
يميل إليه البشر من ميلهم إلى شهادة الحس وانشدادهم إلى الزمان والمكان .
صفحة (363)
وقد كان هذا موفراً في عهد النبي (ص) ، حين كان هو (ص) الذي يمارس الدعوة
الاسلاميةبيده ، فتتوفر على يده العديد من المزايا التي لا يمكن أن يوجد مجموعها في
أي عصر آخر .
المزية الأولى :
قوة الاقناع الناتجة مما له من الثقافة الالهية العالية ... وما له من الهيبة في
نفوس المسلمين .
المزية الثانية :
تلقى الوحي من الله عز وجل ، في القرآن وغيره .حتى لكأن الفرد الاعتيادي آنذاك ،
يحس بأثر تعاليم الوحي في حياته العملية ، وتطبقها ف يمجتمعه الذي يعيشه ،ويحس بما
يستجد من تعاليم وتوجيهات ... وبما ينزل من قرآنمبشراً ومنذراً ومعلماً ومهدداً .
المزية الثالثة :
العدل الشامل الذي ساد الدولة الاسلامية في عصره (ص) ... ذلكالعدل الذي أعطى الدليل
التاريخي الحاسم على مر العصور ، وإلى يوم الظهور الموعود ... على نجاح التجربة
الاسلامية في مجال التطبيق .
المزية الرابعة :
النص المؤزر المستمر الذي كان يناله الجيش الاسلامي بقيادته (ص) ، مما لا يمكن أن
يخطر على بال ، بحسب التخطيطات العسكرية المعروفة يؤمئذ ... بل في كل عصر ، مع حفظ
النسبة بين الجيشين المتحاربين عدة وعدداً . وذلك نتيجة للتوفيق الالهي الذي كان
يحالفه في غزواته ، كما نطق به التنزيل ، ودلت عليه التجربة التاريخية .
صفحة (364)
المزية الخامسة :
شخصيته (ص) من حيث كونه المثل الأعلى للخلق الاسلامي الرفيع . فقد طبق على نفسه
التعاليم التي جاء به بدقة وإخلاص ، فكان مثلا ًيحتذى وقدوة للورى وكمالاً إنسانياً
عالياً ، حتى نطق التنزيل بالاعجاب به وتأييده بقوله عز من قائل : ﴿ وأنك لعلى خلق
عظيم ﴾(1) .
إلى غير ذلك من المميزات التي لا شك أن لها الأثر البالغ العميق في تقريب الفرد من
الايمان وإيضاحه له وترسيخه في نفسه ... حتى أنه ليكاد يرى جميع العقائد والمفاهيم
التي يبشر بها النبي (ص) حسية جلية واضحة للعيان ، بالرغم من كونها أموراً فكرية أو
ميتافيزيقية .
ورغم هذا الوضوح ، فقد مدح الله تعالى : ﴿ الدين يؤمنون بالغيب ﴾(2) و ﴿الذين يخشون
ربهم بالغيب﴾(3) ، وأثنى عليهم في عدد من مواضيع كتابه الكبير .
وسيتوفر مثل هذا الوضوح ، في تطبيق آخر لهذه المميزات العديدة ، ما عدا الوحي ، في
القائد الاسلامي العالمي الجديد ، المهدي (ع) الذي سيتكفل إيضاح الدعوة الاسلامية
وتطبيقها على البشر أجمعين .
إلا أن شيئاً من هذه المميزات ، لا يكاد يوجد في عصر الغيبة الكبرى ، عصر الفتن
والانحراف . ومن هنا ، كان الإيمان بالعقائد الاسلامية بالنسبة إلى الفرد الاعتيادي
، أبعد عن الحس ، يحتاج إلى صدر أرحب ووجدان أخصب وتعب ف يالفحص والتفكير أكثر ...
خاصة بعد الحكم الاسلامي ، وتأكيد القرآن على عدم جواز التقليد في العقيدة ، وشجب
اتباع الاباء والمربين بدون برهان ، بل لا بد للفرد أن يأخذ بزمام عقيدته بنفسه
ويومن بها عن الوعي واقتناع .
________________
(1) القلم ك 68/4 . (2) البقرة : 2/3 . (3) الأنبياء : 21/49 . والملك : 67/12 ،
وفاطر : 35/18 .
صفحة (365)
ومن المعلوم أنه كلما حصل العناء في سبيل العقيدة الالهية ، أكثر ، واستلزم الايمان
تضحية أكبر ... وكانت النتائج صحيحة صالحة ... كان ذلك موجباً للكمال البشري والقرب
الالهي بشكل أكبر وأعظم .
وهذا المعنى بالذات ، من جملة حلقات التخطيط الالهي لتربية الأفراد المخلصين
الممحصين في عصر الفتن والانحراف . وسنوضح ذلك بعد قليل .
الأمر الثاني :
مما يقوم به الفرد المخلص في عصر الغيبة : تحمل التضحيات والمشاق في سبيل إيمانه
وتمسكه بإسلامه ... تلك المشاق التي لم تكن موجودة في عصر النبوة ولن تكون موجودة
في عصر الظهور .
فإن المشاق التي تبذل عادة في سبيل العقيدة على قسمين :
القسم الأول :
ما يبذله الفرد عن طواعية واختيار ، من خدمات وأتعاب .وهو ما سميناه بالتمحيص
الاختياري .وعرفنا أثره الكبير في تكامل الفرد طبقاً لقانون التمحيص العام .
القسم الثاني :
ما يقع على الفرد من الآخرين في المجتمع ، من قهر ومطاردة وإيلام ، ضد إيمانه
وأعماله وعقيدته .
ويختلف هذان القسمان في ثلاثة مستويات رئيسية :
المستوى الأول :
إن القسم الأول مشترك بين عصر النبوة وعصر الغيبة وعصر الظهور . فان لكل عصر من هذه
العصور مشاكله التي تحتاج من المخلصين المبادرة إلى حلها .وحسبنا من ذلك ، إن الفرد
في عصر النبوة كان يخرج طواعية لينال الشهادة في سبيل الحق والواجب .
ولكن القسم الثاني : غير موجود في المجتمع الذي يحكمه الاسلام ، سواء في عصر النبوة
او عصر الظهور ... وإنما هو بعصر الفتن والانحراف ... هذه العصور التي نعيشها ، حيث
أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً ، وطورد المخلصون على اخلاصهم وحسن تصرفهم .
صفحة (366)
المستوى الثاني :
إن القسم الأول من التضحية منسجم مع العقيدة ، لا يجد الفرد فيه أي مجابهة لها أو
مناقضة لمقتضياتها . باعتبار كون القيام به مطابق مع تعاليمها وفي مصلحة الدعوة
اليها والتركيز عليها .
وأما القسم الثاني ، فهو يتضمن – بشكل مباشر وصريح – مجابهة للعقيدة ، وأيقاعاً
للظلم على الفرد باعتبار ما يحمله من إيمان وما يقوم من عمل في سبيل الحق .
المستوى الثالث :
إن القسم الثاني أكثر إيلاماً للنفس وأصعب تحملا ًللفرد من الأول .
فإن القسم الأول من التضحية ، مهماجر من مصاعب وآلام ، فانه أمر اختياري للفرد لا
يجد فيه أسفاً . وإنما يجد فيه المخلص حلاوة الايمان ونور العمل الصالح .
وأما القسم الثاني ، فيجد فيه الفرد ضغط الاضطرار وقسوة المرارة وضيق الالم ...
ولولا ثقة الفرد بربه وعقيدته ، وقائده المهدي (ع) ، لكان من الهالكين .
وعلىأي حال ، فمن الجلي أن تحمل التضحية من كلا القسمين ، كما عليه حال العمل العام
خلال الغيبة ، أصعب منه وأعقد من تحمل قسم واحد من العمل . وهذا أيضاً أحد عناصر
التمحيص الالهي وأسبابه ، على ما سنذكر .
الأمر الثالث :
صمود الفرد ضد الاغراء ، بشكل غير موجود ، لا في عصر النبوة ولا في عصر الظهور .
صفحة (367)
فإن الاغراء الذي قد يواجهه الفرد على قسمين :
القسم الأول :
الاغراء الناتج من مصالحه الشخصية وشهواته النفسية ، باعتبار ما للشهوات
الغريزية من اندفاع الاشباع ، من دون أن تنظر إلى الطرق والوسائل . وقد قيل صدقاً :
إن الغرائز لا عقل لها .
القسم الثاني :
الاعراء الناتج من قبل الآخرين ، حين يرى الفرد ما لعصر الفتن والانحراف من جمال
وحضارة وتنظيم ... وما لاتباع تياراته وحكامه من ضمان للمال والشهوة والراحة في
الحياة . فيأتي كل ذلك إلى نظر الفرد بهيجاً عظيماص يغويه بالاتجاه نحوه والحصول
عليه والعمل على الوصول إليه .
والقسم الأول ، مواكب للبشرية على طول وجودها الطويل ، ما دام في الانسان في
الانسان شهوات وما دامت له مصالح خاصة . لا يختلف فيه عصر الغيبة الكبرى عما قبله
أو ما بعده . وهذا هو المحك الأساسي للتمحيص العام للبشرية أجمعين .
إلا أن القسم الثاني خاص بعصر الغيبة الكبرى ، بصفتها عصر الفتن والانحراف . لوضوح
أن المصالح الشخصية التي تقتضي الاغراء بالحصول على القوة والمال ، كلها موجهة إلى
دولة الحق ، عند وجودها في عصر النبوة أو عصر الظهور ... بخلافه في عصر الغيبة ،
فانها موجهة للحضارة المادية والحكام المنحرفين .
الأمر الرابع :
إيمان الفرد بالمهدي (ع) ، ويتجلى ما يستلزمه من تضحيات ومصاعب ، في مستويات ثلاثة
:
المستوى الأول :
كونه إيماناً بالغيب ... فيلاقي من العقبات ما قلناه في الأمر الأول ، سواء كان
باعتبار الايمان باليوم الموعود ، الذي يطبق الله تعالى أطروحته الكاملة على البشر
. أو باعتبار الإعتبار الإيمان بالمهدي (ع) على الخصوص كقائد لذلك اليوم الموعود .
أو باعتبار الايمان فعلاً بوجود المهدي (ع) وغيبته ... على الاختلاف بين الناس في
هذه العقائد الثلاث. فان الايمان بأي واحدة منها إيمان بالغيب ، فضلاً عن الايمان
بها جميعاً ، طبقاً للفهم الامامي للمهدي (ع) . فانها جميعاً خارجة عن الحس
الاعتيادي . إلالأولئك الخاصة الذين شاهدوا المهدي (ع) على وجه التعيين . وقليل ما
هم .
صفحة (368)
المستوى الثاني :
إستلزام طول مدة الغيبة وتماديها ، بحسب الذهنية الاعتيادية للبشر ، فيما شاهدوا من
مقادير عمر الانسان ، استلزامه لاستبعاد وجود المهدي (ع) خلال هذه المدة ، وترجيح
موته أو عدم ولادته .
كيف وهو المذخور لنشر العدل ورفع الظلم ، فلماذا لا يخرج لنشره وهو يرى الظلم
المتفاقم على وجه الأرض . وقد أسلفنتا الجواب على مثل هذه الأسئلة ، فلا نعيد .
المستوى الثالث :
ما يستلزمه الايمان بوجود المهدي (ع) وعلمه بأعمال الناس ومشاهدته للمجتمع عن كثب
حال غيبته ... من شعور الفرد بالمسؤولية المضاعفة ، بالتركيز على العمل الصالح على
الصعيدين الشخصي والاجتماعي ، ليكون عند حسن ظن قائده به وثقة إمامه .
ومن الواضح ، أن الإيمان بالغيبة وما تتضمنه من مصاعب ، غير موجود ، لا في عصر
النبوة ، ولا في عصر الظهور .
إذن ... فهذه أمور أربعة ، تمثل المسؤوليات المهمة والتضحيات الكبرى التي يجب على
الفرد المسلم القيام بها خلال الغيبة الكبرى . وهي التي – بمجموعها – جعلت هذه
الفترة من عمر البشرية الطويل ، أصعب الفترات ، من حيث تأكد التمحيص وعمق الامتحان
. والتي جعلت الفوز فيه بالشكل الكامل الشامل ، قليلاً ومحتاجاً إلى زمان طويل
وتربية مستمرة ، سواء على مستوى الفرد ، أو على مستوى الأمة جميعاً .
كل ذلك ، ليتحقق الضمان الأكيد في الحصول على جماعة من الصامدين ضد كل هذه المصاعب
، الناذرين أنفسهم في سبيل ربهم وعقيدتهم على كل حال ، لا تأخذهم في الله لومة لائم
... ليكونوا هم أعوان المهدي (ع) في نشر القسط والعدل على وجه البسيطة في اليوم
الموعود ... وبغير هذا المستوى من الاخلاص ، لن يمكن تحقيق الحكم العالمي العادل ،
بأي حال من الأحوال .
صفحة (369)
فهذا هو الكلام في الناحية الأولى ، في ما تقتضيه القواعد العامة من فضل الاخلاص
والمخلصين خلال عصر الفتن والانحراف ، بشكل يفوق غيره من العصور .
الناحية الثانية :
فيما نطقت به الأخبار من فضل المؤمنين المخلصين المضحين في سبيل الله في عصر الفتن
والانحراف ... المنتظرين لليوم الموعود ، فيما قبل الظهور .
أخرج مسلم (1) والترمذي (2) وابن ماجة (3) عن النبي (ص) أنه قال : العبادة في الهرج
كهجرة إليَّ .
والفهم الواعي الصحيح لهذا الحديث الشريف ، يتوفق على تقديم عدة مقدمات :
المقدمة الأولى :
إن المراد بالهرج ، وهو الفتن والانحراف الذي يقع في عصر الغيبة الكبرى .
باعتبار ما نطقت به أخبار الفريقين ومصادر العامة على وجه الخصوص ، من وقوع الهرج
والقتل والفتن خلال هذا العصر . فان هذه الأخبار ، تكون قرينه تدلنا على ان المراد
بالهرج في هذا الحديث هو عصر الهرج والفتن ، لا نفس الهرج ، وهو القتل .
المقدمة الثانية :
يراد بالهجرة إلى النبي (ص) : الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام . وهو في واقعه
أساس الأعمال الاسلامية جميعاً ومبدؤها الذي تنطلق منه ، لأنها تعبير آخر عن اعتناق
الاسلام نفسه .
المقدمة الثالثة:
قد عرفنا ما تقتضيه القواعد من أن الإيمان والعمل الاسلامي ، كلما واجه من العقبات
أكثر واحتاج من التضحيات إلى عدد أكبر ، كان مقرباً إلى الله تعالى بشكل أعمق
وموجباً لتكامل الفرد بنحو أسرع .
___________________
(1) جـ8 ، ص 208 . (2) جـ 3 ، ص 332 . (3) جـ 2 ، ص 1318 .
صفحة (370)
المقدمة الرابعة :
يراد بالعبادة ، معناها العام ، لا خصوص الصلاة والصوم ، وإن كانت هذه من أقدس
أشكال العبادات . بل يراد كل عمل مطلوب في الاسلام يحققه الفرد امتثالاً للأمر
الالهي ، وتطبيقاً لتعاليم الإسلام . فتشمل العبادة بهذا المفهوم سائر العال
الاسلامية ، الفردية منها والاجتماعية ، كما سبق أن حملنا عن ذلك فكرة كافية ...
وحققناه مفصلاً في بحث متكامل عن المفهوم الواعي للعبادة في الاسلام .
إذن ينتج من هذه المقدمات الأربع : أن مراد النبي (ص) من حديثه هذا هو : أن العمل
الاسلامي في سبيل الله بمختلف مستوياته ، مما يقع في عصر الهرج والفتن والانحراف له
من الفضل عند الله وعند رسوله ، كفضل اعتناق الاسلام نفسه .
وليس ذلك بالعجيب ، بعد الذي سمعناه من الأخبار ورأيناه بالعيان ، من مجابهة الفتن
والانحراف ، للعقيدة من مجابهة الفتن والانحراف ، للعقيدة والمعتقدين ، وقهرهم على
ترك الإيمان والخروج عن طاعة الله عز وجل ، بمختلف وسائل الظلم والاغراء ... إذن
فتكون المحافظة على العقيدة والبقاء على السلوك الصالح ، من الأهمية كالدخول في
الاسلام لأول مرة ، وليت شعري ، قد يكون البقاء على العمل الصالح مستلزماً للتضحية
والمتاعب أكثر مما يستلزمه اعتناق الاسلام لأول مرة .
وأخرج ابن ماجة (1) والترمذي(2) في حديث رسول الله (ص) قد سبق أن سمعنا قسماً منه ،
أنه قال : فان من ورائكم أيامٍ الصبر .الصبر فيهن على مثل قبض على الجمر . للعامل
فيهن أجر خمسين رجلاً يعملون بعمله .
فالعمل الواحد المتشابه ، يتضاعف فضله وأجره ، بتضاعف التضحية في سبيل تحقيقه . حتى
إذا ما وصلت التضحية إلى أوجها ، وكان التمسك بالدين كالقبض على الجمر في الشدة
والبلاء ، وصل الفضل والأجر إلى أوجه أيضاً ... وكان العمل الواحد ، من الرجل
الواحد ، في مثل هذا الظرف ، معادلاً لعمل خمسين عامل مثله ، في حال الرخاء والدعة
.
_________________
(1) جـ2 ، ص 1331 . (2) جـ2 ، ص 437 .
صفحة (371)
ورقم الخمسين ، بطبيعة الحال ، لا يراد به التحديد ، بل هو لمجرد المبالغة والتكثير
كقوله تعالى : ﴿أ، تستغفر لهم سبعين مرة ﴾(1) . فلا ينافي القول بأن فضل الفرد
الصابر المجاهد قد يفرق عمل غيره باضعاف هذا المقدار ، بازدياد ما يتحمل من المحن
والآلام .
وروى الكليني في الكافي (2) بسنده إلى عمار الساباطي . قال قلت لأبي عبد الله (ع) :
أيما أفضل العبادة في السر مع الامام المستتر في دولة الباطل ، أو العبادة في ظهور
الحق ودولته (3) مع الامام منكم الظاهر .
فقال : يا عمار : الصدقة في السر أفضل من الصدقة في العلانية . وكذلك – والله –
عبادتكم في السر مع إمامكم المستتر في دولة الباطل وحال الهدنة ، أفضل ممن يعبد
الله عز ذكره ، في ظهور الحق مع إمام الحق الظاهر في دولة الحق . وليست العبادة مع
الخوف في دولة الباطل مثل العبادة والأمن في دولة الحق ...
إلى أن يقول : قلت : قدر الله رغبتي في العمل وحثثتني عليه .
ولكن أحب أن أعلم كيف صرنا نحن اليوم أفضل أعمالاً من أصحاب الإمام الظاهر منكم في
دولة الحق ، ونحن على دين واحد .
فقال : أنكم سبقتموهم إلى الدخول في دين الله عز وجل ، وإلى الصلاة والصوم والحج ،
وإلى كل خير وفقه ، وإلى عبادة الله عز ذكره سراً من عدوكم مع إمامكم المستتر ،
مطيعين له صابرين معه منتظرين لدولة الحق ، خائفين على إمامكم وأنفسكم من الملوك
الظلمة ... مع الصبر على دينكم وعبادتكم وطاعة إمامكم والخوف من عدوكم . فبذلك ضاعف
الله عز وجل الأعمال ، فهنيئاً لكم .
قلت : جعلت فداك ، فما ترى إذن أن نكون من أصحاب القائم ، ويظهر الحق .ونحن اليوم
في إمامتك وطاعتك ، أفضل أعمالاً من أصحاب دولة الحق والعدل .
___________________
(1) التوبة 9/80 . (2) أنظر المصدر المخطوط . (3) في المصدر المخطوط : ودولة .
والظاهر أنه تحريف .
صفحة (372)
فقال : سبحان الله . أما تحبون أن يظهر الله تبارك وتعالى الحق والعدل في البلاد ،
ويجمع الكلمة ويؤلف الله بين قلوب مختلفة ، ولا يعصون الله عز وجل في أرضه وتقام
حدوده في خلقه ، ويرد الله الحق إلى أهله ، فيظهر حتى لا يختفي شيء من الحق ، مخافة
أحد من الخلق (1) . أما والله يا عمار ، لا يموت منكم ميت على الحال التي أنتم
عليها ، إلا كان أفضل عند الله من كثير من شهداء بدر وأُحُد .
فابشروا .
ودلالة على هذه الرواية على تفضيل العبادة والعابدين والصبر والصابرين، خلال عهود
الظلم والانحراف ، على العبادة في عهود الراحة والرخاء ، ذلك الرخاء الناتج عن حصول
دولة الحق بقيادة الإمام المهدي (ع) وتطبيقه للأطروحة العادلة الكاملة على العالم .
دلالة على ذلك ، أوضح من أن يخفى أو أن يكون محلاً للمناقشة .
ولكننا من أجل تجلية الموقف ، نود التعرض إلى نقطتين :
النقطة الأولى :
أنه قد اشترط الإمام الصادق عليه السلام ، في هذه الرواية ، في تحديد فضل الصابرين
... بأن يكونوا مع إمامهم المستتر .يعني : المستتر بإمامته ، لا يباشر الحكم .فقد
يقول قائلاً : أننا الآن في عصر الغيبة الكبرى لسنا مع إمام ظاهر ، ولا مع إمام
مستتر – بذلك المعنى – فلا يكون لمخلصنا من الفضل ما وصف في هذه الرواية .
ويجاب عن ذلك ، على مستويين :
المستوى الأول :
أننا بالفعل مع إمام مستتر ، طبقاً للمفهوم الامامي ، الذي انطلقت منه هذه الرواية
... ولسنا محرومين من هذه المزية لكي لا يشملنا الفضل الموصوف في الرواية .فان
المهم هو كون الفرد موافقاً مع الإمام إماناً وعقيدة . وتستطيع أنت أن تضيف إلى ذلك
– إن رغبت - : كونه معاصراً له في الزمان . وكلا هذين الأمرين متوافران لدى من
يعتقد بالغيبة .فانه يعتقد أنه على طول الخط معاصراً زماناً مع إمامه المهدي (ع)
،ومتفق معه في العقيدة والإيمان . وأما كون الامام معروفاً بالشخص فهذا ليس له أي
دخل في صدق كون الفرد معه ، كما هو واضح .
___________________
(1) في المصدر المخطوط : مخافة أحد من أحد من الحق . وهو تخريف ، يرجح أن يكون
صحيحه ما أثبتناه .
صفحة (373)
وبتعبير أدق : إن المهم الذي أكدت عليه الرواية ، هو كون الامام مستتر بإمامته
خوفاً من الظالمين ... كون الفرد مطيعاً له عقيدة وسلوكاً . وهذا بنفسه متوفر في
عصر الغيبة ، بالنسبة إلى الفرد المخلص ، كما كان متوفراً في عصر الأئمة (ع) . فان
كلا العصرين ، هما من عصور الفتن والانحراف وانحسار الحق واستتار الامام . ولا يبقى
لمعروفية الامام بشخصه دخل مهم من هذه الجهة .
المستوى الثاني :
أننا نفترض – جدلاً – أن وجود الغيبة يمنع من كوننا مع الامام . أو نجر الكلام إلى
من لا يقول الغيبة أصلاً . ولكن مع ذلك نقول بشمول الفضل الموصوف في الرواية
للمخلصين الموجودين خلال عصر الفتن والانحراف .
فان ما هو المدار في ثبوت الفضل ، وما هو الأساس في التمحيص الالهي ، على ما عرفنا
، إنما هو الخوف ، من الظلم والصمود ضد كيد الأعداء وضد مطاردة المنحرفين ... فان
العمل والعبادة خلال الخوف ، أفضل وأعلى في درجات الكمال ، من العمل في عصور
الاطمئنان والرخاء . وهذا الجو العاصف موجود في القرون المتأخرة ، كما هو موجود في
عصر الأئمة المعصومين عليهم السلام بدون فرق .فان كلا العصرين ، من عصور الفتن
والانحراف.
ويزداد الخوف وتتكاثر المصاعب ضد المخلصين ، في العصور المتأخرة عن عصر الأئمة (ع)
من عدة نواحٍ :
الأولى : إن الحكم في ذلك العصر ، مهما كان مصلحياً ومنحرفاً ، كان يقوم باسم
الاسلام ، وعلى أساس تطبيقه . على حين لا نجد اليوم على وجه الأرض حاكماً على
الاطلاق يمثل هذا الاتجاه . بعد أن اتجهت أساليب الحكم إلى المادية والعلمانية .
الثانية : أن التنظيم العام الذي تقوم عليه الدولة في ذلك العصر ، كان أبسط بكثير
مما تقوم عليه الدول اتلآن . من جهات عديدة جداً . في الجهاز العسكري وجهاز الشرطة
ونوع الأسلحة وشكل الحكم وأسلوب التجسس والمطاردة ، وتنظيم الدولة ، والأحزاب
والتكتلات ... إلى غير ذلك .
صفحة (374)
الثالثة : أنه في ذلك العصر ، كانت تغزو المجتمع تيارات إلحادية وأساليب هدامة ،
إلا أنه كانت ضعيفة ، مرفوضة من قبل الرأي العام المسلم ومطاردة من قبل السلطات
الحاكمة . وأما التيارات الالحادية ونحوها ، اليوم ، فهي مدعمة بتفكير المفكرين
وتأليف المؤلفين ، ووسائل الاعلام العالمية ، ومدعمة أيضاً بالتأييد المطلق من قبل
كثير من الدول ، تبذل عليها الميزانيات الطائلة والأساليب الهائلة .
وتطارد من يعارضها ويدعو الناس إلى رفضها والتوجه إلى الحق ، المتمثل بالاسلام
وتعاليم الله عز وجل .
ومن هنا نفهم أن الظلم فيما بعد عصر الأئمة (ع) أشد وأوكد ، والتمحيص الالهي أعقد .
فإذا كان لأصحاب الأئمة عليهم السلام ، من الفضل ما ذكرته الرواية ، فهو أوكد وأعمق
في حق المخلصين المتأخرين عن ذلك العصر . وكلما تعقتد التمحيص وصعب ، كان الفضل عند
الله أكثر والكمال المحرز في الإيمان والاخلاص أكبر .
النقطة الثانية :
قول الامام الصادق (ع) – بحسب الرواية - : لا يموت منكم ميت على الحال الذي أنتم
عليها ، إلا كان أفضل عند الله من كثير من شهداء بدر وأُحُد .
فابشروا .
وهذا واضح وصحيح ، بعد أن نلاحظ أمرين مما قلناه :
الأمر الأول :
ما قلناه ، من أفضلية الممحصين الكاملين الصالحين لقيادة العالم بين يدي المهدي (ع)
.من الأعم الأغلب من أصحاب رسول الله (ص) .كما سبق أن برهنا عليه .
الأمر الثاني :
ما قلناه قبل قليل ، من أفضلية من يعيش في عصر الغيبة عمن يعيش في غيره من العصور ،
ولو أثبت الفرد الجدارة والصمود ضد الظلم والانحراف .
فإن قال قائل : انهم قد استشهدوا في سبيل الله تعالى دوننا ، فيجب أن يكونوا أفضل
منا .
صفحة (375)
قلنا: كلا . فان الشهادة التي نالها الأغلب في بدر وأُحُد ، كانت باعتبار الاندفاع
الثوري والوهج العاطفي الحراري الذي أوجده رسول الله (ص) في مجتمعه . كما سبق أن
عرفنا . ومثل هذا العمل وإن كان يمثل نجاحاً كبيراً في التمحيص الاختياري ، إلا أنه
لا يمكن أن يكون سبباً لتربية الفرد وتكامله ، ودقة تمحيصه ... فان ذلك ما يحتاج
إلى زمان طويل وتسلسل تدريجي بطيء ، وتكامل متواصل ... ولا يمكن للفرد أن يقفز دفعة
واحدة إلى الكمال ، مهما كانت الظروف التي عاشها صعبة ومتعبة .
ومثل هذه التربية البطيئة ، يمر بها الفرد المسلم بل الأجيال المسلمة في عصر الغيبة
الكبرى ، بشكل أطول وآكد بكثير مما مر به أصحاب رسول الله (ص) خلال عقدين من الزمن
. وستنتج نتائج أوسع وأعمق وذات مستويات أكبر مما نتج بالنسبة إلى الأغلب ممن عاصر
النبي (ص) . كما استطعنا أن نتبين خطوطه العريضة فيما سبق من البحوث .
* * *
وبذلك نستطيع أن نفهم سائر الروايات الواردة في فضل الصامدين على الحق المنتظرين
لليوم الموعود .
منها : ما رواه الصدوق في الاكمال (1) عن الإمام الحسين بن علي عليهما السلام ، أنه
قال- في كلام له عن المهدي (ع) - : له غيبة يرتد فيها أقوام ، ويثبت على الدين فيها
آخرون . ويقال لهم : متى هذا الوعد إن كنتم صادقين .أما أن الصابر في غيبته على
الأذى والتكذيب بمنزلة المجاهد بالسيف بين يدي رسول الله وآله الطاهرين الأخبار .
وما أخرجه البرقي في المحاسن (2) عن الإمام الصادق (ع) ، قال : من مات منكم على
أمرنا هذا فهو بمنزلة من ضرب فسطاطه إلى رواق القائم ، بل بمنزلة من يضرب معه
بالسيف ، بل بمنزلة من استشهد معه ، بل بمنزلة من استشهد مع رسول الله (ص) .
___________________________
(1) أنظر المصدر المخطوط . (2) جـ2 ، ص 172.
صفحة (376)
وأخرج أيضاً (1) : من مات منكم على هذا الأمر منتظراً له ، كان كمن كان في فسطاط
القائم (ع) . وعن الإمام الباقر (ع) – في ضمن حديث أنه قال : القائل منكم : إن
أدركت القائم من آل محمد نصرته ، كالمقارع معه بسيفه ... الحديث .
بل أن الممحصين الكاملين لأعظم حتى من هذه الدرجة كما تدل عليه روايات أخرى :
منها : ما رواه الصدوق في إكمال الدين (2) أيضاً عن الإمام بن الحسين (ع) في حديث
له عن المهدي (ع) : إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره ، أفضل
من أهل كل زمان ، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والافهام والمعرفة ما
صارت به الغيبة عندهم بمنزلة العيان ، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين
يدي رسول الله بالسيف . أولئك المخلصون حقاً ... والدعاة إلى دين الله سراً وجهراً
.
وما رواه الشيخ في الغيبة(3) عن النبي (ص) أنه قال : سيأتي قوم من بعدكم ، الرجل
الواحد منهم له اجر خمسين منكم . قالوا : يا رسول الله ، نحن كنا معك ببدر وأُحُد
وحنين وأُنزل فينا القرآن . فقال : لو تحملون لما حملوا لم تصبروا صبرهم .
إذن فهؤلاء الممحصون الكاملون ، أفضل من عامة المعاصرين للنبي (ص) .
والسر فيه ما قلناه من فجاجة أولئك من حيث التمحيص ، وعمق هؤلاء . والشخص الفج لا
يتحمل التمحيص العميق بطبيعته ، وهو معنى قوله : انكم لو تحملون لما حملوا ، لم
تعبروا صبرهم .
______________________________
(1) المصدر والصفحة وكذلك الخبر الذي يليه . (2) أنظر المصدر المخطوط . (3) أنظر ص
275 وأخرجه في الخرايج ، ص 195 .
صفحة (377)
ونود أن نعلق على هذه الأخبار الأخيرة بنقطتين :
النقطة الأولى :
إن التعبير بالفسطاط وبالسيف ، إنما جاء في هذه الروايات ، مماشاة مع ما يعرفه
الناس في عصر صدور هذه الروايات . وقد سبق أن قلنا في أول القسم الثاني من هذا
التاريخ ، أننا يجب أن نبحث عن مصاديق جديدة لمثل هذه التعبيرات ، مناسبة للعصر
الذي تتحدث عنه . فيكون المراد بالسيف سلاح الامام المهدي (ع) وبالفسطاط مقره أو
عاصمته أو نحوها .
ومن المحتمل أن يكون المراد بالبفسطاط المدرسة الفكرية ، بحسب ما نصطلح عليه اليوم
أوالمبدأ المستلزم لاتجاه فكري وسلوكي خاص في الحياة .
والقرينة على ذلك ، ما رواه أبو داود (1) عن رسول الله (ص) في حديث له عن الفتنة ،
قال : يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً ، حتى يصير الناس إلى فسطاطين : فسطاط
إيمان لا نفاق فيه .وفسطاط نفاق لا إيمان فيه ... الحديث .
فان المراد منه – بكل وصوح – المدرستين الفكريتين أو المبدأين العقائديين ، شبههما
بفسطاطين لجيشين متحاربين كما كان عليه أهل ذلك الزمان .
النقطة الثانية :
عرفنا في الجانب الأول من الحديث عن الانتظار والمنتظرين ، نفس ما أقادتنا إياه هذه
الروايات من كون الفرد الممحص الكامل أفضل من كثير من المستشهدين بين يدي رسول الله
. كما عرفنا أنه بمنزلة المعاصرين مع المهدي (ع) العاملين في سبيل نصرته
وذلك التجاور المكاني والزماني ، ليس له حساب في العقيدة والعمل ، وإنما الذي يؤخذ
بنظر الاعتبار هو درجة الاخلاص ، والايمان . وقد عرفنا أن أصحاب المهدي (ع) على
درجة عليا من الاخلاص الممحص وقوة الايمان ... فإذا كان الفرد في عصر الغيبة
ممّحصاً بنفس الدرجة كان مثل أصحاب المهدي (ع) بطبيعة الحال .
_________________________
(1) جـ2 ، ص 411 .
صفحة (378)
إلا أن ما ورد في بعض الروايات ، من أن الفرد المخلص في زمان الغيبة ، كالمستشهد
بين يدي المهدي (ع) ، مما لا يكاد ينسجم مع القواعد إذ المفروض تماثل الفردين في
الاخلاص الممحص ، مع زيادة الآخر بفضل الشهادة في سبيل الله عز وجل . إلا أن ينال
هذا الفرد في عصر الغيبة ، الشهادة في سبيل الله أيضاً .
* * *
الجهة السادسة :
في المنزلة السئلة والقيمة المنحطّة لأعداء المهدي (ع) في عصر الهدنة ، عصر الغيبة
الكبرى وما قبله .
روى النعماني في الغيبة (1) والصدوق في الاكمال (2) والطبرسي في الاعلام (3) عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: أقرب ما يكون العباد إلى الله عز وجل ، وأرضى ما يكون
عنهم إذا فقدوا حجة الله ، فلم يظهر لهم ، ولم يعلموا بمكانه . وهم في ذلك يعلمون
أنه لم تبطل حجج الله عنهم ولا تبطل بيناته ز فعندها فتوقعوا الفرج صباحاً ومساءً .
وإن أشد ما يكون غضب الله على أعدائه ، إذا افتقدوا حجته ، فلم يظهر لهم . وقد علم
أن أولياءه لا يرتابون . ولو علم أنهم يرتابون لما غيب عنهم حجته طرفة عين . ولا
يكون ذلك إلا على رأس شرار الخلق .
ويقع الكلام في هذه الرواية ، ضمن عدة نقاط :
النقطة الأولى :
فيما هو مقتضى القاعدة لتحديد درجة مسؤولية الفرد تجاه العصيان لأحكام الاسلام في
عصر الغيبة الكبرى.
الصحيح هو تضاؤل المسؤولية إلى حد ما في العصيان أثناء عند الفتن والانحراف
والاغراء ،عنها في الزمن المعاصر لعصر التشريع ... لكن لا بدرجة يلزم منها انعدام
الاختيار وسقوط التكليف .
_________________________
(1) ص 83 وما بعدها . (2) أنظر المصدر المخطوط . (3) ص 404 .
صفحة (379)
ويتم البرهان على ذلك بمعرفة عدة مقدمات :
المقدمة الأولى :
في إيضاح مراتب الجبر والاختيار .
فإن الفرد لا تكون إرادته في كل الأفعال على حد سواء ، بل تختلف على مراتب متعددة ،
تضعف في بعضها حتى تنعدم وتوجد في بعضها حتى تتضح ...
كما يبدو من المراتب الآتية :
المرتبة الأولى :
الجبر الفلسفي ، بمعنى أن الانسان يقوم بأعماله ، كما يصدر النور من الشمس والرائحة
من الزهر ، أو كالقلم بيد الكاتب والعصا في يد الضارب . وهو أعلى درجات الجبر
وانعدام الارادة وفقدان الاختيار .
ويقوم هذا الجبر على أحد أساسين :
الأساس الأول :
الأساس المادي .. كالقول بالمادية التاريخية التاريخية ، الذي يربط التطورات
التاريخية ، وجميع تصرفات الأفراد بتطور وسائل الانتاج . فالفاعل المؤثر – في
الحقيقة – هي هذه الوسائل ، وليس للانسان أي يد في تغيير ما يقوم به من أعمال .
وهذا واضح من اتجاه الماديين التاريخيين ، إذ لو كان للأفراد اختيار في أفعالهم ،
لكانوا هم صانعي التاريخ والمشاركين في تطويره ، ولم يكن تطويره مستنداً تماماً إلى
وسائل الانتاج ، كما قد أكدوا عليه .
والظاهر أن كل كل المذاهب المادية ، تقول بالجبر الفلسفي هذا ، باعتبار أن القول
بالاختيار اعتراف بأمر ميتافيزيقي لا يمكنهم الايمان به .على أنه يتضمن المنافاة
للعلل المادية الضرورية التأثير في الانسان ... تلك العلل التي تقدمها هذه المذاهب
.
الأساس الثاني :
الأساس الالهي ، بمعنى أن الله تبارك وتعالى هو الفاعل المؤثر في إيجاد أفعال
الانسان ، إيجاداً قهرياً . وأشهر من يقول بذلك هم الأشاعرة من المسلمين واليهود من
أهل الكتاب .
صفحة (380)
وكلا الأساسين باطلان في الاسلام : أما الأساس الأول ، فباعتبار مناقضة المادية مع
الاسلام في النظر إلى الكون والحياة أساساً كما هو المبرهن عليه في كتب العقائد .
وأما الأساس الثاني ، فلاستلزماته بطلان الثواب والعقاب ، وسقوط الفرد عن استحقاقه
. كما هو المبرهن عليه في كتب العقائد أيضاً .
المرتبة الثانية :
القسر على فعل معين ، بعد الاعتراف ببطلان الجبر في المرتبة الأولى ... كما لو شد
وثائق شخص بحبل- مثلاً – والقي في فمه الماء أو الطعام ، أو نقل من مكان إلى آخر
محمولاً .
ولا يسمى ذلك بالاضطرار اصطلاحاً ، وإن كان يمكن أن يسمى به .
المرتبة الثالثة :
الاكراه ، مع افتراض توفر الاختيار في المرتبتين السابقتين .
وأوضح أشكاله هو التهديد أو بالشر المستطير ، لشخص على أن يعمل عملاً ما ، تهديداً
قابلاً للتطبيق ... فيضطر الفرد لايقاع الفعل قهراً عليه .
ولهذه الاكراه أشكال أخرى ، كما لو كان التهديد متوجهاً إلى شخص والأمر متوجهاً إلى
شخص آخر . كما لو أمرك شخص بفعل ، مهدداً إياك بقتل ولدك مثلاً .وكما لو كان الأمر
متعلقاً بايقاع أحد أمور متعددة ، لا بإيقاع شيء واحد . مثل ما إذا قال ذلك الشخص :
اعمل كذا أو كذا وإلا قتلتك .
المرتبة الرابعة : الاضطرار ، وهو الالتجاء إلى فعل معين تجنباً لأمر آخر وشيك
الوقوع عليه .
كما لو باع داره التي يسكنها لسداد دينه أو الصرف على صحته ... وغير ذلك .
وهاتان المرتبتان غير منافيتين للاختيار بالدقة ، فان الفرد يوقع الفعل بإرادته على
أي حال ، وإن كان فعله قد يكون مخالفاً لهوى النفس أو للعقيدة التي يحملها مخالفة
شديدة . على حين كانت المرتبتان الأوليتان ، منافيتين مع الاختيار مباشرة ، إذ لا
معنى للاختيار الفعلي مع أي منهما .
صفحة (381)
المرتبة الخامسة :
ما نستطيع أن نسميه بالاضطرار غير المباشر .وهو عبارة عن ردود فعل معينة تجاه
مؤثرات عامة أو خاصة ، يقوم بها الانسان بإرادته واختياره . لكن لا يكاد يوجد له
منها مناص عرفاً وعادة ... وإن وجد المناص منها عقلاً.
يندرج في ذلك الكثير من الأفعال ، كاضطرار التاجر إلى بيع سلعته بأرخص مما اشتراها
أحياناً .وكاستمرار المعتاد أو المدمن على شيء ، وعدم استطاعته ترك عادته ،
كالادمان على الخمر أو التدخين مثلاً .وكاستمرار المختص بحقل من حقول المعرفة في
التدقيق وزيادة البحوث في حقله ، دون الحقول الأخرى .
فالطبيب المتمرس – مثلاً – لا يمكن له أن يكون فيزياوياً أو مهندساً معمارياً .
وكالتزام الشخص الاعتيادي بتقاليد مجتمعه وعقائد آبائه . وكاضطرار الجوعان إلى
الطعام في موعده ، ما لم يصل إلى حد الخوف من الهلاك، فيكون مندرجاً في المرتبة
السابقة .
ولهذه المرتبة مستويان يختلفان في درجة انحفاظ الاختبار .
المستوى الأوةل :
أن تكون ظروف الفرد وملابساته تعيّن عليه الفعل ، بحيث يكون قاصراً عن تركه ، ولا
مناص به عرفاً عنه .
المستوى الثاني :
أن لا يبلغ التسبيب إلى درجة القصور ، بل تكون له فرصة الاختيار عرفاً ، وإن كان
الدافع إلى الفعل والحافز عليه شديداً .
وأمثلة هذين المستويين ، نسبية تختلف بين فرد وآخر وفعل آخر ، بحسب اختلاف الظروف
النفسية والعقلية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها ، مما يمر به هذا الفرد
أو ذاك .فقد يكون الفرد قاصراً عن ترك شيء ، ولا يكون الفرد قاصراً عن ترك شيء ،
ولا يكون فرد آخر قاصراً عن ترك نفس الشيء . أو يكون فرد قاصراً عن شيء دون شيء آخر
.
فمثلاً قد يكون أحد الأطباء قادراً بحسب ظروفه على أن يختص بالفيزياء أيضاً . ولا
يكون طبيب آخر غير قادر على ذلك ، بحسب ظروفه وهكذا .
صفحة (382)
المرتبة السادسة :
الاختيار المطلق ، بمعنى أن يكون للفرد حرية الفعل والترك معاً ، بمقدار خمسين
بالمئة على السواء .
وهذا أمر نسبي أيضاً ، فقد تكون أطراف التخيير كلها ممكنة ، وليس في أحدها حافز
أكثر من الآخر ... وقد يكون في بعضها حافز أكثر ، وقد يكون في بعضها مثبط أو مبعد .
وقد يكون بعضها مضطراً إلى فعله بالمرتبة الثانية أو الثالثة ، ويكون الاختيار
باعتبار الأطراف الأخرى ، وهكذا .
المقدمة الثانية :
إذا عرفنا هذه المراتب الست ، أمكننا أن نعرف بوضوح اختلافها في درجة الاختيار ،
وأن نلاحظ اختلافها في درجة المسؤولية القانونية المترتبة عليها .
فان كل فعل له أثر قانوني ، تتناسب درجة مسؤولية طاعته وعصيانه مع درجة الاختيار
تناسباً طردياً . ويدور التشريع مدار الاختيار تماماً ، سواء كان التشريع عقلياً أو
شرعياً دينياً أو قانوناً وضعياً . بل أن كل من يتصدى لوضع أي تشريع فانه يفترض
سلفاً أن من يأمره وينهاه ويعاقبه شخص له اختيار الفعل والترك ... وإلا فلا معنى
للأمر والنهي ولا للنصح والتوجيه ... ويكون العقاب ظلماً والثواب لغواً . فانه إذا
انعدم الاختيار ، انعدمت المسؤولية ، إذ يكون للفرد العاصي عندئذ بأنه كان مقهوراً
ومجبوراً على العصيان .. ولا معنى لعقابه حينئذ .
فإن قال قائل : فان هناك الكثيرون ممن يؤمنون بالوجود القانوني للتشريع ويعملون
عليه . مع أنهم يؤمنون بالجبر وانعدام الاختيار بالمرة . كالماديين والأشاعرة .
قلنا له : العمل على التشريع من قبل هؤلاء ، ناشيء من أن وجدانهم الارتكازي قائم
على الاختيار ، وحياتهم العملية قائمة على الايمان به ، من حيث أن تحمل مسؤولية
العصيان أمر عقلاني عام ... فهم مؤمنون بالاختيار عملياً وإن اعتقدوا من الناحية
الفلسفية بخلافه ، وغفلوا عن المنافاة بين ثبوت المسؤولية وبطلان الاختيار .
صفحة (383)
وعلى أي حال ، فالمسؤولية القانونية ، تزداد بازدياد الاختيار وتقل بقلته ، كما
أنها توجد بوجوده وتنعدم بانعدامه . فهي موجودة في المرتبة الثالثة وما بعدها بوجود
الاختيار في هذه المراتب جميعاً . نعم ، قد يكون الفرد العادي معذوراً في بعض مراتب
الاكراه أو الاضطرار الشديدة ، بالرغم من أنه يعتبر عاصياً بالدقة العقلية . كما
أنه مع سعة الوعي وعمق الأثر ، قد لا يكون الفرد معذوراً حتى في هذه المرتبة ، كما
أنه يجب عليه تحمل الشدائد في سبيل أهدافه .
خذ مثلاً أن فرداً عادياً إذا اضطر إلى سرقة شيء من المتاع أو أكره عليه كان
معذوراً ... ولكن لو اكره الرئيس الأعلى للدولة أو أحد علماء الاسلام على مثل هذه
السرقة ، لا يكون معذوراً البتة ، لأن في ذلك افتضاح دولته أو دينه ، بل يجب عليه
تحمل ما يكره والصبر عليه . حتى لو كان هو القتل – احياناً – إذا كان الهدف من
العمق والشمول ، بحيث تبذل في سبيله النفوس .
وتتضاءل المسؤولية ، بنقصان الاختيار ، ففي مورد القصور – مثلاً – تكون المسؤولية
منتقيه إلى حد كبير . لكنها في مورد الاضطرار غير المباشر تكون ثابتة على شكل ناقص
، لإمكان أن يتصرف الفرد بشكل يختلف عما قام به من عمل ، ويكون رد فعله تجاه الحافز
بشكل آخر . وتكون المسؤولية كاملة في صورة الاختيار المطلق ، بطبيعة الحال .
وليس تفاوت درجات المسؤولية ، بدعاً من القول . بل له أمثلة كثيرة في القوانين .
فمثلاً : قسموا القتل إلى عمد وشبه العمد والخطأ . ووجدوا من الظلم إيقاع عقاب
المتعمد على شبه العمد أو الخاطئ . كما أنهم قسموه إلى ما كان عن سبق إصرار وما لم
يكن . ووجدوا الظلم إيقاع العقاب الذي يستحقه الأول على الثاني . ووجدوا من الظلم –
أيضاً – إيقاع عقاب السارق الاعتيادي على السارق في المجاعة .
ونجد في الاسلام أن عقاب الزاني المحصن أشد من عقوبة غير المحصن . إلى غير ذلك من
الأمثلة . كل ذلك لأن درجة الاختيار أخذت بالتضاؤل ، فتضاءلت معها المسؤولية ، ومن
ثم درجة استحقاق العقاب .
صفحة (384)
ولك من المثالين الأخيرين خير إيضاح ، فان درجة اختيار السارق العادي في ترك السرقة
أكبر منها في السارق الجائع الذي لا يجد قوتاً ... وإن كان الأخير مذنباً أيضاً .
كما أن درجة اتختيار المحصن المتزوج في التعفف عن الزنا أكبر من درجة الأعزب . وإن
كان هذا مذنباً أيضاً ... وهكذا .
وليت شعري ، لا أعلم ماذا يقول الماديون وغيرهم من القائلين بالجبر الفلسفي في مثل
هذه الموارد الواضحة قانونياً .فانها مما لا يمكن تفسير الفرق بين مراتبها بناء على
رأيهم ، إذ يكون كل العصاة مجبورين على مستوى واحد على العصيان . بل يكون هؤلاء
القائلين بالجبر ، مجبورين على اتخاذ هذا الرأي أيضاً !!.
المقدمة الثالثة :
أنه كلما توفرت وازدادت أسباب الايمان بالاسلام بالنسبة إلى الفرد ، ازدادت درجة
إمكان اختياره له واعتناقه إياه وإطاعته لتعالميه . حتى ليصبح متساوي الأطراف ،
كالمرتبة السادسة ، بل في طرف اعتناقه حفز قوي ودافع شديد ، لا يوجد مثله في طرف
تركه . كما كان عليه الحال ، فيما بعد الفتح في عصر النبي (ص) ، حتى أننا سبق أن
قلنا لأن الإيمان بالغيب كاد أن يكون حسياً ، وهو ما سوف يكون عليه الحال بعد
الظهور . وفي مثل ذلك يكون العصيان ذا مسؤولية كبرى واستحقاق كبير للعقاب .
وكلما صعب طريق الايمان وازدادت عقباته ومزالقه ، وتكثرت التضحيات التي يتطلبها
ومقاومة أشكال الظلم والاغراء التي يواجهها ... كانت درجة الاختيار والمسؤولية أقل
، لا محالة ، حتى تصبح من مرتبة الاضطرار غير المباشر بأحد المستويين السابقين . بل
قد تنقص عن ذلك في بعض الأحيان .
ومن الممكن القول : ان اكثر حالات العصيان والانحراف في عصر الفتن والانحراف ، حيث
تتركز المصالح الخاصة ويقل الوازع الاخلاقي والديني ، ويدرك الفرد أن كثيراً من
الأعمال المنحرفة تعتبر ضرورة من ضروريات حياته ، ويتوقف أمنه وراحته عليها ... ان
اكثر هذه الحالات هي من قبيل الاضطرار غير المباشر بالمستوى الثاني على أقل تقدير .
صفحة (385)
وأما القصور الحقيقي ، فيمثل الجزء الأقل ، من أسباب الانحراف في العالم ...
باعتبار وضوح القضايا الدينية الاولية ، كالتساؤل عن مبدأ العالم والغاية من خلقه .
فإذا استطاع الفرد أن يسير سيراً حسناً في اسنتتاجه ، استطاع الوصول إلى الحق لا
محالة .ومن هنا ، شجب القرآن تقليد الآباء لمنافاته الصريحة مع تلك القضايا الأولية
الواضحة .
ولئن كان القصور ، وهو الجزء الأقل من أسباب الانحراف في العالم ، موجب للعذر عقلاً
وشرعاً ، فان الاضطرار غيرالمباشر ، وهو الجزء الأغلب من الأسباب ، غير موجب للعذر
أساساً . لوجود الاختيار والمسؤولية فيه إلى درجة كافية . وخاصة بعد اتضاح معالم
الحق ، وقيام الحجة والبرهان عليه وإمكان التضحية في سبيله إلى درجة معقولة ، من
قبل الفرد العادي .
إذن ينتج من هذه المقدمات الثلاث : إن المسؤولية القانونية ، وان كانت متوفرة
للمنحرفين في عصر الغيبة الكبرى، ولم يكن البشر معذورين في عقائدهم وأعمالهم
الباطلة . إلا أن الظروف التي يعيشونها تكفكف من عمق المسؤولية وتقلل من درجتها ،
بمقدار ما تقلل من درجة الاختيار ، وتجعل الحافز على الانحراف ، قوياً فعالاً .
وإلى مثل ذلك ، وما يشبهه تشير الرواية التي أخرجها الشيخ في الغيبة (1) بطريق صحيح
عن زرارة عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : حقيق على الله أن يدخل الضلاّل
الجنة . فقال زرارة : كيف ذلك جعلت فداك ؟ قال : يموت الناطق ولا ينطق الصامت ،
فيموت المرء بينهما ، فيدخله الله الجنة .
والشرح الأولي لهذه الرواية : ان المراد من الضلاّل بالتشديد : المنحرفين من
المسلمين ، وإدخالهم الجنة إنما يكون بسبب قلة المسؤولية التي أشرنا اليها ، حتى
تكاد تنعدم فينعدم العقاب بالمرة وذلك في ظرف معقد خال من التبليغ الاسلامي ، عند
موت الناطق بالحق ، وصمت الموجود .
وقد يراد بالناطق والصامت ، الأئمة المعصومين عليهم السلام . فيراد بالصامت الامام
المهدي (ع) وبالناطق من قبله منهم عليهم السلام . وتكون الفترة المشار إليها ، هو
عصر الغيبة الكبرى الذي نؤرخ له . كما قد يراد بالناطق والصامت أيّ مفكر ومبلغ
إسلامي وداعية إلى الحق سواء كان معصوماً أو لا .
__________________________
(1) ص 277 .
صفحة (386)
يكون المراد فترة أو عدة فترات صعبة من عصر الغيبة ، مع افتراض وجود الارشاد إلى
الحق في غير هذه الفترات. هذا ، وأما الفهم الدقيق لهذه الرواية ، فله مجال آخر ،
ويكفينا في هذا الصدد أن الفرق بين ما قلناه بني ما قلناه وبين مؤدّى هذه الرواية :
هو أن قلة المسؤولية التي أشرنا إليها ، ناتج من ظروف الظلم والاغراء . وأما قلة
المسؤولية التي تشير إليها الرواية فناتجه من ضعف التبليغ الاسلامي ، وما يسببه من
الجهل والفراغ العقائدي بشكل عام .
وكلا الأمران صحيح ، وموجب لضعف المسؤولية ، فضلاً عما إذا اجتمعنا ، كما هو
الموجود في عدد من عصور عصر الغيبة الكبرى . ومرادنا من الاستشهاد بهذه الرواية ،
رفع الاستغراب من قلة المسؤولية مع الانحراف .
النقطة الثانية :
أنه بالرغم مما قلناه من قلة المسؤولية إلى حد ما في عصر الفتن والانحراف .
إلا أن ذلك لا ينافي قانون التمحيص . ولا ينافي صدق الرواية التي سبقت ودلت على
اشتداد غضب الله تعالى على أعدائه إذا غيب حجته .
ويمكن أن نطلع على ذلك من خلال جانبين :
الجانب الأول :
في أن قلة المسؤولية لا تنافي التمحيص .
وذلك : لأننا لم نقل بانتقاء المسؤولية ، كيف ... وإن عصيان الله من أشد الأمور
مسؤولية وإجراماً . ولكننا قلنا بقلتها في صورة الاضطرار غير المباشر عن صورة
الاختيار المطلق . أو بتعبير آخر ، قلتها في عصر الفتن والانحراف عن عصر التشريع
ومجاورة قواد الاسلام ، سواء السابقين منهم أو المهدي (ع) بعد ظهوره .
صفحة (387)
...فكل ما ينتج لدينا هو أن الفرد الفاشل في التمحيص في عصر الغيبة أخف جرماً من
شخص فاشل في عصر الظهور .تماماً كما ينتج لدينا أن الشخص الناجح في التمحيص في عصر
الغيبة أفضل وأحسن من الشخص "الناجح في عصر الظهور " (1) لأن مضاعفة التمحيص وشدته
، يلازم كله هذين الأمرين .
ومعه يبقى التمحيص على حاله ، من حيث أساليبه ونتائجه :
أما أساليبه ، فباعتبار أن قلة المسؤولية النسبية ، لا تعني تغير الواقع الذي يعيشه
الفرد من الظلم والتعسف والانحراف . كما لا تعني انعدام مسؤوليته تجاهه .
وأما نتائجه : فباعتبار أن التمحيص ينتج المطلوب الذي خططه الله تعالى من أجله ،
وهو وجود العدد الكافي من المخلصين الممحصين لنصرة المهدي (ع) بعد ظهوره والتشرف
بحمل مسؤولية الفتح العالمي . بل أن نتيجة التمحيص تكون بالنسبة إلى الناجحين أفضل
كما عرفنا ، وإن كانت بالنسبة إلى الفاشلين فيه قليلة .
الجانب الثاني :
في أن قلة المسؤولية لا تنافي صدق الرواية . وذلك بناء على الايمان بغيبة الامام
المهدي (ع) وخط آبائه عليهم السلام ، الذي صدرت هذه الرواية على أساسه .
وذلك : لأن ما قلناه من قلة المسؤولية يشارك فيها ، إلى حد كبير ، البعد عن عصر
التشريع وصعوبة الوصول إلى تفاصيل الاسلام إلا للاختصاصيين والمدققين الاسلاميين
.وأما في عصر التشريع فهذه الصعوبة غير موجودة.لا مكان الرجوع إلى النبي (ص) أو إلى
الأئمة (ع) كل في عصره عند الحاجة . ووجوب ذلك في نظر الإسلام .
ونحن في تاريخ الغيبة الصغرى (2) اقمنا القرائن الكافية التي تثبت أن عدداً من
الخلفاء ، كانوا يعرفون حق الأئمة عليهم السلام وصدقهم ... وكانوا – مع ذلك –
يناجزونهم المطاردة والتعسف والتنكيل .
_______________________________
(1) لكن هناك بعد الظهور تمحيصاً إضافياً يمنع من صدق هذه النتيجة صدقاً مطلقاً .
على ما سوف يأتي في التاريخ القادم .
(2) أنظر ص 447 وما بعدها إلى عدة صفحات .
صفحة (388)
ومن هذا المنطلق بالتعيين ، نعرف المراد من الرواية ، إذ تقول : وإن أشد ما يكون
غضب الله على أعدائه إذا افتقدوا حجته ، فلم يظهر لهم ... الخ . وذلك بعد الالتفات
إلى مقدمتين :
المقدمة الأولى :
ما عرفناه الآن ، من تضاعف المسؤولية في ذلك العصر ، عنه في عصر الغيبة الكبرى ،
وهذا في العصيان الاعتيادي ، فكيف بمطاردة الأئمة (ع) وقواعدهم الشعبية ، مع علم
الحكام بأن الحق إلى جانبهم .
المقدمة الثانية :
إن المراد من قوله – في الرواية - : إذا افتقدوا حجته ..النظر إلى أول الغيبة ، فقط
. لأن الافتقاد أو الغيبة إنما حصل في ذلك الحين ، وأما ما بعده من الزمان ، فهو
استمرار لذلك المعنى ، وليس افتقاداً آخر .
فينتج عن المقدمتين : ان المراد هو اشتداد غضب الله تعالى على الحكام ، في مبدأ
الغيبة الصغرى ، حيث كانوا يطاردون أولئك الذين يعرفون أن الحق إلى جانبهم . ويعصون
ما يفهمونه من الحكم الاسلامي الصحيح .
فان ناقشنا في المقدمة الثانية ، وقلنا بشمول التجيس لكل عصر الغيبة الكبرى .
باعتبار المقابلة بين الفقرتين في الرواية . فانه (ع) يقول : أقرب ما يكون العباد
إلى الله عز وجل ... إذا فقدوا حجته ... وأشد ما يكون غضب الله على أعدائه إذا
افتقدوا حجته ... الحديث . وحيث علمنا أن جانب الرضا شامل لكل عصر الغيبة ، وغير
خاص بأولها ، نعلم أن جانب الغضب شامل لجميعها أيضاً .
وهذا الكلام وجيه إلى حد كبير ، ومطابق مع التخطيط الالهي . لما عرفناه من أن
التمحيص حين ينتج نتائجه النهائية في آخر عصر الغيبة الكبرى . يكون الناس على طرفين
متناقضين : قلة شديدة الايمان قوية الارادة إلى درجة كبيرة . فهذا هو ما تشير إليه
هذه الرواية . غذ يكون لاقرب الالهي والرضا عن أولئك القلة ، ويكون الغضب الشديد
على المتطرفين ، من هؤلاء الكثرة .
وأما من خلال هذا العصر ، فمن الواضح ، أن التمحيص كلما سار قدماً وتصاعد درجة ،
ازداد إيمان المؤمنين وانحراف المنحرفين معاً . وتصاعد الرضا والغضب المشار إليه في
الرواية ، بشكل متدرج مقترن .
صفحة (389)
النقطة الثالثة :
قوله (ع) – في تلك الرواية - : وقد علم الله تعالى أن أولياءه لا يرتابون . ولو علم
أنهم يرتابون لما غيب عنهم حجته طرفة عين .وهو تعبير ورد في عدة روايات (1) .
نفهم من ذلك : أن الارتياب والشك بوجود المهدي (ع) أثناء غيبته ناشئ في واقعه من
الانحراف والفساد الموجود في هذا العصر ، وأما لو خلي الفكر الانساني المستقيم
ونفسه لما رقى اليه الشك .
ونحن وإن كنا قلنا أن طول الغيبة سبب للشك بحسب طبيعة البشر لكونها من الأمور غير
المعهودة في ربوعهم . إلا أن الشخص الذي يربط الأمور بمصدرها الحقيقي الأول ، تبارك
وتعالى ، ويعرف قدرته الواسعة وحكمته اللانهائية ، لا يستبعد عليه التصدي لحفظ شخص
معين أمداً طويلاً ، لأجل تنفيذ العدل في اليوم الموعود . بل يرى أن ذلك لازم
ومتعين بعد قيام البرهان على وجود الغرض الأصلي من الخليفة وعلى حقيقته . وانحصار
تحقق هذا الغرض بهذا الأسلوب . بحيث لو لم تكن هناك أي رواية تدلنا على وجود المهدي
، لكان اللازم على الفكر الانساني أن يعترف به .
وإنما الذي يمنع من ذلك ، ويزرع في طريقه المصاعب والمتاعب ، هو الانحراف الفكري ،
وخاصة إذا وجد لدى بعض القواعد الشعبية الذين بني مذهبهم على الاعتزاز بوجوده
والتسليم بإمامته .
ومن هنا نرى أن أولياء الله الممحصين الذين ليس للفتن إلى قلوبهم ولا للضغط والظلم
طريق إلى قوة إرادتهم ... لا يرقى إليهم الشك في المهدي (ع) . لأن العوامل النفسية
والموانع المنحرفة لذلك غير موجودة لديهم . فيبقون على الفطرة التي فطر الله الناس
عليها ، من الايمان بقدرته وحكمته ، فيسلمون بنتيجة الدليل القطعي الدال على وجود
المهدي .
ومن هذا المنطلق نعرف ، أنه لو لم يكن الفكر الانساني مدركاً لذلك ، بحيث أمكن
سراية الشك إلى أولياء الله تعالى ... لما غيب الله عنهم حجته طرفة عين .
_________________________________
(1) أنظر إكمال الدين المخطوط وغيبة النعماني ، ص 83- 84 .
صفحة (390)
لاستلزامه نقصان الحجة أو بطلانها بالنسبة إلى البشر ، وهو مما لا يمكن أن يصدر من
قبل الله تعالى ، فانه ملازم من أحد أمرين غير ممكنين : أما إلغاء إمامته أو تكليف
البشر بالاعتقاد بها بدون دليل ، وكلاهما مما لا يكون ... فيتعين المحافظة على
ظهوره بالمقدار يثبت وجوده وتقوم به الحجة في الاسلام .
فإن قيل : أنه إذا لم يغب الفرض الالهي الذي عرفناه منحرفاً ، لأنه يؤدي إلى عدم
تنفيذ اليوم الموعود . وهو محال ، بعد تعلق الحكمة والمصلحة به لدى الله عز وجل .
قلنا : هذا صحيح ، إلا أن غيبته في الحقيقة ناتجة عما ذكر في الرواية من أن أولياء
الله تعالى منذ الأزل ، فأسس تخطيطه منذ خلق الخليفة عليه . وأما القول : بأن
الغيبة توجب الارتياب ونقصان الحجة على إثبات وجود المهدي (ع) ، فهو قول باطل ، كما
ذكرنا .
ولو فرض هذا القول تاماً صحيحاً احتاج الأمر إلى أن إدخال تغييرات أساسية في
التخطيط الالهي لليوم الموعود ، وأدى بنا إلى افتراضات غير واقعية في الخارج ، مما
نحن في غنى عن افتراضها ، بعد قيام الدليل القطعي على خلافها .
هذا هو تمام الكلام في هذه النقطة الثالثة .
وبه ينتهي الكلام في الجهة السادسة والأخيرة من الفصل الثالث من هذا القسم الثاني
من هذا التاريخ .
وبذلك ينتهي هذا الفصل أيضاً . وبه ختام هذا القسم الثاني من التاريخ .
والحمد لله رب العالمين .
صفحة (391)
القسم الثالث
في شرائط الظهور وعلاماته
وينقسم الكلام في هذا القسم ، بلحاظ الحديث عن شرائط الظهور تارة
وعلاماته تارة أخرى ... إلى فصلين رئيسيين
صفحة (393)
الفصل الأول
في شرائط الظهور
وتعرض فيه هذا المفهوم ، ضمن عدة جهات :
الجهة الأولى :
في الفرق بين شرائط الظهور وعلاماته :
عرفنا من شرائط الظهور : وجود العدد الكافي من المخلصين الممحصين لغزو العالم بالحق
والهدى . وسنعرف من علائم الظهور وجود الدجال والخسف وغيرهما .
ويشترك هذان المفهومان : الشرائط والعلائم ، بأنهما معاً مما يجب تحققه قبل الظهور
، ولا يمكن أن يوجد الظهور قبل تحقق كل الشرائط والعلامات . فان تحققه قبل ذلك ،
مستلزم لتحقق المشروط قبل وجود شرطه أو الغاية قبل الوسيلة ... كما أنه مستلزم لكذب
العلامات التي أحرز صدقها وتوافرها .
إذن ، فلا بد أن يوجدا معاً قبل الظهور ، خلال عصر الغيبة الكبرى ، أو ما قبل ذلك ،
على ما سنعرف . ويتدرج وجودها بشكل متساوق حتى يتم ، فيتحقق الظهور عند ذلك . ولا
يمكن تأخره عن تماميه الشرائط ولا عن تمامية العلامات .
فان تخلف الظهور عن شرائطه يلزم منه تخلف المعلول عن العلة . أو بعبارة أدق : يلزم
عدم قيام المهدي (ع) بوظيفته الاسلامية وحاشاه .. وفشل التخطيط الالهي في نهاية
المطاف . على ما سنوضح تفصيلاً فيما يلي من البحث . وإن تخلف الظهور عن مجموع
العلامات المحرزة الصحة لزم كذبها ، بصفتها علامات ، وهو خلاف إحراز صحتها ، على
أقل تقدير .
صفحة (395)
وبالرغم من نقاط الاشتراك هذه ، فان بينهما من نقاط الاختلاف ، والفروق ، لا بد لنا
من بيانها بشكل يتضح الفرق بين المفهومين بشكل أساسي :
الفرق الأول :
إن إناطة الظهور بالشرائط اناطة واقعية ، واطته بالعلامات اناطة كشف واعلام .
وهذا هو الفرق الأساسي المستفاد من نفس مفهوم اللفظين : الشرط والعلامة . فان معنى
الشرط في الفلسفة ، ما كان له بالنتيجة علاقة عليّة وسببية لزومية . بحيث يستحيل
وجوده بدونه .
وهذا هو الذي نجده على وجه التعيين في شرائط الظهور . فاننا سنرى أن انعدام بعض
الشرائط يقتضي انعدام الظهور أساساً بحيث لا يعقل تحققه . وانعدام بعضها الآخر
يقتضي فشله ومن ثم عدم إمكان نشر العدل الكامل المستهدف في التخطيط الالهي الكبير .
إذن فلا بد أولاً من اجتماع الشرائط ، لكي يمكن تحقق الظهور ونجاحه .
أما العلامة ، فليس لها من دخل سوى الدلالة والاعلام والكشف عن وقوع الظهور بعدها ،
مثالها مثال هيجان الطيور الدال على وقوع المطر أو العاصفة بعده من دون إمكان أن
يقال : ان العاصفة لا يمكن ان تقع بدون هيجان الطيور . بل يمكن وقوعها ، بطبيعة
الحال .وإن كان قد لا تنفك عن ذلك في كل عاصفة .
وهذا هو الذي نجده في علامات الظهور ، فانه يمكن تصور حدوثه بدونها . ولا يلزم من
تخلفها انخرام سبب أو مسبب ... غير ما أشرنا إليه من كذب الدليل الدال على كونها من
العلامات . وهو مما لا يمكن الاعتراف به بعد فرض استحالة الكذب على النبي (ص)
والأئمة (ع) ، وكفاية الدليل للاثبات التاريخي .
ومعه ، فتنبثق ضرورة وجودها قبل الظهور ، بصفتها دليلاً كاشفاً عن وقوعه ، لا
بصفتها ذات ارتباط واقعي لزومي ، كما كان الحال في شرائط الظهور .
نعم ، ينبغي أن نأخذ بنظر الاعتبار ، نقطة واحدة ، وهي أن بعض العلامات ، كوجود
الدجال وقتل النفس الزكية ، مربوطة ارتباطاً عضوياً بالشرائط . بمعنى أن هذه
العلامات من مسببات ونتائج عصر الفتن والانحراف الذي هو سبب التمحيص الذي هو سبب
إيجاد أحد شرائط الظهور ، على ما سنوضح . إذن يكون بين هذا القسم من العلامات وبين
بعض الشرائط علاقة سببية لزومية ... فيكون لها في نهاية الشوط ، نفس المفهوم الذي
للشرائط .
صفحة (396)
غلا أن هذا لا ينافي ما قلناه ، باعتبار أمرين مقترنين :
الأمر الأول :
عدم وقوع العلامة في سلسلة علل الظهور . بل هي من معلومات ونتائج بعض علل الظهور .
فلا تكون بذلك من العلل ، وإن كان وجودها لزومياً قبل الظهور .
الأمر الثاني :
ورودها في الأخبار كعلامة ملفتة للنظر إلى وجود الظهور . وهي – بلحاظ هذه الزاوية
بالتعيين – لم يلحظ فيها سوى الكشف والدلالة على الظهور ... سواء كانت من علله أو
لم تكن . وليس كذلك حال الشرائط ، فانها ، غير معروفة النتائج للناس وغير ملفتة
لنظرهم على الاطلاق ، على ما سنذكر .
إذن ، فكل ما ينتج من هذا التسلسل في التفكير ، هو ضرورة وجود العلامات قبل الظهور
، وهو أمر صحيح ومشترك بين العلامات والشرائط . وأما أنه ينتج تحويل هذه الأمور من
كونها علامات إلى كونها شرائط فلا .
الفرق الثاني :
إن علامات الظهور ، عبارة عن عدة حوادث ، قد تكون مبعثرة ، وليس من بد من وجود
ترابط واقعي بينهما ، سوى كونها سابقة على الظهور ... الأمر الذي برَّر جعلها علامة
للظهور ، في الأدلة الاسلامية .
وأما شرائط الظهور ، فان لها- باعتبار التخطيط الالهي الطويل – ترابط سببي ومسببي
واقعي ، سواء نظرنا إلى ظرف وجودها قبل الظهور ، أو نظرنا إلى ظرف انتاجها بعد
الظهور . على ما سنوضح فيما يلي ، بعد هذا الفصل .
الفرق الثالث :
إن العلامات ليس من بد أن تجتمع أصلاً في أي زمان . بل يحدث أحدها وينتهي ، ثم يبدأ
الآخر في زمان متأخر ... وهكذا . كما أنها قد تجتمع صدفة أحياناً . فهي حوادث
مبعثرة في الزمان كما أنها مبعثرة بحسب الربط الواقعي.
صفحة (397)
وأما الشرائط ، فلا بد أن تجتمع في نهاية المطاف ، فانها توجد تدريجياً ، إلا أن
الشرط الذي يحدث يستمر في البقاء، ولا يمكن – في منطق التخطيط الالهي – أن يزول .
فعندما يحدث الشرط الآخر ، يبقى مواكباً للشرط الأول، وهكذا تتجمع الشرائط وتجتمع
في نهاية المطاف ... في اللحظة الأخيرة من عصر الغيبة الكبرى .
ومن هنا الفرق الآتي .
الفرق الرابع :
إن علامة الظهور ، حادثة طارئة ، لا يمكن – بطبعها – أن تدوم ، مهما طال زمانها .
بخلاف شرائط الظهور ، وبعض أسبابها ، فأنها بطبعها قابلة للبقاء ، وهي باقية فعلاً
، بحسب التخطيط الالهي ، حتى تجتمع كلها في يوم الظهور .
الفرق الخامس :
إن العلامات تحدث وتنفذ بأجمعها قبل الظهور . في حين أن الشرائط لا توجد بشكل
متكامل إلا قبيل الظهور أو عند الظهور . ولا يمكن أن تنفد ، وإلا لزم انفصال الشرط
عن مشروطه والنتائج عن المقدمات ... وهو مستحيل .
والسر في ذلك كامن في الفرق بين النتائج المتوخاة من وراء كلا المفهومين .
فان العلامات بصفتها دلالات وكواشف عن الظهور ، فان وظيفتها سوف تنتهي عند حدوثه ،
ولا يبقى لها أي معنى بعده . وأما الشرائط فحيث أنها دخيلة في التسبب إلى وجود يوم
الظهور ، وإلى تحقق النصر فيه ... فلا بد أن تجتمع في نفس ذلك العهد ، حتى تكوّن
بمجموعها الشرط الكامل للنجاح . إذ مع تخلف بعضها تتخلف النتائج المطلوبة ، لا
محالة .
الفرق السادس :
إن شرائط الظهور دخيلة في التخطيط الالهي ، ومأخوذة بنظر الاعتبار فيه ... باعتبار
توقف اليوم الموعود عليه . بل أننا عرفنا : أن البشرية كلها من أول ولادتها وإلى
يوم الظهور ، كرّسها التخطيط الالهي ، لايجاد يوم الظهور .
وأما العلامات ، فليس لها أي دخل من هذا القبيل .... بل كل انتاجها ، هو اعلام
المسلمين وتهيئة الذهنية عندهم لاستقبال يوم الظهور . وجعلهم مسبوقين بحدوثه في
المستقبل أو بقرب حدوثه .
صفحة (398)
الفرق السابع :
إن علامات الظهور ، يمكن بالانتباه أو بالفحص والتدقيق ، التأكد مما وجد منها وما
لم يوجد ... باعتبارها حوادث يمكن تحديدها والاشارة إليها . ومن هنا انبثقت دلالتها
للمسلمين على قرب الظهور .
وأما الشرائط ، فقد قلنا اجمالاً أنه من المتعذر تماماً التأكد من اجتماعها .
وذلك ، لأن منها : حصول العدد الكافي من المخلصين الممحصين في العالم . وهذا مما لا
يكاد يمكن التأكد منه لأحد من الناس الاعتياديين . لأنه لا يمكن أن نعلم في الأشخاص
المخصلين أنهم وصلوا إلى الدرجة المطلوبة من التمحيص أو لا . ونشك في حدوث العدد
الكافي في العالم منهم على استمرار . فيبقى العالم بحصول هذا الشرط منغلقاً تماماً
. وإنما نعرف حصوله بحصول الظهور نفسه ، فان حصوله يكشف عن وجود سببه وشرطه قبله لا
محالة .
فهذه هي الفروق بين علامات الظهور وشرائطه . ويمكن اعتبار الفرق الأول فرقاً في
المفهوم والمعنى . واعتبار الفروق الأخرى فروقاً في الخصائص والصفات .
الجهة الثانية :
ما هي وكم هي شرائط الظهور ؟!
ونحن إذ نتكلم عن شرائط الظهور ، إنما نريد بها الشرائط التي يتوقف عليها تنفيذ
اليوم الموعود ، ونشر العدل الكامل في العالم كله فيه ... ذلك اليوم الذي يعتبر
ظهور المهدي (ع) الركن الأساسي لوجوده ، ومن ثم يتحدد ظهوره عليه السلام بنفس تلك
الشرائط . بالرغم من أن فكرة الغيبة والظهور ، إذا لاحظناها مجردة ، لن نجدها منوطة
بغير إرادة الله عز وجل مباشرة . ولكن الله تعالى أراد أن يتحدد الظهور بنفس هذه
الشرائط ، لأجل انجاح اليوم الموعود . لأن المهدي (ع) مذخور لذلك ، فيكون بين
الأمرين ترابط عضوي وثيق .
صفحة (399)
وإذا نظرنا إلى هذا المستوى الشامل ارتفعت الشرائط إلى ثلاثة :
الشرط الأول :
وجود الأطروحة العادلة الكاملة التي تمثل العدل المحض الواقعي ، والقابلة التطبيق
في كل الأمكنة والأزمنة ، والتي تضمن للبشرية جمعاء السعادة والرفاه في العاجل ،
والكمال البشري المنشود في الآجل .
إذن بدون مثل هذه الأطروحة يكون العدل الكامل منتقياً ، وغير ممكن التطبيق . والعدل
الجزئي الناقص ، لا يمكن أن يكون مجدياً أو مؤثراً في سعادة البشرية لوجود جوانب
النقص المفروضة فيه ، تلك الجوانب التي يمكن أن تتأكد وتبرز ، فتقضي على مثل هذا
العدل في يوم من الأيام .
كما أن العدل الناقص ، لا يمكن أن يكون مستهدفاً لله عز وجل ، ومخططاً له من قبله
تعالى ... فان خطط له ، هوالعبادة الكاملة التي لا تتحقق إلا بالعدل الكامل . وخاصة
بعد أن عرفنا أن البشرية كلها قد عملت في التمهيد لذلك الهدف الالهي ، فهل من
الممكن أن يخطط الله تعالى استغلال جهود البشرية ومآسيها لايجاد العدل الناقص ؟ وهل
ذلك إلا الظلم الشنيع للبشر ، جل الله تعالى عنه علواً كبيراً .
إذن ينتج من هذا الشرط ثلاثة أمور :
الأمر الأول :
أن الهدف في الحقيقة هو تطبيق الأطروحة العادلة الكاملة التي لا تحتوي على ظلم أو
نقص .
الأمر الثاني :
أن تكون هذه الأطروحة ناجزة عند الظهور . إذ مع عدمها يومئذ ، ينتقي التطبيق
بانتقائها ، ويتعذر العدل المنشود في اليوم الموعود .
الأمر الثالث :
أن تكون هذه الأطروحة معروفة ولو بمعالمها الرئيسية ، قبل البدء بتطبيقها . لما
عرفنا في الحديث عن التخطيط الالهي من أن تطبيقها يتوقف على مرور الناس بخط طويل من
التجربة والتمحيص عليها ، ليكونوا ممرنين على تقبلها وتطبيقها ، ولا يفجؤهم أمرها
ويهولهم مضمونها ويصعب عليهم امتثالها ، فيفسد أمرها ويتعذر نجاحها ، كما هو واضح .
صفحة (400)
الشرط الثاني
وجود القائد المحنك الكبير الذي له القابلية الكاملة لقيادة العالم كله
ويتم الكلام حول هذا الشرط ضمن نقطتين :
النقطة الأولى :
يرجع هذا الشرط بالتحليل إلى شرطين :
أحدهما : اشتراط وجود القائد للثورة العالمية . حيث لا يمكن تحققها من دون قائد .
ثانيهما : أن يكون لهذا القائد قابلية القيادة العالمية .
أما اشتراط وجود القائد ، فقد برهنا عليه في بحث سابق عن أهمية القيادة في التخطيط
الالهي . وكل ما نريد إضافته هنا ، هو التعرض إلى :
قيادة الجماعة :
فإن البديل المعقول الوحيد لقيادة الفرد ، هو قيادة الجماعة . فإذا استطعنا مناقشة
قيادة الجماعة وإبطاله ، يعني الأخذ بقيادة الفرد ، والإيمان بها كسبب وحيد رئيسي
لنجاح اليوم الموعود .
فان حال الجماعة لا يخلو من أحد ثلاثة أشكال :
الشكل الأول :
أن يكون كل فرد قابل لقيادة منفرداً فضلاً عن الاجتماع .
الشكل الثاني :
أن يكون كل فرد ناقصاً غير قابل لهذه القيادة ، ولكن الرأي العام المتفق عليه بينهم
، قابل لهذه القيادة .
الشكل الثالث :
أن يكون كل فرد ناقصاً ورأيهم العام ناقصاً أيضاً .
أما الشكل الأول ، فلا شك أنه لا بد من اسقاطه عن نظر الاعتبار ، لعدم تحققه في أي
ظرف من ظروف التاريخ وعدم تحققه في المستقبل أيضاً ما دامت البشرية . ولم يدّعه أحد
من المقنتين أو المتفلسفين أو الاجتماعيين أصلاً.
صفحة (401)
فإذا توقف اليوم الموعود على مثل هذا الشكل ، كان غير ممكن التطبيق إلى الأبد ، وهو
خلاف اجماع أهل الأديان السماوية المعترفة باليوم الموعود .
على أن افتراض : أن مجموع الأفراد إذا كانوا قابلين للقيادة منفردين ، كانوا قابلين
لها مجموعين ... افتراض غير صحيح ، لأن ممارسة القيادة الجماعية تصطدم بتنافي
الآراء وتضادها ، بخلاف القيادة الفردية . وتنازل البعض أو الأقلية عن آرائهم بازاء
الآخرين ، طبقاً للمفهوم الديمقراطي الحديث ... يعني التنازل عن عدد من الآراء
الكبيرة القابلة لقيادة العالم – كما هو المفروض في هذا الشكل الأول – وهو خسارة
عظيمة وظلم مجحف .
وأما الشكل الثالث : فلا شك من ضرورة اسقاطه عن الاعتبار أيضاً ، فان اجتماع
الناقصين لا يمكن أن يحقق كمالاً.فإذا كان رأيهم المتفق عليه ناقصاً ، كانت قيادتهم
ناقصة ، وتعذر عليهم تطبيق الأطروحة العادلة الكاملة ، بطبيعة الحال .
فإن قال قائل : إن هذا النقصان نسبي وغير محدد المقدار . فلعله يكون بمقدار ، لا
يكون مانعاً من المقصود .
قلنا له : كلا . فان النقصان بالنسبة إلى كل مبدأ حياتي ، راجع إلى الاخلال
بمتطلباته . فالنقص المقصود هنا ، هو النقص المؤدي إلى الاخلال بمتطلبات الأطروحة
الكاملة . ومعه يكون فرض النقصان مساوقاً مع عدم تطبيق تلك الأطروحة لا محالة .
وأما الشكل الثاني : فهو ممكن بحسب التصور . بأن يكون رأي الفرد ناقصاً غير قابل
للادارة والقيادة . ولكن يكون الرأي العام المتفق عليه قابلاً لها .
إلا أننا يجب أن نلاحظ أن قيادة العالم وتطبيق الأطروحة الكاملة من الدقة والأهمية
، تفوق بأضعاف مضاعفة قيادة أي دولة في العالم مهما كانت واسعة وكبيرة . ومن هنا
كان للرأي العام لأجل أن يكون كاملاً وقابلاً لهذه القيادة ، أن يكون كل فرد من
مكوِّنيه بالرغم مما عليه من نقصان ، ذو درجة عليا من الوعي والشعور بالسمؤولية
والتدقيق في الأمور ، بحيث يتحصل بانضمامه إلى غيره ذلك الرأي العام المتفق عليه ،
القابل للقيادة . وهذه الصفة لم تصبح غالبة في الأفراد على طول الخط التاريخي
الطويل لعمر لابشرية تجاه أي مبدأ من المبادئ فضلاً عن العدل الكامل . وفي دولة
محدودة ، فضلاً عن أفراد البشرية في دولة عالمية .
صفحة (402)
وهذا أمر وجداني يعيشه كل فرد منا بالنسبة إلى ملاحظة أنحاء الفشل والاضطرار إلى
التعديلات المتوالية في الدول والسياسات العامة ، مهما كانت قيادتها شخصية أو
جماعية . ولم تنجح أي ديمقراطية جماعية لحد الآن من الخطأ والزلل ، بل العمد في
أكثر الأحيان .
وإنما نقول بامكان ذلك : في مورد واحد ، وهو أهم الموارد وأعظمها ، وهو أن هؤلاء
الأفراد المخلصين الممحصين الذين عرفنا بعض صفاتهم وأساليب تمحيصهم وتربيتهم ، إذا
قاموا بمهمة يوم الظهور وتمرنوا على الحكم واطلعوا اطلاعاً واسعاً ومباشراً على
دقائق وحقائق الأوضاع في العالم... فيومئذ يكون ما يتفقون عليه رأياً كاملاً ناضجاً
قابلاً للمشاركة في قيادة العالم على وجود الحقيقة ... ومع استمرار التربية بين يدي
المهدي (ع) يكون هذا الرأي العام (معصوماً) عن الخطأ لا محالة .
وهذا المستوى هو المشار إليه بقوله تعالى : ﴿ وأمرهم شورى بينهم ﴾ . وهو الذي يعتمد
عليه المهدي (ع) ويدخل الالهي في قيادة العالم بعد وفاة المهدي (ع) .
وهذه الشورى ليست في الإسلام للمجتمع الناقص أو المنحرف أو الكافر .
وإنما تكون للمؤمنين الكاملين ﴿ الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش ، وإذا ما
غضبوا هم يغفرون . والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة ، وأمرهم شورى بينهم ،
ومما رزقناهم ينفقون ﴾ (1) .
فهذا استطاعت الأمة بالتربية الموسعة المتواصلة ، تحت القيادة الحكيمة ، أن يصل كل
أفرادها أو جلهم إلى مثل هذه المرتبة العليا من الكمال ، كان الرأي العام المتفق
عليه ، للأمة الاسلامية كلها "معصوماً " لا محالة ، ويكون اجماعها سهل الايجاد إلى
حد كبير ، ورأيها قابلاً لقيادة العالم بنفسه . ويومئذ يكون للديمقراطية القائمة
على أساس العدل المحض وجه وجيه إن كان ثمة حاجة للاستغناء عن الحكم الفردي يومئذ .
_________________________________
(1) الشورى : 43/37-38
صفحة (403)
وهذا هو المشار إليه بقوله (ص) فيما روي عنه : لا تجتمع أمتي على خطأ أو على ضلالة
. فان الأمة لا تكون كذلك إلا إذا كان رأيها العام معصوماً . لا ما يكون رأياً
عاماً في عصر الفتن والانحراف وانقسام الأمة الاسلامية إلى مذاهب ومبادئ مختلفة .
كما أنه هو المشار إليه بقوله تعالى : ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس ﴾ باعتبار أن
التشريع الذي أنزل إليهم قابل لتربيتهم حتى يكونوا خير أمة أخرجت للناس .
ولن يكونوا على هذا المستوى فعلاً الا مع الطاعة الكاملة ، والوصول إلى مستوى
"العصمة" في الآراء العامة . وأما في عصر الفتن والانحراف ، فلعمري أنهم ليسوا
بالفعل خير أمة أخرجت للناس .
ولذا قال الله تبارك وتعالى:﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن
المنكر وتؤمنون بالله﴾(1)ولن تكون الأمة آمرة وناهية ومؤمنة إلا في ذلك العصر .
وعلى أي حال ، يستحيل على عصر الفتن والانحراف ، أن يوجد رأياً عاماً كاملاً عادلاً
، يمكنه أن يقود العالم قيادة جماعية في اليوم الموعود .
ومعه تبطل الأشكال الثلاثة للقيادة الجماعية ، ومعه يتعين أن تكون القيادة منوطة
بفرد واحد يكون على المتسوى الكامل من قابلية قيادة العالم قيادة عادلة .
وهذا هو المقصود ، فاننا لا نعني من القائد الواحد إلا ذلك .
_________________________
(1) آل عمران : 3/110 .
صفحة (404)
الشرط الثالث :
وجود الناصرين المؤازرين المنفذين بين يدي ذلك القائد الواحد . وتتعين البرهنة على
ذلك والقول به ، بعد نفي فرضيتين :
الفرضية الأولى :
أن يفترض أن هذا الفرد الواحد ، يغزو العالم بمفرده .
وهو واضح الامتناع والبطلان ، مهما أوتي الفرد من كمال عقلي وجسمي ...
بعد التجاوز عن الفرضية الآتية ، وهو إيجاد المعجزة من أجل تحقيق النصر .
فإن قال قائل : بأن هذا القائد يبدأ العمل منفرداً ويستمر به ، حتى يحصل على عدد من
الأصحاب والمؤيدين ...كما فعل النبي (ص) .
قلنا : هذا معناه أنه لا يغزو العالم إلا بعد تحصيل المؤيدين والمناصرين ... لا أن
يغزو العالم منفرداً
الفرضية الثانية :
إن هذا القائد يغزو العالم عن طريق المعجزة . وقد سبق أن ناقشنا ذلك مختصراً .
وحاصل المناقشة تتلخص في جوابين :
الجواب الأول :
أنه لو كانت الدعوة الالهية على طول التاريخ ، قائمة علىإيجاد المعجزات من أجل
النصر ز لما وجد علىوجه الأرض منذ خلقت أي انحراف أو ضلال ، ولما احتاج الأمر إلى
قتل وجهاد . في حين قدمت الدعوة الالهية آلاف الأنبياء والعالمين كشهداء في طريق
الحق ، بما فيهم الأئمة المعصومين عليهم السلام ، وأوضحهم الامام الحسين (ع) في
فاجعة كربلاء .
ولو كان الأمر كذلك ، لما احتاج اليوم الموعود إلى أي تأجيل أو تخطيط ، إذ يمكن
إيجاده في أي يوم منذ ولدت البشرية إلى أن تنتهي . ولعل الأولى والأحسن في مثل ذلك
، أن يكون نبي الاسلام وهو خير البشر هو القائد العالمي المنفذ لليوم الموعود
والهدف الأساسي من خلق البشر . مع أنه لم يشأ الله له ذلك .
صفحة (405)
الجواب الثاني :
إن الدعوة الالهية على طول الخط ، على التربية الاختيارية للفرد والأمة ، على
السواء .
وذلك : أنه بعد أن وهب الله تعالى للانسان : السمع والبصر ، والفؤاد يعني العقل
والاختيار ، وهداه النجدين : طريق الحق وطريق الباطل ، وحمَّله مسؤولية أعماله
والأمانة الكبرى التي رفضت السموات والأرض أن يحملنها ، وحملها الانسان ... انه في
هذا الجو تبدأ فكرة التمحيص .
ومن المعلوم أن الايمان الممحص ، ولو بشكله البسيط يكون أثمن وأرسخ من الايمان
القهري ... فانه يتصف بالفحالة والضيق ، وفي قلة الاستجابات الصالحة المطلوبة من
قبل الانسان . وهذا الايمان القهري هو الذي يمكن أن ينتج من جو المعجزات .
إذن ، فحيث تنتفي هاتين الفرضيتين ، يتعين ما المطلوب ، وهو احياج القائد في تطبيق
العدل على العالم إلى الناصرين والمؤيدين ، لكي ينتشر بالجهاد انتشاراً طبيعياً .
وتندرج في هذا الشرط ، الصفات الأساسية التي يجب أن يتصف بها هؤلاء المريدون .
ليكون هذا الشرط في واقعه: وجود المؤيدين على النحو المعين لا المؤيدين كيف كان .
إذ من المعلوم أن المؤيدين المصلحيين ، لا يمكن أن يقوموا بالمهمة المطلوبة ،
باعتبار ما تحتاجه من التضحيات الجسام التي تنبو مصالحهم عنها من أول الطريق .
وأهم ما يشترط في هؤلاء المؤيدين ، شرطان متعاضدان ، يكمل أحدهما الآخر ، ويندرج
تحتهما سائر الأوصاف :
أحدهما : الوعي والشعور الحقيقي بأهمية وعدالة الهدف الذي يسعى إليه ، والأطروحة
التي يسعى إلى تطبيقها .
ثانيهما : الاستعداد للتضحية في سبيل هدفه على أي مستوى اقتضته مصلحة ذلك الهدف .
وبمقدار ما يوجد في نفس الفرد من هاتين الصفتين ، يكون الفرد ، قابلاً للعمل
الاجتماعي العام والجهاد في سبيل الحق . والتكامل فيهما هو الذي ينتج عن التمحيص
الالهي . ووجودهما في العدد من الناس الكافي لغزو العالم وتطبيق الأطروحة العادلة
الكاملة فيه ... الذي هو الشرط الثالث للظهور ... هو النتيجة التي تحصل عن التخطيط
الالهي الموعود . كما سبق أن عرفنا .
صفحة (406)
وبمقدار ما يفقد الفرد من هاتين الصفتين ، يكون عاجزا ًعن العمل والجهاد .
مهما كان مخلصاً في تدينه على الأساس الانعزالي المتقشف المتحنث . وبمقدار ما تفقد
الأمة من هاتين الصفتين تكون عاجزة عن تطبيق العدل في ربوعها ، حتى لو اجتمعت كل
أفراد الأمة بل جميع البشرية لانجاحه ، ما دام اجتماعهم مصلحياً غير مخلص ولا واع
ولا ممحص .
ومن هنا ، استهدف التخطيط الالهي ، إيجاد التمحيص الذي يربي الأمة التربية
التدريجية البطيئة نحو إيجاد هذين الشرطين ، وتكاملهما في نفوس الأفراد ، بحيث
يكونون قابلين لقيادة العالم . فيحققون هذا الشرط الثالث . وقد سبق أن حملنا فكرة
كافية عن أسلوب ذلك .
* * *
يبقى علينا بعد الاطلاع على الشروط الأساسية للظهور ، التعرض إلى ملاحظتين :
الملاحظة الأولى :
أنه قد يقال بلزوم شرط رابع لتطبيق الأطروحة العادلة الكاملة في اليوم الموعود ،
وهو وجود قواعد شعبية كافية ذات مستوى في الوعي والتضحية كاف ، من أجل هذا التطبيق
، لتكون هي رائدة الأول في اليوم الموعود .
فإن المخلصين الممحصين الذين يتوفر فيهم الشرط الثالث ، يمثلون الطليعة الواعية
لغزو العالم ، وأما تطبيق الأطروحة فيحتاج إلى عدد أكبر من القواعد الشعبية الكافية
ليكونوا هم المثل الصالحة لتطبيق الأطروحة العادلة الكاملة في العالم ، حين يبدأ
انتشاره يومئذ .
وهذا الأمر ، لا يخلو من صحة ، وقد وفر الله تعالى له في تخطيطه ، نتيجة للتمحيص ،
مستويين من الشعور :
المستوى الأول :
الاخلاص الاقتضائي الذي عرفنا أنه عبارة عن استعداد جماعة للتجاوب مع تجربة يوم
الظهور وتطبيقاته ، وقلنا أن هذا الشعور يوجد عند كثير من البشر ، وإن كانوا
يمارسون قبل الظهور شيئاً من العصيان والانحراف .
صفحة (407)
المستوى الثاني :
الشعور باليأس من كل التجارب السابقة التي ادعت لنفسها حل مشاكل العالم ، ثم افتضح
أمرها وانكشف زيفها ، نتيجة للتمحيص والتجربة .
وينعكس هذا الشعور في النفس ،على شكل توقع غامض لأطروحة عادة جديدة تكفل الحل
الحقيقي للمشاكل والمظالم البشرية . وسيتمثل هذا الشعور بالارتباط نفسياً ، بأول
أطروحة شاملة تدعي لنفسها ذلك .
وسيكون كلا المستويين من أفضل الأرضيات الممكنة لتلقي يوم الظهور ، على ما سنشرح في
التاريخ القادم .
وأما وجود قواعد شعبية موسعة في العالم ، لها شعور واضح بالرضا بتطبيقات اليوم
الموعود ، فهو مما لا ينبغي أن نتوقعه ، بعد الذي عرفناه من التخطيط الالهي والحديث
النبوي المتواتر ، من أنه لا بد أن تمتلئ الأرض ظلماً وجوراً ... إلى حين الظهور .
وهو – أيضاً – مما لا حاجة إليه ، بعد وجود هذين المستويين من الشعور ، لدى الناس
... وابتداء المهدي (ع) بغزو العالم ، من زاوية في غاية الشدة والقوة ، على ما
سنعرف في التاريخ القادم أيضاً ... وسنعرف الضمانات المتوفرة لانتصاره يومئذ ...
بدون أن يؤخذ وجود هذه القواعد الشعبية بنظر الاعتبار .
الملاحظة الثانية :
إن هذه الشرائط الأربعة من شرائط تطبيق العدل المحض في اليوم الموعود .
وإن قلنا : شرائط الظهور ، فتصبح الشرائط ثلاثة ، لأن معنى الظهور مستلزم لوجود
قائد معد في التخطيط الالهي لتكفل مسؤولية اليوم الموعود ، وهو يعني التسليم المسبق
بتحقق الشرط الثاني . فلا تبقى لدينا إلا شرائط ثلاثة .
ولو غيرنا وقلنا : شرائط الظهور في الاسلام ، فقد أخذنا الشرط الأول مسلّماً مفروض
التحقق ، فلم يبق سوى الشرطين الأخيرين .
ولو أننا مشينا خطوة أخرى ، فقلنا بقلة أهمية الشرط الرابع بازاء الثالث ،
بحيث حذفنا الرابع واعتبرناه من الصفات لا من الشرائط ، أو أدرجناه في الثالث ،
باعتبار أنهما يعودان إلى فكرة واحدة من نتائج التمحيص ، يتكفل الثالث وجودهما
المعقد القليل ويتكفل الرابع وجودها المبسط العريض ... لو مشينا هذه الخطوة ، لم
يبق لدينا إلا الشرط الثالث ، وهو وجود العدد الكافي من المخلصين لغزو العالم . وهو
الشرط الأساسي الذي قلنا أن التخطيط الالهي ، بعد الاسلام قد استهدفه .
صفحة (408)
إلا أن الاعراض عن الشرطين الأولين ، لا يعني إسقاطهما عن الشرطية ، وإنما يعني
ذينك الشرطين ، ويكون التركيز – بطبيعة الحال- على الشرط المتبقي .
ولابد لنا في نهاية المطاف أن نشير أن هناك فرقاً أساسياً بين الشرطين الأولين ،
والشرطين الأخيرين . فالأولان يتوقف عليهما أصل وجود اليوم الموعود . إذ بدون
الأطروحة العادلة والقائد الرائد لها ، لا معنى لوجوده أصلاً . والشرطان الأخيران ،
مما يتوقف عليه نجاح اليوم الموعود وتحقيق أهدافه . وبخاصة الثالث الذي هو وجود
العدد الكافي من المخلصين لغزو العالم ، إذ لولا وجودهم لما أمكن النجاح إلا
بالمعجزة ، التي عرفنا أن ديدن الدعوة الالهية على عدم إيجادها .
* * *
الجهة الثانية :
في ارتباط شرائط الظهور بالتخطيط الالهي .
حملنا – إلى الآن – فكرة مهمة عن هذا الارتباط . ينبغي لنا في هذه الجهة أن نركز
الكلام ونفصله ، مع تحاشي التكرار جهد الامكان ... وذلك ضمن نقطتين :
عرفنا في الفصل الذي عقدناه لبيان التخطيط الالهي لليوم الموعود : ان هذا التخطيط
مكرس خصيصاً لأجل إنجاح اليوم الموعود وضمان وجود العدل فيه .
ولو لم يكن لذلك شيء من الشروط ، لأمكن إيجاده في أي وقت . ولأمكن الاستغناء عن
التخطيط أيضاً . وإنما تبرهن وجود هذا التخطيط ، باعتبار البرهنة على وجود هذه
الشرائط من ناحية ، والبرهان بشكل طبيعي غير اعجازي ، فيما لا ينحصر توقفه على
المعجزة .
صفحة (409)
والتخطيط الالهي يقوم بتربية البشرية بأسلوب معين لأجل إيجاد هذه الشرائط تدريجاً
خلال عمر البشرية الطويل .
فأول هذه الشرائط وجوداً هو حصول الأطروحة الكاملة العادلة المتمثلة بالاسلام ،
باعتبار أن البشرية قبله كانت في مرحلة التربية التدريجية للاعداد لفهم هذه
الأطروحة ، كما سبق أن أوضحنا .
ولم يكن في الامكان أن تسود العالم أطروحة سماوية سابقة ، باعتبار كونها (عدلاً
مرحلياً ) يقصد به التربية إلى تقبل العدل الكامل أكثر مما يقصد به التطبيق الشامل
. مضافاً إلى ما قلناه من أن تمحيص البشرية لم يكن كاملاً ، وكان لابد لها أن تمر
بالتمحيص على الطروحة الكاملة نفسها .
ومن ثم يكون لهذا الشرط السبق المنطقي في التربية على سائر الشرائط الأخرى ... إذ
لا معنى لوجود القائد قبل وجود القانون الذي يوكل إليه تطبيقه ... كما لا معنى
للتمحيص الكامل المنتج للشرطين الأخيرين ، إلا التمحيص على الأطروحة الكاملة .
فإن قيل : فلماذا لا يمكن وجود القائد قبل وجود الأطروحة أو معها .
قلنا في جوابه : إن أردتم من وجود القائد ، وجوده وممارسته للقيادة فعلاً ... فهذا
مما لا يمكن نجاحه قبل وجود الأطروحة العادلة والتمحيص الكامل . وإن أردتم وجوده ،
ولو في الغيبة ، بمعنى وجوده قبل الاسلام غائباً حتى يأذن الله تعالى له بالظهور .
فهذا الاحتمال ، يحتوي على اسفاف في التفكير . إذ لا موجب لوجوده في ذلك الحين .
وإذا كان خالياً عن –الحكمة لم يكن الله تعالى ليفعله . بل ان الحكمة في تأخره عن
الاسلام ، لعدة نواحٍ مهمة : منها طول الغيبة طولاً مفرطا ًلو وجد قبل الاسلام .مما
يسبب فتح أفواه الشكاكين أكثر . ومنها :عدم وجود ارهاصات كافية واردة لنا من قبل
الاسلام لاثبات وجوده لو كان موجوداً . إذن فوجوده يومئذ معناه ضياعه على الناس
وانتفاء البرهان على وجوده أصلاً . وهو محذور مهم خطط الله تعالى لرفعه رفعاً باتاً
. إلى غير ذلك من النواحي . ومعه فيتعين أن يكون القائد موجوداً ومولوداً بعد نزول
الأطروحة العادلة الكاملة ، المتمثلة بالاسلام .
صفحة (410)
وكان ثاني الشروط تحققاً هو وجود القائد المذخور لليوم الموعود ، انطلاقاً من زاوية
الاعتقاد بغيبته عليه السلام .
وقد عرفنا لذلك آثاراً مهمة تمت إلى التمحيص بصلة ... كالتربية على طاعته واحترام
رأيه وامتثاله . ولولا الغيبة لم يكن تحقق ذلك . مضافاً إلى مصالح أخرى سنذكرها في
الجهة الآتية إنشاء الله تعالى .
ومعه يكون لهذا الشرط التقدم المنطقي في الرتبة على الشرطين الأخيرين ، باعتبار
كونهما منبثقين عن التمحيص ... ذلك التمحيص الذي يقوم – بالنسبة إلى جزئه المهم –
على تقدم وجود القائد وغيبته ، بحيث لولا ذلك لكان التمحيص ناقصاً نقصاً مهماً .
إلى حد يكاد يتعذر إيجاد اليوم الموعود وإنجاحه ، على ما سنسمع في التاريخ القادم .
وأما الشرطان الأخيران : أعني وجود الناصرين الممحصين بالعدد الكافي لغزو العالم ،
ووجود القواعد الشعبية المطبقة ... فما آخر الشرائط تحققاً ... وهما يوجدان مقترنين
نتيجة للتمحيص الطويل ، في عصر الفتن والانحراف، خلال عصر الغيبة الكبرى ، كما سبق
أن أوضحنا .
النقطة الثانية :
إن هذه الشرائط الذي ذكرناها لليوم الموعود ، مع التحفظ على روحها ، والتوسع في
مدلولها ، هي شرائط الدعوة الالهية في كل حين . وبمقدار ما تتضمنه دعوة أي نبي أو
إمام من نقاط قوة وتركيز لهذه الشروط ، فانها تستطيع التوسع والانتشار ، وبمقدار ما
تفقده منها تأخذ بالضيق والضمور وتضطر إلى الانسحاب الجزئي ، أو الأخذ بالعزلة
والتقية .
بل نستطيع القول بأن هذه الشرائط ، بصيغها الموسعة ، تكون هي الشروط الأساسية لنجاح
أي دعوة كانت مما يتوقع لها التوسع والانتشار ، أو أنها تطمع بذلك بشكل وآخر .
فبمقدار ما تحرزه من هذه الشروط تستطيع التقدم والسيطرة ، بمقدار ما تسخره منها ،
تضطر إلى الانسحاب والعزلة ومجاملة الناس .
ولا يلزمنا في تصور ذلك ، إلا تعميم معنى الشرائط وتوسيعها إلى حد ما ، فيصبح الشرط
الأول : هو وجود الفكرة المنظمة القانونية التي تدعي لنفسها إصلاح العالم ... وهو
ما يصطل عليه بالمبدأ في لغة العقائديين ، أياً كانت وجهته .
صفحة (411)
فإذا كان للمبدأ قائد محنك قدير ، وكان له من المؤيدين والمخلصين ، المقدار الكافي
لنشر دعوته ، ومن القواعد الشعبية المناصرة له المقدار الكافي أيضاً ... كتب لدعوته
النجاح والتقدم لا محالة .
وأقصى ما تحاول الدعوات في العالم جاهدة لايجاده ، هو إيجاد هذين الشرطين الأخيرين
، بعد فرض كونها دعوات مبدأية ذات قيادة . وقد كُرس التخطيط الالهي على تحقيقها
أيضاً ، بعد أن أصبحت الأطروحة العادلة الكاملة بميلاد المهدي (ع) دعوة ذات قيادة .
وإن لم تستطع الدعوات إحراز هذه الشرائط ، وبخاصة الشرطين الأخيرين ... كان ذلك
سبباً لتقهقرها وتقدم خصومها ومناوئيها . فاما أن تبقى في ميدان الجهاد والمجابهة
حتى تفنى عن آخرها وتنقطع دعوتها بالمرة . وأما أن تأخذ بمسلك السرية والتكتم
ومجاملة الناس . لأجل المحافظة على مبدئها وقواده ... وهو المعنى الرئيسي للتقية،
كما أوضحنا فيما سبق .
إذن فالتقية تقترن على طول الخط ، وفي جميع الدعوات في العالم ، مع قصور هذه
الشرائط عن ضمان النجاح ... كالمسلك الذي تطبقه الأحزاب المبدأية في العصور
المتأخرة ، من السرية والكتمان ... وكما أمر به الاسلام في العصر الذي لم تتحقق فيه
هذه الشرائط بالنسبة إلى الأطروحة العادلة الكاملة ، وهو عصر ما قبل الظهور .
وعلى أي حال ، فالدعوة الالهية ، على طول الخط ، كانت تدور مدار وجود هذه الشرائط
وعدمها . ويتجلى ذلك بكل وضوح ، في التاريخ الاسلامي . حيث نرى النبي (ص) كان
ملتزماً في أول دعوته بالسرية والتكتم أو "التقية" حينما لم يكن الشرطان الأخيران :
الأنصار والمؤيدين متوفرين لديه . ولم يبدأ دعوته إلا بعد أن أحرز من محتوى الشرطين
ما يكفي لضمان البقاء . ولم يبدأ بالحرب مع الأعداء ، في أول غزواته في بدر ، إلا
عندما حصل على العدد الكافي من الناصرين المندفعين بالحرارة العاطفية الثورية ،
التي قلنا أنها البديل عندهم عن الوعي والاخلاص الممحص ، لعدم توفر التمحيص الكافي
بالنسبة إليهم .
صفحة (412)
واستمر الفتح الاسلامي مبنياً على هذا الأساس ... وإنما بدأ الانحطاط والضمور ، مع
الانحراف وقلة اخلاص المخلصين وعدم اندفاع المندفعين .
ونرى الامام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ، إنما يأخذ بزمام الاصلاح
في الأمة الاسلامية ، حين يجد الناصرين المؤيدين ، فيناجز الناكثين والقاسطين
والمارقين من القتال . ولولا ذلك ن لم يكن الجهاد لازماً عليه . كما نفهمه من قوله
عليه السلام : أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، لولا حضور الحاضر ، وقيام الحجة
بوجود الناصر ، وأما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم
، لا لقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها ، ولألفيتم دنياكم هذه أزهد
عندي من عطفة عنز (1) .
وإنما أخذ الله تعالى على العلماء ذلك ، عند قيام الحجة بوجود الناصر ، وهو عبارة
عن توفر الشرط الثالث ، الذي لولاه لما وجب على القائد الاسلامي تكفل القيادة ،
ولاعتزال علي عليه السلام هذا المركز الهام ، ولم يغرّه ما فيه من منزلة وشهرة ومال
.
وإنما أكد على توفر الشرط الثالث ، باعتبار وضوح توفر سائر الشروط في دعوته عليه
السلام . وعدم وجود بوادر انخرامها إلا فيما يعود إلى هذا الشرط . فان دعوته مبدئية
ذات قيادة ، وهو بشخصه القائد ... وإنما كان عليه السلام يعاني من توفر الشرط
الثالث ... حيث نراه في العهد الأخير من خلافته يخاطب أصحابه بأنهم ملأوا قلبه
قيحاً ويتمنى إبدالهم بخير من صرف الدينار بالدرهم . وهذا راجع في حقيقته والتأسف
من ضعف الشرط الثالث يومئذ وعدم توفره بالنحو المطلوب ... للظروف التي كان يعيشها
المجتمع يومئذ ، مما لا مجال للافاضة فيه .
وحينما يتولى ابنه الامام الحسن عليه السلام مركز الخلافة ، والقيادة ، ويحاول
مناجزة القتال للجهاز المنحرف الحاكم ... يتفرق عنه جيشه ، ويستطيع معاوية شراء
ضمائر قادته واحداً بعد واحد . حتى لم يبق للامام (ع) من جيشه ناصر ... اضطر إلى
الصلح مع معاوية ... وهذا في واقعه ، رجوع إلى المحافظة على الدعوة المدئية بعد
انخرام الشرط الثالث ... أو الرجوع إلى التقية ، بالمعنى الذي قلناه بعد عدم وجود
الناصرين المؤيدين . ولتفصيل ظروف هذا القائد الممتحن الصابر مجال آخر .
___________________________
(1) أنظر نهج البلاغة شرح محمد عبده ، ط. مصر ، ص 31 وما بعدها .
صفحة (413)
ويأتي دور الامام الحسين بن علي عليه السلام بعد ذلك ... فتأتيه مئات الكتب من
العراق من الناصرين المؤيدين الثائرين على الحكم الأموي المنحرف ... فتتوفر له
"الحجة بوجود الناصر " ..أعني الشرط الثالث ، بعد توفر الشرائط الأخرى . فيشعر
بوجوب قيامه بالدعوة الالهية والثورة لطلب الاصلاح في أمة جده رسول الله (ص) ، كما
قال هو عليه السلام (1) .
وإذ ينحرف عنه هؤلاء الناصرون ، وينخرم الشرط الثالث ، نجد ما يترتب عليه من مأساة
دموية كبرى في كربلاء ... عليه وعلى آله وأصحابه السلام . فعيطي بذلك درساً خالداً
من التضحية والجهاد في سبيل الأطروحة العادلة الكاملة ، ليكون موقفه محكاً مقتدىً ،
لمن يريد أن يكون من الناجحين في التمحيص الالهي الكبير .
ويأتي دور الأئمة المعصومين عليهم السلام المتأخرين عن الامام الحسن (ع) ... فيبدأ
عصر الهدنة ، كما سمعنا تسميته بذلك من قبلهم عليهم السلام ... وذلك : باعتبار عدم
توفر الشرط الثالث وانعدام الناصرين المخلصين ، أو قلتهم عن المقدار الكافي للثورة
.
ويتضح ذلك بجلاء من موقف الامام الصادق (ع) تجاه مبعوث الثورة الخراسانية إليه .
الذي كان يقول له بأن الثائرين هناك أصحابه مؤيدوه ، فلماذا لا يقوم بالجهاد
والمطالبة بحقه في الحكم المباشر ... قائلاً : يا ابن رسول الله لكم الرأفة والرحمة
، وانتم أهل بيت الامامة . ما الذي يمنعك أن يكون لك حق تقعد عنه ، وأنت تجد من
شيعتك مئة ألف يضربون بين يديك بالسيف .
فقال له (ع) : اجلس يا خراساني رعى الله حقك . ثم قال : يا حنيفة ، اسجري التنور ،
فسجرته حتى صار كالجمرة وأبيض علوه . ثم قال : يا خراساني قم فاجلس في التنور .
فقال الخراساني : يا سيدي يا ابن رسول الله لا تعذبني بالنار ، أقلني أقالك الله .
قال : قد أقتلك .
______________________________
(1) مقتل الحسين ، ص 139 .
صفحة (414)
قال الرواي – وهو حاضر ذلك المجلس - : فبينما نحن كذلك ، إذ أقبل هارون المكي ،
ونعله في سبابته . فقال : السلام عليك يا ابن رسول الله . فقال له الصادق (ع) : ألق
نعلك من يدك واجلس في التنور . قال : فألقى النعل من سبابته ، ثم جلس في التنور .
وبعد هنيهة التفت إليه الامام عليه السلام ، وقال : كم تجد بخراسان مثل هذا . فقال
: والله ولا واحداً . فقال : أما أنا لا نخرج في زمان نجد فيه خمسة معاضدين لنا ،
نحن أعلم بالوقت (1) .
يتضح لنا من هذه الرواية أمران مقترنان :
احدهما : الصفة التي يجب أن يتحلى بها الناصر للدعوة الالهية ، نتيجة للاخلاص .
الممحص الذي عاش تجربته واقتطف ثمرته . وهي الايمان المطلق بالقيادة ، بحيث لا
يصرفه عن امتثال تعاليمها صارف ، ولا تأخذه فيها لومة لائم ، وإن جر عليه الوبال ،
وإن لم يفهم وجه الحكمة من التعاليم ، بعد أن كان لديه الايمان المطلق بالتعاليم .
ثانيهما : إن هذه الصفة غير موجودة في عصر التمحيص والامتحان ، أو عصر الهدنة ، في
العدد الكافي للقيام بالدعوة الالهية . ومن ثم يكون الشرط الثالث منخرماً . فلا
يكون القيام بهذه الدعوة واجباً ولا يوجد أي ضمان لنجاحها على تقدير القيام بها ...
كما كان عليه الحال ، في ثورات الثائرين في عصر الأمويين والعباسيين ، فانها جميعاً
كانت تفقد الضمان للنجاح ، فكان يكتب عليها الفشل ، مهما قويت واتسعت برهة من الزمن
.
وبهذا نستطيع أن نتبين بوضوح ، الأهمية البالغة للشرط الثالث الذي يريد الله تعالى
بتخطيطه العام إيجاده في البشرية من خلال التمحيص ، وما هي النتيجة الكبرى التي سوف
ينتجها ، وما هي الصفة التي يتحلى بها المخلص الممحص الذي يستطيع المشاركة في تطبيق
العدل الكامل على العالم كله ، بين يدي القائد المهدي (ع) . إذن ، فهذه الشرائط في
واقعها ، هي شرائط الدعوة الالهية في كل حين .
وحيث لم تتوفر على مر العصور ، لم تستطع هذه الدعوة شق طريقها المأمول في العالم
بالرغم من أن الله تعالى انزل دينه ﴿ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ﴾ .
_____________________________
(1) البحار ، جـ11 ، ص 139 ، عن المناقب لابن شهر اشوب .
صفحة (415)
وستشق هذه الدعوة طريقها ، ويتحقق مدلول هذه الآية الكريمة ، في أول فرصة تتوفر
فيها هذه الشروط . وليس ذلك غلا عند ظهور الامام المهدي (ع) .
ولولا التخطيط الالهي لايجاد الشروط ، باعتبار استهدافه لليوم الموعود ، لأمكن عدم
تحقق شيء من هذه الشروط في أي وقت من عمر البشرية الطويل .
ولكن الله تعالى ، وهو اللطيف الخبير بعباده ، شاء ان يتفضل على البشرية باليوم
الموعود ، وأن يربيها لأجل أن يزرع فيها بذور المسؤولية وإيجاد الشروط التي بها
تستطيع تكفل مسؤوليته .
* * *
الجهةالرابعة :
التخطيط الالهي الخاص بإيجاد القائد وكان للشرط الثاني حصته من التخطيط الالهي
لليوم الموعود ، وهو وجود القائد العظيم الذي يتكفل بعلمه وتعاليمه تطبيق العدل
المحض الكامل على العالم كله .
ويكون ذلك على مستويين ، الأول : بلحاظ إيجاد قابلية هذه القيادة في شخص القائد .
والثاني : باعتبار تكامل هذه القابلية لديه ، باعتبار أطروحة محتملة سنذكرها ونحاول
فهمها من الأدلة الاسلامية .
ومن هنا يقع الكلام في تفاصيل هذين المستويين .
المستوى الأول :
في إيجاد القائد العظيم ، بمعنى إيجاد الشخص القابل للقيادة العالمية أساساً .
ينحصر السبب لايجاد هذه القابلية في اي شخص ، بعد وجود القابلية الذاتية فيه من
ناحية نفسية وعقلية لذلك, ...ينحصر إيجادها بالتعليم والتثقيف من قبل شخص مطلع على
أساليب هذه القيادة وقواعدها العامة .
فإن لم يكن على وجه الأرض قائد تام المواصفات ، ليتكفل تربية من بعده من الأفراد
ليصبحوا قواداً . واقتضت المصلحة إقامة الحجة على البشر بإيجاد مثل هذا القائد ...
سمح (قانون المعجزات) الذي سبق أن ذكرناه، بوجود معجزة الوحي لايجاد النبي القائد .
فيكون المعلم والموجه والمربي الذي يوجد من شخص النبي قائداً عالمياً هو الله تعالى
. فيوجد النبي حاملاً إلى البشر أطروحته المبدئية ، وقابلاً للقيادة بمقدار من
يدعوهم إلىالايمان به واتباعه من البشر . فإن كانت دعوته عالمية وجب أن تكون
قابليته عالمية ، كما سبق أن برهنا عليه ... وهكذا كان نبي الاسلام (ص) .
صفحة (416)
وأما إذا كان مثل هذا القائد موجوداً على وجه الأرض ، واحتاجت الدعوة الالهية إلى
قائد جديد . فلا حاجة لاقامة المعجزة في مثل ذلك لتربية عنصر القيادة في القائد
الجديد . لامكان حصور التعليم على هذا المستوى الرفيع من قبل القائد الموجود ، بعد
اختيار الشخص القابل ذاتاً لتلقي هذا التعليم .
وقد يخطر في الذهن ، التساؤل عن الحاجة إلى التعليم ، في حين نجد الكثير من القادة
المعروفين كنابليون مثلاً ، قد قاموا بالقيادة حسب المنهج الذي رسموه ، بدون تعليم
مسبق .
والجواب عن ذلك : إن تعليم القائد يمكن أن يكون على أحد مستويات ثلاثة :
المستوى الأول :
تلقيه للثقافة العامة الموجودة لدى الفكر البشري ، في فرع واحد أو عدة فروع .
والتعليم على هذا المستوى موجود بالنسبة إلى كل قائد ، ممن يخطر على ذهن السائل .
يشترك في ذلك القادة على المتسوى الالهي والقادة على المتسوى المادي .
بل من الممكن أن نقول : أن القيادة لا تتوقف على هذا التعليم أصلاً . بحيث لو كان
القائد جاهلاً بفروع المعرفة أمكن أن ينجح في قيادته ، كما حدث أحياناً في التاريخ
، في بعض القيادات القديمة . نعم ، لو كان القائد هاوياً على مثل هذه المعرفة كان –
بلا شك – أفضل .
المستوى الثاني :
معرفته قيادة الحروب ، وتحريك القطعات العسكرية . وهو وإن كان ضرورياً للقائد ، إلا
أن القواعد العامة لذلك ، مما يتلقاه القادة بالتعليم ، وبدونها يكون فاشلاً لا
محالة . وليس كما ظن السائل من تولي القيادة بدون تعليم .
وأما تطبيق ذلك في الحروب ، فهو تابع إلى ذكاء القائد وعمق خبرته ، وليس مما يتلقاه
بالتعليم من كل القادة .
صفحة (417)
المستوى الثالث :
معرفته للايديولوجية العامة التي يستهدف نصرها ويحاول انجاحها وتطبيقها .
وهذا هو الجانب المهم الذي يعطي للقيادة مغزاها وللحروب معناها . وهو المحك الذي
تختلف به القيادة الالهية عن غيرها . فان القادة الاعتياديين يعرفون ذلك من
الاتجاهات العامة التي يستوحونها من المصالح الخاصة أو المجتمع المنحرف أو الكافر .
فتكون فكرة السيطرة أو الوطنية أو القومية أو غيرها عناصر كافية لتغطية هذه الحاجة
، من دون حاجة إلى التلقي بالتعليم .
وأما القيادة القائمة على الأساس الالهي ، فهي تنطلق من عدة زوايا كل واحدة منها
تحتاج إلى تعليم أولاً وإلى مران وتمحيص ثانياً وإلى تكامل وتعميق ثالثاً .
الزاوية الأولى :
استيعاب الهدف الذي من أجله وجدت البشرية واستهدفت هدايتهم ، ومن أجلها بعث
الأنبياء ووجب الجهاد ، وأقيمت الدولة الاسلامية .
الزاوية الثانية :
استيعاب دقائق القانون الذي يطبق في المجتمع البشري ، سواء على مستوى الدولة ، أو
قبلها .
الزاوية الثالثة :
طرق الارتباط بالناس وممارسة هدايتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر والقواعد
العامة التي تمت إلى ذلك بصلة .
الزاوية الرابعة :
الغيرية المطلقة : ورفض الأنانية ، بحيث يمكن الفرد في أية لحظة أن يضحي بكامل
كيانه في سبيل الهدف الذي عمل من أجله .
صفحة (418)
إلى غير ذلك من الزوايا ، التي يكون التعبير عنها باختصار سهلاً ، وأما تعميقها
وتطبيقها في عالم الحاية ، في غاية الصعوبة ، مضافاً إلى المستويين الأول والثاني ،
العاملين لكل قائد . ومن هنا احتاجت القيادة الالهية إلى تعليم.
وهذا هو الذي حصل ، بعدما قام التخطيط الالهي ، على إيجاد السبب المزدوج في القائد
: القابلية الذاتية والقابلية التربوية ، ومنه نستطيع اقتناص عدة نتائج مهمة :
النتيجة الأولى :
حين يكون السبب في التربية هو التعليم المباشر من قبل الله تعالى أو المتصل به
بالواسطة ... يكون من المستحيل عادة وجود قائد عالمي يقوم في قيادته على أساس مادي
. وهو – أيضاً – مما لم يحدث في أي فترة من التاريخ. فان القيادة العالمية لا تكون
إلا من التعليم الالهي ، ذلك التعليم المنافي للأساس المادي . وكل القواد الدنيويين
أو الماديين ليسوا عالميين على أي حال ، وإن قادوا دولاً كبيرة .
النتيجة الثانية :
إذا كن هذا هو سبب وجود القائد ، أمكننا دحض كل خلافة يدعيها صاحبها ويقوم بها عن
طريق "السيف" في أي عهد متأخر عن صدر الاسلام ، مما يكون قبل الظهور . كخلافة
العباسيين والعثمانيين أو كل من كان على وتيرتهم، ممن نعلم بعدم توفر هذا السبب
لديه ولدى أعقابه من الخلفاء .
النتيجة الثالثة :
أننا نقول نفس الشيء بالنسبة إلى المهدي الذي يولد في آخر الزمان ، طبقاً للفهم غير
الامامي .
فانه بعد وضوح انتفاء الوحي بالنسبة غليه ، لا يكن قابلاً للقيادة العالمية التي
يجب أن يتكفلها بعد انفصاله عن التربية الالهية المباشرة وبالواسطة أيضاً . فأنه لا
يوجد في عصره قائد عالمي سابق عليه ليباشر تعليمه وتكميله.
فإن قال قائل : إن لتمحيص الساري المفعول خلال عصر الغيبة الكبرى ، كفيل بإيجاد مثل
هذا الشخص .
قلنا له : كلا ، فان غاية ما للتمحيص من مقدرة هو إيجاد الأفراد المخلصين إلى درجة
عالية ، بحيث يستطيعون المشاركة في قيادة العالم ، تحت إشراف القائد الأكبر . وأما
أن يخلق التمحيص شخصاً له قابلية قيادة العالم ، من خلال عدد محدود من السنوات
...فلا .
صفحة (419)
فإن قال قائل : فان التمحيص يمكن أن يفرض مضاعفة بالنسبة وإليه وتشديده عليه ،
ليصنع منه قائداً عالمياً .
قلنا في جوابه ك إن التمحيص قاصر أساساً على إيجاد القائد العالمي . فان التمحيص
شيء والقيادة شيء آخر . ولولا التعليمات الموسعة التي يتلقاها الممحصون من قبل
المهدي (ع) لقيادة العالم بعد ظهوره ... لما أمكنهم ممارسة القيادة لمجرد كونهم
ممحصين . فان ما يفعله التمحيص هو تقوية الايمان والاخلاص وقوة الارادة ، وهذا مما
لا يكفي وحده لقيادة أياً كانت ، فضلاً عن قيادة العالم . وإن كان يكفي لأن يصبح
الفرد جندياً فدائياً في جيش عقائدي ثوري . وليس للمخلصين الممحصين من وضعية في غزو
العالم أكثر من ذلك .
ونحن ، وإن كنا لا ننكر ما للتمحيص من أثر بالغ في تثقيف الفرد من النواحي
الأخلاقية والدينية ، واطلاعه على المناقشات المناسبة لتيارات الانحراف في عصره من
وجهة نظر الاسلام . إلا أنها – على أي تقدير – لا يمكن أن تفي بالقيادة العالمية .
إذن ، فلا يمكن للتمحيص أن يوجد المهدي على المستوى المطلوب . وكل شخص وجد متأخراً
في الزمان منفصلاً عن التعليم الالهي ولو بالواسطة ... فأنه لا يمكن أن يقوم بمهمة
اليوم الموعود .
فإن قال قائل : إن المهدي متصل بالله تعالى مباشرة عن طريق الالهام ، كما يقول به
ابن عربي في الفتوحات المكية(1)وغيره . ومعه فالالهام هو الذي يباشر تربيته ولا
حاجة له إلى تلقي التعليم بالواسطة .
قلنا له : ان هذا صحيح ، بالنسبة إلى زمن توليه القيادة فعلاً ، ولا كلام لنا في
ذلك . وإنما الكلام في جعله قائداً لكي يمارس مهمته بعد ذلك . ولم يدع ابن عربي
تلقي المهدي للالهام قبل توليه القيادة ، كذلك وكل من يفهم المهدي بغير الفهم
الإمامي .
_________________________________
(1) أنظر الباب السادس والستين والثلاثمائة من المجلد الثالث ، ص 327 وما بعدها .
صفحة (420)
ومعه يتعذر القول بوجود المهدي وولادته في آخر الزمان ، طبقا لذلك الفهم ... لأن كل
من يوجد في العصر المتأخر عن عصر التشريع ، لا يمكن أن يكون قائلاً عالمياً
لانقطاعه عن الوحي ولو بالواسطة . لا يستثنى من ذلك أحد .
ومعه فلو قصرنا لانظر على ذلك ، لزم القول بفشل التخطيط الالهي ، وعدم تنفيذ اليوم
الموعود . إذن فلا بد من تصور التخطيط الالهي بالنحو المنسجم مع الإيمان بغيبة
المهدي ، ومشاركة الغيبة نفسها بقسط وافر من هذا التخطيط .
فان الأسلوب الوحيد الذي يمكن به ربط الإمام المهدي (ع) في تربيته القيادية بالوحي
، ولو بالواسطة ، ولو بالواسطة هو أنه ابن الإمام الحسن العسكري عليه السلام ،
ليكون قد تلقى الحقائق الكبرى عن طريق آبائه عن النبي (ص) عن الوحي الالهي .
فإذا تم ذلك ، تعين كونه مولوداً في زمان أبيه وباقياً إلى الآن ، محفوظاً بعناية
الله تعالى ، من أجل أن يقوم بالقيادة الكبرى في اليوم الموعود . إذن أصبحت الغيبة
الكبرى من الأسباب الضرورية لنجاح الدعوة الالهية في ذلك اليوم .
نعم ، يمكن أن نفترض بعض الافتراضات لتصوير ارتباط المهدي بالوحي ، بدون الغيبة .
كتسلسل وراثة قابلية القيادة العالمية طيلة هذه المدة بدون انقطاع ، إلى أن تتم
شرائط اليوم الموعود ، ويكون القائد الموجود في ذلك الحين هو المهدي .
أو يفترض انفصال ولادته عن وفاة أبيه بزمن طويل !! بطريق اعجازي ، وتلقيه التعليم
عنه بنحو اعجازي أيضاً . وغير ذلك من الافتراضات . إلا أن شيئاً منها لم يقل به أحد
من المسلمين ، فهو منفي بضرورة الدين واجماع المسلمين . فيتعين القول بالغيبة أعني
بقاءه الطويل من زمان أبيه إلى حين ظهوره .
النتيجة الرابعة :
اننا بعد أن عرفنا ان السبب الوحيد الموجود لقابلية قيادة العالم ، استطعنا أن
نبرهن به على بطلان كل مهدوية مدعاة على طول التاريخ أو تدعى في المستقبل مما لا
يكون متصلاً بالوحي ولو بوسائط .. فان الشخص الذي لا تتوفر لديه هذه الصفة يتعذر
عليه بالمرة القيام بالمهام الكبرى المنوطة بالمهدي (ع) . ومن ثم لم نر شخصاً
مدعياً للمهدوية استطاع السيطرة على العالم كله ، مضافاً إلى غفلة المدعي عن عدم
تمامية إنتاج التخطيط الالهي للعدد الكافي من المخلصين الممحصين .
صفحة (421)
ومن هنا يكون لنا مستمسك برهاني ، ضد مدعي المهدوية ، اسبق في الرتبة من الدليل
الذي أشرنا اليه في التاريخ السابق (1) من اننا نستكشف من فشل الدعوة المهدوية
المدعاة انها دعوة كاذبة ، وان قائدها ليس هو المهدي المنتظر . لأننا لا نعني
بالمهدي ، إلا القائد العالمي القائم بأطروحة الحق العادلة الكاملة .
* * *
المتسوى الثاني :
في تكامل قابلية القيادة العالمية من الكامل إلى الأكمل ، بلحاظ أطروحة نطرحها
ونحاول البرهنة عليها . ويقع الكلام في ذلك في جوانب ثلاثة :
الجانب الأول :
في تحديد الأطروحة التي نقصدها ، والمفهوم الذي نريده ... يعرض معنى التكامل
بالنسبة إلى الكامل العظيم الذي له قابلية قيادة العالم ، وأسباب ذلك .
أن درجات التكامل المتصورة للعقل لانهائية العدد ، كلما وصل الفرد إلى مرتبة منها ،
استحق أن يرقى إلى درجة بعدها . تبدأ بأول درجات الإيمان وتنتهي بالوجود اللانهائي
الجامع لكل صفات الكمال ، الله عز وجل .
وحصول الانسان على الكمال اللانهائي ، غير ممكن ، كما ثبت في الفلسفة الاسلامية ،
إلا أن تصاعده من الكامل إلى الأكمل فالأكمل ، في غاية الامكان والوضوح . وكل درجة
يصل إليها الفرد ، فهي درجة محدودة ليست لا متناهية بطبيعة الحال .
ومن هنا يسير الناس المؤمنون في درجات الكمال ، من القليل إلى الكثير ومن الكثير
إلى الأكثر . ومن هنا ينبثق إمكان القول بتكامل ما بعد العصمة .. وإمكان تربية
المعصوم وان كان خير البشر ، فانه ان كانت الدرجة الدنيا من تكامله هي أعلى من كل
البشر ، فالدرجة العليا كذلك لا محالة .
_________________________________
(1) أنظر تاريخ الغيبة الصغرى ، ص 355 .
صفحة (422)
وإذا كان هذا التكامل ممكناً ، كان ضرورياً ، لما أشرنا إليه من أن الفرد كلما وصل
إلى درجة من الكمال استحق الدرجة التي بعدها ، لا يختلف في ذلك المعصوم عن غيره ..
بحسب البرهان المقام في الفلسفة .
ويمكن لقائد عالمي ، ممن يوجد عنده المستوى الأول من قابلية القيادة العالمية ،
كالمهدي (ع) أن يتكامل بأسباب معينة ، يمكن ارجاعها إلى ثلاثة أسباب :
السبب الأول :
الالهام . فانه ثابت للقائد العالمي الذي وجد المستوى الأول بالنسبة إليه .
ويمكن إثبات ذلك بعدة أدلة نذكر منها اثنين :
الدليل الأول :
ما ورد في الأخبار ، من أن الامام إذا أراد أن يعلم شيئاً أعلمه الله تعالى ذلك .
وقد خصص الشيخ الكليني في الكافي باباً كاملاً لنقل هذه الأخبار .
والامام ، هو الاقئد العالمي بلغتنا الحديثة ، فإذا خطر في ذهنه شيء لم يستطع
التوصل إلى جوابه أو حله ، أسعفه الله تعالى بالالهام في ذهنه ذلك الجواب المطلوب .
الدليل الثاني :
ان القيادة العالمية لمدى صعوبتها وتعدد مشاكلها ، لا يمكن القيام بها إلا من قبل
قائد ملهم ، يستوحي عدداً من الأخبار ويتلقى التعاليم من هذا المصدر الجليل . فإذا
توقف القيام بها على الالهام ، وجب على الله إيجاد هذه المعجزة، طبقاً لقانون
المعجزات ، ازجاء لحاجات الدولة الاسلامية العالمية ، التي هي الهدف الأساسي من
إيجاد البشرية .
وسنعرض لذلك تفصيلاً في تاريخ ما بعد الظهور .
السبب الثاني :
ما يمر به القائد من مصاعب ومحن . فانها توجب تصاعد كماله وترسخه ، بنفس التفسير
الذي ذكرناه للتكامل الناتج عن التمحيص ، مع حفظ الفرق في المرتبة فقط . حيث يفوق
هذا الكمال ذلك الكمال الثابت للفرد العادي بما لا يقاس من المراتب . تبعاً للفرق
بين الكمال المسبق للإمام والكمال المسبق للفرد العادي .
صفحة (423)
ولا يمكن أن نسمي هذا التكامل بالتمحيص ، بالرغم من أنه يحمل نفس فكرته وقاعدته
العامة ، من حيث كونه سبباً لتصاعد الكمال . إلا أن المعنى الأساسي للتمحيص هو
اختبار الجيد من الرديء ، والمعنى الذي اصطلحناه هو السبب الذي يحول الفرد من
القصور والضعة إلى الكمال والرفعة . وكلا هذين الأمرين غير موجودين سلفاً في القائد
العالمي بل هو في أول مراتبه القيادية ، في درجة عالية من الكمال بحيث لا يقاس إليه
أي فرد من البشر .
السبب الثالث :
ما يقوم به القائد من أعمال وتضحيات في سبيل دعوته وخدمة دينه وربه ، فانه يتكامل
بذلك ويزداد في أفق وجوده العظيم ترسخاً وعمقاً .
ومن أمثلته عن التاريخ تقبُّل النبي إبراهيم الخليل عليه السلام الأمر بقتل ولده
بكل رحابة صدر . وقيام الامام الحسين عليه السلام بثورته الدامية بالرغم من عظيم
التضحيات . ومن هنا قال له جده نبي الاسلام (ص) : بأن لك مقامات لن تنالها إلا
بالشهادة على ما روى عنه .
وهذا يحمل نفس المعنى الذي قلناه للتمحيص الاختياري ، بالنسبة إلى الفرد الاعتيادي
الممحص . مع اختلاف المرتبة ، بطبيعة الحال . وأيضا ًمن الصعب تسميته بالتمحيص ، بل
هو من التكامل الاختياري من الدرجات العليا وتفكيره المعمق الملهم ، تذليل المصاعب
العالمية عن درب الدعوة الالهية .
فان قيل : أن هذا متوفر لدى القائد العالمي ، في أول مراتب قابليته للقيادة ، فما
الحاجة إلى الزائد .
قلنا : أن قابلية قيادة العالم ، تتضمن ذلك بلا شك . ولكن هذه القابلية قابلة
للزيادة والتكامل . ومن الواضح أن الثمر يتحسن بتحسن الأصل ، والنتائج تتعمق بتعمق
السبب .. فكذلك هذا القائد ، عند حصوله على تكامل ما بعد العصمة ، فان تطبيقاته
وأعماله سوف تسهل وتتعمق عما كانت عليه أكثر وأكثر ، بطبيعة الحال .
صفحة (424)
وسيأتي في الجانب الثالث ، ما يلقي ضوءاً أكثر على هذه الأطروحة .
الجانب الثاني :
في محاولة استفادة هذه الأطروحة من الأدلة الاسلامية : الكتاب الكريم والسنة
الشريفة :
وأشد هذه الأدلة صراحة ما أخرجه الكليني في الكافي (1) بسند صحيح عن الامام الباقر
(ع) أنه قال : لولا انا نزداد، لنفذنا . ومثله أخبار أخرى عن الامام الصادق والهادي
عليهما السلام بسندين آخرين .
وفي خبر آخر عن ابي جعفر الباقر )ع) انه قال : لولا انا نزداد لانفذنا . قال الراوي
: قلت : تزدادون شيئاً لا يعلمه رسول الله (ص) . قال : اما انه إذا كان ذلك عرض على
رسول الله (ص) ثم على الأئمة ثم انتهى الأمر الينا .
وعقد الكليني (2) أيضاً باب بعنوان : ان الأئمة (ع) يزدادون في كل ليلة جمعة .
وأورد فيها ثلاثة أحاديث ، مما يدل على ذلك . وفيها التصريح باستفادة علم جديد عن
طريق الالهام ، وهو السبب الأول للتكامل الذي ذكرناه . وفيه التعبير بقوله : ولولا
ذلك لانفدنا . وبقوله : لولا ذلك لنفد ما عندي .
ولفهم هذا النفاد المشار اليه في هذه الأخبار أطروحتان :
الأطروحة الأولى :
ان هذا النفاد ناشئ من الأعمال العظام والتضحيات الجسام التي يقوم بها الامام طبقاً
لمسؤولياته العظمى . فانها توجب تضاؤل الطاقة المختزنة فيه ، لولا التوفيق الالهي
للتكامل .
__________________
(1) أنظر باب لولا أن الأئمة يزدادون لنفد ما عندهم (المخطوط) . (2) أنظر المصدر
المخطوط .
صفحة (425)
الأطروحة الثانية :
ان هذا النفاد ناشيء من مواجهة المشاكل المستجدة التي لا تكفي القابليات السابقة
للامام لتغطية حلولها وتذليل مشاكلها ، مما يجعل الدعوة الالهية متوقفة على ازدياد
الامام وتلقيه للالهام .
ويمكن أن تصبح هاتان الأطروحتان ، بعد تدقيقهما ، وجهاً واحداً مشتركاً لتفسير هذا
الأمر ، لا حاجة إلى الدخول في تفاصيله .
وعلى أي حال ، فقد دلت هذه الأخبار ، بكل صراحة ، على تكامل الامام وتزايده المستمر
، من تكامل ما بعد العصمة . لوضوح ان المراتب المسبقة لهذا الكمال ، تمثل درجة
العصمة بأحسن صورها ، طبقاً للفهم الامامي الذي انطلقت منه هذه الأخبار .. فكيف
بالتكامل الجديد الذي يحصلون عليه .
ويمكن ان يستفاد ذلك من القرآن الكريم ، الذي يحصلون عليه .
منها : قوله تعالى مخاطباً نبيه العظيم : وقل رب زدني علماً (1) . وهو صريح بما
نريد التوصل اليه ، من حيث أن النبي (ص) خير البشر وأعلمهم ، ولكنه مع ذلك قابل
للزيادة في العلم .
منها : قوله تعالى : وإذ قال إبراهيم : رب ارني كيف تحي الموتى . قال : أولم تؤمن ؟
قال : بلى : ولكن ليطئمن قبلي . قال : فخذ أربعة من الطير فصرهن اليك ، ثم اجعل كل
جبل منهن جزءا يأتينك سعيا ، واعلم ان الله عزيز حكيم (2) .
فان ابراهيم عليه السلام ، ازداد بعد هذه الحادثة اطمئنانا ويقينا ، وتزايد في
مراتب التكامل العليا ، بكل وضوح . فان الهدف منها لم يكن سوى حصول الاطمئنان . قود
تحقق الهدف بعد وقوعها .
ومنها قوله تعالى : ﴿ وإن يونس لمن المرسلين اذ ابق إلى الفلك المشحون ، فساهم فكان
من المدحضين ، فالتقمه الحوت وهو مليم . فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه
إلى يوم يبعثون ﴾ (3) . فقد أوجب تسبيحه في بطن الحوت له كمالا استحق به النجاة من
هذا السجن الذي كان يقدر له التأبيد لو لم ينل هذا الكمال بالتضرع إلى الله تعالى
والعمل الاختياري في التقرب اليه عز وجل .
______________________________
(1) طله : 2/114 . (2) البقرة : 2/260 . (3) الصافات : 37/139-144 .
صفحة (426)
ومنها : قوله تعالى : "ونادى نوح ربه فقال : رب ابني من أهلي وان وعدك الحق وانت
احكم الحاكمين . قال : يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح ، فلاتسْألْنِ ما
ليس لك به علم . اني اعظك ان تكون من الجاهلين . قال : رب ، اعوذ بك ان أسألك ما
ليس لي به علم . والا تغفر لي وترحمني أكن من
الخاسرين "(1) .
فانه لا شك ان نوح عليه السلام ازداد بعد وعظ الله عز وجل اياه وتعليمه له ، ازداد
كمالا عما كان عليه قبل ذلك ، واذ تنتج هذه الزيادة الجديدة ، فانها تسير مع سائر
التضحيات في سبيل الدعوة الالهية ، بما فيها الاستغناء عن الولد ، اذا كان عملا غير
صالح ، وعضوا فاسدا في التخطيط الالهي . ومن هنا نسمعه يقول : "رب أعوذ بك أن أسألك
ما ليس بك علم " .
ومنها قوله تعالى : "وان كادوا ليفتنوك عن الذي أوحينا اليك لتفتري علينا غيره .
واذن لاتَّخذوك خليلا . ولولا ان ثبتناك ، لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا ، اذن
لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ، ثم لا تجد علينا نصيرا " (2) .
فان الآية ، وان كانت دالة على ان النبي (ص) لم يركن ، إلى الكفار ، ولم يقارب
الركون اصلا ، باعتبار جعل ذلك في جواب لولا الامتناعية .. الا انها تدل – بكل وضوح
- : ان عدم الركون ناشئ من التثبيت الالهي ، ذلك التثبيت الذي ازداد به النبي (ص)
كمالا إلى كماله العظيم . ولولا ذلك لكان الكمال السابق على التثبيت غير مانع من
مقارنة الركون . ومن هنا اقتضت مصلحة الدعوة الالهية ، افاضة هذا التثبيت عليه صلى
الله عليه وآله , إلى غير ذلك من الموارد والآيات في القرآن الكريم .
_________________________
(1) هود : 11/46-47 . (2) الاسراء : 17/73-75 .
صفحة (427)
وبذلك نستطيع – بكل وضوح – ان ننفي نقاط الضعف والذنوب عن الانبياء ، كما يريد
المنحرفون أن يفهموه من القرآن الكريم . فانه بعيد كل البعد عن ذلك ، وانما هو من
التسامي من كمالٍ عظيمٍ إلى اعظم ، من تكامل ما بعد العصمة . مع توفر قابلية
القيادة الكبرى، في الدرجة السابقة من الكمال ، فضلا عن المراتب العليا منها .
وللتوسع في الكمال عن هذا الموضوع مجال آخر في العقائد الاسلامية .
وعلى اي حال ، فقد ثبت بالكتاب الكريم والسنة الشريفة ، وجود التكامل ، بل ضرورته
للدعوة الالهية ، بالنسبة إلى كل من أُوْكِلَ اليه قيادة العالم من الانبياء
والمرسلين والأئمة عليهم السلام اجمعين .
الجانب الثالث :
في تطبيق هذه القاعدة على المهدي (ع) بعد ثبوتها بالادلة الاسلامية .. وبه نتبين
دخالة الغيبة في التخطيط الالهي، بشكل اكيد وشديد ، لا يمكن التخلي عن افتراض في
طريق كمال التطبيق في اليوم الموعود .
والمتحصل مما سبق ، هو انه عليه السلام يتكامل – بعد العصمة – خلال غيبته ، بعدة
اسباب :
السبب الأول :
الالهام بالمعنى الذي قلنا بصحته ، ودلت الاخبار على وجوده . فلئن كان آباؤه عليهم
السلام يتكاملون في كل ليلة جمعة ، خلال عدد محدود من السنين ، فهو يتكامل خلال عدد
غير محدود ، يصل إلى عدة مئات ، بل قد يصل إلى الآلاف من السنين .. من يدري ؟ ..
ومعه تكون النتيجة أكبر وأضخم من النتائج التي وصل اليها آاؤه عليهم السلام في
اثناء حياتهم .
فان قيل : بانه يلزم من ذلك كون الامام المهدي (ع) خيراً من آبائه ، وهو خلاف
الادلة الدالة على ان الأئمة المعصومين من نور واحد ، وانهم متساوون في الفضل ليس
فيهم أفضل سوى أمير المؤمنين (ع) وصي رسول الله (ص) .
قلنا يمكن الجواب على ذلك بجوابين :
الجواب الأول :
أنه لا خير في ذلك . فليكن المهدي (ع) أفضل من آبائه ، باعتبار أن التخطيط الالهي
منعقد بإيكال اليوم الإلهي الموعود دونهم .
صفحة (428)
وقد دلت على ذلك الروايات ، ولعل اوضحها الخبر السابق الذي اخرجه النعماني في
الغيبة (1) عن ابي عبدالله الصادق عليه السلام حين سئل : هل ولد القائم ؟ فقال : لا
ولو ادركته لخدمته ايام حياتي .
وفي حديث آخر (2) عن الريان بن الصلت قال : للرضا عليه السلام : انت صاحب هذا الأمر
؟ فقال : انا صاحب هذا الأمر ، ولكني لست بالذي أملؤها عدلا كما ملئت جورا . وكيف
أكون ذلك على ما ترى من ضعف بدني . وان القائم هو الذي اذا خرج كان في في سن الشيوخ
ومنظر الشبان .. الحديث .
واما الادلة المشار اليها الدالة على تساوي الأئمة (ع) فيمكن ان تحمل على تساويهم
في الامامة ، أو في قابليتهم للقيادة العالمية بغض النظر عن تكامل ما بعد العصمة .
كما يمكن ان يستثنى منها المهدي (ع) بالخصوص نظرا إلى هذه الادلة الاخرى .
الجواب الثاني :
انه لا يلزم مما افضلية المهدي (ع) على آبائه ، خلافا لما تخيله السائل ، ولما
قلناه في الجواب الأول .
وذلك : لان نفس تلك الروايات دلت على ان كل ما يحصل عليه امام متأخر من الكمال ،
يعطيه الله تعالى لكل الأئمة المتقدمين عليه ولرسول الله (ص) أيضاً وقد سبق أن
سمعنا قول الإمام الباقر (ع) – في حديث- : أما أنه إذا كان ذلك عرض على رسول الله
(ص) ثم الأئمة ثم انتهى الأمر إلينا .
وفي خبر آخر للكُليني في الكافي (3) عن أبيعبدالله (ع) انه قال : ليس يخرج شيء من
عند الله عز وجل ، حتى يبدأ برسول الله (ص) ، ثم بامير المؤمنين صلوات الله عليه .
ثم بواحد بعد واحد ، لكي لا يكن آخرنا اعلم من اولنا .
_______________________
(1) ص 129 . (2) أنظر الكافي (نسخة مخطوطة) . (3) المصدر نفسه .
صفحة (429)