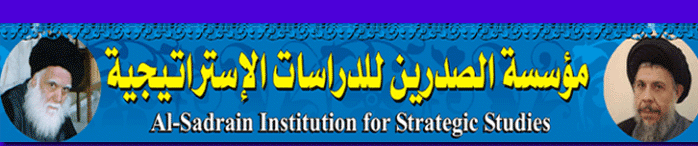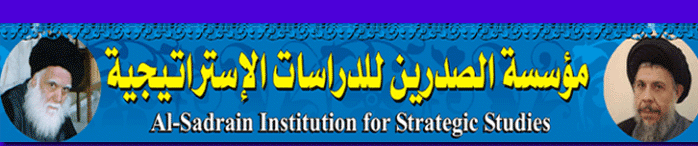نقول في جوابه : إن هذا غير صحيح لعدة وجوه .
أولاً : أنه افتراض لم يقل به أحد . فهوعلى خلاف اعتقاد كل المسلمين . إذن فهو باطل
جزماً .
ثانياً : أننا إن فهمنا الغيبة طبقاً لأطروحة خفاء الشخص ، فليس الحياة بعد الموت
أولى منها ، من الناحية الإعجازية . وإن قلنا بالغيبة طبقاً لأطروحة خفاء العنوان ،
كانت هذه الأطروحة أولى بالأخذ من ذلك الافتراض ، لأنها أقرب إلى الأسلوب الطبيعي ،
كم عرفنا فيما سبق . وقد عرفنا أيضاً أن قانون المعجزات ينفي كل معجزة يمكن أن يوجد
الغرض منها بشكل طبيعي .
ثالثاً : أننا مع هذا الافتراض سوف نخسر شيئاً أساسياً سوف نشير إليه ، وهو تكامل
القائد خلال عصر الغيبة من تكامل ما بعد العصمة . إذ مع ذاك الافتراض لا يكون هذا
التكامل موجوداً ، فإنه لا محالة يحيى على نفس المرتبة التي مات عليها من الكمال .
إذن فالحفاظ على القائد العظيم ، هو المطلوب الأساسي من الغيبة ، الذي تشارك فيه
الغيبة في التخطيط الالهي .
ويمكن أن نضيف عدة أمور أخرى يشارك فيها عصر الغيبة في هذا التخطيط :
الأمر الأول :
تكامل القائد ، من تكامل ما بعد العصمة ، ذلك الكمال الذي يؤهله إلى مرتبة أعلى
وأعمق وأسهل في نفس الوقت من أساليب القيادة العالمية العادلة . وسنبحث ذلك مفصلاً
في القسم الثاث من هذا التاريخ .
الأمر الثاني :
ما سمعناه في القسم الأول من قيام المهدي(ع) بالعمل الإسلامي المنقذ للأمة من
الهلكات ، والفاتح أمامه سبل الخير ، والموفر ـ في نتيجته ـ أكبر مقدار من المخلصين
الممحصين ، المشاركين في بناء الغد الموعود .
الأمر الثاني :
مساهمة الحوادث التي تمر خلال عصر الغيبة الطويل ، بإيجاد شرط الظهور ، وهو كون
الامة على مستوى المسؤولية . كما سبق أن أوضحنا .
صفحة (237)
الأمر الرابع :
شعور الأمة ، على طول الخط ، بوجود القائد الفعلي لها الماسك بزمام أمرها والمطلع
على خصائص أعمالها . ذلك الشعور الذي يرفع من معنويات الأفراد ويقوي فيهم روح
العزيمة والإخلاص ، مما يساعد على زيادة أعداد المخصلين الممحصين .
الأمر الخامس :
تعمق الفكر الإسلامي من حيث الفهم من الكتاب والسنة ، سواء في العقائد أو الأحكام ،
مما يجعل الأذهان مستعدة أكثر فأكثر لتقبل وفهم الأحكام التفصيلية التي يعلنها
المهدي (ع) في دولته العالمية الموعودة .
ونحن لا زلنا نرى المفكرين الإسلاميين ، يتحفون مجتمعهم ببحوث وتدقيقات جديدة قائمة
على التعمق والسعة في فهم الكتاب والسنة ، من جوانبها المتعددة ، فهذه البحوث كلها
واقعة ضمن التخطيط الالهي الكبير .
ونحن نشعر بما لتعقد الحياة وتضاعف الظلم البشري ووجود التيارات المعادية للإسلام
... من إيجاد الدافع القوي للمفكرين الإسلاميين ، في السير قدماً نحو التعمق
والتدقيق . فيكون ذلك من هذه الجهة أيضاً ، مندرجاً في التخطيط الالهي .
وقد يخطر في الذهن : أننا سبق أن قلنا أن الأمة عند نزول الإسلام كانت على مستوى
فهمه وقابلة لاستيعابه ، بصفته الأطروحة العادلة الكامة ، إذن فهم قد فهموه . فما
هو الحاجة إلى هذه الزيادة في التدقيقات .
وجواب ذلك : أننا نحتمل ـ على أقل تقدير ـ أن الأطروحة العادلة المعلنة بين البشر
ذات مستويين من الناحية الفكرية . فالمستوى الأدنى منها ، كان البشر على مستوى فهمه
واستيعابه عند بدء الإسلام . وهو الذي أصبح معلناً منذ ذلك الحين إلى عصر الظهور .
وهو الذي يعيش التدقيقات والتعميق على طول الزمن .
والمستوى الأعلى منها سوف يعلن بعد الظهور عند الإبتداء بالتطبيق العادل . وهو
يحتاج في فهمه إلى مستوى فكري وثقافي في البشرية لا يحصل إلا بتلك التدقيقات . ولو
كان قد أعلن في بدء الإسلام لما كان مفهوماً على الإطلاق .
صفحة (238)
وهذا الامر وإن كنا نعرضه الآن معرض الإحتمال ، إلا أننا سنسمع في الكتاب الآتي من
هذه الموسوعة مثبتات ذلك.
إذن فهذه الدقة المكتسبة في الفكر الإسلامي فقط هي التي تشارك في تعميق المستوى
الثقافي اللازم تحققه في اليوم الموعود .... بل تشارك في ذلك سائر القطاعات والشعوب
في العالم ، بما تبذل من دقة وعمق في سائر العلوم .
لوضوح أن البشرية على العموم ، وليس المجتمع المسلم وحده ، هو الذي يجب أن يتقبل
الأحكام المهدوية ... فإن حكم المهدي (ع) يعم العالم كله ، ولا يختص بالمجتمع
الإسلامي .
مضافاً إلى أن التقدم العلمي في سائر حقول المعرفة البشرية ، سوف تشارك مشاركة
فعالة في بناء الغد المنشود ، ذلك الغد الذي يصعب تقدم البشرة بالسرعة المطلوبة بعد
تحققه ، لولا أنها كانت قد تقدمت وتكاملت قبل ذلك .
إذن فعصر الغيبة يشارك في التخطيط الالهي من هذه الناحية أيضاً .
وبهذا نكون قد حملنا فكرة كافية عن التخطيط الالهي والتمحيص الذي ينال البشر خلال
عصر الغيبة الكبرى. وهو ما عنيناه في هذه الناحية الأولى من هذا الفصل من اقتضاء
القواعد العامة في الإسلام لوجود الظلم والإنحراف في المجتمع . وسيكون ما نسرده من
النصوص في الناحية الآتية مؤديات لفحوى القواعد العامة التي عرفناها .
الناحية الثانية
في ذكر النصوص والأخبار الخاصة الدالة على التنبؤ بالمستقبل ، من وصف الزمان وأهله
، من حيث مقدار تمسكهم بالدين وشعورهم بالمسؤولية الإسلامية ، وما يصير إليه الأمر
من فسادهم وانحرافهم . وما يستلزم ذلك من قبل الله تعالى ومن قبل الناس .
صفحة (239)
ونحن في هذا التاريخ ، وإن كنا قصرنا همنا في التعريض إلى الأخبار المروية من قبل
المعتقدين بغيبة الإمام المهدي عليه السلام ، لنرى مقدار صدقها واتجاه تفكيرها .
إلا أن وصف حوادث الزمان ، حيث نجده منقولاً من قبل الرواة من سائر مذاهب المسلمين
، فمن هنا كان الأفضل الإحاطة بهذه الروايات أيضاً .
ونحن توخياً للاختصار والضبط في نفس الوقت ، سوف نقتصر على ما أخرجه الصحيحان
البخاري ومسلم من هذه الأخبار ، فيما إذا كان لهما في الحادثة المعينة رواية ، وإلا
نقلنا عن الحفاظ الآخرين أيضاً . ونضم ذلك إلى الأخبار الأمامية المستقاة من
المصادر القديمة .
ولولا هذا الاختصار لكان اللازم التعرض إلى عشرات الروايات في المعنى الواحد أو
الحادثة الواحدة ، لتكثر مثل هذه الأخبار ، في المصادر بشكل واسع جداً . إلا أن
الالتزام بذلك مما لا يلزم ، كما هو واضح ، بعد أن كان الصحيحان من ناحية والكتب
الأمامية القديمة هي أوثق مصادر المسلمين المعروفة في العصر الحاضر .
ومن هذا المنطلق ،يمكن أن نتحدث في عدة جهات :
الجهة الأولى :
في الأخبار الدالة على صعوبة الزمان وفساده ، على شكل مطلق ، ليس فيه إشارة إلى
حوادث معينة . وهي على عدة أقسام :
القسم الأول :
ما دل من الأخبار على امتلاء الأرض ظلماً وجوراً . وهو مضمون مستفيض بل متواتر بين
الفريقين ، وإن امتنع الشيخان عن إخراجه .
صفحة (240)
أخرجه أبو داود مكرراً ، مرة بلفظ : يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً
. وأخرى بلفظ : لو لم يبق من الدهر إلا يوم ، لبعث الله رجلاً من أهل بيتي يلمؤها
عدلاً كما ملئت جوراً . ومرة ثالثة بلفظ : المهدي مني ... يملأ الأرض قسطاً وعدلاً
كما ملئت ظلماً وجوراً (1).
وأخرج في الصواعق المحرقة (2) عن أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه ما ذكرناه في
اللفظ الثاني للحديث . وعن أبي داود والترمذي : لو لم يبق من الدينا إلا يوم واحد
.. إلى أن قال : يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً . وعن الطبراني :
فيبعث الله رجلاً من عترتي أهل بيتي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً
... الحديث . وعن الروياني والطبراني (3) : المهدي من ولدي ... إلى أن يقول : يملأ
الأرض عدلاً كما ملئت جوراً .
وغير ذلك كثير ، موزع في المصادر ، كالذي ذكره الشبلنجي في نور الإبصار والصبان في
إسعاف الراعبين والشبراوي في الإتحاف وأبو نعيم الأصفهاني في أربعينه وسبط ابن
الجوزي في تذكرته . وكما الدين بن طلحة في مطالب السؤول . مضافاً إلى ما أخرجه أحمد
في مسنده والحاكم في مستدركه والسيوطي في العرف الوردي ... إلى غير ذلك من المصادر
.
وأما من روى هذا المضمون من علماء الإمامية ومصنفيهم ، فأكثر من أن يحصر . تعرض له
كل من روى في العقائد أو التاريخ ، وتكلم عن الإمام المهدي (ع) .
والمراد بالظلم ، الإنحراف عن جادة العدل الإسلامي ، ونحوه الجور وهو الميل ، يقال
: جار عن الطريق أي مال . وهذا الميل ، من وجهة نظر نبي الإسلام (ص) الذي روى عنه
هذا الحديث الشريف ، هو الميل عن تعاليم الإسلام والعدل الصحيح ، على الصعيدين
الفردي والإجتماعي .
والحديث نص واضح بامتلاء الأرض جوراً وظلماً قبل ظهرو المهدي (ع) في اليوم الموعود
. وهو معنى ما قلناه طبقاً للقواعد العامة ، من أن إغلب الناس نتيجة للتمحيص الالهي
، سوف يسودهم الانحراف عقيدة أو سلوكاً ، بحيث يكون الاتجاه الظاهر للبشرية هو قيام
النظام الفردي والإجتماعي على أساس مناقض مع تعاليم الإسلام ، من دون أن يكون
للصالحين المخلصين ـ وإن كثروا ـ أثر مهم ونتائج ظاهرة .
(1) انظر سنن أبي داود ، جـ2 ، ص 422 . (2) أنظر : ص 97 . (3) نفس المصدر ، ص 98 .
صفحة (241)
وهذا لعمري ما كنا ولا زلنا نشاهده في عصور الفسق والضلالة التي نعيشها ونطلع عليها
بالحس والعيان . فصلى الله تعالى عليك يا نبي الإسلام إذ تنبأت بذلك ... وسلام الله
تعالى عليك يا مهدي الإسلام إذ تزيل كل ذلك وتبدله إلى القسط والعدل الكاملين
الشاملين ، طبقاً لإرادة الله وتخطيطه .
القسم الثاني :
ما دل من الأخبار على وجود الفتن وازدياد تيارها وتكاثرها إلى حد مروع . أخرج ذلك
العديد من رواة الفريقين . منها : ما رواه البخاري (1) من قوله صلى الله عليه وآله
: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن .... الخ الحديث . وما رواه
أيضاً (2) من قوله (ص) : ستكون فتن ، القاعد فيها خير من القائم ... الخ الحديث .
وأخرجه مسلم بألفاظ وأسانيد مختلفة (3) . وأخرج عنه (ص) أيضاً (4): أني لأرى مواقع
الفتن خلال بيوتكم كمواقع المطر . وذكر له أكثر من إسناد واحد .
ومنها : ما رواه النعماني (5) عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام ، في حديث طويل
يتحدث فيه عن (الفتن المضلة المهولة ) . وما رواه أيضاً (6) عن الإمام محمد بن علي
الجواد عليه السلام أنه قال : لا يقوم القائم عليه السلام إلا على خوف شديد من
الناس وزلازل وفتنة وبلاء يصيب الناس ... الخ الحديث.
(1) صحيح البخاري ، جـ 9 ، ص61 . (2) المصدر ، ص64 . (3) صحيح مسلم ، جـ 8 ،ص 168 و
169 .
(4) نفس المصدر والصفحة . (5) انظر غيبة النعماني ، ص 77 . (6) المصدر ، ص 135 .
صفحة (242)
وللفتنة عدة معانٍ في اللغة ، يختلف معنى هذه الأحاديث الشريفة باختلافها ، وإن كان
بالإمكان إرجاعها إلى معنى واحد شامل على ما سنذكر .
المعنى الأول :
الامتحان والإبتلاء والاختبار . وأصلها مأخوذ من قولك فتنت الفضة والذهب إذ أذبتهما
بالنار لتميز الرديء من الجيد ... والفَتْن الإحراق . ومنه قوله تعالى : ﴿ يوم هم
على النار يفتنون ﴾ (1) .
ويؤيد كون المراد من الفتنة هو ذلك ، ما رواه النعماني في الغيبة (2) عن أبي الحسن
عليه السلام في قوله تعالى: ﴿ ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا
يفتنون ﴾ ... قال : يفتنون كما يفتن الذهب : ثم قال يخلصون كما يخلص الذهب .
فإذا تمّ هذا المعنى ، تلتحق هذه الأخبار بأخبار التمحيص والامتحان ، التي سوف
نذكرها ، فإنها تتحد معها في المدلول ، باعتبار أن الفتنة بمعنى التمحيص والخلاص هو
المشار في الحديث هو النجاح في التمحيص .
المعنى الثاني :
الكفر والضلال والإثم . والفاتن المضل عن الحق . والفاتن الشيطان .. وفتن الرجل أي
أزله عما كان عليه . ومنه قوله عز وجل : ﴿ وإن كادوا ليفتنوك عن الذي أوحينا إليك
﴾. أي يميلوك ويزيلوك (3) .
وإذا تم هذا المعنى ، التقت هذه الأخبار مع الأخبار الناقلة لحدوث الظلم والجور ،
في المضمون ... ونحوها مما نص على حدوث الكفر والضلال .
المعنى الثالث :
اختلاف الناس بالآراء (4) . ويؤيد كون المراد هذا المعنى ما رواه النعماني (5) في
الحديث السابق عن محمد بن علي الجواد عليه السلام الذي قال فيه : وفتنة وبلاء يصيب
الناس وطاعون وسيف قاطع بين العرب واختلاف شديد في الناس وتشتت في دينهم وتغير في
حالهم .
(1) لسان العرب ، مادة فتن . (2) المصدر ، ص 107 . (3) لسان العرب ، مادة فتن . (4)
المصدر نفسه . (5) ص 135 .
صفحة (243)
وإذا كان هذا هو المعنى المراد ، فسيلتقي مضمونه بالأخبار الدال على حدوث التشتت
والاختلاف ، التي سوف نذكرها .
المعنى الرابع :
القتل ، وما يقع بين الناس من القتال . ومنه قوله تعالى : ﴿ إن خفتم أن يفتنكم
الذين كفروا ﴾ (1) . ومعه تندرج في أخبار حدوث الهرج والمرج والقتل الآتية .
والصحيح أنه بالإمكان إرجاع هذه المعاني إلى معنى واحد ، أو فهم الفتنة الواردة في
الأخبار على أساس مجموع هذه المعاني . فإن التمحيص الالهي ، وهو المعنى الأول ،
ينتج عند الفاشلين فيه الكفر والضلال ، وهو المعنى الثاني . وليس الكفر والضلال
متمثلاً في مذهب معين ، بل في كثير من الآراء والمذاهب المتباينة في مدلوها
المتناحرة في سلوكها . ومن هنا ينتج المعنى الرابع وهو القتل ، نتيجة لهذه الفوضى
المذهبية أو الفكرية . ومن هنا وردت كل هذه الحوادث في الاخبار كما اشرنا وستطلع
عليها تدريجياً .
القسم الثالث :
ما دل على الجزع من صعوبة الزمن وضيق النفس الشديد منه .
فمن ذلك ما أخرجه البخاري (2) بإسناده عن النبي (ص) قال: لا تقوم الساعة حتى يمر
الرجل بقبر الرجل فيقول : يا ليتني مكانه . وأخرجه مسلم بنصه (3).
(1) لسان العرب ، مادة فتن . (2) جـ9 ، ص 73 . (3) جـ 8 ، ص 182.
صفحة (244)
وأخرج مسلم (1) أيضاً عنه (ص) أنه قال : والذي نفسي بيده ، لا تذهب الدنيا حتى يمر
الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول : يا ليتني كنت مكان صاحب القبر ، وليس به الدين
إلا البلاء .
وروى الصدوق في الإكمال (2) عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه
يعاني المؤمنون في زمان الغيبة من " ضنك شديد وبلاء طويل وجزع وخوف " .
ومن الواضح أن الجزع وتمني الموت ، يكون نتيجة للشعور بالمشاكل والمصاعب التي يمر
بها الفرد في المجتمع المنحرف . ذلك الإنحراف الناتج ـ في واقعه ـ من التخطيط
الالهي كما عرفنا . إذن فهذه الحالة من نتائج هذا التخطيط ، وهي المنتجة في نهاية
المطاف لنتيجتين مهمتين :
إحداهما : اليأس من القوانين والنظريات السائدة في العالم ، بعد أن أثبتت التجربة
أنها لا تؤدي إلا إلى هذه المشاكل والمصاعب
ثانيتهما : تمني المستقبل العادل الذي يحل هذه المشاكل ويرفع هذه المصاعب ، كما سبق
أن ذكر في المرتبة الرابعة من مراتب الإخلاص فيما سبق . وسيكون هذا الشعور من أفضل
الضمانات ، للتأييد العام لليوم الموعود ونحن إذا نظرنا إلى الواقع ، نجد أن الأمة
الإسلامية عامة والقواعد الشعبية المهدوية خاصة ، قد مرت في كثير من عصور تاريخها
الضنك والبلاء . حتى قيل في وصف عصور الحكم العباسي :
نحن والله في زمان بئــيس لو رأيناه في المقام فزعن
أصبح الناس فيه من سوء حال حق من مات منهم أن يُهَنَّ
ـــــــــــــــــــ
(1) جـ 8 ، ص 183 . (2) انظر المخطوط .
صفحة (245)
وإن أعظم ضنك وبلاء يقع في البشر ، هو ما يكون من بعضهم تجاه البعض ، من الظلم
والطغيان ، وخوف الأكثرية الكاثرة من القوى الجبارة الظالمة الحاكمة في العالم .
وإن أعظم البلية بالنسبة إلى البشرية جمعاء في العصر الحاضر هو الخوف من اصطدام
الأسلحة الفتاكة في العالم في حرب عالمية ثالثة لا تبقي ولا تذر . يكون الكل فيها
هالكين مندحرين ليس فيها غالب أو منتصر . ولله في خلقه شؤون .
وعلى أي حال ، فمن المحتمل أن يتزايد الضيق والفتك بأضعاف ما هو عليه الآن ، خاصة
بالنسبة إلى المؤمنين المخلصين في المجتمع الإسلامي ... بما يقابلون من تيارات
التعسف والإنحراف الظالمة المعادية للإسلام . ولهم في المهدي وبركاته العامة
ومستقبله العظيم ، أعظم السلوان والعزاء .
القسم الرابع :
ما دل على وجود الحيرة والبلبلة في الأفكار والاعتقاد .
كالخبر الذي روي عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال عن المهدي (ع)
فيما قال : يكون له حيرة وغيبة تضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون (1) .
وإنما نسبت الحيرة إلى المهدي (ع) باعتبار كونها ناتجة من غيبته المستندة إليه .
إذ لو كان ظاهراً بين الناس لما وقعت هذه الحيرة ، كما هو معلوم .
ويمكن أن يراد بالحيرة عدة وجوه أو كل هذه الوجوه :
الوجه الأول :
الحيرة في العقائد الدينية ، نتيجة للتيارات الباطلة التي تواجه جهلاً وفراغاً
فكرياً في الأمة ، مما يحمل الفرد الإعتيادي على الإنحراف .
(1) انظر غيبة النعماني ، ص 104 وانظر إكمال الدين المحفوظ .
صفحة (246)
الوجه الثاني :
الحيرة بالعقائد الدينية ، بمعنى أن المؤمنين حين يحسون بالمطاردة والتعسف ضدهم وضد
عقائدهم ، يحيرون أين يذهبون لكي ينجوا بالحق الذي يعتقدونه وبالاتجاه الإسلامي
الذي يتخذونه .
الوجه الثالث :
الحيرة في الإمام المهدي (ع) بمعنى أن طول غيبته توجب وقوع الناس في الشك والإختلاف
في شأنه . كما حدث في صفوف المسلمين فعلاً ، وقد أشارت إليه الأخبار التي سنسمعها
فيما بعد .
الوجه الحيرة :
الحيرة بالجهاد الواجب في زمن الغيبة من دون قائد وموجه ورائد . فإن المؤمنين
بتكليفهم الإسلامي من ذلك ، يشعرون في نفس الوقت بالأسف لعدم اتصالهم بالقائد
العظيم الذي يوجههم إلى النصر .
وعلى أي حالة ، فكل ذلك مندرج في التخطيط الالهي ، مما لا بد أن يحدث في الناس
نتيجة للغيبة ليشارك في التمحيص والاختبار ، فيرفع من إخلاص المخلصين ويعمق في كفر
المنحرفين . وهو المراد بقوله : تضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون .
القسم الخامس :
ما دل على وقوع الهرج والمرج .
وهي أخبار كثيرة استقل بإخراجها الرواة العامة فيما أعلم . روى البخاري (1) عدداً
منها و مرة بلفظ : أن بين يدي الساعة لأياماً ينزل فيها الجهل ... إلى أن قال :
ويكثر فيها الهرج . ذكر له أكثر من طريق . ومرة أخرى بلفظ : بين يدي الساعة أيام
الهرج .
وأخرج مسلم (2) : فضل العبادة في الهرج كهجرة إليَ . يعني إلى النبي (ص) . وروى
الآخرون ، كالترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم ، ما يدل على ذلك ، ونحن نقتصر على ما
في الصحيحين .
(1) انظر جـ 9 ، ص 61 . (2) جـ 8 ، ص 208 .
صفحة (247 )
والمراد بالهرج بفتح الهاء وسكون الراء ، أحد أمرين :
الأول : الاختلاط والاضطراب المؤدي إلى القتل أو كثرته بين الناس . وتطبيقه في
العالم في عصرنا الحاضر ما يسمى بحرب العصابات أو حرب الشوارع ، مع ما تصاحبه من
الاضطرابات والبلبلة . وهذا المعنى هو الذي تؤيده المصادر اللغوية .
الثاني : القتل نفسه ، وإن لم يصاحبه الاضطراب . كما هو ظاهر بعض الأخبار ، فيما
أخرجه البخاري (1) حيث فسر الهرج بالقتل في عدة أحاديث ، مع احتمال أن يكون التفسير
من الراوي .
إلا أن الصحيح رجوع الأخبار إلى المعنى الأول ، وإن اندرج المعنى الثاني فيها
بطبيعة الحال . فإنه قال : ويكثر فيها الهرج والهرج القتل ز إذن فالقتل فيها كثير ،
وكثر القتل لا تكون إلا مع البلبلة والاضطراب . وأما انطباقه على القتل الفردي فلا
دليل عليه .
وأما إناطتها بالساعة وجعلها من علاماتها ، فهو مما لا يخل بالمقصود لأن المراد
وقوع ذلك قبل قيام الساعة ، ولو بزمان طويل . ومن المعلوم أن كل مايقع في الغيبة
الكبرى فهو واقع قبل قيام الساعة ، فيكون من علاماتها وأشراطها بطبيعة الحال . وقد
سبق أن ذكر أن كل فساد وانحراف يذكر في الأخبار ـ عموماً ـ فهو من أوصاف فترة
الغيبة الكبرى ،المربوطة بالمهدي عليه السلام . وقد مررنا على ذلك إجمالاً ، وحولنا
برهانه على ما سيأتي : وفي خبر مسلم قوله (ص) : العبادة في الهرج كهجرة إليّ ....
زيادة على المعنى العام الذي كنا نتوخاه ، زيادة زيادة واعية إسلامياً ومطابقة
للقواعد العامة ، يأتي التعرض لها في الناحية الثالثة من هذا الفصل .
(1) جـ 9 ، ص 61 .
صفحة (248)
فهذا هو المهم من الأخبار الدالة على فساد الزمان بنحو مطلق ، من دون الإشارة إلى
حوادث بعينها . وقد ثبت من ذلك في حدود التشدد السندي الذي ذكرناه ... المعنى العام
الذي يدل عليه المجموع وهو شيوع الفساد والإنحراف وعصيان الأوامر الإسلامية . بل
وتثبت التفاصيل أيضاً باعتبار كثرة الأخبار فيها وجعل بعضها قرينة على بعض وجعل
القواعد العامة قرينة أيضاً لما عرفناه من أن كل هذه التفاصيل مما يترتب على
التخطيط الالهي .
الجهة الثانية :
في الأخبار الدالة على حدوث وقائع أو ظواهر معينة ، ناتجة عن الضلال والإنحراف .
القسم الأول :
في الأخبار الدالة على تحقيق الجهل وتفشيه في المجتمع الإسلامي .
فمن ذلك ما أخرجه البخاري (1) من الحديث النبوي القائل : أن من أشراط الساعة أن
يرفع العلم ويثبت الجهل .... الحديث . وأخرج في حديث آخر (2) : أن يقل العلم ويظهر
الجهل . وأخرج في موضع آخر (3) : إن بين يدي الساعة أياماً يرفع فيها العلم وينزل
فيها الجهل .
وفي موضع رابع أخرج البخاري (4) من قوله (ص) : يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر
الهرج ... الحديث .
وأخرج مسلم عدة متون بهذا المضمون ، في باب خاص بذلك (5) لا حاجة إلى الإطالة
بذكرها . وأخرجها غيرهما ، كابن ماجه والترمذي وأحمد .
ـــــــــــــ
(1) جـ 1 ، ص 30 . (2) نفس الجزء ، ص 31 .(3) جـ 9 ، ص 61 . (4) جـ 1 ، ص 31 . (5)
انظر جـ 8 ، ص 85 .
صفحة (249 )
والمراد برفع العلم ارتفاعه من المجتمع وقلة العلماء والمتعلمين . والمراد به العلم
بالأحكام الشرعية والعلوم الإسلامية . كما أن المراد بنزول الجهل وظهوره
تفشيه في المجتمع المسلم من الناحية الفكرية الإسلامية ، أيضاً بطبيعة الحال . وفي
التعبير برفع العلم وقبضه ، إيضاح أنه مستند إلى الله تبارك وتعالى ، مع تنزيه الله
تعالى عن إسناده وتحقيق الجهل إليه عز وعلا . تماماً كما قال إبراهيم خليل الرحمن
عليه السلام : وإذا مرضت فهو يشفيني (1) ولم يقل : وهو الذي يمرضني ويشفيني ، كما
قال : وهو الذي يطعمنى ويسقيني (2) .
وعلى أي حال ، فاستناده إلى الله تعالى ، يكون ـ مرة ـ بتوسيط عباده ، في ضغط
المنحرفين على المؤمنين بالسكوت وعدم تبليغ الأحكام والمفاهيم الإسلامية إلى الأمة
. ويكون ـ تارة أخرى ـ بفعل الله تعالى مباشرة بأن يموت العلماء تدريجياً ويقل
المتعلمون ، فتصبح الأجيال القادمة خالية من العلماء فارغة فكرياً من الثقافة
الإسلامية . ومن هنا أخرج البخاري (3) عن النبي (ص) أنه قال : إن الله لا يقبض
العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء . حتى إذا لم يبق
عالماً اتخذ الناس رؤؤساً جهالاً ، فسئلوا فافتوا بغير علم ، فضلوا وأضلوا .
ومن هنا يكون هذا الأمر مما يحكم الوجدان بحدوثه ، وموافقاً للقاعدة ومندرجاً في
التخطيط الالهي ، وموحداً في المضمون مع ما سنذكره من بيان وجود علماء السوء في
الأخبار . ويكون ترك تعلم المتعلمين ناتجاً عن التيار العام للفساد والبعد عن
التعاليم الإسلامية . وهو بدوره يسبب بعداً أكثر ... وهكذا .
القسم الثاني :
ما دل من الأخبار على تشتت الأراء واختلاف النوازع والأهواء ، وكثرة الدعوات
المبطلة .
أخرج ابن ماجه في سننه : أنها ستكون فتنة وفرقة واختلاف (4) .
ــــــــــــ
(1) الشعراء 26 / 80 .(2) الشعراء 26 / 79 .(3) جـ ص 36 .(4) السنن ، ص 1310 .
صفحة (250)
وأخرج أيضاً : يكون دعاة على أبواب جهنم ، من أجابهم إليها قذفوه فيها (1) ونحوه
أخرجه مسلم في صحيحه (2).
وأخرج ابن ماجة أيضاً ، قوله (ص) : ومما اتخوف على أمتي أئمة مضلين (3) وقوله (ص) :
تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك . الحديث (4) .
وروى النعماني (5) عن أبي عبد الله الصادق (ع) في حديث : وليرفعن إثنتا عشرة راية
مشتبهة لا يدري أي من أي. وروى نحوه الصدوق في إكمال الدين (6) .
وروى النعماني (7) أيضاً عن الإمام الباقر عليه السلام في حديث يصف به فساد المجتمع
ويقول : واختلاف شديد بين الناس وتشتت في دينهم وتغير من حالهم .
وروى الشيخ الطوسي في الغيبة (8) عن أبي سيعد الخدري قال : قال رسول الله (ص) :
أبشركم بالمهدي يبعث في أمتي على اختلاف من الناس وزلازل ، يملأ الأرض عدلاً وقسطاً
.... الحديث . ونقله ابن حجر في الصواعق (9) بلفظ مقارب عن أحمد والماوردي .
وهذا المضمون ، مطابق للقاعدة العامة ، كالقسم السابق ، فإنه يعطي صورة أخرى للظلم
والفساد . فإن اختلاف الأراء وتشتتها من أوضح صور الظلم ومستلزماته . وقد كان هذا
وما زال موجوداً بين الناس سواء على المستوى المذهبي الإسلامي أو على المستوى
السياسي أو الإقتصادي أو غيره من حقول الحياة . فإن المجتمع المنحرف منقسم على نفسه
دائماً ومتناحراً في داخله على طول خط انحرافه .
ــــــــــــ
(1) انظر السنن ، ص 1317 . (2) جـ 6 ، ص 20 .(3) السنن ، ص 1304 . (4) السنن ، ص
1324 .
(5) انظر الغيبة ، ص 77 (6) انظر المصدر المخطوط . (7) الغيبة ، ص 135 .(8) ص 111
.(9) ص 99 .
صفحة (251)
وأما دعاة السوء والأئمة المضلين ، فما أكثرهم في التاريخ ! فقد كانوا يتمثلون في
عصر الخلافة بالعلماء المدعين للإسلام الضالعين مع الجهاز الحاكم ، ولا زال أمثالهم
موجودين إلى العصر الحاضر . كما كانوا يتمثلون بالقرامطة ونحوهم ممن يدعو إلى
الإسلام وهم منه براء . ويتمثلون في عصرنا الحاضر ، بعدد غير قليل من الأفكار
والعقائد المنحرفة في العلنة في المجتمع المسلم ، كالبهائية والقاديانية وأكثر
مسالك التصوف ... وغيرها .
ومن هنا يكون ما قيل في الرواية صحيحاً جداً ، من أن كل من تابعهم وأجاب دعواتهم ،
قذفوه في جهنم ، بمعنى أنهم سببوا الخروج عن الإسلام الحق ، بحيث يستحق العقاب
الالهي .
القسم الثالث :
الأخبار التي دلت على اختلاف الناس بشأن المهدي عليه السلام ، خلال غيبته الكبرى .
نتيجة لطول الغيبة واستبعاد الناس وجوده خلال الزمان الطويل ، وما يقترن بذلك من
الدعاوى والتزويرات .
والروايات في ذلك عن أئمة الهدى عليهم السلام كثيرة . وأما العامة فلم يرووا فيه
شيئاً ،لأنه مخالف لرأيهم القائل بإنكار وجود الغيبة الكبرى للمهدي (ع) .
من ذلك ما أخرجه الصدوق في الاكمال (1) عن الإمام الباقر (ع) في حديث يشبه به
المهدي (ع) بعدد من الأنبياء ... إلى أن قال : وأما شبهه من عيسى عليه السلام
فاختلاف من اختلف فيه . حتى قالت طائفة منهم : ما ولد . وقالت طائفة : مات . وقالت
طائفة : قتل وصلب .... الحديث .
ـــــــــــ
(1) انظر إكمال الدين ، المحفوظ . (2) نفس المصدر .
صفحة (252 )
وروي ايضاً (2) عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين (ع) في حديث قالفيه : وأما من
عيسى فاختلاف الناس فيه .
وروى النعماني (1) عن أبي جعفر الباقر (ع) إن للقائم غيبتين يقال له في إحداهما :
هلك ، ولا يدري في أي واد سلك وروي عن الإمام الصادق (ع) بلفظ : مات أو هلك في أي
واد سلك (2) .
وفي الإكمال أيضاً (3) عن الإمام الصادق(ع) : أما والله ليغيبن إمامكم شيئاً من
دهركم ، ولتمحصن (4) حتى يقال : مات أو هلك أو بأي واد سلك . ولقد معن عليه عيون
المؤمنين .
وأخرج ثقة الإسلام الكليني في الكافي عدداً من الأخبار الدالة على نفس هذا المضمون
في باب عقدة لذلك بعنوان : باب في الغيبة (5) .
وهذا كله واضح الإندراج في التخطيط الالهي المقتضي للتمحيص والامتحان . فإن طول
الزمن وزيادته على عمر الإنسان الطبيعي ، قد يورث الشك في بقاء الفرد واستمراره على
أقل تقدير ... لولا الدليل القطعي على بقاء المهدي(ع) وعلى التخطيط الالهي لحفظه
لليوم الموعود . ومن هنا كان المشكك في ثبوت ذلك أو المنساق وراء حسه المادي،
مفكراً لبقاء المهدي (ع) وغيبته .
نستطيع أن نعثر على القائلين بجميع ما ذكرت الروايات من الآراء ووجهات النظر .
فإنها تعرضت إلى أربعة أقوال
القول الأول :
أنه لم يولد ، والمراد أن الإمام الحسن العسكري (ع) مات ولم يعقب ولداً .
(1) انظر الغيبة ، ص 91 . (2) المصد ر، ص80 .(3) انظر المصدر المخطوط . (4) في
المخطوط : وليمحض وهو خطأ على الظاهر (5) انظر المصدر المخطوط .
صفحة (253)
وقد عرفنا في تاريخ الغيبة الصغرى مناشئ هذا القول ، وكيف كان هو الاعتقاد الرسمي
للدولة بعد وفاة الإمام العسكري (ع) مما سبب استيلاء جعفر الكذاب على التركة .
وأما القول بأن المهدي (ع) لم يولد ، وإنما يولد في مستقبل الدهر ليملا الأرض قسطاً
وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً ... فهو القول الذي يذهب إليه إخواننا أهل السنة
والجماعة عموماً ، بعد أن تسالموا مع الإمامية على ظهور المهدي (ع) وقيامه بدولة
الحق .
القول الثاني :
أنه ولد ولكنه مات . والقائل بذلك على قسمين :
القسم الأول :
من يزعم أن محمد بن الحسن العسكري عليهما السلام ، مات .
وقد ذهب إلى ذلك بعض المتأخرين كالشيخ محمد بن أحم السفاريني الأثري الحنبلي في
كتابه لوائح الأنوار البهية ، حيث قال : وأما زعم الشيعة أن اسمه " يعني المهدي "
محمد بن الحسن وأنه محمد بن الحسن العسكري ، فهذيان . فإن محمد بن الحسن هذا قد مات
، وأخذ عمه جعفر ميراث ابيه الحسن (1) .
وهذا زعم تتسالم كل المصادر التأريخية الأولى على نفيه ، من سائر مذاهب المسلمين .
أما مؤرخو الإمامية كالشيخ النعماني والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي والشيخ المفيد ،
وكذلك من يدور في فلكهم، كالمسعودي واليعقوبي ، فأمرهم واضح ، فإنهم يثبتون ولادته
وغيبته بالصراحة ، شأنهم في ذلك شان كل العلماء الإماميين ... كيف لا وهو من
ضروريات المذهب .
وأما مؤرخو العامة المتقدمون كالطبري وابن الأثير وابن خلكان وابن الوردى وأبي
الفداء ، والمتأخرون كابن العماد والزركلي ... وغيرهم . فإنهم ينصون على ولادته
ويذكرون اختفاءه وأنه المهدي المنتظر صاحب السرداب بزعم الشيعة .
ـــــــــــ
(1) انظر جـ 2 و ص 68 .
صفحة (254)
وليس فيهم أي شخص يشير إلى موته . وكيف يستطيعون الأخذ بهذا الرأي ، بعد الذي
عرفناه مفصلاً في تاريخ الغيبة الصغرى ، من اختفاء المهدي (ع) عن أكثر قواعده
الشعبية فضلاً عن غيرها . ومن هنا تكون الأخبار عنه في مثل هذه التواريخ أخباراً
منقطعة ، بل مع اليأس من حصول أي اطلاع على شيء ....
فكيف يستطيعون أن يدعوا موته تاريخياً ، إلا بنحو التزوير . ومن هنا كفوا عن
التصريح بذلك ، كما هو واضح لمن يراجع تلك المصادر .
وأما المتأخرون ، كالسفاريني المولود عام 1114 هـ(1) ، فهم عيال على المتقدمين ،
وليس لهم أن يأتوا بخبر جديد . ولا يؤخذ من قولهم ما عارض أقوال المتقدمين ، كما هو
واضح ، بل تكون أقوال المتقدمين أولى بالترجيح. إذن فالسفاريني أوأي شخص آخر مثله ،
يتحمل مسؤولية كلامه وحده .
وأما استيلاء جعفر الكذاب على ارث الإمام العسكري (ع) فلم يكن عن استحقاق ، بعد
وجود الوارث الشرعي . وقد عرفنا تفاصيل ذلك في تاريخ الغيبة الصغرى أيضاً ، فراجع .
القسم الثاني :
من القائلين بموت المهدي : من يدعي ظهور المهدي وانتهاء حركته . وهم أتباع مدعي
المهدوية في التاريخ ، الذين قاموا بالسيف وماتوا أو قتلوا ، ولم يبق لأصحابهم مهدي
منتظر ، بعد ذلك .
إلا أن مثل هؤلاء الناس ينقرضون بعد موت صاحبهم بمدة غيرة طويلة ، إذ يعجزون عن
تزريق إعتقادهم إلى الأجيال ، اللاحقة لهم ، بعد إتضاح أكذوبة ادعاء المهدوية بدليل
وجداني صريح ، وهو أن هذا المدعي مات ولم يستطع أن يفتح العالم ولا يقيم حكم الله
العادل على البشر أجمعين . ونحن ـ وكل مسلم ـ لا نعنى من المهدي إلا الشخص الذي
يفعل ذلك . وحيث أن هذا المدعي لم يصل إلى هذه النتيجة طيلة حياته ، إذن فهو ليس
مهدياً بالقطع واليقين .
ـــــــــــ
(1) انظر ملحق الجزء الأول من كتابة ، ص1
صفحة (255)
القول الثالث :
مما دلت عليه الروايات : هو القول بأنه قتل أو صلب . ولم نجد من يقول بذلك ، غير ما
يمكن أن يدعيه أصحاب مدعي المهدوية ، فيما إذا قتل صاحبهم أو صلب ، فيقولون : صلب
المهدي أو أنه قتل . يعنون بذلك صاحبهم .
القول الرابع :
التشكيك أنه بأي واد سلك .
فإن كان المراد به الاختفاء وجهالة مكان المهدي (ع) حال غيبته ، فهو أمر واضح في
ذهن كل قائل بالغيبة . إلا أن هذا المعنى خلاف ظاهر الروايات السابقة التي تقول :
مات أ هلك وبأي واد سلك . بحيث يكون المراد موته في بعض الوديان والبراري .
ولم نطلع على من يقول بهذا القول أو يحتمله . على أنه قول في غاية الغرابة ، فإن من
يعتقد بغيبة المهدي (ع) إنما يعتقد بها ناشئة بإرادة الله تعالى وحاصلة بقدرته
وتخطيطه . فكما أن الله حفظه خلال المدة السابقة ، أياً كان مقدارها ، فهو كفيل بأن
يحفظه خلال المدة الآتية ، أياً كان مقدارها . وبصونه من كل العاهات والآفات
والبليات ، تمهيداً لقيامه في اليوم الموعود لتنفيذ ، الغرض الالهي الكبير .
ولعلي هذين القولين الأخيرين ، مما سوف يظهر في مسقتبل السنوات ، وخاصة لو تطاولت
الغيبة مئات أخرى أو آلاف أخرى من السنين .
القسم الرابع :
ما دل على انحراف الحكام وفسقهم وخروج تصرفاتهم وحكمهم عن تعاليم الإسلام ، في
البلاد الإسلامية .
وأوضح ما ورد في ذلك وأكثرها صراحة ، ما أخرجه مسلم في صحيحه (1) بإسناده إلى النبي
(ص) أنه قال : يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيها رجال
قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان أنس .
ــــــــــــــــ
(1) جـ 6 ، ص 20 .
صفحة (256)
وأخرج أيضاً (1) أنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها ... الحديث .
وروى الصدوق في الاكمال (2) حديثاً عن رسول الله (ص) عن الله عز وجل في جواب عن
السؤال وقت ظهور المهدي (ع) قال : فأوحى الله عز وجل إلى يكون ذلك إذا رفع العلم
وظهر الجهل ... إلى أن قال : وصار الأمراء كفرة وأولياؤهم فجرة وأعوانهم ظلمة وذوي
الرأي منهم فسقة .
وفي حديث آخر عن أمير المؤمنين (ع)(3) في حديث كالذي سبقه يقول فيه :
وابتعوا الأهواء واستخفوا الدماء وكان الحلم ضعفاً والظلم فخراً ، وكان الأمراء
فجرة والوزراء ظلمة .... الحديث .
وفي حديث آخر (4) عن أبي عبد الله (ع) : ورأيت الولاة يقربون أهل الكفر ويباعدون
أهل الخير ، ورأيت الولاة يرتشون في الحكم ، ورأيت الولاية قيالة لما زاد .
وهذا هو الموافق للوجدان ، وللقواعد العامة ، ولمقتضى التمحيص الإلهي . أما موافقته
للقواعد العامة والتمحيص الالهي ، فباعتبار أمرين مقترنين :
الأمر الأول :
أن الحكام يكونون ـ في العادة ـ من أبناء المجتمع المنحرف ، ومن نتائج تربيته . إذ
يكونون منذ نعومة أظفارهم معتادين على الإبتعاد عن الدين وعصيان أحكامه ، كأي فرد
ناشئ على هذه التربية . ومن ثم نجدهم يصدرون تلقائياً وبإقتناع عما اعتادوا وألفوه
، وإن غيروا في أسلوب الإنحراف وطوروه .
ومن ثم يكون من الصعب أن نتصور الفرد المنحرف ابن المجتمع المنحرف ، حاكماً بالحق
والعدل ، ومطبقاً لأحكام الإسلام . بل يكون فسق الحكام والوزراء نتيجة طبيعية
لإنحراف المجتمع وفساده .
ــــــــــــ
(1) نفس الجزء ، ص 17 . (2) انظر المصدر المخطوط . (3) منتخب الأثر ، ص 427 عن
الخرايج والجرايح .
(4) نفس المصدر ، ص 429 .
صفحة (257)
الأمر الثاني :
إن انحراف الحكام ، يشارك ـ لا محالة ـ في زيادة الظلم والتعسف في الناس ومطاردة
الحق وأهله ، فيكون ذلك محكاً آخر لتمحيص أشد وامتحان أصعب .... كما هو مقتضى
التخطيط الالهي .
وأما موافقته للوجدان ، فللوضوح التاريخي القطعي ، بأن الحكم في البلاد الإسلامية ،
ساد بعد الخلافة الأولى ضمن مراحل ثلاث :
المرحلة الأولى :
الحكم الإسلامي المنحرف ، المتمثل بـ ( الملك العضوض) الذي أخبر به الرسول (ص) وسار
عليه الخلفاء الأمويون والعباسيون والعثمانيون (1) .
فإنهم بالرغم من توليهم زمام الحكم بسبب ديني ، ويكون المفروض فيهم تطبيق حكم
الإسلام ، إلا أن ما مارسوه من الحكم كان مبنياً على المصلحة الذاتية والطمع بكراسي
الحكم وتناسي المبدأ الإسلامي المقدس ، وقد استعرضنا صورة من ذلك ، في تاريخ الغيبة
الصغرى . ورأينا أنه لم يختلف في ذلك شخص الخليفة والوزاء والقضاة والقواد ، وسائر
الضالعين بركابهم .
المرحلة الثانية :
الحكم الكافر مبدئياً ، وإن كان الحاكم مسلماً بحسب الظاهر (2) . وهو الحكم الذي
تعقب فترة الخلافة ، ولا زلنا نعيشه إلى حد الآن في أكثر بلاد الشام . وقد أسس على
الأسس المجلوبة من مبادئ الحضارة الأوروبية المادية ، سواء منها الجانب الرأسمالي
أو الجانب الإشتراكي ، أو غيرهما . وبذلك نبذت أحكام الإسلام تماماً ، وقام الحكم
على أسس القوانين الوضعية البشرية .
ـــــــــــــــــــ
(1) وصيغته النظرية : أن يكون الحاكم مسلماً فاسقاً يدعي بظاهر حالة تطبيق الإسلام
.
(2) وصيغته النظرية : أن يكون الحاكم مسلماً فاسقاً يتوخى تطبيق القوانين الوضعية
بصراحة .
صفحة (258)
المرحلة الثالثة :
أن يكون الحكم كافراً في المبدأ والقانون والحاكم (1) .
وهو ما تحقق في فترات متقطعة في تاريخ المجتمع الإسلامي ، نتيجة لحملات الكفر عليه
من التتار والمغول والصليبيين والإستعمار الأوروبي المباشر الحديث .
وقد تحققت في المرحلة الأولى فضلاً عن المراحل المتأخرة ، جميع تلك التنبؤات التي
يجمعها ويمثلها الإنحراف عن الإسلام بقليل أو كثير . فكانت قلوبهم قلوب الشياطين
تميل عواطفهم نحو الشر ، قد اتبعوا الأهواء أي المصالح الضيقة واستخفوا بالدماء اي
استهانوا بالقتل ، فكان قتل الفرد بل المئات شيئاً هيناً بل مفخرة كبرى لفاعله .
واصبح الحلم و (الفعو عند المقدرة ) ضعفاً ، والظلم والتنكيل فخراً ... وأصبح
الأمراء وهم الحكام خلفاء كانوا أو ملوكاً أو رؤساء أم سلاطين ... أصبحوا فجرة
ووزاررؤهم ظلمة وذوي الرأي منهم فسقة .
وقد كان الحكام في كل هذه المراحل الثلاث ، وخاصة الأخيرين منها ، يقربون أهل الكفر
، وهم المنحرفون المتزلفون للحكام ، ويباعدون أهل الخير والصلاح ، ممن يأنف عن أن
يعطى الدنية من نفسه . وأما الرشوة فحدث عنها ولا حرج كما هو واضح للعيان . ولله في
خلقه شؤون .
هذا كله في المجتمع الإسلامي الذي أسسه الرسول (ص) وتعاهده بالرعاية ، فأصبح ـ بعد
ذلك ـ مبنياً على الخروج على كتابه وسنته وهداه . وهو المجتمع الذي تتحدث عنه هذه
الروايات عادة . وأما الحكم في غير المجتمع الإسلامي ، فهو قائم على طول الخط على
الكفر المحض وإن كان ولا زال يتسافل تدريجياً إلى المادية عقائدياً والتسيب
أخلاقياً ، والضعف إقتصادياً ، في كبار الدول فضلاً عن صغارها . كما تشهد بذلك
الأثار وتدل عليه الأخبار.
ــــــــــــــ
(1) وصيغته النظرية : أن يكون الحاكم كافراً اساساص والقانون وضعياً .
صفحة (259)
القسم الخامس :
أخبار التمحيص والإمتحان .
فإننا بعد أن عرفنا فلسفته وإندراجه كعنصر أساسي في التخطيط الالهي .. نريد أن يكون
منا إطلاعة على عدد من الأخبار الدالة عليه .
أخرج ابو داود (1) وابن ماجه (2) بلفظ مقارب جداً ، عن رسول الله (ص) : كيف بكم
وبزمان يوشك أن يأتي ، يغربل الناس فيه غربلة ، وتبقى حثالة من الناس قد مرجت
عهودهم وأماناتهم ، فاختلفوا ، وكانوا هكذا ( وشبك بين أصابعه ) ... الحديث .
وروى الصدوق في إكمال الدين (3) والكليني في الكافي(4) عن أبي عبد الله الصادق (ع)
: إن هذا الأمر لا يأتيكم إلا بعد يأس . ولا والله حتى تميزوا ، ولا والله لا
يأتيكم حتى تمحصوا . لا والله لا يأتيكم حتى يشقى من يشقى ويسعد من يسعد .
وروى الصدوق أيضاً(5) عنه عليه السلام : كيف أنتم إذا بقيتم بلا إمام هدى ولا علم .
يبرأ بعضكم من بعض . فعند ذلك تمحصون وتميزون وتغربلون ... الحديث .
وروى النعماني في الغيبة (6) والكليني في الكافي (7) عنه عليه السلام أيضاً أنه قال
ك لا بد للناس من أن يمحصوا ويميزوا ويغربلوا . وسيخرج من الغربال خلق كثير .
وروى النعماني (8) أيضاً عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال : والله لتميزن
والله لتمحصن ، والله لتغربلن كما يغربل الزوان من القمح .
ـــــــــــــــــــ
(1) انظر السنن ، جـ2 ، ص 237 . (2) انظر السنن ، جـ 2 ، ص 1307 . (3) انظر الإكمال
المخطوط .
(4) انظر المصدر المخطوط .(5) انظر الإكمال المخطوط .(6) ص 108 .(7) انظر المخطوط
.(8) ص 109 .
صفحه(260)
وفي الكافي (1) ، عن أبي عبد الله عليه السلام : إن أمير المؤمنين عليه السلام لما
بويع بعد مقتل عثمان صعد المنبر وخطب بخطبة ذكرها ، يقول فيها : إلا إن بليتكم قد
عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيه (ص) . والذي بعثه بالحق لتبلبلن بلبلة ولتغربلن
غربلة ، حتى يصير أسفلكم ، وليسبقن سابقون كانوا قد قصروا ، وليقصرن سباقون كانوا
قد سبقوا وروى النعماني أيضاً (2) بسنده عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث قال
فيه : فوالذي نفسي بيده ما ترون ما تحبون حتى يتفل بعضكم في وجوه بعض ، وحتى يسمي
بعضكم بعضاً كذابين ، وحتى لا يبقى منكم " أو قال : من شيعتي " كالكحل في العين أو
كالملح في الطعام . وسأضرب لكم مثلاً ، هو مثل رجل كان له طعام فنقّاه وطيّبه ثم
أدخله بيتاً وتركه فيه ما شاء الله . ثم عاد إليه فإذا هو قد أصابه السوس ، فأخرجه
ونقاه وطيبه ، ثم أعاده إلى البيت فتركه ما شاء الله . ثم عاد إليه ، فإذا هو قد
أصابته طائفة من السوس فأخرجه ونقّاه وطيّبه وأعاده . ولم يزل كذلك حتى بقيت منه
رزمة كرزمة الأندر لا يضره السوس شيئاً .
وكذلك أنتم تميزون حتى لا يبقى منك إلا عصابة لا يضرها الفتنة شيئاً .
والتمحيص هو التنقية وإبعاد الردئ ، والغربلة هي النخل بالغربال حتى تخرج الزوان ،
وهو الحب الغريب عن الحنطة يكون على شكلها وليس منها .
وغربلة البشر تكون بقانون التمحيص الذي عرفناه . وغربالهم فيها هي الظروف الصعبة
والظلم الذي يعيشه الفرد والمجتمع من ناحية والشهوات والمغريات والمصالح الضيقة ،
من ناحية أخرى ."وسيخرج من الغربال خلق كثير" بمعنى أن أكثر البشر يتبعون الباطل
وينحرفون مع الشهوات والمصالح أو مع الظالمين المنحرفين . فيصبحون" حثالة قد مرجت
(3) عهودهم وأماناتهم " والمراد بها الدين والالتزام بالإسلام وما تستتبعه من خلق
كريم وسلوك مستقيم .
ـــــــــــــ
(1) انظر المخطوط . (2) ص 112. (3) أي اضطربت والتبست وفسدت ، المنجد مادة مرج .
صفحة (261)
وتبقى في نتيجة التمحيص الطويل " عصابة لا تضرها الفتنة شيئاً " لأنهم يمثلون الحق
صرفاً ، وينتمون إلى قسطاط الحق الذي لا كفر فيه ، كما سبق أن سمعنا من الأخبار .
وقد عرفنا أن قانون التمحيص عام للبشرية مرافق لها في عمرها الطويل . وقد نطق به
التنزيل . قال الله تعالى : ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز
الخبيث من الطيب (1) وقال عز وجل : ليميز الله الخبيث من الطيب ، ويجعل الخبيث بعضه
على بعض فيركمه فيجعله في نار جهنم وأولئك هم الخاسرون (2) .
وقال : وليمحصن الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين . أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما
يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين (3).
ولكن هذا القانون يكون أشد وآكد إذا اقترن بالإعداد لليوم الموعود ، إعداداً يمكن
به حمل التبعة والشعور بالمسؤولية تجاه العالم كله .
ولعلنا نستطيع أن نفهم من قوله تعالى : ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم
الصابرين ... كيفية التمحيص وأسلوبه ، وذلك : إن التمحيص ليس للكشف والإظهار فقط
أمام الآخرين أو أمام التاريخ ، وأن كان هذا هو جانبه الظاهر المنظور . وإنما يتضمن
ـ في الحقيقة ـ تغييراً حقيقياً وتأثيراً جوهرياً في ذات الفرد يعلمه الله تعالى
منه بعد وجوده وتحققه .
ويتضح ذلك من بيان مقدمتين :
المقدمة الأولى :
أن للفرد العاقل المختار اتجاهات ووجهات نظر ، وله مواقف وآراء تجاه كل حادثة مما
يمر به في حياته . وهوعلى الدوام يحدد مواقفه فعلاً وتركا وآراءه إيجاباً وسلباً ،
صادراً صدرواً تلقائياً عن اتجاهاته ووجهات نظره العقائدية والعقلية والثقافية
.فتتحدد مواقفه بتحديد إتجاهاته ،وتتغير بتغييره،لا محالة،تجاه كل حادث من حوادث
الحياة .
(1) آل عمران 3 / 179 . (2) الأنفال 8 / 37 . (3) آل عمران 3 / 141 ـ 142 .
صفحة (262)
ويكون للحوادث المتغيرة المتطورة الأثر الكبير في تغيير وتطوير اتجاهات الفرد فضلاً
عن مواقفه ... وبذلك يكسب الصغير خبرة والكبير حنكة والجاهل علماً ، كما هو واضح
جداً لكل فرد عاقل يعيش في هذه الحياة .
وقد يزداد الأثر في هذا المقدار الاعتيادي ، فيما إذا كان الحادث أو مجموعة الحوادث
، ذات صيغة أساسية في حياة الفرد . ولكل فرد من الحوادث ما تكون أساسية في حياته .
فقد تعمق الحوادث اتجاهه وترسخه وقد تضعفه وتضعضعه ، وقد تغير شكله وطريقه . وبتغير
الاتجاه تتغير المواقف بالطبع . فيكاد يصبح الفرد فرداً آخر ، أو تسبغ على سلوكه
تغيرات كبرى أو صغرى تختلف بإختلاف أهمية الحوادث . فقد يصبح الفرد المنحرف معتدلاً
والمعتدل واعياً ، بل قد يصبح الواعي منحرفاً والمنحرف واعياً . وقد يصبح الجبان
شجاعاً والشجاع جباناً والبخيل كريماً والكريم بخيلاً والكذاب صادقاً والصادق
كذاباً ... وهكذا وهكذا .
هذا كله في الحوادث الفردية التي يصادفها الناس في الحياة . ومتى كانت الحوادث أوسع
من الوجود الفردي وأكبر ، كان أثرها أعمق وأشمل على المجتمع كله ، فضلاً عن الفرد ،
كالاتجاه العام للحاكمين سياسياً أو المتنفذين اقتصادياً أو إجتماعياً أو غير ذلك .
وكالغزو أو الاستعمار الذي تتعرض له البلاد ، أو التدهور الإقتصادي التي يمر بها أو
تمر به . فإن كل ذلك يؤثر في الأفراد بل في الشعب كله أثاراً بليغة ،قد يبلغ مدى
تأثيره عمقاً واسعاً في الزمان والمكان .
ومن هنا بالذات و تنبثق فكرة التمحيص والإمتحان ، فإننا بعد أن نعرف : إن لكل واقعة
في الإسلام حكماً معيناً ، ونعرف : إن لكل فر موقفاً معيناً تجاه كل حادثة .إذن فلا
بد أن ينظر إلى مدى تطابق موقف الفرد مع حكم الإسلام. فإن كان منسجماً معه ، فهو
ناجح في التمحيص ، وإن كان مختلفاً معه ، فهو فاشل وراسب لا محالة .
والحوادث المتعاقبة ، قد تصقل من عقيدة الفرد الدينية ، وقد تضعضعها ، بشكل متوقع
أو غير متوقع ، فإن لكل فرد إعتيادي نوازعه الخيرة ونوازعه الشريرة ، واتجاهاته
الخاصة . وقد تكون هذه الإتجاهات متميزة بسلوك إعتيادي معين ، فإذا طرأت حادثة
معينة اضطر إلى الإستجابة لها بإتخاذ موقف من المواقف لا محالة .
صفحة (263)
واضطر إلى التفكير في حال نفسه وفيما هو مقتنع به ، ومن هنا قد يصل الفرد إلى لزوم
اتخاذ موقف جديد ، وإعادة النظر فيما كان مقتنعاً به من التفكير ، وما كان يتخذه من
مواقف .
وليس لاستجابات الأفراد وقراراتهم تجاه الحوادث ، ضابط معروف او قاعدة عامة معينة
... لكثرة العناصر والأسباب الداخلية والإجتماعية التي تؤثر فيه ، والتي تختلف بين
فرد وآخر في هذا العالم الواسع .
ومن هنا يكتسب التمحيص أهميته ، فإنه قبل حدوث الحادثة ـ أية حادثة ـ تكون حالة
الفرد من حيث اتجاهه ورد فعله وما سيتخذه من سلوك ، مجملة ذاتاً وليس لها أي تعين
واقعي . والحوادث وحدها هي التي تعين واقع اتجاهه الجديد ، ودرجة عقيدته وإيمانه ،
كما تكشف لنا ولنفسه ايضاً ، هذا الاتجاه الجديد ومقتضياته المتمثلة في سلوكه
الجديد الذي يتخذه .
فإذا كان للأفراد اتجاهات على الدوام وكانت الحوادث تحدث باستمرار ،وكان لهم تجاهها
ردود فعل وآراء ومواقف، إذن يكون التمحيص والامتحان مستمراً باستمرار الحياة
البشرية .
ومن هنا نرى أن التمحيص كلما اكتسب أهمية أكبر في التخطيط الالهي ، كما هو كذلك
خلال عصر الغيبة الكبرى .. شاء الله تعالى أن يعرض الأفراد لحوادث أعقد وأصعب ، حتى
يكون اتخاذهم للمواقف الجديدة حاسماً وأكيداً ، ليتضح ما إذا كانت مواقفهم منسجمة
مع تعاليم الإسلام أو لا .
المقدمة الثانية :
وهي تتعلق بفهم الآية الكريمة .. وذلك أن هناك فرقاً في علم الله تعالى منم حيث
متعلقه لا من حيث ذاته بين حال ما قبل وجود الشيء في الخارج وبين ما بعد وجوده .
فعلمه عز وجل بالشيء قبل وجوده : أنه سيوجد وعلمه به بعده : أنه قد وجد . وتحقيق
ذلك والبرهنة عليه مفصلاً موكول إلى مباحث الفلسفة الإسلامية .
إذا تمت هاتان المقدمتان استطعنا أن نعلم المراد من الآية الكريمة : ولما يعلم الله
الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين .
صفحة (264)
فإن الفرد ـ أي فرد ـ قبل حصول ظروف الجهاد ، وقبل تشريعه ، يكون ناقص التكوين
حقيقة ، لا مجاهداً ولا صابراً ، وتكون حالته النفسية واتجاهاته مجملة من حيث كونه
سيتخذ موقف الجهاد عند طرد ظروفه وسيصبر على مسؤولياته أولاً . بمعنى أن له درجة ما
قبل الجهاد ، ولا لعقاب الخارجين على مسؤولياته . ومن ثم قال الله تعالى : أم حسبتم
أن تدخلوا الجنة ، ولما يعلم الله المجاهدين منكم ويعلم الصابرين .
وبعد طرد ظروف الجهاد ، يتحدد الموقف الواقعي للفرد ، بأنه مجاهد أو غير مجاهد ،
ذلك الموقف الذي يكسب به درجته الجديدة من الكمال أو التسافل .
فإنه قد يكون رد فعله تجاه هذه الظروف منافياً مع تعاليم الإسلام العادلة فيكون
فاشلاً في التمحيص الالهي متسافلاً عن درجته الإيمانية التي كان عليها . وقد يكون
رد فعله تجاه هذه الظروف منسجماً مع تلك التعاليم ، فيكون ناجحاً في هذا التمحيص ،
صاعداً فوق ما كان عليه من درجة الإيمان ، في سلم الكمال .
فإذا تحدد اتجاهه الجديد ، بالجهاد والصبر ، علم الله تعالى ذلك منه ، كعلمه
بالأشياء بعد وجودها ، ويكون الفرد ساعتئذ مستحقاً لثواب المجاهدين .
إذن فليس المراد من نسبة العلم إلى الله في الآية مجرد الانكشاف لاستلزامه نسبة
الجهل إليه قبل ذلك ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . وإنما المراد تغير الواقع
المتمثل في تغير اتجاهات المكلفين ومواقفهم ، فيعلم الله تعالى بتجدد الوجود عليها
وحصول مرتبة الكمال أو التسافل للفرد . وهذا العلم هو المتحقق بالنسبة إلى الله
بأنه سيوجد ، وبعده عالم بأنه وجد ، كما سبق أن عرفنا .
صفحة (265)
فإذا عرفنا هذه القاعدة العامة في كيفية التمحيص ، وأثره الواقعي .. فهمنا ما ذكر
في الروايات السالفة .. كيف يوجب التمحيص أن يسبق سابقون كانوا قد قصروا ويقصر
سباقون كانوا قد سبقوا ، وعرفنا لماذا يبقى بعد التمحيص حثالة من الناس قد مرجت
عهودهم وآماناتهم ، بعد أن تسالفوا في مواقفهم وردود فعلهم . ويبقى من جهة أخرى
عاصبة لا تضرهم الفتنة شيئاً ، لأنهم نجحوا في التمحيص وسيطروا على كل المصاعب ،
فلا يستطيع الظلم بكل كبريائه ولا الدنيا بكل مغرياتها حملهم على الإنحراف . ورزمة
كرزمة الأندر أو كالكحل في العين أو الملح في الطعام من القلة ، بالنسبة إلى مجموع
البشرية بل المسلمين . وهذا معنى أنه : يشقى من يشقى ويسعد من يسعد .
وعرفنا أن سبب التمحيص والغربلة بالغربال الذي يغربل به الأفراد ( كما يغربل الزوان
من القمح ) .. هي الحوادث المستجدة على الدوام في ظروف الظلم والإغراء .
القسم السادس :
الأخبار الدالة على حدوث وقائع وظواهر معينة محددة من أشكال العصيان والإنحراف في
المجتمع المسلم .
أخرج البخاري (1) عن أنس قال قال رسول الله (ص) : إن من اشراط الساعة أن يرفع العلم
ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا . واخرج في حديث آخر (2) بلفظ : ويظهر الجهل
ويظهر الزنا .
وأخرج ابن ماجه (3) : ليشربن ناس من أمتي الخمر و يسمونها بغير اسمها ، يعزف عن
رؤوسهم بالمعازف والمغنيات .
وفي نور الإبصار (4) : وهذه علامات قيام القائم مروية عن أبي جعفر رضي الله عنه :
قال : إذا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال ، وركبت ذات الفروج السروج . وأمات
الناس الصلوات واتبعوا الشهوات ، واستخفوا بالدماء وتعاملوا بالربا وتظاهروا بالزنا
، وشيدوا البناء واستحلوا الكذب ، وأخذوا الرشا و واتبعوا الهوى ، وباعوا الدين
بالدنيا ، وقطعوا الأرحام وضنوا بالطعام فكان الحلم ضعفاً ، والظلم فخراً ،
والأمراء فجرة والوزراء كذبة والأمناء خونة والأعوان ظلمة والقراء فسقة . وظهر
الجور وكثر الطلاق وبدا الفجور و وقبلت شهادة الزور ، وشربت الخمور ، وركبت الذكور
، واستغنت النساء بالنساء . واتخذ الفيء مغنماً والصدقة مغرماً ، واتقي الأشرار
مخافة السنتهم ... الحديث .
ــــــــــــــــ
(1) انظر الصحيح ، جـ1 ، ص 30 . (2) المصدر و ص 31. (3) انظر السنن ، ص 1333 . (4)
ص 171 .
صفحة (266)
وفي إكمال الدين (1) عن رسول الله (ص) في مخاطبته لله عز وجل ليلة المعراج ،وفيه
يقول : فقلت : الهي وسيدي متى يكون ذلك ـ يعني ظهور المهدي (ع) ـ؟ فأوحى الله عز
وجل إلى : يكون ذلك ـ إذا رفع العلم وظهر الجهل ، وكثر القراء وقل العمل ، وكثر
القتل ، وقل الفقهاء الهادون ، وكثر فقهاء المصاحف وزخرفت المساجد ، وكثر الجور
والفساد ، وظهر المنكر وأمر امتك به ونهي عن المعروف . واكتفى الرجال بالرجال
والنساء بالنساء ، صار الأمراء كفرة وأولياءهم فجرة وأعوانهم ظلمة ، وذوي الرأي
منهم فسقة ... الحديث .
وروي في الخرايج والجرايح (2) بسنده عن البرك بن سبرة قال : خطبنا علي بن أبي طالب
، فقال : سلوني قبل أن تفقدوني . فقام صعصعة بن صوحان فقال : يا أمير المؤمنين :
متى يخرج الدجال ؟ فقال : ما المسؤول عنه بأعلم من السائل .
ولكن لذلك علامات وهيئات يتبع بعضهم بعضا . إن علامة ذلك ك إذا فات الناس الصلوات
وأضاعوا الأمانة واستحلوا الكذب وأكلوا الربا ، وشيدوا البنيان ، وباعوا الدين
بالدنيا واستعملوا السفهاء وشاوروا النساء وقطعوا الأرحام ، وأتبعوا الأهواء ،
واستخفوا الدماء . وكان الحلم ضعفاً والظلم فخراً ، وكانت الأمراء فجرة والوزراء
ظلمة والعلماء خونة والفقراء فسقة .
ــــــــــــــــ
(1) انظر المصدر المخطوط . (2) ص 191 .
صفحة (267)
وظهرت شهادة الزور واستعلن الفجور ، وقيل البهتان والإثم والطغيان ، وحليت المصاحف
وزخرفت المساجد وطولت المنارة واكرم الأشرار ، وازدحمت الصفوف ، واختلفت القلوب ،
ونقضت العهود ، واقترب الموعود .
وشاركت النساء ازواجهن في التجارة حرصاً على الدنيا ، وعلت أصوات الفساق واستمع
منهم ، وكان زعيم القوم ارذلهم . واتقى الفاجر مخافة شره ، وصدق الكاذب وأئتمن
الخائن ، واتخذت المغنيات ، ونسبت (1) الرجال بالنساء والنساء بالرجال ، ويشهد
الشاهد من غير أن يستشهد . وشهد الآخر (2) قضاء لذمام لغير حق تعرفه . وتفقه لغير
الدين ، وآثروا عمل الدنيا على عمل الآخرة . لبسوا جلود الضأن على قلوب الذباب (3)
، وقلوبهم أنتن من الجيف وأمر الصبر ... الحديث .
والأخبار في ذلك مطولة وكثيرة . وأود أن أسرد الحديث الآتي على طوله ، باعتباره
وثيقة مهمة في التاريخ الذين نحن بصدده .
روي في منتخب الأثر (4) عن تفسير الصافي عن تفسير القمي عن ابن عباس . قال : حججنا
مع رسول الله (ص) حجة الوداع ، فأخذ بحلقة باب الكعبة ، ثم أقبل علينا بوجهه فقال :
ألا أخبركم بأشراط الساعة ! .
فكان أدنى الناس منه يؤمئذ سلمان رحمه الله فقال : بلى يا رسول الله .
فقال : إن من أشراط القيامة ، إضاعة الصلوات واتباع الشهوات ، والميل مع الأهواء ،
وتعظيم أصحاب المال وبيع الدين بالدنيا . فعندما يذاب قلب المؤمن في جوفه ، كما
يذاب الملح في الماء ، مما يرى من المنكر فلا يستطيع أن يغيره .
ــــــــــــــــ
(1) كذا في المصدر ، ولعلها : تشبهت . (2) هذه العبارة من رواية " منتخب الأثر " ،
ص 428 لهذا الحديث . وأما الخرايج والجرايح ففيها خطأ مطبعي .(3) في منتخب الأثر ـ
نفس الصفحة : على قلوب الذئاب . (4) ص 432
صفحة (268)
قال سلمان : وإن هذا لكائن يا رسول الله ؟
قال : اي والذي نفسي بيده يا سلمان ، إن عندهم يليهم أمراء جورة ،ووزراء فسقة
وعرفاء ظلمة وأمناء خونة .
فقال سلمان : وإن هذا لكائن يا رسول الله ؟
قال : اي والذي نفسي بيده ، يا سلمان ، إن عندها يكون المنكر معروفاً ، والمعروف
منكراً ، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين ،ويصدق الكاذب ويكذب الصادق .
قال سلمان إن هذا لكائن يا رسول الله ؟
قال : أي والذي نفسي بيده و فعندها إمارة النساء ، ومشاورة الأماء ، وقعود الصبيان
على المنابر . ويكون الكذب طرفاً والزكاة مغرماً والفيء مغنماً ، ويجفو الرجل
والديه ويبر صديقه . ويطلع الكوكب المذنب .
قال سلمان : أن هذا لكائين يا رسول الله ؟
قال : أي والذي نفسي بيده . وعندها تشارك المرأة زوجها في التجارة ، ويكون المطر
فيضاً (1) ويغيض الكرام غيضاً . ويحتقر الرجل المعسر . فعندها تقارب الاسواق ، إذا
قال هذا : لم أبع شيئاً ، وقال هذا : لم أربح شيئاً . فلا ترى إلا ذاماً لله .
قال سلمان : إن هذا لكائن يا رسول الله ؟
قال : أي والذي نفسي بيده ،يا سلمان ، فعندها تليهم أقوام أن تكملوا قتلوهم وإن
سكتوا استباحوهم . ليستأثرون بفيئهم ، وليطأون حريتهم وليسفكن دماءهم ، وليلمؤن
قلوبهم دغلاً ورعباً ، فلا تراهم إلا وجلين خائفين مرعوبين مرهوبين .
قال سلمان : وإن هذا لكائن يا رسول الله ؟
قال : أي والذي نفسي بيده ، يا سلمان . إن عندها يؤتى بشيء من المشرق وبشيء من
المغرب يلون أمتي ، فالويل لضعفاء أمتي منهم . والويل لهم من الله ،لا يرحمون
صغيراً ولا يوقرون كبيراً ولا يتجافون عن مسيء .
(1) وفي نسخة : غيضاً .
صفحة (269)
جثتهم جثث الآدميين وقلوبهم قلوب الشياطين .
قال سلمان : وإن هذا لكائن يا رسول الله ؟
قال (ص) : أي والذي نفسي بيده ، يا سلمان ، وعندها يكتفي الرجال بالرجال والنساء
بالنساء ، ويغار على الغلمان كما يغار على الجارية في بيت أهلها .
وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال ، وتركبن ذوات الفروج السروج ، فعليهن من
أمتي لعنة الله .
قال سلمان : وإن هذا لكائن يا رسول الله ؟
قال : أي والذي نفسي بيده ، يا سلمان . وعندها تحلى ذكور أمتي بالذهب ويلبسون
الحرير والديباج ويتخذون جلود النمور صفافاً (1) .
قال سلمان : وإن هذا لكائن يا رسول الله ؟
قال : اي والذي نفسي بيده يا سلمان ، وعندها يظر الرب ، ويتعاملون بالعينة (2)
والرشا ، ويوضع الدين وترفع الدنيا .
قال سلمان : وإن ذلك لكائن يا رسول الله ؟
قال : أي والذي نفسي بيده يا سلمان ، وعندها يكثر الطلاق ، فلا يقام لله حد . ولن
يضروا الله شيئاً .
قال سلمان : وإن هذا لكائن يا رسول الله ؟
قال : اي والذي نفسي بيده يا سلمان ، وعندها تظهر القينات والمعازف ، وتليهم شرار
أمتي .
قال سلمان : وإن هذا لكائن يا رسول الله ؟
ــــــــــ
(1) أي مستوية مطمئنة والمهاد كونها ملساء . وفي نسخة أخرى : صفاقاً ، أي كثيفة
ثخينة .
(2) بيع العينة هو بيع الشيء إلى أجل بزيدة على ثمنه مقابلة انتظار الثمن ( المنجد
) أقول : وهو غير جائز في شرع الإسلام .
صفحة (270)
قال(ص) : أي والذي نفسي بيده و يا سلمان . وعندها يحج أغنياء أمتي للنزهة ويحج
أوساطها للتجارة ، ويحج فقراؤهم للرياء والسمعة . فعندها يكون أقوام يتفقهون لغير
الله ويكثر أولاد الزنا ، ويتغنون بالقرآن ، ويتهافتون بالدنيا .
قال سلمان : وإن هذا لكائن يا رسول الله ؟
قال(ص) : أي والذي نفسي بيده ، يا سلمان . ذلك إذا انتهكت المحارم ، واكتسبت المآثم
وسلط الأشرار على الأخيار ويفشو الكذب و وتظهر اللجاجة ، وتفشو الفاقة ، ويتباهون
في اللباس ، ويمطرون في غير أوان المطر ، ويستحسنون الكوبة والمعازف ، وينكرون
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، حتى يكون المؤمن في ذلك الزمان أذل من الأمة .
ويظهر قراؤهم وعبادهم فيما بينهم التلاوم ، فأولئك يدعون في ملكون السماوات :
الأرجاس الأنجاس .
قال سلمان : وإن هذا لكائن يا رسول الله ؟
قال : أي والذي نفسي بيده ، يا سلمان . فعندها لا يخشى الغني على الفقير ، حتى أن
السائل يسأل في الناس فيما بين الجمعتين لا يصيب أحداً يضع في كفه شيئاً .
قال سلمان : وإن هذا لكائن يا رسول الله ؟
فقال : أي والذي نفسي بيده ، يا سلمان . فعندها يتكلم الروبيضة .
فقال سلمان : ما الروبيضة ؟ يا رسول الله ، فداك أبي وأمي .
قال (ص) : يتكلم في أمر العامة من لم يكت يتكلم (1) .. الحديث .
وروى الشيخ الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه (2) عن الإصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين
(ع) قال : سمعته يقول: يظهر في آخر الزمان واقتراب الساعة ، وهو شر الأزمنة ، نسوة
كاشفات عاريات ، متبرجات من الدين ، داخلات في الفتن ، مائلات إلى الشهوات ، مسرعات
إلى اللذات ، مستحلات للمحرمات ، في جهنم داخلات .
(1) انظر أيضاً الروبيضة في سنن ابن ماجه ، جـ2 ، ص 1340 وغيره .
(2) ص 247 ، جـ 3 ، وانظر منتخب الأثر ، ص 426 .
صفحة (271)
إلى غير ذلك من الاخبار الكثيرة ، وفيها المطول والمختصر . ويكفينا منها ما ذكرناه
... وهي لعمري بمجموعها الوثيقة التاريخية المهمة ، والوجه الصادق المخلص ، المطابق
للقواعد والوجدان ، في الكشف عن تاريخ البشر خلال عصر الغيبة الكبرى .
ويتم الكلام في فهم هذه الأخبار وتحديد مداليلها في ضمن أمور :
الأمر الأول :
أننا لنشعر من سلمان الفارسي رضي الله عنه ـ في خبر ابن عباس ـ وهو يعيش المجتمع
الفاضل العادل الذي يقوده النبي (ص) ويرعاه ... أننا لنشعر منه استغرابه وشدة عجبه
من صفات الفسق والإنحراف التي يعلن النبي (ص) عن تحققها في آخر الزمان . ومن هنا
نراه يكرر على النبي (ص) القول : وإن ذلك لكائن يا رسول الله . فيجيبه النبي (ص)
مؤكداً أي والذي نفسي بيده .
كما أننا لنحس بكل وضوح الأسى الشديد الذي يتضمنه كلام النبي (ص) وهو يصف خروج
الناس عن شريعته وعصيانهم لتعاليمه ، وتركهم للعدل الصحيح ، مما يسبب لديهم أسوأ
الآثار . كيف لا ، والله تعالى يقول : يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا
كانوا به يستهزئون (1) .
والنبي (ص إذ يخطاب الناس بذلك ، ويطلعهم عليه ، لا يخص به صحابته وأهل عصره ـ
باجتنابهم الخصال السيئة والإنحرافات المقيتة التي ذكرها رسول الله (ص) في بيانه .
إلا أن غرضه الأساسي والأهم هو مخاطبته الأجيال القادمة ، وعلى الأخص تلك الأجيال
التي تتصف بهذه الصفات ، وتنحرف مثل هذه الإنحرافات ، حتى ينبهها عن غلفتها ويشعرها
بواقعها ، ويتم الحجة عليها . ذلك التنبيه الذي يؤثر في وجدان عدد من الناس
المخلصين ، التأثير الصالح المطلوب ، فيتأكد إخلاصهم وتقوى إرادتهم ويزداد شعورهم
بالمسؤولية للتمهيد لليوم الموعود ، طبقاً للتخطيط الالهي الكبير .
(1) الروم : 30 / 36 .
صفحة (272 )
الأمر الثاني :
أننا نفهم مما قلناه الآن : إن رواية ابن عباس بل جميع هذه الروايات تشارك في
التخطيط الالهي من ناحية أسبابها ومن ناحية نتائجها .
أما من ناحية أسباب صدور هذه الرويات ، فباعتبار علم النبي (ص) والأئمة (ع)
بالتخطيط الالهي ، وما سوف يقتضيه على طول الخط التاريخي الطويل . ومن ثم نراهم
يخبرون بهذا الجانب من التخطيط ، كما أخبروا بجوانب أخرى ، في الأخبار السابقة
كروايات التمحيص ... وغيرها .
وأما من ناحية نتائجها ، فلما تتوخاه هذه الأخبار من إتمام الحجة ، والتنبيه من
الغفلة ، وإيجاد شرط الظهور بإعلاء درجة الإخلاص في الأجيال المعاصرة للانحراف .
الأمر الثالث :
إن بعض هذه الأخبار ، تكون قرينة مبينة بالنسبة إلى البعض الآخر . إذ بالرغم من أن
جملة منها لا يتضح منها كون الانحراف المخبر به حاصلاً في عصر الغيبة الكبرى على
التعيين . إلا أن خبر نور الإبصار وخبر إكمال الدين ، قرن تلك الحوادث بما قبل ظهور
المهدي (ع) ومع اتحاد الحوادث نعرف أن المراد من جميع الأخبار هو ذلك .
كما أنه قرنت هذه الحوادث في خبر " الخرايج والجرايح " بما قبل ظهور الدجال ، فإذا
علمنا بالقطع واليقين بأن ظهوره سابق على ظهور المهدي (ع) ،كما تدل عليه الروايات
الآتية المروية من قبل الفريقين . إذن نفهم بوضوح أن هذه الحوادث سابقة أساساً على
ظهور المهدي (ع) . وهو معنى حصولها في فترة الغيبة الكبرى ، كما هو واضح .
واقترانها بما قبل قيام الساعة ، في بعض هذه الأخبار ، لا يكون مضراً بما فهمناه ،
باعتبار ما قلناه فيما سبق ، من أن السابق على الظهور سابق على قيام الساعة . وليس
من الضروري أن تكون أشراط الساعة واقعة قبلها مباشرة .
وسيأتي التعرض إلى تفصيل ذلك في القسم الثالث من هذا التاريخ .
صفحة (273)
الأمر الرابع :
مقصود النبي (ص) والأئمة (ع) هو اطلاع الأمة على الانحراف الأساسي الذي يستفحل في
المجتمع ، فيبتعد به عن العدل الإسلامي ، بكل تفاصيله ، بما فيه التعاليم الإلزامية
والتوجيهات الإستحبابية والأخلاقية . فإن العدل الكامل لا يتحقق إلا باتباع كل
التعاليم واجبها ومستحبها وعباديها وأخلاقيها . ويتحقق الانحراف بالخروج على أي
منها .
ومن ثم نسمع من هذه الأخبار و وقوع الإنحراف عن المستحبات ، كترك الصدفة المستحبة
وتحلية المصاحف وزخرفة المساجد ، وإطالة المنارة فيها ، ونحو ذلك .
الأمر الخامس :
إن عدداً من الحوادث الواردة في هذه الروايات ، تتضمن أموراً يمكن أن تقع على وجه
إسلامي صحيح ، كما يمكن أن تقع على وجه باطل منحرف . ونعرف بالطبع ـ من وقوعها في
كلام النبي (ص) أو الإمام (ع) وهو بصدد تعداد الحوادث المنحرفة ، أنها منحرفة ،
وواقعة على شكلها الباطل .
مثال ذلك : تشييد البناء ،فإنه إن وقع من الفرد بعد تطبيق كل الأنظمة المالية في
الإسلام ،وعلى الوجه الشرعي الصحيح ، لم يكن فيه حزازة . بل قد يتضمن مصلحة عامة في
كثير من الأحيان . ولكنه إن وقع على خلاف ذلك كان عصياناً وانحرافاً في نظر الإسلام
.
الأمر السادس :
إن ما تتضمنه هذه الأخبار ، أمور راجحة وصحيحة شرعاً ، إلا أنها إذا اقترنت بسلوك
منحرف أو اتجاه فاسد ، اكتسبت معنى منحرفاً سيئاً ،بمعنى أن مجموع فعل الفرد لا
يكون محموداً ،بل يكون ممثلاً لحظ الانحراف لا محالة.
صفحة (274)
مثال ذلك : قوله : إذا ازدحمت الصفوف واختلفت القلوب . فإن ازدحام الصفوف للصلاة
الجامعة أو لغرض آخر كالوعظ أو تشييع جنازة أو نحو ذلك، أمر مطلوب وراجح في
الإسلام..ولكنه إذا افترن بتفرق القلوب وتشتت الأهواء والنوازع، لم يكن دالاً على
قوة ولا على وعي وإرادة، ومن ثم يكون مذموماً مقيتاً.
ومثاله الآخر: إن الرجل يجفو والديه ويبر صديقه. فإن بر الصديق وإن كان أمراً
عادلاً راجحاً على الأغلب، إلا أنه إذا اقترن بجفاء الوالدين دل على خبث النية
وانحراف والاتجاه. ويدل على أن الصداقة لم تنعقد على أساس الإسلام بل على أساس
المصالح الضيقة والأعمال المنحرفة، إذ لو لم يكن كذلك، لما جفا الفرد والديه.
وهكذا... قس على هذه الأمثلة ما سواها.
الأمر السابع:
يراد ببعض التعابير في هذه الأخبار معناها الكنائي أو الرمزي، لا المعنى الحقيقي
المفهوم من اللفظ لأول وهلة. ومعه لا حاجة إلى تخيل حدوث هذه الأمور بطريق إعجازي،
بل يمكن أن يكون حدوثها طبيعياً اعتيادياً.
فمن ذلك قوله: لبسوا جلود الضأن على قلوب الذئاب. فإن المراد هو التعبير عن دماثة
الظاهر وخبث الباطن وشراسة الطبع. وهذا واضح.
ومن ذلك: قوله: يذاب قلب الؤمن في جوفه، كما يذاب الملح في الماء، لما يرى من
المنكر، فلا يستطيع أن يغيره.
فإن المراد التعبير من شدة أسفه ووجده لما يرى من العصيان ومخالفة العدل الإلهيي،
وهو غير قادر على رفعه أو تغييره، بسبب عمق ظروف الإنحراف.
ومن ذلك قوله: إن عندها يؤتى بشيء من المشرق وبشيء من المغرب يلون ( أي يحكمون )
أمتي.
فإن أفضل تفسير لذلك: هو المبادئ المادية التي جلبت إلى بلاد الإسلام من الغرب تارة
ومن الشرق أخرى. ويمارس الحكام المنحرفون الحكم طبقاً لأحدهما أو لكليهما في بعض
الأحيان.
صفحة (275)
والظاهر من التعبير الوارد في الرواية: اشتراك كلا الشيئين في ولاية الأمة. ولم
يحدث ذلك في التاريخ إلا في السنوات المتأخرة التي عشناها ونعيشها، حين أصبح الحكام
في شرقنا الإسلامي يمثلون الشرق الملحد والغرب المشرك معاص، ويعبرونهما معاً مثلاً
أعلى قدوة تحتذي، لو قيست بمبادئ الإسلام وتعاليمه، في رأيهم الخاطئ.
ومن ذلك: قوله: يتكلم الرويبضة. فإن المراد به – كما فسره صلى الله عليه وآله في
نفس الحديث – : كل رجل يتكلم في أمر العامة، لم يكن يتكلم قبل ذلك.
وإن أفضل فهم لهذه العبارة، هو هو أن يقال: أنه عاش المجتمع المسلم عدة قرون، لا
يتكلم باسم العامة ولا يدير شؤونهم إلا أشخاص صادرون عن الدين بشكل وآخر، كالخلفاء
والقضاة والفقهاء. حتى ما إذا ورد تيار الحضارة الحديثة إلى العالم الإسلامي، أباح
جماعة من المنحرفين لأنفسهم أن ينطقوا باسم العامة أو باسم الشعب وينظروا في أمره
ويديروا شؤونه، من دون أن يكون لهم أي حق حقيقي سوى السيطرة التي اكتسبوها بالقوة
والحديد والنار على الناس. وأصبحالتكلم باسم الشعب شعاراً راسخاً يقتنع به
الكثيرون، بالرغم من أنه يمثل انحرافاً حقيقياً عن الإسلام الذي يوجب تكلم الحاكم
باسم الله لا باسم الشعب.
ولعل التعبير بالروبيضة يشعرنا بوجود تيار رابض أو كامن بين أبناء الإسلام دهراص من
الزمن، أنتج في نهايته هذه النتيجة.
وهذه أمر صحيح، بعد الذي نعرفه من التاريخ الحديث، من أن الاستعمار استطاع أولاً
السيطرة الثقافية والعقائدية على عقول عدد كبير من أبناء هذه البلاد، مما أنتج في
نهاية الخط، سطرتهم على الحكم وممارستهم الأساليب لكافرة في إدارة بلاد الإسلام.
فكانت تلك السيطرة اعداداً كامناً لإيجاد هذا الحكم في نهاية المطاف.
وهذا يبرهن أيضاً على صحة ما في هذه الأخبار، مما قد تكلمنا عنه فيما سبق، من أن
الأمراء يصبحون كفرة والوزراء فجرة وذوي الرأي فيهم فسقة.
صفحة (276)
الأمر الثامن:
أشرنا في منهج الفهم الدلالي للروايات، إلى أنه قد يرد فيها تعابير يختلف مصداقها
ويتطور على مر العصور، وإن فهم الناس المعاصرون لصدور النص، مصدقاً معيناً، بل وإن
صرح لهم بمصداق معين جرياً على قانون مخاطبتهم على قدر عقولهم، كما سبق. وقلنا أنه
لا بد من التوسع في الفهم، وتطبيق التعبير على كل مصداق متطور، خاصة بعد اليقين بأن
النبي (ص) أو الإمام (ع) يقصد المصداق الذي يحدث في الزمان الذي يتكلم عنه، لا الذي
يحدث في الزمان الذي يتكلم فيه. ومن المعلوم اختلاف المصداقين إلى حد بعيد، طبقاً
لتطور الزمان وتغير الأحوال.
فإذا استوعبنا ذلك استطعنا أن نطبقه في كثير من تعابير هذه الأخبار.
فمن ذلك: قوله: وتركب ذات الفروج السروج. فإن السرج وإن كان هو ما يوضع على الفرس،
وقد ركبته النساء في التاريخ أحياناً، وتحققت النبوءة. وهو ما فيه الكفاية للمكتفي.
إلا أننا يمكن أن نجد مصاديق أخرى لذلك على مر العصور... فيما إذا فهمنا من السروج
كل مركوب يختص بالرجل في نظر الإسلام. بمعنى أن ستعماله بالنسبة إلى المرأة ملازم
عادة مع التبرج والخروج على الآداب الإسلامية، تماماص كما هو الحال في ركوب
الفرس...فكذلك ركوب الدراجة الهوائية أو البخارية أو سياقة السيارة أو الطائرة أو
الباخرة... ونحو ذلك.
ومن ذلك: قوله: وتظهر القينات والمعازف. وقوله: واتخذت المغنيات. فإنه بالرغم من أن
ذلك قد حدث فعلاً منذ عصر الأمويين إلى ما بعده بعدة قرون. إلا أننا يمكن أن نفهم
منه ما هو الأعم والأشمل لينطبق على ما تذيعه وسائل الإغلام الحديثة من حفلات
غنائية وما تبثه من أساليب خلاعية لا أخلاقية على شاشة السينما والتلفزيون وعلى
أمواج الراديو، فإنها لا تختلف في مضمونها وحقيقتها عن تلك الحفلات القديمة إلا في
اجتماع السامعين والمشاهدين مع المغنين في مجلس واحد. كما لا تختلف في مقدار
انحرافها عن الإسلام وعصيانها لتعاليمه.
الأمر التاسع:
إن هناك أموراً وردت في كلام النبي (ص) – في الخبر الطويل لابن عباس – لم يكن يقهم
منها معاصروه إلا معنى غامضاً غائماَ، بمقدار ما ترشد إليه قواميس اللغة. ولكن قد
أثبتت العصور الأخيرة، بما عاشت من تجارب، مدى أهميتها الكبرى وأثرها البالغ في
المجتمع.
صفحة (277)
فمن ذلك: ما يصفه (ص) من موقف الحكام المنحرفين تجاه الشعب المسلم بقوله: إن تكلموا
قتلوهم وإن سكتوا استباحوهم. فإن مثل هؤلاء الحكام يستغلون نقاط الضعف في الأمة على
طول الخط، ويختطون معهم خطة العسف والقهر، لايختلف في ذلك الحكم الفردي الدكتاروي
عن الحكم المبدئ المنحرف القائم على غير الإسلام.
فأول ما يواجهون به الأمة: منعها عن الحرية الفكرية والسياسية وصراحة الرأي، فإن (
تكلموا قتلوهم ) أو هددودهم بالعقاب الأليم. فإن استسلم الناس وسكتوا ( استباحوهم )
واستغلوا واستحلوا خيراتهم وسيطروا على مواردهم ومصادرهم.
ومن ذلك: ما ذكره (ص) من حصول كثرة الطلاق. على حين لم يكن يحدث في دولته من الطلاق
إلا النذر القليل بنسبة ضئيلة جداً. لما كان الزوجان يلتزمانه فيما بينهما من تطبيق
العدل الإسلامي، ونبذ الأنانية.
وأما حين يبتعد المجتمع عن أحكام الله عز وجل، وتتعقد حياته تعقيداً منحرفاً، تبدأ
الأسر بالتفسخ والبيوت بالانفصام، وتكثر حوادث الطلاق حتى بعد وجود الذرية.
وقد أثبت العلم الإجتماعي الحديث، أن كثرة الطلاق تدل على حدوث عنصر أو عناصر، غير
مرغوبة في الحياة الإجتماعية، وأنه يؤدي بدوره إلىعدة آثار سيئة مما يضطر الحكومات
على طول الخط إلى رصد المبالغ الضخمة للملاجئ ونحوها لكي تحوي الأطفال المتسيبين
الفاقدين للمربى والكفيل.
ومن ذلك قوله: وتفشو الفاقة. فإن انتشار الفقر يكون بأحد سببين، كلاهما ناتج عن سوء
التنظيم الاقتصادي.
السبب الأول:
الرأسمالية أو الاستقطاب المالي عند عدد قليل من الناس، وبقاء الآخرين على حالة
الضعف والفاقة، محكومين من قبل أرباب المال من حيث أوضاعهم
صفحة (278)
السياسية والاقتصادية والإجتماعية... بل حتى من حيث النواحي الإخلاقية والعقائدية
في كثير من الأحيان. فإن المتمولين هم المسيطرون على تربية الناشئة وتثقيف الشعب،
مضافاً إلى نفوذهم في البلاد.
السبب الثاني:
انخفاض المستوى الاقتصادي لدى جميع أفراد المجتمع، بقلة الدخل العام والواردات
الشخصية. وقد تواجه مثل هذا الضعف الاقتصادي نتيجة لبعض الأزمات، أو سوء التصرف من
قبل الحاكمين.
والسبب الأول هو الأغلب في المجتمعات، والأشد ضراراً عليها في المدى البعيد. وخاصة
إذا عممنا مفهوم الطبقية المالية إلى المجتمع الزراعي والصناعي معاً. وقد نشأ هذا
الوضع في المجتمعات الإسلامية، نتيجة لتناسي العدل الإسلامي وانحساره عن عالم
التطبيق الإجتماعي. وكان من أوضح نتائجه أن تفشو الفاقة وينتشر الفقر.
الأمر العاشر:
ليس شيء مما ذكر في هذه الروايات، لم يتحقق في خلال التاريخ الإسلامي. ومن المستطاع
القول بأن كل الصفات المعطاة فيها، موجودة بشكل وآخر، على طول تاريخ الإنحراف إلى
العصر الحاضر، وستبقى نافذة المفعولن ما دام مجتمع الظلم والفتن موجوداً، إلى حين
قيام الإمام المهدي (ع) بدولة الحق.
ولا نستطيع الدخول في تفاصيلهت وتكرار مداليلها بأكثر مما قلناه وإنما ذلك موكول
إلى القارئ، إن شاء أن يراجع النصوص فاهماً لها انطلاقاً من الأساس الإسلامي
الصحيح.
وبهذا ينتهي الكلام في الجهة الثانية من الناحية الثانية من هذا الفصل.
* * *
عرض على المنهج السندي:
وإذا عرضنا هذه الأخبار على المنهج السندي الذي التزمناه، من رفض الأخذ بخبر الواحد
في هذا المجال، ما لم تقم على صحته قرائن خاصة أو تحصل فيه استفاضة أو تواتر...
فإنه ينتج صحة الأعم الأغلب من هذه الأخبار. وإن كان كل واحد منها بمفرده خبر واحد،
قد يوسم بالضعف.
صفحة (279)
فإن عدداً من هذه الأخبار قامت القرائن القطعية على صحته... يمكن أن نحمل فكرة عنها
فيما يلي:
القرينة الأولى:
تحقق الحوادث التي أعربت عنها في التاريخ كما سمعنا، فإننا ذكرنا أن ذلك من القؤائن
على صدق الخبر.
القرينة الثانية:
إن بعضها وارد في مورد معارضة الجهاز الحاكم، الذي كان مسيطراً في عصر صدور هذه
الأخبار أو عصر تسجيلها. كقوله (ص): يكون أقوام أمتي يشربون الخمر ويسمونها بغير
اسمها. فإنه كان على هذا ديدن عدد من الخلفاء الأمويين والعباسيين... يسمونها:
الطلي أو الختج أو الفقاع... ويفتون بجواز الشرب ما لم يصل إلى حد الإسكار.
القرينة الثالثة:
إن عدداً منها مسجل في المصادر، قبل أن يشعر مؤلفوها أو رواتها بحدوث تلك الأحداث
أساساً. وإنما حدثت بعد ذلك نتيجة لتزايد ابتعاد المجتمع عن الإسلام. كما هو واضح
لمن استقرأ عدداً من الحوادث المنقولة، وقد استعرضنا بعضها عند محاولة فهمنا لهذه
الأخبار
يضاف إلى هذه القرائن: أن جملة من مضامين هذه الأخبار دل عليه عدد منها، ولم تختص
بخبر واحد أو خبرين. وقد اعتبرنا في المنهج السندي ذلك من المرجحات.
ولعلك لاحظت معي تكرر الحوادث في الأخبار التي سمعناها. إن هذه الحوادث المكررة هي
مقصودنا في المقام.
كما أن بعضها مستفيض أو متواتر لفظاً، وهو الخبر القائل بأن المهدي (ع) يملأ الأرض
قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً. فإنه مروي من قبل الفريقين بأعداد كبيرة، منها
ما ذكرناه ومنها ما لم نذكره. وقد ذكر الشيخ الصافي في منخب الأثر أنه مروي بما
يزيد على المئة والعشرين طريقاً.
صفحة (280)
وأما ما لم يكن محتوياً على هذه القرائن والصفات من الأخبار، فمقتضى التشدد السندي
الذي سرنا عليه... رفضه، وإيكال علمه إلى أهله.
كالخبر الذي رواه النعماني في الغيبة(1)، المعرب عن حصول اثنتي عشرة رواية مشتبهة.
وقد سبق. أو ما رواه ابن ماجة(2) من ( أن بين يدي الساعة دجالين كذابين قريباً من
ثلاثين، كلهم يزعم أنه نبي ). لو حملنا النبوة على معناها الإصطلاحي وهو الرسالة عن
السماء. وفي البخاري(3) يقول: كلهم يزعم أنه رسول الله. فإن هذه الأرقام لا تثيت.
وإن وجد في التالريخ حقاً عدد ممن يدعي الإمامة أو النبوة.
* * *
الجهة الثالثة:
في الأخبار الدالة على صلاح الزمان وتحسن الوضع العام فيه... بشكل يشمل بإطلاقه
تحسن المجتمع خلال عصر الغيبة الكبرى.
وقد ذكرنا بعد ( منهج التمحيص الدلالي ) أقسام الأخبار الدالة على صلاح الزمان
وحسنه، وقلنا أنه لا بد من حمل مطلقاتها على مقيداتها، على النحو الذي سبق.
وأود في هذا الصدد، أن أورد عدة من هذه النصوص وأذكر الوجه الحق في تمحيصها.
ولم نجد من الرواة الإماميين من روى مثل ذلك، بل أن أخبارهم مطبقة على تدهور الزمان
وفساده خلال عصر الغيبة الكبرى. وإنما هي أخبار قليلة وردت في مصادر العامة.
(1) انظر ص 247 وما بعدها. (2) أنظر السنن، جـ 2 ، ص 1304. (3) أنظر الصحيح ، جـ 9
، ص 74.
صفحة (281)
فمنها: ما أخرجه البخاري(1) عن رسول الله (ص) أنه قال: تصدقوا! فسيأتي على الناس
زمان يمشي الرجل بصدقته، فلا يجد من يقبلها.
وفي حديث آخر(2) يعد به عدداً من أشراط الساعة، ويقول فيه:
وحتى يكثر فيكم المال، فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول
الذي عرضه عليه: لا أرب لي به.
وأخرج مسلم(3) عن رسول الله (ص): تصدقوا، فيوشك الرجل يمشي بصدقته، فيقول الذي
أعطيها: لو جئتنا بالأمس قبلتها، فأما الآن فلا حاجة لي بها. من يقبلها.
وأخرج أيضاً(4): لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال، فيفيض، حتى يهم رب المال من
يقبل صدقته. ويدعى إليه الرجل، فيقول: لا أرب لي فيه.
إلا أن مثل هذه الأخبار، لها محامل ممكنة، وعليها اعتراضات. فإن صحت المحامل فهو
المطلوب، وإلا وردت عليها الاعتراضات.
أما المحامل، فهي عدة تقييدات يمكن أن نوردها عليها:
التقييد الأول:
أن نخص هذه الأخبار، بما بعد ظهور المهدي (ع)، فيكون مدلولها طبيعياً وصحيحاً،
وموافقاً مع الأخبار الكثيرة المتواترة الدالة على تزايد الخير والرفاه في زمن ظهور
المهدي (ع)، على ما سنسمع في التاريخ القادم(5).
وربما يصلح قرينه على هذا التقييد، قوله: لو جئتنا بالأمس قبلتها، يعني قبل
الظهور،وأما الآن – يعني بعد الظهور – فلا حاجة لي بها.
(1) أنظر الصحيح، جـ 9 ، ص 73 – 74. (2) المصدر ، ص 74. (3) أنظر الصحيح، جـ 3 ، ص
84.
(4) المصدر والصفحة. (5) وهو الكتاب الثلث من هذه الموسوعة.
صفحة (282)
ومعه، لابد من رفع اليد عن ظهور قوله: يوشك الرجل... في قرب حدوث ذلك، بجعل الأخبار
الثلاثة الأخرى قرينة عليه.
وهذا التقييد وإن كان حملاً،يمكن أن يصح في سائر هذه الخبار، إلا أن واحداً منها
يأباه – بظاهره -، وهو الحديث الثاني الذي نقلناه عن البخاري، فإنه اقترن فيه
الأخبار بكثرة المال بالأخبار عن حدوث حوادث عديدة سيئة كالفتن والهرج، وغيرهما على
ما سنسمع. مما عرفنا اختصاص حدوثه في عصر الغيبة الكبرى دون عصر الظهور. إلا أن هذا
الإيراد، يمكن أن يتوجه كأشكال على هذا الخبر نفسه، لا على هذا التقييد الأول.
التقييد الثاني:
أن نقول: إن أقصى ما تدل عليه هذه الأخبار، هو أن الناس لا يقبلون الصدقة. وما أن
منشأ ذلك هو كثرة المال فلا دليل عليه. فقد تكون له مناشئ أخرى كالتعفف أو التنفر
من الصدقة الإسلامية بسبب الإنحراف، أو غير ذلك من الأسباب.
إلا أن هذا التقييد، ولإن أمكن انطباقه على الرواية الأولى، ولكن من المتعذر
انظباقه على الباقي. للتصريح فيها بأنه: لا حاجة لي فيه أو لا أرب لي فيه... وهو
ظاهر بوضوح بأن رفض الصدقة ناشئ من الغنى زكثرة المال. وخاصة مثل قوله: لو جئتنا
بالأمس قبلتها، أما الآن فلا حاجة لي بها... باعتبار أنه كان بالأمس فقيراً وأما
اليوم، فهو غني.
وحيث نفترض بطلان كل هذه المحامل، يتعين كون المراد كثرة المال عند جميع أفراد
المجتمع المسلم خلال عصور الغيبة الكبرى.
صفحة (283)
ومعه ترد الاعتراضات التاليه
الاعتراض الأول:
إن هذه الأخبار معارضة بما دل على تفاقم الخطب وزيادة الشر كلما تقدم الزمان.
فمن ذلك: ما أخرجه البخاري(1) عن رسول الله (ص) أنه قال: أصبروا! فإنه لا يأتي
عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه. حتى تلقوا ربكم. والمراد بلقاء الله تعالى موت
الأفراد، لا حصول القيامة، لكي لا بشمل عصر ما بعد الظهور. ولو شمله الإطلاق، ان
مقيدأً بالأدلة القطعية الدالة على حصول الرفاه الحقيقي العادل يومئذ.
وعلى أي حال، فتفاقم الخطب، المستمر خلال عصر الغيبة الكبرى، ينافي حصول الرفاه
فيه.
الاعتراض الثاني:
إن هذه الأخبار – بشكل عام – منافية مع طبيعة الشياء، وفلسفة تسلسل الأمور من
أسبابها.
فإنه بعد الوضوح وكثرة الأخبار الدالة على وجود الانحراف والفتن والأمراء الكفرة
والوزراء الفسقة، وغير ذلك من الظواهر والحوادث التي سمعناها... كيف يمكن أن يكثر
المال ويعم الرفاه ويتعدد الإغنياء، إلى حد يصبح كل أفراد المجتمع المسلم من
الموسرين. فإن هذا مما لا يمكن أن يتمخض عند الإنحراف، وما لم تصل إليه أي من النظم
والقوانين الوضعية، لا يمكن وصولها إليه في المستقبل... ما لم ينزل القانون
الإسلامي العادل الكامل إلى حيز التنفيذ.
ومن الطريف الذي لم نفهم له وجهاً: أن رواية واحدة للبخاري تقرن بين عدد من الحوادث
السيئة المنحرفة وبين كثرة المال، حيث نراه يقول فيما يقول: وحتى يقبض العلم وتكثر
الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن، ويكثر الهرج وهو القتل. وحتى يكثر المال...
إلى أن يقول: وحتى يتطاول الناس في البنيان.
(1) أنظر الصحيح، جـ 9، ص 61 – 62.
صفحة (284)
وحتى يمرالرجل بقبر الرجل، فيقول: يا ليتني مكانه... الحديث(1).
واحتمال: أن ذلك باعتبار اختلاف الأزمنة، لا باعتبار زمان واحد، مناف لظاهر الخبر
باقتران الحوادث، ومناف مع ظاهر الأخبار الأخرى الدالة على بقاء الانحراف طيلة زمان
الغيبة الكبرى.
الاعتراض الثالث:
إن هذه الأخبار منافية ومعارضة مع ما دل على شيوع الفاقة وازدياد الفقر، كما سمعنا
في حديث ابن عباس... وهو الأنسب مع طبيعة تطور الحوادث، والأوفق مع سائر الروايات.
وعلى أي حال، فمع أخذ هذه الاعتراضات بنظر الاعتبار، تسقط هذه الروايات عن إمكان
الأخذ بها، وخاصة بعدما التزمناه من التشدد من التشدد السندي، حيث دلت القرائن على
نفيها وعدم حدوث ما دلت عليه. ومعه لا يبقى دليل على تحسين الوضع خلال عصر الغيبة
الكبرى. بل نبقى آخذين بالأقسام السابقة من الأخبار الدالة على حدوث الإنحراف
وتزايده خلال هذا العصر. وهو الموافق للوجدان وطبائع الأشياء.
نعم، حمل هذا القسم من الخبار، على أنها تتحدث عن عصر ما بعد الظهور... أمر ممكن.
وبه تخرج عن محل الاستدلال.
وبهذا ينتهي الكلام في الناحية الثانية من هذا القسم الثاني من هذا التاريخ. وبه
ينتهي هذا الفصل كله.
(1) أنظر الصحيح، جـ 9، ص 74.
صفحة (285)
الفصل الثالث
في التكليف الاسلامي خلال عصر الغيبة الكبرى
وما يقتضيه هذا التكليف من سلوك المستوى الفردي والاجتماعي ، وما يقتضيه من استعداد
نفسي وثقافي على كلا المستويين . وفض من يتبع هذا التكليف الاسلامي ، وحال من يعصيه
ويخرج عليه . وعرض ذلك انطلاقاً من القوعد العامة في الاسلام من ناحية ومن الأخبرا
الخاصة الواردة في هذا الصدد من ناحية أخرى .
ويقع الكلام في هذا الفصل ، ضمن عدة جهات ، بمقدار ما هو المطلوب من التكاليف في
الاسلام ، وما قد يترتب على ذلك من نتائج .
الجهة الأولى :
من التكاليف المطلوبة إسلامياً حال الغيبة : الاعتراف بالمهدي عليه السلام كإمام
مفترض الطاعة وقائد فعلي للأمة، وإن لم يكن عمله ظاهراً للعيان ، ولا شخصه معروفاً
.
وهذا من الضروريات الواضحات ، على المستوى الامامي ، للعقيدة الاسلامية ، الذي
أخذناه في هذا التاريخ أصلاً مسلماً وأجنا البرهان عليه إلى حلقات قادمة من هذه
الموسوعة .
فانه الامام الثاني عشر لقواعده الشعبية ، وهو المعصوم الطاعة الحي منذ ولادته إلى
زمان ظهوره . وقد عرفنا في تاريخ الغيبتين الصغرى والكبرى ، الأعداد الكبيرة من
الأخبار الدالة على ذلك ، وفلسفة دخله في التخطيط الالهي ومقدار تأثير الإمام عليه
السلام في العمل في صالح الأمة الاسلامية عموعاً ، وقواعد الشعبية خصوصاً . كما
عرفنا مقدار تأثير وجوده في رفع معنويات قواعده وتمحيص إخلاصهم وتحسين أعمالهم .
صفحة (287)
وحسب الفرد المسلم أن يعلم أن إمامه وقائده مطلع على أعماله وملم بأقواله ، يفرح
للتصرف الصالح ويأسف للسلوك المنحرف ، ويعضد الفرد عند الملمات ... حسب الفرد ذلك
لكي يعي موقفه ويحدد سلوكه تجاه إمامه ، وهو يعلم أنه يمثل العدل المخص وإن رضاه
رضاء الله ورسوله ، وإن غضبه غضب الله ورسوله.
كما أن حسب الفرد أن يعرف أن عمله الصالح ، وتصعيد درجة إخلاصه ، وتعميق شعوره
بالمسؤولية تجاه الاسلام والمسلمين ، يشارك في تأسيس شرط الظهور ويقرب اليوم
الموعود . إذن فـ(الجهاد الأكبر) لكل فرد تجاه تفسه يحمل المسؤولية الكبرى تجاه
العالم كله ، وملئه قسطاً وعدلاً كما ملئ ظلماً وجوراً . فكيف لا ينطلق الفرد
مجاهداً عاملاً في سبيل إصلاح نفسه وإرضاء ربه .
ومن ثم نرى النبي (ص) يؤسس أساس هذا الشعور في الرد المسلم ويقرن طاعة المهدي (ع)
بطاعته ومعرفته-على المستوى العملي التطبيقي – بمعرفته . فان معرفة النبي (ص) بصفته
حامل مشعل العدل إلى العالم ، لا يكون بالاعتراف التاريخي المجرد بوجوده ووجود
شريعته ، بل بالمواظبة التامة على الالتزام بتطبيق تعاليمه والأخذ بإرشاداته
وتوجيهاته ، وإلا كان الفرد منكراً للنبي (ص) على الحقيقة ، وإن كان معترفاً بوجوده
التاريخي .
وحيث أن أفضل السوك الاسلامي وأعدله إنما يتحقق تحت إشراف القائد الكبير المهدي (ع)
إذن تكون أحسن الطاعة لنبي الاسلام وأفضل تطبيقات شريعته ، هو ما كان بقيادة المهدي
(ع) وما بين سمعه وبصره . إذن صح أن معرفة المهدي (ع) – على المستوى السلوكي
التطبيقي – معرفة للنبي (ص) . وإنكاره على نفس المتسوى انكار له .
ومن ثم نسمع النبي (ص) يقول : من أنكر القائم من ولدي فقد أنكرني(1)
_______________________________
(1) انظر الاكمال المخطوط . ومنتخب الاثر ص 492.
صفحة (288)
ونراه يقول : القائم من ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي ، وشمائله شمائلي ، وسنته سنتي
. يقيم الناس على ملتي وشريعتي ، ويدعوهم إلى كتاب ربي عز وجل . من أطاعه فقد
أطاعني ، ومن عصاه فقد عصاني ، ومن أنكره في غيبته فقد أنكرني ، ومن كذبه فقد كذبني
، ومن صدقه فقد صدقني ... الحديث(1) . إلى غير ذلك من الأخبار الواردة بهذا المضمون
عنه (ص) وعن أثمة الهدى (ع) .
وهذا الكلام من النبي (ص) وإن كان منطبقاً على المعتقد الامامي في المهدي (ع) ، إلا
أنه بنفسه قابل للتطبيق على المعتقد العام لأهل السنة والجماعة في المهدي إذا
استطعنا الفاء فكرة الغيبة عن كلامه (ص) ، فانهم عندذ يتفقون مع الامامية في مضمون
الحديث جملة وتفصيلا . إذ من المقطوع به والمتسالم عليه بين سائر المسلمين أن
المهدي (ع) هو الرائد الأكبر في عصره لتطبيق الاسلام ، فهو يقيم الناس على ملة رسول
الله (ص) ويدعوهم إلى كتاب الله عز وجل . ومن الطبيعي مع اتحاد الاتجاه والأطروحة ،
أن تكون طاعة المهدي (ع) طاعة للنبي (ص) وعصيانه عصياناً له ، وتكذيبه تكذيباً له
وتصديقه تصديقاً له .
كما أنه من الحتم أن يكون انكار ظهور المهدي (ع) وقيامه بالسيف لاصلاح العالم ،
إنكاراً لرسالة النبي (ص) ورفضاً لجهوده الجبارة في بناء الاسلام ، كيف لا ...
وظهور المهدي (ع) هو الأمل الكبير لرسول الله (ص) في أن تسود شريعته في العالم ،
وتتكلل مساعيه وتضحياته بالنصر المبين . بعد أن لم تكن الشروط وافية والظروف مواتية
لحصول هذا النصر في عصره ، كما أوضحناه فيما سبق .
بل يكون إنكار المهدي (ع) في الحقيقة إنكاراص للغرض الأساسي من خلق البشرية والحكمة
الالهية من وراء ذلك، مما قد يؤدي إلى التعطيل الباطل في الاسلام .
________________________
(1) انظر الاكمال المخطوط : باب من انكر القائم.
صفحة (289)
فانه بعد أن برهنا أن الغرض من خلق البشرية هو إيجاد العبادة الكاملة في ربوع
المجتمع البشري بقيادة الإمام المهدي (ع) في اليوم الموعود ... إذن يكون إنكار
المهدي مؤدياً إلى نتيجة من عدة نتائج كلها باطلة كما يلي: النتيجة الأولى :
إن خلق البشرية ليس وراءه هدف ولا غاية . وهذا منفي بنص القرآن القائل : ﴿وما خلقت
الجن والانس إلا ليعبدون﴾ . وبالبرهان العقلي الفلسفي القائل بضرورة وجود العلة
الغائية والهدف ، من وراء كل فعل اختياري ، وبخاصة إذا كان الفاعل حكيماً لا
نهائياً ... رب العالمين .
النتيجة الثانية :
إن الغرض من الخليفة وإن كان موجوداً ، إلا أنه ليس هو إيجاد المجتمع الصالح العابد
، بل هو أمر آخر لا نعلمه !! . وهذا مخالف لنص القرآن وصريحه في الآية السابقة .
وخلاف ما تسالمت عليه الأديان السماوية من الايمان بمصير البشرية إلى الخير والعدل
في نهاية المطاف .
النتيجة الثالثة :
إن هذا الغرض الالهي وإن كان ثابتاً ، إلا أنه ليس من الضروري نزوله إلى حيز
التطبيق ، بل يمكن أن يبقى نظرياً على طول الخط .
وهذا من غرائب الكلام ، فان معنى ذلك تخلف الحكيم عن مقتضى حكمته ، ونقضه لغرضه ،
وهو مستحيل عقلاً ، كما ثبت في الفلسفة . وليس معنى تنفيذ هذا الغرض إلا إيجاده في
الخارج .
النتيجة الرابعة :
إن هذا الغرض ، يحدث في الخارج ، إلا أنه لا يحتاج إلى قائد ، بل يمكن أن يتسبب
الله تعالى إلى إيجاده تلقائياً ، ومعه لا حاجة إلى افتراض وجود المهدي (ع) .
وهذا لا معنى له ، لأنه يتضمن انكاراً لما اعترفت به الأديان كلها وتسالمت عليه من
وجود القائد في اليوم الموعود .مضافاً إلى أنه يتضمن أيضاً إنكاراً لطبيعة الأشياء
، فان الأمة بدون القائد ليست إلا أفراداً مشتتين مبعثرين ، لا يمكنهم أن يحفظوا أي
مصلحة تتعلق بالمجموع ، ما لم يرجع الأمر إلى الاستقطاب القيادي والتوجيه العام
المركزي ... وهذا واضحة في كل أمة على مدى التاريخ .
واحتمال : قيام المعجزة لايجاد هذا الغرض الأقصى ، بدون قائد ، فقد سبق أن عرضنا
فكرته وناقشناها .
صفحة (290)
النتيجة الخامسة :
إن تنفيذ هذا الغرض يحتاج إلى قائد ، ولكنه غير منحصر المهدي (ع) ، بل يستطيع أن
يقوم به الكثيرون .
وهذا زعم عجيب ، إذ لا نقصد بالمهدي (ع) إلا القائد المطبق للغرض الإلهي . بعد أن
غضضنا النظر عن الاعتقاد الإمامي بشخصه ، إذن فيكون إنكاره إنكاراً لتنفيذ ذلك
الغرض الأساسي كلياً . وأما من حيث قابلية القيادة ، وأنها هل تختص بشخص واحد أو هي
ممكنة للعديدين . فهذا ما سنعرض له في الكتاب الآتي من هذه الموسوعة .
إذن ، فيتعين الاعتراف بوجود المهدي (ع) منفذاً للغرض الالهي الكبير . ولا تختص
نتيجة هذا البرهان بالمسلمين، فضلاً عن الامامية منهم . وإنما هي واضحة على مستوى
كل الأديان السماية .
* * *
الجهة الثانية :
إن من التكاليف المطلوبة في عصر الغيبة : الانتظار .
وننطلق إلى الحديث عن ذلك ضمن عدة نقاط :
النقطة الأولى :
في مفهوم الانتظار .
إن المفهوم الاسلامي الواعي الصحيح للانتظار ، هو التوقع الدائم لتنفيذ الغرض
الالهي الكبير ، وحصول اليوم الموعود الذي تعيش فيه البشرية العدل الكامل بقيادة
وإشراف الإمام المهدي عليه السلام .
وهذا المعنى مفهوم إسلامي عام تشترك فيه المذاهب الكبرى في الاسلام ، إذ بعد إحراز
هذا الغرض الكبير وتواتر أخبار المهدي عن رسول الإسلام (ص) بنحو يحصل اليقين
بمدلولها وينقطع العذر عن انكاره أمام الله عز وجل . وبعد العلم باناطة تنفيذ ذلك
الغرض بإرادة الله تعالى وحده ، من دون أن يكون لغيره رأي في ذلك ، كما سبق . إذن
فمن المحتمل في كل يوم أن يقوم المهدي (ع) بحركته الكبرى لتطبيق ذلك الغرض ، لوضوح
احتمال تعلق إرادة الله تعالى به في أي وقت .
صفحة (291)
لا ينبغي أن تختلف في ذلك الأطروحة الامامية لفهم المهدي (ع) عن غيرها ... إذ على
تلك الأطروحة ، يأذن الله تعالى له بالظهور بعد الاختفاء ، وأما بناء على الأطروحة
الأخرى القائلة ، بان المهدي (ع) يولد في مستقبل الدهر ويقوم بالسيف ، فلاحتمال أن
يكون الآن مولوداً ، ويوشك أن يأمره الله تعالى بالظهور .
وهذا الاحتمال قائم في كل وقت . بل أن لمعنى الانتظار مفهوماً أعم من الإسلام وأقدم
. أما قدمه فلما ذكرناه من تبشر الأنبياء باليوم الموعود ، فالبشرية كانت ولا زالت
تنتظره ، وإن تحرفت شخصية القائد وعنوانه على ما ذكرناه . وستبقى تنتظره ما دام في
الدنيا ظلم وجور . وأما عمومه فباعتبار التزام سائر أهل الأديان السماوية به، مع غض
النظر عن الاسم .
وهذا بنفسه ، ما يجعل المسؤولية في عهدة كل مؤمن كل مؤمن بهذه الأديان ، وخاصة
المسلم منهم . في أن يهذب نفسه ويكملها ويصعد درجة اخلاصه وقوة إرادته ، لكي يوفر
لنفسه ولاخوانه في البشرية شرط الظهور في اليوم الموعود .
النقطة الثانية :
لا يكون الفرد على مستوى الانتظار المطلوب ، إلا بتوفر عناصر ثلاثة متقرنة :
عقائدية ونفسيةوسلوكية . ولولاها لا يبقى للانتظار أي معنى إيماني صحيح ، سوى
التعسف النفسي المبني على المنطق القائل : إذهب أنت وربك فقاتلا ، أنَّا ههنا
قاعدون ... المنتج لتمني الخير للبشرية من دون أي عمل إيجابي في سبيل ذلك .
العنصر الأول :
الجانب العقائدي ... ويتكون برهانياً من ثلاثة أمور :
الأمر الأول :
الاعتقاد بتعلق الغرض الالهي بإصلاح البشرية جميعاً ، وتنفيذ العدل المطلق فيها في
مستقبل الدهر . وان ما تعلق به الغرض الالهي والوعد الرباني في القرآن لا يمكن أن
يختلف . وقد سبق أن عرفنا برهانه .
صفحة (292)
الأمر الثاني :
الاعتقاد بأن القائد المظفر الرائد في ذلك اليوم الموعود ، هو الإمام المهدي (ع) ،
كما تواترت بذلك الأخبار عند الفريقين ، بل بلغت ما فوق حد التواتر . وقد علمنا أن
ذلك ضروري الثبوت .
الأمر الثالث :
الاعتقاد بأن المهدي القائد هو محمد بن الحسن العسكري (ع) ... الأمر الذي قامت
ضرورة المذهب الامامي . وقامت عليه الأعداد الضخمة من أخبارهم ... ووافقهم عليه
جملة من مفكري العامة وعلمائهم كابن عربي في الفتوحات المكية . والقندوزي في ينابيع
المودة والحمويني في فرائد السمطين ، والكنجي في البيان ...وغيرهم .
والمعتقدون بهذه الأمور ، وان كانوا على بعض الاختلافات ، إلا أننا ذكرنا في فصل
(التخطيط الالهي) ان الأمرني الأولين يرجعان إلى الثالث في نتائجهما وتطبيقاتهما ،
فيمكن الاعتقاد بها جميعاً بدون أي تناف أو اختلاف .
العنصر الثاني :
الجانب النفسي للانتظار . ويتكون من أمرين رئيسيين :
الأمر الأول :
الاستعداد الكامل لتطبيق الأطروحة العادلة الكاملة عليه ، كواحد من البشر ، على أقل
تقدير ، إن لم يكن من الدعاة اليها والمضحين في سبيلها .
الأمر الثاني :
توقع البدء بتطبيق الأطروحة العادلة الكاملة أو بزوغ فجر الظهور في أي وقت ... لما
قلناه من أنه منوط بإرادة الله تعالى ، بشكل لا يمكن لغيره التعيين أو التوقيت .
ومن المحتمل أن يشاء الله تعالى ذلك في أي وقت . مضافاً إلى الأخبار الدالة على
حصوله فجأة بغتة ، وسنروي طرفاً منها فيما يأتي .
وهذا الشعور يمكن أن يوجد في نفس الفرد المؤمن باليوم الموعود ، طبقاً لأي من
الأمور الثلاثة في العنصر الأول، وطبقاً لمجموعها أيضاً . ويكون شعوراً طيباً على
نفسه مرضياً لضميره ، باعتبار ما يتضمنه من شعور بالاخلاص تجاه نفسه ومجتمعه وأمته
... وهي الجهات التي سوف ينتشلها اليوم الموعود من المشاكل والظلم .
صفحة (293)
وإذا تم لدى الفرد الشعور بهذين الأمرين في نفسه ، فقد تم لديه العنصر الثاني ،
واستطاع أن يتقبل بسهولة ورحابة صدر العنصر الآتي .
العنصر الثالث :
الجانب السلوكي للانتظار .
ويتمثل بالالتزام الكامل بتطبيق الأحكام الالهية السارية في كل عنصر ، على سائر
علاقات الفرد وأفعاله وأقواله ، حتى يكون متبعاً للحق الكامل والهدى الصحيح ،
فيكتسب الارادة القوية والاخلاص الحقيقي الذي يؤهله للتشرف بتحمل طرف من مسؤوليات
اليوم الموعود .
وهذا السلوك ضروري وملزم لكل من يؤمن باليوم الموعود ، على أي من المستويات السابقة
، فضلاً عن مجموعها . وبخاصة المسلمين الذين قام البرهان لديهم بأن المهدي (ع) يطبق
أطروحته العادلة الكاملة متمثلة في أحكام دينهم الحنيف .
وأما المسلم الامامي الذي يعمل بأن قائده معاصر معه ، يراقب أعماله ويعرف أقواله ،
ويأسف لسوء تصرفه ... فهو مضافاً إلى وجوب اعداد نفسه لليوم الموعوم ، يجب أن يكون
على مستوى المسؤولية في حاضره أيضاً ، وفي كل أيام حياته ، لكي لا يكون عاصياً
لقائده متمرداً على تعاليمه . وهذا الاحساس نفسه ، يسرع بالفرد إلى النتيجة
المطلوبة ، وهو النجاح في التمحيص ، والاعداد لليوم الموعود .
وإذا كان الفرد على هذا المستوى الرفيع ، استطاع أن يحرز الخير ، على مستويات أربعة
.
المستوى الأول :
إحراز الخير لنفسه في دنياه وآخرته . أما في آخرته ، فباعتبار رضاء الله عز وجل .
وأما في دنياه ، فباعتبار أمرين : أحدهما : السلوك العادل الذي يتخذه الفرد
والمعاملة الصالحة والعلاقات الجيدة التي يعامل بها الآخرين . وثانيهما : أنه يصبح
على مستوى المسؤولية لتحمل مواجهة القيادة في اليوم الموعود ، إذا بزغ فجره .
صفحة (294)
المستوى الثاني :
إحراز الخير لأمته ، باعتبار أنه إذ يعد نفسه الاعداد الصالح ، فانه يشارك في تهيئة
شرط اليوم الموعود ، بمقدار تكليفه وقدرته ، فيكون قد تسبب إلى الخير كل الخير
لأمته .
المستوى الثالث :
إحراء الخير لا لأمته فحسب ، بل للبشرية جمعاء . فان الخير الناتج من إيجاد شرط
الظهور ، عام لكل البشر ، والمشاركة في إيجاده مشاركة في إيجاد العدل الكامل السائد
في اليوم الموعود .
وهذه المستويات الثلاثة ، مما تقتضيه العقائد الاسلامية العامة المشتركة بين سائر
المذاهب ... بل مما يقضيه الاعتراف باليوم الموعود ، في أي دين من الأديان .
المستوى الرابع :
إن الفرد بمساهمته في إيجاد شرط الظهور ، يساهم في إرضاء إمامه المهدي (ع) وجلب
الراحة إليه ... بالنسبة إلى الشعور بزيادة المؤمنين وقلة العاصين ، والمشاركة
الحقيقية في الإعداد للهدف الكبير .
وهذا المستوى خاص بالأطروحة الامامية لفهم المهدي (ع) .
فهذه هي الجهات الأساسية التي يجب أن يتخذها الفرد ، لكي يكون على المستوى الاسلامي
المطلوب للانتظار .
* * *
النقطة الثالثة :
في حث فكرة المهدي (ع) على العمل .
صفحة (295)
اتضح مما ذكرناه في النقطتين الاسبقتين ، وغيرهما ، ما هو الحق في الجواب على
الشبهة القائلة : بأن انتظار الإمام المهدي (ع) سبب للتكاسل عن الاصلاح وترك العمل
الاجتماعي ، وعدم معارضة الظلم والظالمين ، اعتماداً على اليوم الموعود والاصلاح
المنشود .
أو انطلاقاً من الاعتقاد بأن المهدي (ع) لا يظهر حتى تمتلئ الأرض ظلماً وجوراً ،
إذن فيجب الظلم والجور وترك العمل استعجالاً لظهور المهدي (ع) .
ويتم النظر في جواب هذه الشبهة على مستويات ثلاثة ، باعتبار أن الأوساط التي تمر
هذه الفكرة بين ظهرانيهم على ثلاثة أقسام رئيسية ، تتخذ عند كل واحد منهم طابعاً
معيناً ، ونتيجة خاصة تختلف عن الآخرين .
المستوى الأول :
أوساط المنكرين للمهدي (ع) على الأساس المادي ، أو ما يمت إليه بصلة .
أولئك الذي لا يجدون دليلاً على مدعاهم إلا بمجرد الاستبعاد والتشكيك ، فهم يحاولون
ان يقنعوا أنفسهم بما يدعون ولعلهم يستطيعون إبعاد المهدويين عن مهدويتهم وتشكيكهم
في معتقدهم !!.
ليت شعري : أن المادية سبق أن قالت : بأن الدين أفيون الشعوب ومخدرها .
فكيف بالاعتقاد بالمهدي الذي هو بعض فروعه .
وقد أجاب الالهيون : - ومعهم الحق – بأن الدين كان ولا يزال أساس الثورات
والمعارضات والمطالبة بإقامة الحق والعدل على مدى التاريخ ، وأكبر مثير للعواطف
الانسانية على طول الخط . ونظرة واحدة إلى تاريخ البشرية مع شيء من الموضوعية
والتجرد تثبت ذلك . وقد قلنا وسنقول في العقيدة المهدوية مثل ذلك على سيأتي عن قريب
.
المستوى الثاني :
أوساط المؤمنين بالمهدي (ع) الذين يتصفون بصفتين مهمتين :
الأولى : التقاعس عن العمل أساساً ، وتقديم المصلحة الخاصة على المصالح العامة
عموماً .
صفحة (296)
الثانية : إن المفاهيم الاسلامية تنطبع في أذهانهم بشكل ناقص وخاطئ ، بشكل تصلح
تبريراً للواقع الفاسد ، أكثر من أي شيء آخر . وتنطلق الشهبة في هذه الأوساط من
الاعتقاد الذي ذكرناه بأن المهدي (ع) لا يظهر حتى تمتلئ الأرض جوراً وظلماً ، كما
ورد في الحديث المتواتر عن النبي (ص) ، إذن يفهمون من ذلك : أنه يجب توفير الظلم
والجور ، وترك العمل ضده ، استعجالاً لظهور المهدي (ع) .
المستوى الثالث :
مستوى الأوساط التي تعتقد بأن العمل الاسلامي ضد الظلم والظالمين ، غير موثر بأي
حال .
وهؤلاء هم اليائسون الذين سيطرت هيبة الانحراف وهيمنة الظلم السائد في البشرية على
نفوسهم ، فاعتقدوا بعدم جدوى أي شيء من الاصلاح أو الأمر بالمعروف في هذا المجتمع
الفاسد . ومن ثم اضطروا إلى السكون وترك العمل ، انتظاراً لظهور المهدي (ع) ليكون
هو الرائد الأول في اصلاح العالم .
فهذه هي أهم الشبه التي تعيش في أذهان بعض المتسويات ، ويمكن أن نعتمد على معارفنا
السابقة في مناقشة هذه الأفكار . وذلك انطلاقاً من وجوه ثلاثة :
الوجه الأول :
إن مشاركة الفرد والمجتمع في إيجاد شرط الظهور ، لا يكون إلا بالعمل الجاد المنتج
لرفع درجة الاخلاص والشعور بالمسؤولية ، ليكون في إمكان المخلصين المشاركة في مهام
هداية العالم عند الظهور .
وقد عرفنا كيف وقع ذلك كقضية رئيسية في التخطيط الالهي لليوم الموعود ، وان عنصر
التمحيص والاختبار في ظروف العالم والانحراف ، هو العنصر الأكبر في إيجاده .
الوجه الثاني :
ما عرفناه من أن هيجب على الفرد أن يجعل نفسه على مستوى رضاء الامام المهدي (ع) قبل
ظهوره وبعده . ولن يكون كذلك إلا إذا كان متمثلاً للأحكام الاسلامية بدقة ، سواء ما
كان منها على المستوى الشخصي أو على المستوى الاجتماعي . ولن يحرز رضاء الامام
بطبيعة الحال، بالاقتصار على الجانب الشخصي من أحكام الاسلام، لأن في ذلك عصياناً
للأحكام الاجتماعية والاصلاحية . وهو ما لا يرضاه الله تعالى ولا رسوله ولا المهدي
.
صفحة (297)
إذن فالاعتقدا بوجود القائد الرائد ، باعث أي باعث على العمل الاجتماعي والاصلاحي .
ولا يكاد يوجد هذا الباعث بدون هذا الاعتقاد إلا بشكل ضئيل .
وأنما انصرف عموم الناس عن العمل نتيجة لتناسيهم قائدهم وتغافلهم عن مسؤولياتهم
تجاهه .
الوجه الثالث :
أننا لو غضضنا النظر – جدلاً – عن الوجهين السابقين ، وفرضنا أن الاعتقاد بوجود
المهدي (ع) ليس له أي أثر في الحث على العمل الاجتماعي المثمر . فهو – على أي حال-
ليس موجباً للمنع عنه والحث على تركه . فلو وجد هناك دافع آخر للعمل ، أمكن أن يؤثر
أثره بكل وضوح ، ويعمل عمله في العقول والقلوب المخلصة .
والسر في ذلك واضح على الصعيد الاسلامي ، كل الوضوع. باعتبار أن الأحكام الاسلامية
الموجودة في الكتاب والسنة ، كانت ولا زالت معروفة وسارية المفعول، ولا زال الناس
مسؤولين عن تطبيقها وامتثالها لك تفاصيلها . ومن الواضح أن الاعتقاد بوجود المهدي
(ع) لا يرفعها ولا يخصصها لضرورة الدين واجماع المسلمين . وليس على الفرد المسلم
الذي يريد الاطاعة والامتثال ، إلا أن يراجع الأحكام الاسلامية ليعرف ما فيها من
جوانب شخصية وجوانب عامة ... لكي يطبقها على حياته الخاصة والعامة ، ويباشر العمل
الاجتماعي العام طبقاً للتكليف الاسلامي بالجهاد أو الأمر بالمعروف أو النهي عن
المنكر أو مكافحة الظلم . وهذا لا ينافي بحال ، عمل الفرد على صعيد عام ، تارة أرى
فيما بعد الظهور ، لو حدث اليوم الموعود خلال حياته .
وأما الفرد الذي يسير في طريق الانحراف ، ويبيع دينه بدنياه ، ويقدم مصلحته الخاصة
وشهواته على كل اعتبار ، فهو من الطبيعي أن لا يكون الاعتقاد بالمهدي (ع) دافعاً له
على العمل ، بعد أن لم يكن الاعتقاد بالاسلام نفسه دافعاً له . وهذا تقصير في الفرد
وليس قصوراً في الفكرة كما هو واضح .
* * *
صفحة (298)
وأود أن أشير في هذا الصدد إلى ملاحظات ثلاث ، لعلها تلقي بعض الضوء على أهمية العم
لالاسلامي ، في عصر ما قبل الظهور :
الملاحظة الأولى :
أننا برهنا خلال عرضنا للتخطيط الإلهي : أن ما يرفع درجة الاخلاص في الأمة ويوجد
شرط الظهور ، هو العمل ضد الظلم فعلاً . ومعه ينبغي أن يمر الفرد فعلاً في ظروف
الظلم والانحراف ، لكي يعمل ضده ، حتى يتصاعد إخلاصه وتقوى إرادته .
ومن هنا نعرف أن الفرد الذي يهرب بنفسه من ظروف الظلم ، أو أن المجتمع الذي يعيش في
الرفاه النسبي بعيداً عن هذه الظروف. فانه لن يعمل ولن يستطيع الوصول إلى حد الوعي
والاخلاص المطلوب . ولو وصل إلى شيء، فإنما يصل إليه ببطء شديد ، ويكون ضحلاً
وقليلاً .
كما أن الأمة إذا شاع بين ظهرانيها الظلم والتعسف ،وكانت راضية به مستخذية تجاهه
،لا يوجد العمل فيها ضده، ولا التفكير لرفعه أو التخفيف منه .
إذن فسفو تكون أمة خائنة يتسافل إخلاصها وينمحي شعورها بالمسؤولية ، وتحتاج في
ولادة ذلك عندها من جديد إلى زمان مضاعف ودهر طويل و ﴿ إن الله لا يغير ما بقوم حتى
يغيروا ما بأنفسهم ﴾(1) . وليت شعري كيف يكون هؤلاء على مستوى إصلاح البشرية كلها
في اليوم الموعود،وهم قاصرون عن إصلاح مجتمعهم الصغير؟!!.
إذن فالتفكير الجدي والعمل هو الأساس لتصعيد درجة الاخلاص والشعور بالمسؤولية
والمران على الصمود والتضحية هو الشرط الأساسي لتكفل مهمة اليوم الموعود . فمن
السخف ما قيل : بأن الاعتقاد بوجود المهدي (ع) داعف على الاستخذاء وترك العمل .
الملاحظة الثانية :
إن تصعيد درجة الاخلاص ، قد يكون قائماً على أساس الاضطرار وقد يكون بالاختيار .
_________________
(1) الرعد 13/11 .
صفحة (299)
أما قيامه على أساس الاضطرار(1) ، فهو الأمر العام الذي يقتضيه التمحيص الالهي ،
بشك لرئيسي . فان الأفراد في حبهم لذاتهم وتفضيلهم للراحة ، لا يميلون-عادة- إلى
العمل الاجتماعي العام ، لما فيه من شعور بالجهد والمسؤولية .
ومن ثم فهم لا ينطلقون نحو إلا تحت وطأة من الاضطرار والشعور بالضغط والاحراج . ومن
ثم كان لابد في حملهم على العمل العام من إيكالهم إلى الظروف الصعبة الظالمة . ومن
ثم انعقد التخطيط الإلهي على حمل الأمة على العمل الاضطراري بهذا المعنى ، لأجل
تحقيق مصالحها الكبرى في يوم الظهور .
وأما قيام الاخلاص والوعي على أسشاس الاختيار ،فباندفاع المكلف إلى العمل أزيد من
مقدرا الاضطرار والاحراج، بمجرد شعوره بالمطلوبية الاسلامية له ،الزاماً أو
استحباباً ... بأ، يكون على الدوام معارضاً للظلم داعياً إلى الحق، هادياً إلى سبيل
ربه بالحكمة والموعظة الحسنة .
صحيح ، ان الاندفاع إلى ذلك ، يحتاج إلى درجة كبيرة من الوعي والاخلاص وقة الارادة
، لا يتوفر إلا للقليل ... إلا أنه –على أي حال-ليس هو المستوى المطلوب توفره في
المشاركة في قيادة العالم كله في يوم الظهور . وإنما يكون العمل الاختياري أو ما
نسميه بالتمحيص الاختياري مضافاً إلى التمحيص الاضطراري ، سبباً لإيجاد مثل هذا
المستوى الرفيع .
ومن الواضح ما لهذا التمحيص الاختياري ، من أثر بليغ في التصعيد السريع ، بشكل أعظم
بكثير مماينتجه التمحيص الاضطراري ... وفي التعجيل بإيجاد شرط الظهور ، بمقدار ما
تقتضيه الظروف الثقافية والفكرية التي يعيشها الفكر الاسلامي ، في أي عصر .
إذن ، فما قيمة هذه الشبهة التي تقول بأن الاعتقاد بالمهدي (ع) يمنع عن العمل
الاجتماعي الاصلاحي ، ولله في خلقه شؤون .
________________________
(1) لا ينبغي الخلط بني الاضطرار وبين الاكراه . فان الاضطرار يمثل حاجة مع انحفاظ
الارادة معها ، كمن يبيع دراه من أجل دين كبير عليه . والاكراه لا تنحفظ معه إرادة
كمن باع تحت وطأة التهديد بالقتل ، او تحت الضرب الشديد مثلاً . ولكل منهما
"اختيار" يقابله .
صفحة (300)
الملاحظة الثالثة:
في فهم الحديث النبوي.
أننا بعد أن عرفنا التخطيط الإلهي لليوم الموعود، نستطيع أن نفهم قوله (ص): يملأ
الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً.
فالظلم والجور، في عصر ما قبل الضهورن جزء من هذا التخطيط، لإيجاد الشرط االثاني
للظهور، وهو توفير قوة الإدارة والإخلاص في الأمة بشكل عام. وقد عرفنا أن هذا يحدث
في نسبة ضئيلة من اليشر، ويكون الباقي على مستوى الانحراف والفساد.
إذن، فالأرض تمتلىء ظلماً وجوراً، لكن لا بالجبر والإكراه، من قبل الله تعالى أو من
غيره، وإنما باعتبار انصراف الأعم الأغلب من الناس إلى مصالحهم واندحارهم تجاه تيار
الخوف والإغراء. وهو لا ينافي توفر شروط الظهور وترسخه في الناس، متمثلاً في تلك
النسبة الضئيلة عدداً الضخمة أهمية وإيماناً وإرادة.
وامتلاء الأرض ظلماً، أمر خارج عن اختيار الفرد بوجوده الشخصي، وإنما هو ناتج عن
الطبيعة البشرية بشكل عام، المتوفرة في المجتمع الناقص. ويكون تكليف الفرد إسلامياً
منحصراً شرعاً في تصعيد درجة إخلاصه وقوة إرداته، عن طريق مكافحة الظلم والعمل على
كفكفته ورفعه. ولكي يتوفر تدريجياً شرط الظهور.
وليت شعري، إن شرط الظهور، هو هذا المستوى اٌيماني، وليس هو كثرة الظلم وامتلاء
الأرض جوراً، كما يريد البعض أن يفكروا. لوضوح أن الأرض لو امتلأت تماماً بالظلم
وانعدم منها عنصر الإيمان، لما أمكن إصلاحها عن طريق القيادة العامة. بل يكون
منحصراً بالمعحزة التي برهنا على عدم وقوعها، أو إرسال نبوة جديدة، وهو خلاف ضرورة
الدين من أنه لا نبي بعد رسول الإسلام.
وإنما تتضمن فكرة اليوم الموعود، سيطرة الإيمان على الكفر، بعد سيطرة الكفر على
الإيمان... مع وجود كلا الجانبين. وهو قول الله تعال بالنسبة إلى المؤنين: ﴿
ليستخلفهم في الأرض وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً ﴾ وقوله (ص): يملأ الأرض قسطاً
وعدلاً، كما ملئت ظلماً وجوراً.
صفحة (301)
النقطة الرابعة:
للبحث عن الانتظار-: في اختلاف مفهومه باختلاف عصور الدعوة الإلهية.
سبق أن برهنا أن إيجاد اليوم الموعود، هو الغرض الأساسي من إيجاد البشرية... وقد
خطط الله تعالى لإيجاده منذ فجر الخليقة، ولازال هذا التخطيط سارياً إلى حين تحقق
نتيجته النهائية وغرضه الأصيل.
وقد كان انتظار البشرية لليوم الموعود، موجوداً، منذ بلغ الأنبياء السابقون عليهم
السلام البشرية عن وجوده... إلا أن الانتظار اكتسب صيغاً متعددة بتعدد أزمنة تطور
البشرية نحو ذلك الغد المنشود. فإن البشرية قد مرت – بهذا الاعتبار – بأربعة أو
مراحل:
المرحلة الأولى:
فترة ما قبل الإسلام. وقد كان الناس خلالهما يفهمون من كل نبي يبلغهم عن اليوم
الموعود، أمرين مقترنين: أولهما: الإهمال من التاريخ وإيكاله إلى إرادة الله تعالى
محضاً. وثانيهما: أن هذا النبي يبلغهم عنه، ليس هو القائد المذخور لهذه المهمة،
وإنما سيوجد في المستقبل البعيد شخص آخر يكون مطلعاً بها، وقائداً للبشرية من
خلالهما.
إذن، فالانتظار لم يكن حاملاً لنفس المفهوم الذي يحمله في عصر الغيبة الكبرى...
فبينما نرى أن صيغته الأخيرة هي: توقع حدوث اليوم الموعود في كل حين، على ما سبق...
نرى أن صيغته يومئذ كانت تتضمن العلم بعدم حدوثه السريع، والاكتفاء بالاعتقاد بأن
هذا مما سيحدث جزماً في المستقبل البعيد.
والناس في تلك العهود، وإن لم يكونوا ملتفتين إلى سر ذلك، إلا أننا عرفنا باطلاعنا
على تفاصيل التخطيط الإلهي. حيث عرفنا أم كلا شرطي اليوم الموعود، لم يكونا متوفرين
في تلك الفترة. فلم تكن البشرية على مستوى فم الأطروحة العادلة الكاملة من ناحية،
ولم تكن علة مستوى الإخلاص وقوة الإرادة المطلوب توفرها في قيادة اليوم الموعود.
صفحة (302)
المرحلة الثانية:
فترة ما بعد الإسلام إلى بدء الغيبة الصغرى... حيث كانت البشرية قد تلقت عن الله عز
وجل أطروحتها العادلة الكاملة. وبذلك توفر أحد الشرطين السابقين.
إلا أن معنى الانتظار لم يكن يختلف – مع ذلك – اختلافاً جوهرياً عما سبق. بمعنى أن
الأمل في ذلك الحين لم يكن منعقداً على حدوث اليوم الموعود بغتة وفي أي وقت. بل كان
المفهوم هو تحققه في المستقبل البعيد أيضاً. غاية الفرق عن المرحلة السابقة، هو
إحراز المسلمين: أن اليوم الموعود سوف يكون طبقاً لأطروحتهم ودينهم، دون غيره.
وهذا واضح جداً، لو لاحظنا طرق التبليغ عن ذلك اليوم من قبل النبي (ص) والأئمة
المعصومين (ع) بعده. أما بالنسبة إلى النبي (ص) فيكفينا اخباراته عن المهدي (ع)
وأنه من ولده وعترته وأنه من ذرية فاطمة عليه السلام، وأنه يوجد فيملأ الأرض قسطاً
وعدلاً، وأنه من ولد الحسين (ع) وإن صفته كذا وكذا... إذن فقائد اليوم الموعود ليس
هو شخص النبي (ص)، ولن يقوم النبي (ص) بهذه المهمة الكبرى، خلال حياته. كما عرفنا
فلسفة ذلك فيما سبق.
إذن فالانتظار في عهد النبي (ص) كان مقترناً باليقين بعدم حدوثه الفوري في ذلك
الحين.
ويبقى الانتظار في عصر الأئمة عليهم السلام، حاملاً لنفس هذا المفهوم. ويمكن أن
نستفيد ذلك من عدة أشكال من الأحاديث التي كانوا عليهم السلام يعلنون بها فكرة
المهدي (ع) أمام الناس.
كقولهم (ع) أن المهدي هو السابع من ولد الخامس منهم(1) أو قول الإمام الباقر عليه
السلام، والله ما أنا بصاحبكم. قال الراوي: فمن صاحبنا؟ قال: انظروا من تخفي على
الناس ولادته فهو صاحبكم(2). فهو إذ ينفي عن نفسه أنه المهدي (ع) نعرف أن اليوم
الموعود لن يتحقق ما دام في الحياة على أقل تقدير.
________________________
(1) أنظر مثلاً منتخب الأثر ص 212 . (2) أنظر إكمال الديم المخطوط.
صفحة(303)
وكقولهم: كيف أنتم إذا بقيتم بلا إمام ولا علم، يبرأ بعضكم من
بعض... الحديث(1). إذن فما دام أئمة الهدى عليهم السلام معروفين ومتصلين بالناس،
فالمهدي غير موجود، ومن ثم فهو لن يقوم بالسيف لإنجاز اليوم الموعود.
وكذلك إذا لاحظنا أخبار التمحيص، التي تنفي الظهور قبل مرور الناس بهذا القانون.
كقوله (ع): إن هذا الأمر ريأتيكم إلا بعد يأس. ولا والله حتى تميزوا. ولا والله حتى
تمحصوا، ولا والله لا يأتيكم حتى يشقى من يشقى ويسعد من يسعد. وقد سبق. إذن فاليوم
الموعود لن يتحقق ما دام الناس غير ممحصين.
وكذلك إذا لاحظنا الأخبار الدالة على حدوث علامات الظهور، مما لم يتحقق في عصر
الأئمة (ع) السابقين، كالصيحة والخسف، وغيرها مما سيأتي. فإنه ما لم توجد هذه
العلامات، لايظهر المهدي (ع)، على ما سوف نوضحه في القسم الثالث من هذا التاريخ.
إذن، فالمسلمون في زمن النبي (ص) والأئمة (ع) لم يكونوا ينتظرون ظهور المهدي (ع)
على الفور، وإن كانوا قد بلغوا بشكل أكيد وشديد عن ظهوره في مستقبل الزمان.
أقول: هذا من الناحية النظرية صحيح. إلا أننا نجد من الناحية العملية، أن هذه
الفكرة صادقة في زمن النبي (ص). وأما في زمن الأئمة (ع)، فلا تخلو هذه الفكرة من
إشكال.
فإننا نجد أن توقع ظهور المهدي (ع) في ذلك الزمن كان كبيراً. سواء في ذلك القواعد
الشعبية الامامية، أو غيرهم. أم غير الامامين فواضح طبقاً لفهمهم لفكرة المهدي (ع).
إذ أن ولادته وقيامه بدولة الحق، ممكن بعد النبي (ص) مباشرة فصاعداً.
وأما الاماميون، فقد دلت الأخبار على وجود هذا التوقع فيهم... بما فيها أخبار
التمحيص نفسها حيث يقول الإمام (ع) فيها: إن هذا الأمر لا يأتيكم إلا بعد يأس... أو
يقول: هيهات هيهات... لا يكون الذين تمدون إليه أعناقكم حتى تمحصوا(2) .
_________________
(1) نفس المصدر. (2) أنظر غيبة النعماني ص
صفحة (304)
وروي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ما تستعجلون بخروج القائم،
فوالله ما لباسه إلا الغليظ ولا طعامه إلا الجشب... الحديث(1).
وروي عن إبراهيم بن هليل قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك، مات أبي على
هذا الأمر، وقد بلغت من السنين ما قد ترى. أموت ولا تحبرني بشيء؟! فقال: يا أبا
إسحاق، أنت تعجل! فقلت: أي والله أعجل وما لي أعجل، وقد بلغت من السن ما قد ترى؟
فقال: يا أبا إسحاق ما يكون ذلك حتى تميزوا وتمحصوا وحتى لا يبقى فيكم إلا الأقل...
الحديث(2).
وهذه الأخبار واضحة جداً في اتوقع والانتظار الفوري، حتى أن أبا إسحاق لم يتصور أن
يكبر سنه ولما يظهر المهدي بعد.
وكذلك إذا نظرنا إلى الأخبار الدالة على وجود توقعات من الأئة (ع) بأشخاصهم بأن
يقوموا بدور المهدي (ع). كالخبر السابق عن الإمام الباقر (ع):والله ما أنا
بصاحبكم... الحديث. وما روي عن حمران بن أعين قال سألت أبا جعفر (ع) فقلت له: أنت
القائم؟... الحديث(3). وفي حديث آخر عنه قال قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام:
جعلت فداك أني قد دخلت المدينة وفي حقوقي هميان فيه ألف دينار، وقد أعطيت الله
عهداً أن أنفقها ببابك ديناراً ديناراً أو تجيبني فيما أسألك عنه. فقال: يا حمران
سل تجب ولاتبعض دنانيرك. فقلت: سألتك بقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وآلة، أنت
صاحب هذا الأمر والقائم به. قال: لا. قلت: فمن هو بأبي أنت وأمي. فقال: ذاك المشرب
حمرة... الحديث(4). وفي حديث آخر(5) عن الريان بن الصلت قال: قلت للرضا عليه
السلام: أنت صاحب هذا الأمر؟ فقال: أنا صاحب هذا الأمر ولكني لست بالذي أملؤها
عدلاً كما ملئت جوراً. وكيف أكون ذلك على ما ترى من ضعف بدني. وإن القائم هو الذي
إذا خرج كان في سن الشيوخ ومنظر الشبان... الحديث.
الى أحاديث أخرى من هذا القبيل.
_____________________
(1) غيبة النعماني ص 122.(2) نفس المصدر ص 111. (3) غيبة النعماني ص 115.
(4) المصدر ص 144 – 155.(5) إعلام الورى ص 407.
صفحة ( 305)
وكذلك إذا نظرنا إلى الخبر القائل: سئل أبو عبد الله عليه السلام: هل ولد القائم؟
فقال: لا. ولو أدركته لخدمته أيام حياتي(1).
إذا نظرنا إلى هذه الأخبار،نجد مفهوم الانتظار، ومزيد الاهتمام بظهور المهدي(ع)...
ناشئاً من سبب رئيسي واحد، هو إبهام فكرة المهدي في أذهانهم والجهل بتفاصيلها، حتى
أن حمران بن أعين والريان بن صلت، وهما من أحلة أصحاب الأئمة (ع) كانا لا يزالان لا
يعرفان من هو القائم على التعيين، وقد مضى من صدر الإسلام أكثر من مئة سنة.
وقد كانت لهذه الأحاديث وغيرها مما صدر من الإيضاحات والتفاصيل عن هذه الفكرة، من
الأئمة المعصومين عليهم السلام، أكبر الأثر في جلاء الفكرة لدى قواعدهم الشعبية
وارتفاع ابهامها تدريجاً، حتة اننا نرى الآن بوضوح طبقاً للتخطيط الإلهي أنه لم يكن
بالإمكان القيام بدور المهدي (ع) في ذلك العصر، لعدم توفر أحد شرائط الظهور. ومن ثم
لم يكن المهدي (ع) مولوداً، ولم يكن أحد من الأئمة السابقين هو المهدي القائم
بالأمر بأي حال.
وقد كان لهذا الإبهام، في غير الأوساط الامامية، أثراً سلبياً أحياناً، إذ فسح
المجال للعديدن في أن يستغلوا تبشير النبي (ص) بالمهدي (ع) فيدّعون المهدوية
لأنفسهم. ولا ننسى بهذا الصدد أن الرشيد العباسي لقب ولده بالمهدي، عسى أن يتوهم
الناس أنه المهدي المنتظر.
وقد سمعنا في تاريخ الغيبة الصغرى(2)، كيف أن جماعة القراطمة في الشرق الأدنى
وجمعاً غفيراً في الشمال الإفريقي قد آمنوا بمهدوية محمد بن عبيد الله العلوي جد
الفاطميين، الذين حكموا مصر بعد ذلك.
_____________________
(1) المصدر ص 129. (2) أنظر ص 353 وما بعدها.
صفحة (306)
المرحلة الثالثة:
- لعصور الانتظار-: عصر الغيبة الصغرى، لمن يؤمن بها، وهم القواعد الشعبية
الامامية.
وفيها – كما عرفنا في تاريخها – كان الإمام المهدي (ع) موجوداً يقود قواعده الشعبية
في الخفاء. ولاشك أن الناس كانوا ينتظرون ظهوره في أي وقت. باعتبار ما يحسونه من
ظلم ومطاردة وتعسف من قبل الحاكمين. وهم يعلمون علم اليقين بوجوده وإطلاعه على
الأوضاع الشاذة التي يعيشها المجتمع، ويعلمون أنه المذخور لإزالة الظلم من العالم
كله غافلين – بطبيعة الحال – عن اقتصاء التخطيط الإلهي تأجيل ذلك، لعدم توفر أحد
شرائط اليوم الموعود.
ولو دققنا النظر، لم نجد في رفع هذا الجو الفكري من الناس، مصلحة. بل كانت المصلحة
تقتضي إيكالهم إلى انتظارهم التلقائي الارتكازي، وعدم التعرض إلى تصحيحه أو تكذيبه.
لأنه على أي حال، يزيد من الربط العاطفي للقواعد الشعبية المهدوية، بإمامها
وقائدها. لوضوح أن الأمل فيه كلما كان أقوى كان هذا الارتباط أبلغ وأكبر.
بل أن هناك من الأخبار ما يدل على أن الإمام المهدي (ع) نفسه كان يذكي هذه العاطفة
ويؤكد قرب الظهور. وقد ذكرناها في تاريخ الغيبة الصغرى وناقشناها(1).
وقد يخطر في الذهن: أنه كان يمكن للناس في تلك الفترة، أن يطلعوا على الخبار الدالة
على توقف ظهور المهدي (ع) على التمحيص، أو الأخبار الدالة على حدوث علامات
الظهور... لكي يعرفوا أن الظهور لم يكن ليقع في تلك الفترة، بعد وضوح أن التمحيص لم
يكن حاصلاً، والعلامات لم تكن حادثة.
ويمكن أن يناقش ذلك بعدة أحوبة، أوضحها: أن الفرد الاعتيادي يحتمل تحقق التمحيص
المطلوب، في عصره، كما يحتمل حدوث علامات الظهور في المستقبل القريب. ومن ثم يحتمل
أنه لم يبق بينه وبين الظهور إلا زمن قصير. وهذا الاحتمال كاف في إذكاء أوراء الجو
النفسي والفكري للانتظار.
ـــــــــــــ
(1) أنظر ص 548 وما بعدها.
صفحة (307)
المرحلة الرابعة:
فترة الغيبة الكبرى، التي لا زلنا نعيشها.
وقد قلنا أن الانتظار فيها يحمل معنى توقع الظهور، وقيام اليوم الموعود في أي وقت
وفي كل يوم. لكونه منوطاً بإرادة الله تعالى لاغير. كما ورد في بان المهدي (ع) الذي
أعلن به انتهاء السفارة وبدء الغيبة الكبرى، حيث قال: فلا ظهور إلا بإذن الله تعالى
ذكره(1). ولما ورد أنه يوم الظهور يحدث فجأة أو بغتة، كلما سمعنا من مكاتبة المهدي
(ع) للشيخ المفيد. وغيرها من الروايات التي سوف نذكرها.
نعم يمكن أن تلاحظ أنه في فترة بدء الغيبة الكبرى، كان هناك من الدلائل على عدم
فورية الظهور، حيث نسمع من بيان انتهاء السفارة نفسه قوله عليه السلام: فقد وقعت
الغيبة التامة، فلا ظهور إلا بإذن الله تعالى ذكره. وذلك بعد طول الأمد وقسوة
القلوب... الحديث(2). وطول الأمد يستدعي مضي عدة سنوات، بل عدة عشرات، لا بد من
انتظار انتهائها، قبل توقع الظهور الفوري.
إلا أن مفهوم طول امد، يختلف باختلاف تصور الأفراد، ومقدار وعيهم العقلي والثقافي
والإيماني. فقد لا يحتاج حين يسمعه الفرد العادي لأول مرة أكثر من عدة سنوات،
وبخاصة من إناطة الظهرو بإذن الله تعالى مع ما يراه الفرد من قسوة القلوب فعلاً
وامتلاء الأرض جوراً. فكان في الإمكان – بحسب الجو النفسي السائد يومئذ – أن يبدأ
مفهوم الانتظار الفوري بعد عدة سنوات من تاريخ هذا البيان. ولم يكن أهل ذلك العصر
بحاجة إلى أن يدركوا أن المراد من طول الأمد ما يزيد على الألف عام بقليل أو بكثير،
كما ندركه الآن.
فإن قال قائل: إن الانتظار للظهور الفوري، ينافي ما جعل من علامات وشرائط للييوم
الموعود، فإنه لا يكون إلا عند حصول تلك الأمور. فالانتظار للظهور الفوري إنما يصح
بعد حصولها، وأنا قبل ذلك فينبغي أن يعود مفهوم الانتظار إلى الشكل الذي قلناه في
صدر الإسلام من العلم بحصول اليوم الموعود مع اليقين بعدم الظهور الفوري.
ـــــــــــــــ
(1) أنظر تاريخ الغيبة الصغرى ص 634، وغيبة الشيخ الطوسي ص 243. (2) نفس المصدرين
والصفحتين.
صفحة (308)
وهذا الإشكال مشابه لما أوردناه في المرحلة الثالثة: عصر الغيبة الصغرى. وجوابه نفس
الجواب، وملخصه: أن العلامات يحتمل وقوعها في أي وقت ويحتمل أن يتبعها ظهور المهدي
(ع) بزمان قصير. وأما شرائط الظهور، فيحتمل اكتمالها ونجازها في أي وقت أيضاً.
وقلنا بأن وجود هذا الاحتمال في نفس الفرد كاف في إيجاد الجو النفسي للانتظار
الفوري.
فإن قال قائل: بأن ما عرفناه شرطاً رئيسياً للظهور، مما هو غير متحقق لحد الان، هو
حصول التمحيص والامتحان للناس، ونحن نجد بالوجدان أن عدداً كبيراً من الناس إن لم
يكن جميعهم أو أكثرهم، غير ممحصين، ولاتصل نتائج اختباراتهم إلى نهايتها.
قلنا: أنه يمكن الجواب على ذلك بوجهين:
الوجه الأول:
إن هذا الكلام يتضمن جهلاً بمعنى التمحيص والاختبار، فإن المراد منه ليس هو تمحيص
الأفراد كأفراد خلال أعماهم القصيرة، لكي نتوقع أن يصل كل فرد خلال حياته إلى
النتائج النهائية للتمحيص.
بل المراد تمحيص الأمة أو البشرية في أمد طويل، بشكل منتج لتمحيص الأفراد، في نهابة
المطاف. ويتم ذلك عن طريق ما نسميه " بقانون الترابط بين الأجيال " فإن كل جيل سابق
يوصل ما يحمله من مستوى فكري وثقافي إلى الجيل الذي يليه. ويكون على الجيل الآخر،
أن يأخذ بهذا المستوى قدماً إلى الأمام. ثم أنه يعطي نتائجه إلى الجيل الذي بعده
وهكذا...
وكذلك الحال بالنسبة إلى نتائج التمحيص، فإن كل جيل يوصل إلى الجيل الذي يليه، ما
يحمله من مستوى في الإيمان والإخلاص... فيصبح الجيل الجديد، قد وصل بالتلقين إلى
نفس الدرجة – تقريباً – من التمحيص التي وصلها الجيل السابق. ثم أن الجيل الآخر
بدوره سيمر بتجارب وسيقوم بأعمال معينة وسيصادف ظروف الظلم والإغراء، فيتقدم في سلم
التمحيص درجة أخرى، وهذكا.
وبقانون تلازم الأجيالن سيأتي على الأمة زمان، يكون الجيل الذي فيها، قد انتج
التمحيص الإلهي فيه نتيجته المطلوبة. حيث ينقسم المجتمع إلى قسمين منفصلين: إلى من
فشل في التمحيص فاختار طريق الضلال محظاَ. وهم الأكثرالذين يملأون الأرض جوراً
وظلماً... وإلى من نجح فيه فاختار طريق الهداية والإخلاص محضاً. وبوجود هذه
المجموعة يتحقق شرط الظهور.
صفحة (309)
إذن، فكيف يمكننا أن ندعي العلم بعدم تمحيص أكثر الناس، كما قلناه في السؤال. مع أن
النتيجة المطلوبة حاصل في الأعم الأغلب منهم. وهذا واضح بالنسبة إلى كل البشر
الكفرة والمنحرفين، فإن التمحيص قد أنتج تطرفهم إلى جهة لضلال. كما أنه واضح
بالنسبة إلى عدد من المؤمنين المخلصين، حيث تطرفوا إلى جهة الهدى والإيمان. هذه هي
نتيجة التمحيص.
نعم، قد تتعلق الإرداة الإلهية، بتأكيد التمحيص وتشديده أكثر مما هو عليه الآن،
متوخية تعميق إخلاص المخلصين، لكي يكونوا بحق على المستوى المطلوب لقيادة العالم في
اليوم الموعود.
وعلى أي حال، فيبقى شرط الظهور محتمل الإنجاز في أي وقت، فلا يكون منافياً مع مفهوم
الانتظار الفوري.
الوجه الثاني: إن التمحيص الدقيق المأخوذ في التخطيط الإلهي، لايجب أن ينتج نتيجة
واضحة فعلية كاملة، بالنسبة إلى كل البشر وإنما اللازم هو ان يصل إلى هدفه، وهو
إيجاد شرط الظهور.
بيان ذلك: أن التمحيص يكون على مستويين:
المستوى الأول:
ما يكون من موقف كل فرد تجاه مصالحه وشهواته. وهذا التمحيص موجود بوجود البشرية
ووجود مفاهيم الحق والعدل والمعلنة بين الناس. ولا ينقطع إلا بانتهاء البشرية.
لايختلف في ذلك عصر الغيبة عن عصر الظهور. فإن عصر الظهور ينتج إيضاح الحق وسيطرته
على العالم. ولكنه لايقوم بتبديل الغرائز والشهوات.
المستوى الثاني: ما يكن من قبل الفرد تجاه تيارات الظلم واضطهاد الظالمين. وهو
تمحيص خاص بما قبل الظهور، لعدم وجود الظلم والظالمين بعده. وهذا هو العنصر المهم
الذي أسسه التخطيط الإلهي لتحقيق شرط الظهور.
صفحة (310)
وشرط الظهور لو كان هو حصول النتيجة في كل البشرن لكان حصولها ضرورياً قبل الظهور،
كما قال السائل... ولكن شرط الظهور ليس بهذه السعة، وإنما هو حصول عدد من ذوي
الإخلاص القوي والإرادة الماضية، بمقدار كاف لزو العالم والسيطرة على البشرية
بأطروحة الحق.
وحينما يحصل هذا المقدار من الناس، تكون نتيجة التمحيص الكاملة، قد تمخضت بالنسبة
إليهم، بإحرازهم درجة الإخلاص العليا. كما تكون قد تمخضت بالنسبة إلى آخرين في
التطرف نحو الإنحراف والفساد.
وأما البشر الآخرون، فلا مانع أن يصلوا إلى بعض درجات التمحيص ويقفوا. وتبقى
الدرجات العليا من مواقفهم وردود فعلهم غامضة غبر ممحصة. وهذا كما هو ثابت بالنسبة
إلى أغلب البشر قبل نهايات الغيبة، كذلك يمكن أن يكون ثابتاً بالنسبة إلى بعضهم عند
أول الظهور أيضاً.
ولكننا – بهذا الصدد – يجب أن نتذكر الدرجات الثلاث، للإخلاص، التي قلناها... ولكها
نتيجة للتمحيص وإن اختلفت مراتبها ومداليلها. وما قلناه قبل أسطر وإن كان صحيحاً في
درجة الإخلاص العليا، فإنه لايحصل إلا في عدد معين البشر، قد تشكل أكثر البشر في
الجيل المعاصر للظهور. ويكون الظهور بنفسه ظرفاً جديداً تتفتح فيه مواهب العديد من
الناس على النحو الموجه المطلوب. على ما سوف نسمع في التاريخ القادم.
وعلى أي حال، فمن المحتمل على الدوام وفي أي وقت، أن يكون العدد الطافي لغزو العالم
قد تحقق، وإن شرط الظهور قد توفر. فيكون الظهور عبلا هذا التقدير – فورياً أو
قريباً جداً. واحتمال تحقق الشرط كاف في احتمل فورية الظهور. ومعه يكون مفهوم
الانتظار الفوري، موجوداً خلال عصر الغيبة الكبرى.
* * *
صفحة (311)
الجهة الثالثة:
من التكاليف المطلوبة في عصر الغيبة الكبرى: الإلتزام بالتعاليم الإسلامية الحقة
النافذة المفعول فيما قبل الظهور.
وهذا من واضحات الشريعة، فإن مقتضى شمول تعاليمها وعمومها لكل الأجيال،وجوب إطاعتها
وتطبيقها على واقع الحياة في كل الأجيال. سواء ما كان على مستوى العقائد والمفاهيم،
لأو ما كان على مستوى الأحكام.
ويقابل هذا الوضوح احتمالان رئيسيان:
الاحتمال الأول:
أن ينجرف الفرد مع النيارات المعادية للإسلام، ويتبع عقائدها وأحكامها، ويعبرها
نافذة عليه، ويدع أوامر الإسلام ونواهيه، بل وعقائده في سبيلها.
وهذا النحو من السلوك واضح الفساد من وجهة نظر الإسلام. وحسبنا منه أنه مستلزم
للعصيان الإسلامي والرسوب في التمحيص الإلهي.
ومعنى فساد هذا الوجه، هو أن العقائد الوحيدة الصحيحة والأحكام الوحيد النافذة في
كل العصور، هي عقائد الإسلام وأحكامه. وأما ما يغزو المجتمع المسلم من عقائد غريبة
وأحكام وضعية، فلا تعتبر حقاً ولا واجبة الامتثال.
الاحتمال الثاني:
أن المهدي بعد ظهوره – على ما سنعرف في التاريخ القادم – سوف يصدر قوانين جديدة،
ويعطي للإسلام تفاصيل وتطبيقات جديدة. فقد يكون من المحتمل أن تكون تلك الأحكام
والقوانين سارية المفعول خلال الغيبة الكبرى أيضاً. مما ينتج أن يكون الاقتصار على
امتثال الأحكام السابقة على الظهور، غير كافية.
إلا أن هذا الاحتمال غير موجود البتة: لليقين بأمرين:
الأمر الأول:
إن أحكام ما بعد الظهور لن تكون ذات أثر (رجعي) بحيث تشمل الزمن السابق عليها.
فإن الإمام المهدي (ع) إنما يصدر قوانينه الجديدة بناء على مصالح وأسباب تتحقق بعد
الظهور، وليس لها في عصر الغيبة الكبرى عين ولا أثر.
صفحة (312)
الأمر الثاني:
أننا – على أي حال – نجهل تلك الأحكام بالمرة، والجهل بالحكم بهذا الشكل، سبب طاف
للمعذورية عن امتثاله أمام الله تعالى ورسوله (ص)، بحسب قواعد الإسلام.
إذن، فتكون الأحكام الإسلامية الصادرة المعلنة، منذ عصر الرسالة، نافذة المفعول،
بكل تفاصيلها وخصائصها،من دون معارض ولاناسخ، ويجب على الفرد إطاعتها وامتثالها.
وهو واضح من وجهة النر الإسلامية.
وهذا هو المراد من عدد من الأخبار على اختلاف مضانيها، تأمر المسلم بالبقاء على ما
كان عليه من عقيدة وتشريع... بالرغم من تيار الفن وشبهات الانحراف.
أخرج ابن ماجة(1) عن رسول الله (ص) أنه ذكر التكليف في عصر الفتن فقال: تأخذون بما
تعرفون وتعدون ما تنكرون. وتقبلون على خاصتكم وتذرون أمر عامتكم.
والمراد بهذا الحديث الشريف، بعد فهمه على أساس القواعد الإسلامية العامة... وهو
وجوب الأخذ بما قامت عليه الحجة من أحكام الإسلام أو عقائده. بمعنى أنه متى دل
الدليل الصحيح على كون شيء معين هو حكم إسلامي أو عقيدة إسلامية، وجب الأخذ به،
بمعنى لزوم العمل عليه إن كان حكماً ووجوب الاعتقاد به إن كان عقيدة. وأما ما كان
محالفاً لذل، فيجب رفضه واعتباره انحرافاً وفساداً.
وأما الذين يشخصون ذلك، ويفهمون ما هو الحكم الإسلامي من غيره، وما هو الدليل
الصحيح وما هو الفاسد، فليس هم العامة أو الجمهور الذين ينعقون مع كل ناعق يميلون
مع كل ريح... فإنهما – لا محالة – تؤثر فيهم موجات الانحراف وتغريهم المصالح
والشهوات. فيحب الاعراض عنهم كوجهين وقادة وأصحاب رأي. وإنما توكل هذه المهمة إلى
المختصين بالنظر إلى الأدلة الإسلامية واستنتاج الأحكام، والمفكرين الذين اتبعوا
أنفسهم في تحقيق وتدقيق العقائد والمفاهيم والأحكام.
ــــــــــــــ
(1) أنظر السنن ص 1308 جـ 2.
صفحة (313)
وبهذا بريد النبي (ص) أن يلفت نظر الفرد المسلم إلى وجوب الإلتفاف حول هؤلاء الخاصة
من العلماء الذين يطلعونه على الحق ويبعدونه عن الباطل، وينقذونه من تيار الفتن،
ويحرزون له النجاح في التمحيص الالهي الكبير.
ومثل هذا الحديث عدة أخبار، رواها الصدوق في إكمال الدين(1) عن أبي عبد الله الصادق
عليه السلام. ففي أحد الأخبار يقول (ع): إذا أصبحت وأمسيت لاترى إماماً تأتم به (
يعني عصر الغيبة الكبرى ) فأحبب من كنت تحب وأبغض من كنت تبغض، حتى يظهره الله عز
وجل.
وفي حديث آخر: تمسكوا بالأمر الأول حتى تستبين لكم. وفي حديث ثالث: فتمسكوا بما في
أيديكم حتى يتضح لكم الأمر. وفي حديث رابع: كونوا على ما أنتم عليه حتى يطلع عليكم
نجمكم (يشير إلى ظهور المهدي (ع)).
والأمر الأول الذي في اليد، هو أحكام الإسلام وعقائده الصحيحة النافذة المفعول في
هذه العصور. ومعنى التمسك به تطبيقه في واقع الحياة، سلوكاً وعقيدة ونظاماً.
وكل هذه الأخبار، تعم العقيدة والأحكام... ما عدا الخبر الأول منها، فإنه خاص
بالعقيدة. فإنه أمر الفرد المسلم بحب من كان يحب وبغض من كان يبغض. والحب والبغض
بالمعنى الإسلامي الواعي الدقيق، يتضمنان نقطتين رئيسيتين:
النقطة الأولى:
ويعتبر الفرد من يحبه مثالاً ومقتدى، بصفته ممثلاً كاملاً للسلوك الإسلامي والكمال
البشري. فيحاول الفرد جهد إمكانه أن يحذو حذوه ويقتفي خطاه. حيث لايمكن أن يصل إل
الكمال بدون ذلك.
وفي مقابلة من يبغضه الفرد المسلم من المنحرفين والمنافقين. فإنهم مثال للسوء
والظلم، يجب الابتعاد عنهم ومغايرة سلوكهم، لكي يمكن للفرد الحصول على الكامال
والسلوك الصحيح.
ـــــــــــ
(1) أنظر المصدر المخطوط
صفحة (314)
النقطة الثانية:
إذ يعتبر الفرد المسلم من يحبه مطاعاً في أقواله، واجب الامتثال في أحكامه. لأن
أحكامه هي أحكام الإسلام وأقواله تطبيقات لما يرضي الله عز وجل. إذن، فلا يمكن أن
يتحقق السلوك الصالح بدون ذلك.
فانظر إلى الجانب العقائدي، كيف يعيش في الحياة متمثلاً في السلوك الصالح ... وإنما
حصل التعرض إلى الجانب العقائدي في الأخبار، لا باعتبار اختلاف العقيدة الإسلامية
في زمن المهدي (ع). إذ من المعلوم أنه عليه السلام لا يغيّر العقائد والأحكام
الرئيسية في الإسلام. وإنما يتصرف فيما دون ذلك.
وعلى أي حال، فنحن الآن غير مسؤولين عن أحكام الهدي (ع) بل يكفينا الاعتقاد بما
عرفناه من الإسلام، وإيكال ما يحدث بعد الظهور إلى وقته.
ومن هنا نعرف نعرف أنه لماذا عبر في الخبر عن الأحكام الحالية بالأمر الأول أو ما
في اليد، وذلك: بمقايستها إلى أحكام ما بعد الظهور. وكذلك التعبير: بمن كنت تحب ومن
كنت تبغض. فإنه بمقايسة من يجب أأن يحبه ويطيعه من أولي الأمر الموجودين بعد
الظهور.
وأخرج الكليني في الكافي(1) والصدوق في إكمال الدين(2) والنعماني في الغيبة. عن
المفضل بن عمر عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، حين يسأله الرواي عن تكليفه في
زمان الغيبة(3) حين تكثر الفتن ودعاوي الضلال وتنتشر الشبهات. قال الرواي: فكيف
نصنع. قال: فنظر إلى شمس داخلة في الصفة. فقال: يا أبا عبد الله ترى هذه الشمس.
قلت: نعم. قال: زالله لأمرنا أبين من هذه الشمس.
(1) أنظر المصدر المخطوط. (2) أنظر المصدر المخطوط. (3) أنظر ص 77.
صفحة (315)
فالمطلوب إسلامياً، هو متابعة خط الأئمة (ع) الذين هم البقاء الأمثل للنبوة
والإسلام … باعتبار وضوح ما هم عليه من الحق ، كوضوح الشمس المشرقة ، وقيام الحجة
فيه على الخلق . فلا بد من التمسك به والسير عليه خلال الغيبة الكبرى ، لكي ينجو به
المسلم من الفتن ويبتعد عن مزالق الانحراف .
ولئن كان هذا الحديث مما لا يومن به إلا القواعد الشعبية الامامية ، فإن الأخبار
المتقدمة تعمهم وغيرهم من أبناء الإسلام .
* * *
الجهة الرابعة : هل المطلوب خلال الغيبة الكبرى ، إتخاذ مسلك السلبية والعزلة ، أو
المبادرة إلى الجهاد.
ويتم الكلام في هذه الجهة ضمن عدة نقاط :
النقطة الأولى : في محاولة فهم العنوان :
دلنا الوجدان والأخبار الخاصة والقواعد العامة ، على ما سمعنا ، على أن زمان الغيبة
الكبرى ، مستغرق بموجات الظلم والانحراف والفساد . فهل من وظيفة الفرد المسلم هو
السلبية والانعزال عن الأحداث ، وعدم وجوب إعلان المعارضة ومحاولة تقويم المعوج من
الأفراد والأوضاع . أو أن وظيفة الفرد في نظر الإسلام هو العمل الاجتماعي الفعال ،
والجهاد الناجز في سبيل الله ضد الظلم والطغيان .
دلت الآيات الكريمة بعمومها على وجوب الجهاد كقوله عز من قائل : ﴿ وأعدوا لهم ما
استطعتم من قوة ﴾ (1). وقوله : ﴿ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في
سبيل الله ، ولا يطؤن موطئاً يغيط الكفار ، ولا ينالون من عدو نيلاً ، إلا كتب لهم
به عمل صالح ، إن الله لا يضيع أجر المحسنين ﴾ (2) .
ودلت الغالبية العظمى من أخبار التنبؤ بالمستقبل على وجوب السلبية والانعزال . بحيث
استغرقت كل أخبار العامة تقريباً ، وأغلب أخبار الخاصة . ولم يكد يوجد من الروايات
الآمرة بالمبادرة إلى الجهاد والأخذ بزمام الإصلاح ، إلا النزر القليل . وسنعرض
لهذه الأخبار فيما يلي من البحث .
ــــــــــــــــــ
(1) الأنفال : 8 / 60. (2) التوبة 9 / 120 .
صفحة (316)
النقطة الثانية:
إذ يعتبر الفرد المسلم من يحبه مطاعاً في أقواله، واجب الامتثال في أحكامه. لأن
أحكامه هي أحكام الإسلام وأقواله تطبيقات لما يرضي الله عز وجل. إذن، فلا يمكن أن
يتحقق السلوك الصالح بدون ذلك.
فانظر إلى الجانب العقائدي، كيف يعيش في الحياة متمثلاً في السلوك الصالح ... وإنما
حصل التعرض إلى الجانب العقائدي في الأخبار، لا باعتبار اختلاف العقيدة الإسلامية
في زمن المهدي (ع). إذ من المعلوم أنه عليه السلام لا يغيّر العقائد والأحكام
الرئيسية في الإسلام. وإنما يتصرف فيما دون ذلك.
وعلى أي حال، فنحن الآن غير مسؤولين عن أحكام الهدي (ع) بل يكفينا الاعتقاد بما
عرفناه من الإسلام، وإيكال ما يحدث بعد الظهور إلى وقته.
ومن هنا نعرف نعرف أنه لماذا عبر في الخبر عن الأحكام الحالية بالأمر الأول أو ما
في اليد، وذلك: بمقايستها إلى أحكام ما بعد الظهور. وكذلك التعبير: بمن كنت تحب ومن
كنت تبغض. فإنه بمقايسة من يجب أأن يحبه ويطيعه من أولي الأمر الموجودين بعد
الظهور.
وأخرج الكليني في الكافي(1) والصدوق في إكمال الدين(2) والنعماني في الغيبة. عن
المفضل بن عمر عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، حين يسأله الرواي عن تكليفه في
زمان الغيبة(3) حين تكثر الفتن ودعاوي الضلال وتنتشر الشبهات. قال الرواي: فكيف
نصنع. قال: فنظر إلى شمس داخلة في الصفة. فقال: يا أبا عبد الله ترى هذه الشمس.
قلت: نعم. قال: زالله لأمرنا أبين من هذه الشمس.
(1) أنظر المصدر المخطوط. (2) أنظر المصدر المخطوط. (3) أنظر ص 77.
صفحة (315)
فالمطلوب إسلامياً، هو متابعة خط الأئمة (ع) الذين هم البقاء الأمثل للنبوة
والإسلام … باعتبار وضوح ما هم عليه من الحق ، كوضوح الشمس المشرقة ، وقيام الحجة
فيه على الخلق . فلا بد من التمسك به والسير عليه خلال الغيبة الكبرى ، لكي ينجو به
المسلم من الفتن ويبتعد عن مزالق الانحراف .
ولئن كان هذا الحديث مما لا يومن به إلا القواعد الشعبية الامامية ، فإن الأخبار
المتقدمة تعمهم وغيرهم من أبناء الإسلام .
* * *
الجهة الرابعة : هل المطلوب خلال الغيبة الكبرى ، إتخاذ مسلك السلبية والعزلة ، أو
المبادرة إلى الجهاد.
ويتم الكلام في هذه الجهة ضمن عدة نقاط :
النقطة الأولى : في محاولة فهم العنوان :
دلنا الوجدان والأخبار الخاصة والقواعد العامة ، على ما سمعنا ، على أن زمان الغيبة
الكبرى ، مستغرق بموجات الظلم والانحراف والفساد . فهل من وظيفة الفرد المسلم هو
السلبية والانعزال عن الأحداث ، وعدم وجوب إعلان المعارضة ومحاولة تقويم المعوج من
الأفراد والأوضاع . أو أن وظيفة الفرد في نظر الإسلام هو العمل الاجتماعي الفعال ،
والجهاد الناجز في سبيل الله ضد الظلم والطغيان .
دلت الآيات الكريمة بعمومها على وجوب الجهاد كقوله عز من قائل : ﴿ وأعدوا لهم ما
استطعتم من قوة ﴾ (1). وقوله : ﴿ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في
سبيل الله ، ولا يطؤن موطئاً يغيط الكفار ، ولا ينالون من عدو نيلاً ، إلا كتب لهم
به عمل صالح ، إن الله لا يضيع أجر المحسنين ﴾ (2) .
ودلت الغالبية العظمى من أخبار التنبؤ بالمستقبل على وجوب السلبية والانعزال . بحيث
استغرقت كل أخبار العامة تقريباً ، وأغلب أخبار الخاصة . ولم يكد يوجد من الروايات
الآمرة بالمبادرة إلى الجهاد والأخذ بزمام الإصلاح ، إلا النزر القليل . وسنعرض
لهذه الأخبار فيما يلي من البحث .
ــــــــــــــــــ
(1) الأنفال : 8 / 60. (2) التوبة 9 / 120 .
صفحة (316)
فأي الوظيفتين تقتضيها القواعد الإسلامية العامة . وهل تقتضي إحداهما على التعيين ،
أو تقتضي على الأمرين ، باختلاف الحالات . وكيف يمكن فهم هذه الاخبار على ضوء ذلك .
هذا لا بد من بحثه ابتداء بالقواعد العامة ، وانتهاء بالأخبار .
النقطة الثانية : فيما تقتضيه القواعد العامة :
ويمكن أن نعرض ذلك ، ضمن جانبين :
الجانب الأول :
في الأحكام الإسلامية ، على المستوى الفقهي للعمل الإجتماعي أو العزلة .
ينقسم العمل الإجتماعي الإسلامي المقصود به الهداية والإصلاح إلى وجهتين رئيسيتين :
أولاهما : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وثانيتهما : الجهاد أو الدعوة
الإسلامية . ولكل منهما مجاله الخاص وشرائطهما المعينة .
فالجهاد يتضمن في مفهومه الواعي ، العمل على ترسيخ أصل العقيدة الإسلامية ، إما
بنشرها ابتداءً أو الوقوف إلى جانبها دفاعاً ... بأعي عمل حاول الفرد أو المجتمع
الوصول إلى هذه النتائج ... سواء كان عملاً سليماً أو حربياً . وإن كان أوضح أفراده
وأكثرها عمقاًً ، هو الصدام المسلح بين المسلمين والآخرين .
وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،فمجاله هو الإطار الإصلاحي للمجتمع المسلم ،
مع انحفاظ أصل عقيدته. ومحاولة حفظه عن الإنحراف والتفكك وشيوع الفاحشة ونحو ذلك .
شرائطهما :
وشرائط الامر المعروف والنهي عن المنكر ، عديدة ، فيما ذكر الفقهاء ، تندرج في
أمرين رئيسيين :
الأمر الأول :
العلم بالمعروف والمنكر ، فلو لم يكن الفرد عالماً بالحكم الشرعي الإسلامي ، أو لم
يكن محرزاً بأن فعل الشخص الآخر معصية للحكم ... لم تكن هذه الوظيفة الإسلامية
واجبة .
الصفحة ( 317)
الأمر الثاني :
احتمال التأُير في الفرد الآخر . فلو لم يكن يحتمل أن يكون لقوله أثر ، لم يجب
القيام بالأمر والنهي ، فضلاً عما إذا احتمل قيام الآخر بالمعارضة والمجابهة أو
إيقاع الضرر البليغ .
ولذلك ورد عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه سئل عن الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر ، أواجب هو على الأمة جميعاً . فقال : لا . فقيل له : ولم ؟ قال : إنما هو
على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر . لا على الضعيف الذي لا يهتدي إلى أي
من أي . يقول من الحق إلى الباطل .والدليل على ذلك كتاب الله عز وجل . قوله : ﴿
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ﴾ . فهذا خاص
غير عام (1) .
وكذلك قوله عليه السلام : إنما يؤمر بالمعروف ويُنهى عن المنكر ، مؤمن فيتعظ أو
جاهل فيتعلم ، فأما صاحب سوط أو سيف ، فلا (2) .
وأما الجهاد فغير مشروط بهذه الشرائط . كيف وإن المفروض فيه التضحية ببذلك النفس
والنفيس في سبيل الله تعالى ومن أجل المصالح الإسلامية العليا .وقد أكد القرآن على
ذلك في العديد من آياته ،على ما سمعنا قبل قليل ... وفي قوله تعالى : ﴿ إن الله
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون
ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن .ومن أوفى بعهده من الله .
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم . التائبون العابدون
الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ،
والحافظون لحدود الله ، وبشر المؤمنين ﴾ (3) .
إذن ، فالجهاد فريضة كبرى لنشر الدعوة الالهية ، داخلة في التخطيط الالهي لهداية
الناس ، فيما قبل الإسلام وفي الإسلام ." في التوراة والانجيل والقرآن ". وإنما
يقوم به على طول الخط ، أولئك الصفوة ذوي الإخلاص الممحَّص والإيمان الرفيع ... "
التائبون العابدون الحامدون الراكعون الساجدون ... " .
ـــــــــــ
(1) وسائل الشيعة جـ 2 ص 533 . (2) المصدر ص 534 . (3) التوبة : 9 / 111 ـ 112 .
الصفحة (318)
وقد ورد عن رسول الله (ص)(1) أنه قال في كلام له : فمن ترك الجهاد ألبسه الله ذلاً
وفقراً في معيشته ومحقاً في دينه . أن الله أغنى أمتي بسنابك خيلها ومراكز رماحها "
أي بأسلحتها " .
وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ، أنه قال : أما بعد فإن الجهاد باب
من أبواب الجنة ، فتح الله لخاصة أوليائه ... إلى أن قال : هو لباس التقوى ، ودرع
الله الحصينة ، وجُنته الوثيقة . فمن تركه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء ،
وديِّث بالصغار والقماءة ، وضرب على قلبه بالأسداد ، وأديل الحق منه بتضييع الجهاد
، وسيم الخسف ومنع النصف ... الحديث .
وعن الصادق أبي عبد الله عليه السلام ، أنه قال : إن الله عز وجل بعث رسوله
بالإٍسلام إلى الناس عشر سنين ، فأبوا أن يقبلوا ، حتى أمره بالقتال . فالخير في
السيف وتحت السيف . والأمر يعود كما بدأ " يعني عند ظهور المهدي عليه السلام " .
إلا أن الجهاد على أهميته الكبرى في الإسلام ، مشروط بشرطين : الأول : خاص بجهاد
الدعوة المتعلق بنشر الإسلام في غير المسلمين . وهو تعلق أمر الولي العصوم به ،
كالنبي (ص) أو أحد المعصومين بعده ومنهم المهدي (ع) نفسه .
بخلاف جهاد الدفاع فإنه غير مشروط بذلك . بل يجب عند الحاجة على كل حال .
ولا يفرق في هذا الحكم بين أن يكون الجهاد دموياً أو لم يكن ... بل كان من قبيل
الجهاد التثقيفي الإسلامي .
الشرط الثاني : احتمال التأثير ، والوصول إلى النتيجة ،ولو في المدى البعيد .
فلو لم يحتمل الفرد أو المجتمع المجاهد الوصول إلى أي نتيجة أصلاً ... لم يجب
الجهاد .
(1) انظر هذا الحديث وما بعده في الوسائل جـ 2 ص 469 .
الصفحة (319)
وهذا الشرط واضح في الجهاد الدموي ، فإنه لا يكون واجباً مع قصور العدة والعدد .
قال الله تعالى : ﴿ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً . فإن يكن منكم مائة
صابرة يغلبوا مائتين ، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين ، بإذن الله ، والله مع
الصابرين ﴾ (1). وأما إذا كان الجيش المعادي أكثر من ضعف أفراد الجيش المسلم فلا
يجب الجهاد ، باعتبار أن احتمال النصر يكون ضئيلاً .
وأما الجهاد العقائدي التثقيفي ، فهو وإن كان مشروطاً باحتمال التأثير أيضاً ، فإنه
إن لم يكن التأثير محتملاً لم يكن هذا الجهاد واجباً ، إلا أن هذا إنما يتصور في
الفرد الواحد ، وأما في التثقيف العام للمجتمع ، فهو يقيني التأثير في الجملة ، على
عدد من الأفراد قليل أو كثير . فيكون واجباً ، مع توفر شرطه الأول .
فهذه هي وظائف العمل الإجتماعي في الإسلام من الناحية التشريعية الفقهية .
نتائجها :
نستطيع الوصول على ضوء ذلك ، إلى عدة فوائد ونتائج كبيرة . متمثلة في عدة أمور :
الأمر الأول :
إن الجهاد على طول الخط ، في تاريخ البشرية ، مقترون في منطق الدعوة الالهية ، بذوي
الإخلاص العالي الممحص ، فإنه ( باب فتحه الله لأوليائه ). لا بمعنى اختصاص وجوبه
بهم ، بل بمعنى أن الله تعالى لا يوجد شرائطه في العالم ، إلا في ظرف وجودهم ، بحسب
تخطيطه الكبير . فإن مهمة غزو العالم كله ، ونشر العدل المحض فيه ، مهمة كبرى لا
تقوم على اكتاف أحد سواهم ، وإلا كان مهدداً بخطر الفشل والدمار .
ولذا حارب النبي (ص) أعداءه وانتصر ،واستطاع أن يبلغ بالفتح الإسلامي مدى بعيداً في
الأرض .ولهذا ـ ايضاًـ فشل الفتح الإسلامي حين فقد خصائصه الرئيسية وتجرد الشعب
المسلم عما يجب أن يتحلى به من صفات . وبتلك الخصائص سوف يحارب المهدي (ع) وينتصر
على كل العالم .
(1) الأنفال : 8 / 66 .
صفحة (320)
ولكن ينبغي أن نحتفظ بفرق بين أصحاب النبي (ص) وأصحاب المهدي (ع) ، وقد أشرنا إليه
فيما سبق : وهو : أن النبي (ص) بُعث في شعب خام غير ممحص الإخلاص قبل ذلك على
الإطلاق ولا مر بأي تجربة لنشر العدل ولم يكن همه غير السلب والنهب من القبائل
المجاورة . ومن ثم كان المندفعون إلى الجهاد بين يديه (ص) ـ فيما عدا النوادر ـ
يمثلون الوهج العاطفي الإيماني وهيمنة القيادة النبوية عليهم ، أكثر مما يمثلون
استيعاب القضية الإسلامية من جميع أطرافها وخصائصها .
فلم يكونوا في الأعم الأغلب ، ممحصين ولا واعين ، بالدرجة المطلوبة لغزو العالم كله
... ولو كانوا على هذا المستوى لما بقي العالم إلى الآن يرزخ تحت نير الاستعباد .
ولكان النبي (ص) بنفسه هو المهدي الموعود ... كما أشرنا إليه في التخطط الالهي .
ومن ثم رأينا ان هيمنة القيادة النبوية ، حين انحسرت عن المجتمع ، بدأ الوهج
العاطفي بالخمود التدريجي . وإن كان قد بقي له من الزخم الثوري ما يبقيه مائتي عام
أخرى ، ينطلق من خلاله إلى منطقة ضخمة من العالم . إلا أن الفتح الإسلامي تحول
تدريجياً إلى مكسب تجاري (1) ، وفشل عن التقدم في نهاية المطاف .
وهذه النتائج المؤسفة ، يستحيل التوصل إليها ـ عادة ـ لو كان الجيش النبوي ممحصاً
وواعياً ، بحسب اتجاهات النفس البشرية وقوانين ترابط الأجيال .
والسر في ذلك ما سبق أن عرفناه ، من أن البشرية عند نزول الإسلام ، كانت مهيئة
للشرط الأول من شروط عالمية الدعوة الالهية ... دون الشرط الثاني ، وهو وجود العدد
الكافي من ذوي الإخلاص الممحص .
وأما المهدي (ع) فسوف يوجد الله تعالى هذا الشرط في أصحابه ، بعد أن تكون البشرية
قد مرت بالظروف القاسية التي تشارك في إيجاد هذا الشرط الكبير .
ومن ثم سوف يستطيع تطبيق الأطروحة العادلة الكاملة على العالم بأسره .
(1) فصلنا القول في ذلك في تاريخ الغيبة الصغرى ص 94 وما بعدها .
صفحة (321)
فإن قال قائل : يلزم من ذلك بأن أصحاب المهدي (ع) أفضل من أصحاب النبي (ص) .قلنا :
نعم ، الأمر كذلك على الأعم الأغلب . ولا حرج في ذلك . فإن أصحاب المهدي (ع) هم
أصحاب للنبي (ص) ومحاربين في سبيل دين النبي (ص) وعدله . وإنما القصور في البشرية
التي لم تكن مهيئة لنشر العدل العالمي قبل أن ينتج التخطيط الالهي نتيجته المطلوبة
، وهو إبجاد الشرط الأخير من شرائط الظهور .
الأمر الثاني :
إن الجهاد منوط على طول الخط ... بوجود القائد الكبير الذي له قابلية غزو العالم
ونشر العدل فيه . فما لم يتحقق ذلك لا يكون الجهاد واجباً . إلا فيما يكون من جهاد
الدفاع الذي لا يكون واجباً على الأمة وإن لم تكون ممحصة ولم تكن لها قيادة .
إلا أن هذا من قبيل الاستثناء لأجل الحفاظ على بيضة الإسلام وأصل وجوده . وقد أثبتت
غالب حوادث التاريخ فشل الأمة الإسلامية في حروف الدفاع حال فقدانها للقيادة والوعي
. ومن هنا وصل الأمر بنا إلى ما وصل إليه من سيطرة الأعداء ، حتى غزينا في عقر
دارنا وأخذ منا طعامنا وشرابنا و وفقد منا استقرارنا وأمننا .
وعلى أي حالة ، ففيما عدا ذلك ، يكون مقتضى القاعدة العامة ، هو إناطة وجوب الجهاد
بوجود القائد الذي له أهلية غزو العالم ونشر العدل فيه . ومن هنا كان وجوب الجهاد
حاصلاً في عصر النبي (ص) ، وكان مهدداً بالانقطاع التام بعده ، لولا أن القواد
المسلمين ، كانوا يحاربون بالوهج العاطفي الذي زرعه النبي (ص) . ومن ثم لم يكن
للفتح الإسلامي قابلية الاستمرار أكثر من زمان الوهج ، مع إنعدام التمحيص والقيادة
.
وهذه القيادة الكبرى ، هي التي سوف تتجسد في شخص المهدي (ع) ، فيبدأ نشر أطروحته في
العالم عن طريق الجهاد ، حتى يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً .
الأمر الثالث :
إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، غير منوط بوجود القيادة الكبرى ولا الإخلاص
الممحَّص ... بل هو مشروع بشكل يشمل الحالات الأخرى .
صفحة (322)
حيث نرى أنه لا يحتاج القيام بهذه المهمة الإسلامية إلا إلى معرفة الحكم الإسلامي
مع احتمال إطاعة العاصي وتأثره بالقول . وأما حاجته إلى تضحية مضاعفة أو وعي عالٍ
أو إخلاص ممحص ، فغير موجودة ... وهذا واضح .
بل أننا نستطيع أن نفهم من الشرط الذي أنيط به ، وهو توقف وجوبه على عدم الخوف
واحتمال الضرر ... وقد سمعنا قول الإمام الصادق عليه السلام : وأما صحاب سوط أو سيف
فلا . إن توقفه على ذلك مأخوذ خصيصاً بنظر الاعتبار لكي يواكب النفوس غير الواعية
وغير الممحصة ويكون شاملاً لها ، حتى إذا ما خافت الضرر ولم تستطع الصمود ، كان لها
في الشريعة المبرر الكافي للانسحاب .
وبهذا يحرز التشريع الإسلامي نتيجتين متساندتين :
النتيجة الأولى :
إن عدداً مهماً من أفراد الأمة ، في عصر التمحيص والامتحان ، يجب عليهم القيام بهذه
الوظيفة الإجتماعية الكبرى: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سواء كان التمحيص قد
أنتج فيهم الإخلاص العالي أو لم يكن . وبذلك يحرز الإسلام ـ على الصعيد التشريعي
على الأقل ـ حفظ المجتمع المسلم من الإنحدار إلى مهاوي الرذيلة والضلال .
النتيجة الثانية :
إن هذا العدد من أفراد الأمة يكونون ـ بمقتضى قانون التمحيص نفسه ـ واقفين على
المحك الأساسي للتمحيص ، من خلال قيامهم بهذه المهمة الإسلامية . فإن تركوها
وأحجموا عنها ، فقد فشلوا في الامتحان . وإن قاموا بها أوجب ذلك لهم تكامل الخبرة
والتدريب والتربية ، مما يسبب بدروه تحمل المسؤوليات الأكبر والأوسع ، ويضعهم على
طريق الإخلاص الممحص والوعي ، في نهاية المطاف .
صفحة (323)
الأمر الرابع :
إن نتائج ترك الجهاد أهم وأوسع من نتائج ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
ويكفينا في هذا الصدد ، أن نعرف الأمر على مستويين :
المستوى الأول :
إن الجهاد ... حيث أنه الوظيفة الإسلامية المشرّغى لغزو العالم غير
الإسلامي ، وإرجاع الأراضي الإسلامية السليبة ، فهو أوسع تطبيقاً من الأمر بالمعروف
الذي لا حدود له إلا ما كان داخل المجتمع الإسلامي من إنحراف وعصيان .
ومن هنا يكون ترك الجهاد موجباً لسلب الأمة نتائج أضخم ومكاسب أكبر من النتائج
والمكاسب المترتبة على الأمر بالمعروف ، كما هو واضح .
المستوى الثاني :
إن الأمر بالمعروف بمنزلة الفرع أو النتيجة أو المسبب عن الجهاد ... وتركه بمنزلة
السبب لوجوبه .
وذلك : أنه لا يجب الأمر بالمعروف في منطقة من العالم ، إلا إذا كانت داخلة ضمن
حدود البلاد الإسلامية ، فلا بد أن تكون المنطقة قد دخلت في ضمن هذه الحدود أولاً ،
ليجب فيها القيام بتلك الوظيفة ثانياً . والغالب أن يكون دخول البلاد إلى حوزة
الإسلام ، بالجهاد المسلح . فيكون الجهاد مقدمة لوجوب الأمر بالمعروف ويكون الأمر
بالمعروف نتيجة له . حيث تكفلت الوظيفة الإسلامية ، الأولى استاع بلاد الإسلام .
وتكفلت الوظيفة الثانية المحافظة على هذه السعة وضمان تطبيق العدل في البلاد
المفتوحة الإسلامية .
وأما إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في البلاد الإسلامية ... فستبدأ
بالإنحدار من حيث الإخلاص والشعور بالمسؤولية ، حتى ينتهي بها الحال أن تغزي في عقر
دارها وتكون لقمة سائغة لكل طامع وغاصب . كما قال الإمام الرضا (ع) فيما روي عنه
(1): لتأمرون بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليستعملن عليهم شراركم(2). فيدعوا
خياركم فلا يستجاب لهم . ويتسبب ذلك أحياناً إلى المنطقة الإسلامية بيد القوات
الكافرة المستعمرة ، كما حصل في الأندلس وفلسطين .... فيعود الجهاد واجباً
لاسترجاعها .فقد أصبح ترك الأمر بالمعروف سبباً لوجوب الجهاد .
ـــــــــــــــــــ
(1) أنظر الوسائل جـ 2 ص 532 وأنظر نحوه في الترمذي جـ 3 ص 317 ، مروياً عن النبي
(ص) .(2 يعني يباشرون الحكم فيكم .
صفحة (324)
الأمر الخامس :
نعرف من ذلك كله ، متى تكون العزلة والسلبية واجبة ، ومتى تكون جائزة ومتى تكون
محرمة ، بحسب المستوى الفقهي الإسلامي.
فإن العزلة والسلبية ، مفهوم يحمل معنى عدم القيام بالفعاليات الإجتماعية الإسلامية
من الجهاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . فمن هنا تكون العزلة الإسلامية من
الجهاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن هنا تكون العزلة محرمة حين يكون
ذلك واجباً ، وتكون واجبة حين يكون ذلك حراماً على بعض الوجوه التي نذكرها فيما يلي
. وتكون العزلة جائزة إن لم يكن في العمل الإسلامي موجب الوجوب والتحريم .
حرمة السلبية :
فحرمة السلبية ، إنما تتأنى من وجوب المبادرة إلى ميادين العمل الإسلامي ...
أما بالقيام بالجهاد على مستوييه : المسلح وغير المسلح ، مع اجتماع شرائطه . وأما
بالقيام بالأمر بالمعروف ومحاولاً الاصلاح في المجتمع الإسلامي ، على مستوييه
المسلح وغيره ، عند اجتماع شرائطه ... وخاصة غير المسلح منه ، الذي هو الأعم الأغلب
منه .
وعلى أي حال ، فإذا وجب العمل الإسلامي حرمت العزلة ، وكانت عصيانا وانحرافاً
إسلامياً خطيراً . وتكتسب أهميتها المضادة للإسلام ، بمقدار أهمية العمل الإسلامي
المتروك .
ومن ثم كان ترك الجهاد عند وجوبه ، والفرار من الزحف من أكبر المحرمات في الإسلام
...طبقاً لقوله تعالى: ﴿ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة
،فقد باء بغضب من الله،ومأواه جهنم وبئس المصير﴾ (1) . كما أن ترك الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر عند وجوبه حرام إسلامياً ، مؤذن بالعقاب ، كما ورد عن النبي (ص) :
إذا أمتي تواكلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فليأذنوا بوقاع من الله . وعنه
(ص) أنه قال : لا تزال أمتي بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على
البر ، فإذا لم يفعلوا ذلك ، نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض ، ولم يكن لهم
ناصر في الأرض ولا في السماء . ومعنى أنه لا ناصر لهم في السماء : ان الله تعالى لا
يرضى بفعلهم ولا يقره .
ــــــــــــــــ
(1) الانفال : 8 / 16 .
صفحة (325)