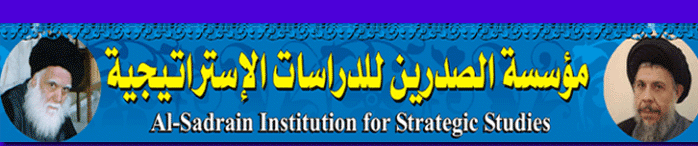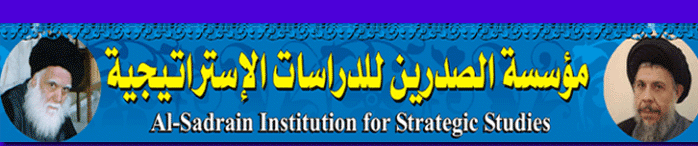الأطروحة الثانية :
أننا إذا غضضنا النظر عن الأطروحة الأولى ، وقلنا أن الإمام مؤهل طبيعياً لقيادة
العالم من دون أي عنصر ميتافيزيقي . وكنا ملتزمين – كما هو الحق – بالأطروحة
الرئيسية الثانية : أطروحة خفاء العنوان ...
إذن يثبت أن المهدي (ع) يعيش في المجتمع بشخصيته الثانية ، يتصل بالناس ويتكلم معهم
ويفحص عن أخبارهم . من دون أن يخطر في بال أحد أنه هو المهدي المنتظر (ع) . بل قد
يستطيع أن يخطط لاستقصاء تفاصيل الأخبار من سائر بلدان العالم وزواياه !
الأطروحة الثالثة :
إذا غضضنا النظر عما في الأطروحة الأولى من ثبوت الإلهام للإمام ، وعما في الأطروحة
الثانية من معيشته وسكناه في صميم المجتمع . وأخذنا بما دل عليه هذا الخطاب ,ودلت
عليه رواية ابن مهزيار ،من بُعد المهدي (ع)، عن المجتمعات ، وانفراده في السكنى
بعيداً عن الناس .
إذن ، فمن الممكن للمهدي (ع) أن يعرف أخبار الناس عن طريق خاصته الذين يرونه
ويعرفونه ،وهم في كل جيل، ثلاثون أو أكثر ، فيخطط عن طريقهم للاطلاع على أخبار أي
مجتمع في العالم شاء .
وهذه الأطروحة تناسب مع كلا الأطروحتين الرئيسيتين . أما مناسبتها مع أطروحة خفاء
العنوان فواضحة ، إذ يفترض – بعد كل ما سلف – أن المهدي (ع) ظاهر بالشخص ولكنه غير
معروف الحقيقة ، وهو منعزل عن المجتمعات والجماعات ، لا يعرفه ولا يتصل به إلا
خاصته . ومعه فيمكن للمهدي (ع) الحصول على الأخبار عن طريق هؤلاء الخاصة ، أو عن
طريق وروده المجتمعات .
صفحة (151)
أحياناً بدون أن يكون ملفتاً للنظر أو مثيراً للانتباه ، ليستطلع من الأخبار ما
يشاء أو يحادث من يريد كما يريد ، ثم يرجع إلى مسكنه متى أراد .
وأما مناسبة هذه الأطروحة ، مع أطروحة خفاء الشخص ، فلعدم اختفائه الشخصي عن خاصته
، وإن كان مختفياً عن سائر الناس . ومن الواضح أن خاصته غير مختفين عن الناس ،
فيكونون هم همزة الوصل بين الناس وبينه ، في نقل أخبارهم إليه ، ونقل أخباره إليهم
إذا لزم الأمر .
وعلى أي حال ، فكل واحدة من هذه الأطروحات الثلاث ، تبرهن إمكان أن يكون المهدي (ع)
حال غيبته على مستوى الأحداث الاجتماعية ومواكبتها خبراً خبراً . وللقارئ أن يختار
أياً من هذه الأطروحات شاء ، وإن كنت أعتقد بصعوبة التصديق بالأطروحة الثالثة
باستقلالها ، لابتنائها على تنازلات غير صحيحة ، وغض النظر عن أمور واقعية .
النقطة الخامسة :
إن المهدي عليه السلام ، لمدى لطفه بنا ، وشعوره بالمسؤولية تجاهنا ،هو غير مهمل
لمراعاتنا ولا ناس لذكرنا، ولولا ذلك لنزل بناء الأواء – وهو الشر – واطلمنا
الأعداء ، أي استأصلونا وأبادونا . فجزاه الله عنا خير جزاء المحسنين .
فمن هنا يظهر بوضوح ، ما للمهدي عليه السلام من تأثير كبير في صلاح حال قواعده
الشعبية وراحتهم وأمانهم ، بالمقدار الممكن له في غيبته . بل أنهم لمدينون له
بالحياة ، إذ لولا أياديه الفاضلة ومساعيه الكاملة ، لما بقي لقواعده الشعبية وجود
، ولأبيدوا عن آخرهم تحت ضربات الأعداء المهاجمين ، وما أكثرهم في كل جيل .
وهذا التأثير من قبل المهدي (ع) يعتبر من أهم مسؤولياته الإسلامية حال غيبته ، كما
عرفنا .
وهذا التأثير يكون واضحاً جداً بناء على الأخذ بأطروحة خفاء العنوان ، سواء قلنا
بأن المهدي (ع) يعيش في المجتمعات أو قلنا أنه يعيش خارجاً عنها ... إذ على أي حال
يستطيع القيام بالعمل المناسب عند الحاجة ، أما بنفسه أو بواسطة خاصته ، بالشكل
الذي يستطيع به أن يحول بين الشر وبين وقوعه .
أحياناً بدون أن يكون ملفتاً للنظر أو مثيراً للانتباه ، ليستطلع من الأخبار ما
يشاء أو يحادث من يريد كما يريد ، ثم يرجع إلى مسكنه متى أراد .
وأما مناسبة هذه الأطروحة ، مع أطروحة خفاء الشخص ، فلعدم اختفائه الشخصي عن خاصته
، وإن كان مختفياً عن سائر الناس . ومن الواضح أن خاصته غير مختفين عن الناس ،
فيكونون هم همزة الوصل بين الناس وبينه ، في نقل أخبارهم إليه ، ونقل أخباره إليهم
إذا لزم الأمر .
وعلى أي حال ، فكل واحدة من هذه الأطروحات الثلاث ، تبرهن إمكان أن يكون المهدي (ع)
حال غيبته على مستوى الأحداث الاجتماعية ومواكبتها خبراً خبراً . وللقارئ أن يختار
أياً من هذه الأطروحات شاء ، وإن كنت أعتقد بصعوبة التصديق بالأطروحة الثالثة
باستقلالها ، لابتنائها على تنازلات غير صحيحة ، وغض النظر عن أمور واقعية .
النقطة الخامسة :
إن المهدي عليه السلام ، لمدى لطفه بنا ، وشعوره بالمسؤولية تجاهنا ، هو غير مهمل
لمراعاتنا ولا ناس لذكرنا، ولولا ذلك لنزل بناء الأواء – وهو الشر – واطلمنا
الأعداء ، أي استأصلونا وأبادونا . فجزاه الله عنا خير جزاء المحسنين .
فمن هنا يظهر بوضوح ، ما للمهدي عليه السلام من تأثير كبير في صلاح حال قواعده
الشعبية وراحتهم وأمانهم ، بالمقدار الممكن له في غيبته . بل أنهم لمدينون له
بالحياة ، إذ لولا أياديه الفاضلة ومساعيه الكاملة ، لما بقي لقواعده الشعبية وجود
، ولأبيدوا عن آخرهم تحت ضربات الأعداء المهاجمين ، وما أكثرهم في كل جيل .
وهذا التأثير من قبل المهدي (ع) يعتبر من أهم مسؤولياته الإسلامية حال غيبته ، كما
عرفنا .
وهذا التأثير يكون واضحاً جداً بناء على الأخذ بأطروحة خفاء العنوان ، سواء قلنا
بأن المهدي (ع) يعيش في المجتمعات أو قلنا أنه يعيش خارجاً عنها ... إذ على أي حال
يستطيع القيام بالعمل المناسب عند الحاجة ، أما بنفسه أو بواسطة خاصته ، بالشكل
الذي يستطيع به أن يحول بين الشر وبين وقوعه .
صفحة (152)
وأما لو أخذنا بأطروحة خفاء الشخص ، فيكون تأثيره في خير المجتمع المسلم – مع غض
النظر عن الافتراضات الفلسفية أو العرفانية – محتاجاً إلى تفسير لمنافاة خفاء الشخص
مع الاختلاط بين الناس ، كما هو واضح . ويمكن الانطلاق إلى ذلك من أحد طرق :
الطريق الأول :
الدعاء . فإن الدعاء المستجاب عمل اجتماعي صحيح ، كما سبق أن عرفنا .
الطريق الثاني :
العمل بواسطة خاصته الذين يرونه ويعرفونه ،ويراهم الناس ويعرفونهم ،وإن جهلوا حقيقة
وساطتهم للمهدي (ع).
الطريق الثالث :
عمله شخصياً بين الناس ، مع افتراض ارتفاع خفاء الشخص عند الحاجة إلى العمل . فيعود
خفي العنوان، إلى حين انتفاء العمل .
النقطة السادسة :
قوله : فاتقوا الله جل جلاله ، وظاهرونا على انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم ،
يهلك فيها من حم أجله ويحمى عنها من أدرك أمله
أمرهم بتقوى الله سبحانه ، ومظاهرته – أي المهدي نفسه – بمعنى معاونته على انتياشهم
أي إخراجهم وإنقاذهم من فتنة قد أنافت أي أشرفت عليهم . يهلك فيها من حم أجله ،
يعني حل قوت موته ، ويحمي فيها من أدرك أمله ، وهو البقاء في الحياة .
وليست هذه الفتنة التي توجب الهلاك ، إلا ما كان يقع من حوادث دامية مؤسفة بين أهل
المذاهب الإسلامية.
وإن من أهم المهام التي يستهدفها المهدي (ع) الحيلولة دون وقوع هذا الشر ودفع هذا
العداء ، ولذا نسمعه يأمر قواعده الشعبية بأن يعينوه في إنجاز عمله وإيصاله إلى
نتيجته وأخذهم بزمام المبادرة إلى القيام بما توجبه عليهم مسؤوليتهم من سلوك وما
تقتضيه التعاليم من أعمال ، حتى ينجوا من الهلكة ومن الدخول في هذه الفتنة .
صفحة (153)
النقطة السابعة :
قوله : اعتصموا بالتقية . من شب نار الجاهلية ، يحششها عصب أموية ، يهول بها فرقة
مهدية(1) .
وهذا هو المنهج الذي يخطط المهدي (ع) للتخلص من هذه الفتنة ، وهو مكون من فقرتين :
الفقرة الأولى :
الالتزام بالتقية ، بمعنى الاحتياط للأمر واتقاء وقوع الفتن والشر . ومن أهم
أساليبه عدم مجابهة أهل المذاهب الإسلامية الأخرى بما يغيضهم ويثير حفيظتهم ، حرصاً
على جمع كلمة المسلمين ، وسيادة الأمن في ربوع مجتمعهم .
وليس الأمر بالتقية جديداً أو مستحدثاً منه عليه السلام ، بعد أن كان قد ورد عن
آبائه المعصومين عليهم السلام التأكيد عليه . كقولهم (ع) : التقية ديني ودين آبائي
... ومن لا تقية له لا دين له ... وغير ذلك(2). فمخالفة هذا الأمر بشكل يوجب الضرر
، مع عدم وجود مصلحة إسلامية مهمة في إحداثه ،يعتبر من أشد المحرمات في الإسلام.
ومن ثم نرى المهدي (ع) يعبر عن هذه الفتن بنار الجاهلية ، بمعنى أنها تمثل انحرافاً
أساسياً عن الإسلام. ويكون من يثيرها من قواعده الشعبية ، مساعداً على هلاك إخوانه
المؤمنين .
(1) الظاهر أن قوله : من شب نار الجاهلية ، مبتدأ محذوف الخبر ، أو شرط محذوف
الجزاء لوضوحه ، تقديره . فهو عاص أو معاند نحوهما .
(2) انظر أخبار التقية في وسائل الشيعة للشيخ الحر العاملي ن جـ 2 ، ص 545 وما
بعدها .
صفحة (154)
الفقرة الثانية :
الالتزام بالهدوء ، والخلود إلى السكينة وضبط الأعصاب ، وعدم التعرض المباشر إلى
القلاقل الحادثة . طبقاً لقوله تعالى : }وإذا مروا باللغوة مروا كراماً{(1) .
ولذا نراه يقول : أنا زعيم – أي كفيل وضامن – بنجاة من لم يرم فيها المواطن ، يعنى
مواطن الهلاك ، وتجنب الاشتراك الفعلي في القلاقل . وسلك في الطعن منها ، يعنى
الفتن ، والاحتجاج على وقوعها ، السبل المرضية في الإسلام بالاعتراض الهادئ وإبداء
الرأي الموضوعي الصحيح .
ومن هاتين الفقرتين ، نفهم رأي الإمام عليه السلام ، في هذه الفتن ، ومرارته وأسفه
منها ، واعتراضه على مسببيها من أهل الإسلام ، بما فيهم بعض قواعده الشعبية .
النقطة الثامنة :
قوله عن هذه الفتن : وهي إمارة لأزوف حركتنا ، ومبائتكم بأمرنا ونهينا . والله متم
نوره ولو كره المشركون .
ولا نستطيع أن نفهم من ذلك ، بطبيعة الحال ، أنه عليه السلام سوف يظهر بعد هذه
الفتن فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً ، كما ملئت ظلماً وجوراً . لأن ذلك لم يحدث ، فلا
يمكن أن يكون الإعراب عن حدوثه مقصوداً للمهدي (ع). على أن مقتضى القواعد العامة
التي عرفناها ، عدم إمكان الظهور في ذلك العصر لعدم توفر شرائطه ومن أهمها كون
الأمة على مستوى التضحية الحقيقية في سبيل الإسلام وقيادة العالم كله بالعدل الكامل
... وهو ما لم يكن متوفراً يومئذ بكل وضوح . وسيأتي في القسم الثاني من هذا التاريخ
مزيد توضيح لذلك .
ومن هنا احتاجت هذه العبارة من الرسالة إلى تفسير .
وما يمكن أن يكون فهماً كافياً لها ، طبقاً لأطروحة خفاء العنوان ، أحد تفسيرين :
التفسير الأول :
أن يكون المراد من الحركة ، انتقاله من العزلة إلى المجتمعات ، ومن البراري والجبال
إلى المدن . باعتبار ما دلت عليه الرسالة نفسها من الاعتزال ، وما قلناه من أن ذلك
– لو صح – فهو خاص ببعض الفترات الأولى من الغيبة دون الفترات المتأخرة . ومعه يكون
من المحتمل أن يكون المهدي (ع) عازماً على رفع اليد عن الاعتزال في ذلك العصر .
(1) سورة الفرقان 25 / 72 .
صفحة (155)
وإذا ورد المجتمعات ، عاش فيها بشخصيته الثانية لا محالة . وعلى أي حال ، تكون فرص
العمل بالنسبة إليه أوسع وأثر أعماله أعمق . ولعل هذا هو المراد من قوله : ومباثتكم
بأمرنا ونهينا ... يعني أعطاؤه التوجيهات ، لكن لا بصفته الحقيقية ، بل بشخصيته
الثانية .
وهذا التفسير محتمل على أي حال ، لولا ما قد يوجد في التفسير الآتي من مرجحات .
التفسير الثاني :
أن يكون المراد من الحركة ظهوره وقيامه في اليوم الموعود . لكن بشكل لا يراد ظهوره
في عصر إرسال هذا الكتاب ، ليكون أخباراً غير مطابق للواقع .
بل يكون المراد ظهوره عليه السلام بعد تلك الفتن ولو بزمان طويل . وهو معنى جعل تلك
الفتن من علامات الظهور ، وسنعرف في القسم الثالث من هذا التاريخ ، أنه لا ضرورة
لافتراض أن تكون العلامة قبل الظهور مباشرة ، بل من العلامات ما يكون سابقاً على
الظهور بكثير . ويكون هذا من ذاك .
وقد يرد إلى الذهن في مناقشة ذلك : أن هذا مخالف لظاهر عبارة الرسالة ، فأنه يقول
:وهي إمارة لأزوف حركتنا، ولا يقال : أزف الشيء إلا قرب زمان حدوثه . فكيف يمكن
افتراض زمان طويل .
والجواب على ذلك : أننا يمكن أن نفهم من التن المشار إليها كإمارة على أزوف الحركة
، مفهوماً عاماً تشمل كل الانحرافات والمظالم في عصر الغيبة الكبرى ، ومن المعلوم
أن هذه المظالم لا تنتهي إلا عند الظهور ، إذن فيكون انتهاؤها إمارة مباشرة للظهور
. والله العالم بحقائق الأمور .
صفحة (156)
النقطة التاسعة :
قوله : إذا حل جمادي الأولى من سنتكم هذه ، فاعتبروا بما يحدث فيه ، واستيقظوا من
رقدتكم لما يكون في الذي يليه . وهو شيء لم نستطع أن نتبينه من التاريخ ، وهو لم
يحص من الحوادث إلا القليل . نعم : سوى بعض الحوادث "الطبيعية" التي سنشير إليها في
النقطة القادمة .
النقطة العاشرة :
قوله : ستظهر لكم في السماء آية جلية ، ومن الأرض مثلها بالسوية .
وظاهر سياق التعبير ، كون هذه الآيات تظهر في جمادي الأولى أيضاً من نفس العام ،
وهو سنة 401 للهجرة .
أما ما حدث في الأرض ، فقد حدثنا التاريخ أنه في النصف من جمادي الأولى من هذا
العام فاض البحر المالح وتدانى إلى الأيلة ودخل البصرة بعد يومين(1) .
وأما ما حدث في السماء ، فهو ما سمعناه من تتابع سقوط النيازك الضخمة ، المعبر عنها
في لغة المؤرخين بالكواكب ... ويحدث عند سقوطها صوت شديد وضوء كثير ، كالذي حدث عام
417 ، كما سمعنا فيما سبق .
وهو وإن لم يكن في نفس عام إرسال الخطاب ، إلا أننا قلنا بأن هذا الخطاب ، حيث أنه
موجه لمجموع القواعد الشعبية المهدوية ، إذن فمن الممكن أن يتأخر الحادث الموعود
عدة سنوات لكونها قليلة بالنسبة إلى عمر الأمة الطويل .
فإن قال قائل : أن هذا مخالف لظهور العبارة الذي فهمناه من السياق وهو حدوث الآيات
السماوية والأرضية في جمادي الأولى من نفس العام ، وهو عام 410 .
يكون الجواب عليه : أننا بين أحد أمرين : الأول : رفع اليد عن هذا الظهور ، في حدود
الآية السماوية ، فأنه يكفي في صدق السياق كون الآية الأرضية واقعة في نفس الموعد .
والثاني : أن نفترض أن جمادي الأول في نفس العام وقعت فيه آية سماوية غير منقولة في
التاريخ .
(1) هامش الكامل ، جـ 7 ، ص 303 .
صفحة (157)
النقطة الحادية عشر :
قوله : ويحدث في أرض المشرق ما يحزن ويقلق .
ولسنا نعاني كثيراً في فهم ذلك ، إذا عرفنا أن هذا الكتاب ورد العراق ، إلى الشيخ
المفيد قدس الله روحه ، فالمراد بالمشرق – إذن – ما كان في شرق العراق ، وهو إيران
نفسها ... دولة البويهيين ومركز ثقلهم يومئذ . وكانت تعاني منذ زمن الحروب والحوادث
الكثيرة المتكررة التي أوجبت شيئاً فشيئاً تفكك الدولة البويهية ، وضعفها وسيطرة
السلاجقة عليها في نهاية المطاف .
على أننا لو راقبنا التاريخ القريب من صدور هذا الكتاب ، لرأينا أن همدان تعاني من
الحروب عام 411(1) وعام 414(2) . ومن المعلوم أن الحروب على الدوام مصدر للقلق
والحزن ، لأنها تكون على طول الخط على حساب الشعب البائس . فإذا لم تكن الحرب عادلة
ولم يكن للشعب فيها نصيب حقيقي ، كان ذلك ظلماً كبيراً وجوراً عظيماً .
النقطة الثانية عشرة :
قوله : ويغلب من بعد على العراق طوائف عن الإسلام مراق ، تضيق بسوء فعالهم على أهله
الأرزاق . ثم تنفرج الغمة بدار طاغوت من الأشرار ، ثم يستر بهلاكه المتقون الأخيار
.
يعني يسيطر بعد الحوادث السابقة من قلاقل طائفية وآيات سماوية وأرضية ، يسيطر على
العراق أقوام خارجين عن تعاليم الإسلام . وفي ذلك تعريض واضح بالسلطان طغرل بك أو
ملوك السلاجقة ، وتابعيه ، فإن بعد أن انتهى من تقويض دولة البويهيين في إيران بعد
حروب مدمرة ، قصد العراق فدخل بغداد عام 447(3) .
(1) الكامل ، جـ 7 ، ص 307 . (2) المصدر ، ص 313 . (3) المكامل ، جـ 8 ، ص 70 .
صفحة (158)
وترتب على دخوله فيها قلاقل وحروب مؤسفة وعم الخلق ضرر عسكره وضاقت عليهم مساكنهم ،
فإن العساكر نزلوا فيها ، وغلبوهم على أقواتهم وارتكبوا فيها كل محذور(1) .
وأما قلة الأرزاق وغلاء الأسعار ، فحدث عنها ولا حرج ... إذ نسمع التاريخ يخبرنا
أنه قد كثر الغلاء وتعذرت الأقوات وغيرها من كل شيء ، وأكل الناس الميتة ، ولحقهم
وباء عظيم ، فكثر الموتى بغير غسل ولا تكفين ، فبيع رطل اللحم بقيراط وأربع دجاجات
بدينار . وسفرجلة بدينار ورمانة بدينار ، وكل شيء كذلك(2) .
وبقي هذا الغلاء عدة سنوات ، بل استمر في التصاعد ... ففي عام 449 زاد الغلاء
ببغداد والعراق ... وأكل الناس الميتة والكلاب وغيرها ، وكثر الوباء حتى عجز الناس
عن دفن الموتى ، فكانوا يجعلون الجماعة في الحفيرة(3) .
أما الخليفة في بغداد ، فكان يعيش جواً آخر بعيداً عن الغلاء والوباء . فقد أكرم
طغرل بك إكراماً عظيماً ومكنه من بلاده تمكيناً أسبع عليه صفة الشرعية ، حين قال له
: إن أمير المؤمنين شاكر لسعيك حامد لفعلك مستأنس بقربك. وقد ولاك جميع ما ولاه
الله من بلاده ورد عليك مراعاة عباده ، فاتق الله فيما ولاك واعرف نعمته عليك في
ذلك واجتهد في نشر العدل وكف الظلم وإصلاح الرعية .
فقبل الأرض ، بين يدي الخليفة . وأمر الخليفة بإفاضة الخلع عليه . فقام إلى موضع
لبسها فيه وعاد وقبل يد الخليفة ووضعها على عينيه وخاطبه الخليفة بملك المشرق
والمغرب ، وأعطي العهد وخرج .
وأرسل إلى الخليفة خدمة كثيرة منها خمسين ألف دينار وخمسين مملوكاً أتراك من أجود
ما يكون ومعهم خيولهم وسلاحهم إلى غير ذلك من الثياب وغيرها(4) فانظر إلى ترف
الحكام وبؤس المحكومين ، وتسامح الخليفة بدماء المسلمين وأموالهم حين ولى عليهم هذا
الظالم العنيد .
(1) المصدر ، ص 77 . (2) المصدر ، ص 79 . (3) المصدر ، ص 81 . (4) المصدر ، ص 80 .
صفحة (159)
فقد كان طغرل بك – بحسب ما وصفه التاريخ - : ظلوماً غشوماً قاسياً ، وكان عسكره
يغصبون الناس أموالهم وأيديهم مطلقة في ذلك نهاراً وليلاً(1) حتى توفي عام 544(2) .
فمن هنا نرى بوضوح ، انطباق الأوصاف على طغرل بك وعسكره وذويه . فإنهم "طوائف عن
الإسلام مراق" باعتبار ما ارتكبوه من المحرمات الصريحة الموجبة للخزي والفضيحة .
وقد ضاقت "بسوء فعالهم على أهله الأرزاق" كما سمعنا . إذ من المعلوم كيف تنحدر
البلاد إلى وضع اقتصادي رديء ، تحت ظل الحروب والقلاقل .
وقد انكشفت الغمة من بعد ، ببوار – يعنى بموت – "طاغوت من الأشرار" وهو طغرل بك
نفسه . وقد أدخل هلاكه السرور على قلوب المتقين الأخيار .
ونفهم معنى انكشاف الغمة بموته ، إذا التفتنا إلى التاريخ وعلمنا أنه لم يحدث مثل
هذا الغلاء والوباء بغد طغرل بك طيلة حكم الدولة السلجوقية .
النقطة الثالثة عشرة :
قوله : يتفق لمريدي الحج من الآفاق ما يأملونه منه على توفير عليه منهم واتفاق .
ولنا في تيسير حجهم على الاختيار منهم والوفاق ، شأن يظهر على نظام واتساق .
وهذه نبوءة صادقة بتسهيل الحج بعد صعوباته التي سمعناها ، وانحلال مشاكله . فيتحقق
للحجاج من كل البلاد ما يأملونه من الأمن والسهولة .
وتصديق هذه النبوءة واضح جداً في التاريخ . فإنه بالرغم من أنه استمر منع الحج حقبة
من السنين ، إلا أنه لم ينقل بعد عام 419 أي منع للحج ، مما يدل على أن الطرق قد
توفرت للحجاج . فقد تحققت النبوءة بعد عشرة أعوام من صدورها .
(1) المصدر ، ص 95 . (2) المصدر ، ص 94 .
صفحة (160)
وأما حدوث ذلك بمساعي المهدي (ع) وجهوده ، فهو بمكان من الإمكان ، طبقاً لما عرفناه
من مسؤولية العمل الإسلامي للإمام المهدي خلال غيبته ، بناء على أطروحة خفاء
العنوان. فإذا دل الكتاب على تأثر عمل الإمام في سهولة الحج ، فلا بد من تسجيل ذلك
تاريخياً ، لو صلح هذا الكتاب للإثبات التاريخي . ودلالة الكتاب على هذا واضحة حين
يقول : ولنا في تيسير حجهم ... شأن يظهر على نظام واتساق .
النقطة الرابعة عشرة :
قوله : فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا ، ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا
وسخطنا ، فإن أمرنا بغتة فجأة ، حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابه ندم على حوبة
.
أمر عليه السلام كل فرد من قواعده الشعبية ، بأن يفعل ما يقربه من محبة إمامه ورضاه
، ويترك ما يقربه من كراهته وسخطه . وهذا معنى واضح ولطيف ، فإن رضى المهدي (ع) رضا
الله تعالى ، وكلما يقرب للمهدي (ع) فهو يقرب إلى الله ... وذلك بالشعور بالمسؤولية
تجاه أحكام الإسلام ، والاستجابات الصالحة تجاه الأحداث ... كما أن سخط المهدي سخط
الله تعالى ، وكلما يبعد عنه يبعد عن الله تعالى .
ويعطي المهدي (ع) لذلك تعليلاً مهماً حين يقول : فإن أمرنا بغتة فجأة ، حين لا
تنفعه توبة الخ .
والمضمون العام لذلك ، هو : أن الفرد المؤمن بظهور المهدي (ع) المتوقع له في كل حين
، بغتة وفجأة ، يجب أن ينزه نفسه عن المعاصي ويقصر سلوكه على طاعة الله عز وجل ،
ليكون على المستوى المطلوب عند الظهور. وحيث كان الظهور محتملاً دائماً ، فيجب أن
يكون الفرد على هذه الصفة دائماً .
وأما إذا بقي الفرد عاصياً منحرفاً سلوكياً أو عقائدياً ، ولم ينزه نفسه في أثناء
الغيبة ، ولم يتب إلى الله تعالى ... فسوف لن تنفعه توبته أو ندمه بعد ذلك .
وسيعاقبه الإمام المهدي (ع) بعد ظهوره على ما اقترفه من ذنوب ، على كل حال ، وسكيون
عقابه في ذلك المجتمع الإسلامي العظيم خزياً أبدياً له . وبما أن الظهور محتمل على
الدوام ، إذن فالبدء بعقاب المذنبين محتمل على الدوام ، فإذا أراد الفرد أن يحول
دون هذا الاحتمال ، فما عليه إلا أن يرتدع عن الذنوب ، ويكمل نفسه من العيوب .
صفحة (161)
الناحية السادسة :
في استعراض نص الرسالة الثانية التي رواها الطبرسي(1) مرسلاً عن الإمام المهدي (ع)
. ولها من قيمة الإثبات التاريخي ما ذكرناه للرسالة الأولى .
بسم الله الرحمن الرحيم
سلام الله عليك أيها الناصر للحق الداعي إليه بكلمة الصدق . فأنا نحمد الله إليك
الذي لا إله إلا هو ، آلهنا وآله آبائنا الأولين . ونسأله الصلاة على سيدنا ومولانا
محمد خاتم النبيين ، وعلى أهل بيته الطاهرين .
وبعد : فقد كنا نظرنا مناجاتك ، عصمك الله بالسبب الذي وهبه الله لك من أوليائه
وحرسك به من كيد أعدائه . وشفعنا ذلك الآن من مستقر لنا بنصب في شمراخ من بهماء
صرنا إليه آنفاً من غماليل ألجأنا إليه السباريت من الإيمان . ويوشك أن يكون هبوطنا
إلى صحصح من غير بعد من الدهر ولا تطاول من الزمان. ويأتيك نبوءنا بما يتجدد لنا من
حال ، فتعرف بذلك ما نعتمده من الزلفة إلينا بالأعمال . والله موفقك لذلك برحمته .
فلتكن حرسك الله بعينه التي لا تنام أن تقابل لذلك فتنة تسبل النفوس قوم حرثت
باطلاً لاسترهاب المبطلين، يبتهج لذمارها المؤمنون ، ويحزن لذلك المجرمون .
وآية حركتنا من هذه اللوثة ، حادثة بالحرم المعظم من رجس منافق مذمم ، مستحل للدم
المحرم ، يعمد بكيده أهل الإيمان ، ولا يبلغ بذلك غرضه من الظلم والعدوان . لأننا
من وراء حفظهم بالدعاء الذي لا يحجب عن ملك الأرض والسماء . فليطمئن بذلك من
أوليائنا القلوب وليثقوا بالكفاية منه ، وإن راعتهم بهم الخطوب ، والعاقبة بجميل
صنع الله سبحانه تكون حميدة لهم ما اجتنبوا المنهى عنه من الذنوب .
(1) انظرها في الاحتجاج ، جـ 2 ، ص 324 ، ط النجف .
صفحة (162)
ونحن نعهد إليك أيها الولي المخلص المجاهد فينا الظالمين , أيدك الله بنصره الذي
أيد به السلف من أوليائنا الصالحين . أنه من اتقى ربه من أخوانك في الدين وأخرج مما
عليه إلى مستحقه كان آمناً من الفتنة المبطلة ومحنها المظلمة المضلة . ومن بخل منهم
بما أعاده الله من نعمته على من أمره بصلته ، فأنه يكون خاسراً بذلك لأولاه وآخرته
.
ولو أن أشياعنا – وفقهم الله لطاعته – على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم
، لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة
وصدقها منهم بنا . فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا تؤثره منهم .
والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل ، وصلاته على سيدنا البشير النذير محمد وآله
الطاهرين وسلم .
وكتب في غرة شوال من سنة اثنتي عشرة وأربعمائة .
نسخة التوقيع باليد العليا صلوات الله على صاحبها : هذا كتابنا إليك أيها الولي
الملهم للحق العلي ، بإملائنا وخط ثقتنا . فاخفه عن كل أحد ، واطوه ، واجعل له نسخة
يطلع عليها من تسكن إلى أمانته من أوليائنا شملهم الله ببركتنا إن شاء الله . الحمد
لله والصلاة على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين .
الناحية السابعة :
في استعراض المهم مما تتكفل هذه الرسالة بيانه . ويمكن أن يتم ذلك في ضمن عدة نقاط
.
النقطة الأولى :
إن الرسالة ذات سياق عام واضح متعمد ، في الصدور من جهة عليا إلى جهة أدنى منها .
وهي في ذلك أوضح من الرسالة الأولى إلى حد كبير .
صفحة (163)
وهي بهذا تنحو منحى القرآن الكريم الذي أكد على هذه الجهة بوضوح ، في عدد من آياته
كقوله تعالى : }ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين}(1) . وقوله:}إذن
لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات}(2) . وقوله: }وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله
الرسل}(3) . إلى غير ذلك .
فالاثنينية بين المتكلم والسامع محفوظة بكل وضوح ، وارتفاع المتكلم على السامع
ملحوظ بكل جلاء . وهذا ثابت في هذه الرسالة أيضاً ، مع بعض الفروق بين سياقها
والسياق القرآني ، لا تخفى على الأديب .
وهذا الإيحاء يعطي زخماً نفسياً معيناً ، لا مناص منه حين يراد السيطرة على السامع
من الناحية العاطفية والفكرية . كيف وإن السامع في كلا هذين الحالين ، يعترف
بارتفاع المتكلم عليه بكل خشوع .
النقطة الثانية :
في تعيين محل سكنه عليه السلام ، عند إرسال هذه الرسالة .
حيث نرى المهدي (ع) – لو صحت الرواية – يعين مستقره أي مسكنه بنصب في شمراخ من
بهماء . والنصب هو الشيء المنصوب . والشمراخ رأس مستدير طويل دقيق في أعلى الجبل .
والبهماء مأخوذ من المبهم وهو المكان الغامض الذي لا يعرف الطريق إليه .ومعه يكون
المراد – والله العالم – أنه عليه السلام يسكن في بيت منصوب على قمة جبل مجهولة
الطريق .
ثم يقول : صرنا إليه آنفاً من غماليل , يغتي أنه انتقل إلى هذا المسكن الجديد ، منذ
مدة ، من غماليل يعني من منطقة كان يسكنها قبل ذلك ، توصف بهذا الوصف . فإن
الغماليل جمع غملول وهو بالضم الوادي ذو الشجر أو غمام أو ظلمة أو زاوية(4) .وقد
تلاحظ معي أن كلا الدارين ذات خفاء وغموض ، وقابلة لاختفاء الفرد في أنحائها بشكل
وآخر .
(1) الحافة 69 / 44 – 45 .
(2) الإسراء 17 / 75 .
(3) آل عمران 3 / 144 .
(4)
القاموس المحيط ، جـ 4 ، ص 26 .
صفحة (164)
ثم يذكر سبب انتقاله إلى المسكن الجديد ، بأنه "ألجأنا إليه" إلى المسكن الجديد
"السباريت من الإيمان" . والسباريت جمع سبرات وسبروت وسبريت : الأرض التي لا نبات
فيها وقيل لا شيء فيها . ومنها سمي المعدم سبروتاً(1) . ومعه يكون لهذه العبارة
تفسيران محتملان .
التفسير الأول :
أن نقرأ "الإيمان" بكسر الهمزة ، فيكون المراد أن الفقراء أو الفارغين من الإيمان
هم الذين ألجاوه إلى اختيار مسكنه الجديد . حيث اقتضت المصلحة نتيجة لتصرفاتهم
المنحرفة ، أن يزداد المهدي (ع) بعداً عن الناس وخفاء في المسكن ، فاختار جبلاً ذو
قمة خفية ليجعله مسكناً .
التفسير الثاني :
أن نقرأ همزة "الإيمان" بالفتحة ، فيكون جمع يمين – ضد اليسار – ويكون المراد
بالسباريت : الأرض الخالية من الزرع الموجودة في يمين الطريق . ولعله طريق الحج أو
طريق إحدى المدن . وقد ألجأه إلى تركها إلى المسكن الجديد قلة الزرع فيها وصعوبة
العيش عليها .
ثم يخبر المهدي (ع) بأنه على وشك الانتقال إلى مسكن آخر ثالث . فأنه سيهبط من قمة
الجبل إلى صحصح ، وهي الأرض المستوية "من غير بعد من الدهر ولا تطاول من الزمان" بل
في فترة قريبة وأمد قصير . وهنا لا يجب أن نفترض أن هذه الأرض خالية من النبات
والزرع ، كتلك الأرض .
ومن هذا السياق نعرف أن المهدي (ع) يختار مكانه بعيداً عن المجتمعات ، على الدوام .
ولعل في هذا امتثالاً للأمر الذي نقله المهدي (ع) عن أبيه (ع) في رواية ابن مهزيار
، وقد سبقت الإشارة إليها أكثر من مرة . وهذا لا ينافي أطروحة خفاء العنوان إذ قد
يكون المهدي (ع) ظاهراً بالشخص مختفياً بالعنوان ساكناً الأماكن المنعزلة في العالم
. وقد سبق أن عرفنا أن هذا أكثر وضوحاً وإمكاناً في أول
(1) انظر المصدر ، جـ 1 ، ص 149 وغيره .
صفحة (165)
الغيبة ، وأما ما بعد ذلك فالحاجة إليه منتفية ، بل قد يكون مخالفاً لبعض تطبيقات
تكاليفه عليه السلام .
وبالرغم من تصريحاته عن مكانه، إلا أننا لا نجد أنه قد ذكره على وجه التعيين، وإنما
ذكر – في الحقيقة – عنواناً كلياً يمكن انطباقه على كل قمة وكل واد . ولم يصل في
الوضوح إلى حد لو بحث الإنسان عن مكانه لوجده .
ونلاحظ بوضوح أن المهدي (ع) يعين مكانه بعبارات لغوية قديمة تكاد تكون مندرسة
الاستعمال ... لا يريد أن يسوقها مساقاً واضحاً ، حتى لا يفهمها من يطلع عليها ،
إلا إذا كان من خاصة الناس في العلم والاطلاع . وهذه خطوة إلى تلافي بعض احتمالات
الخطر المحتملة الوقوع على تقدير الاطلاع على هذا الخطاب .
وعلى أي حال نرى المهدي (ع) يعد الشيخ المرسل إليه ، بأن يوصل إليه أنباءه فيما
يتجدد له من حال . ولعل المراد المباشر لذلك ، هو إخباره بانتقاله إلى المكان
الجديد في الصحصح ، ولكن العبارة أعم من ذلك، تشمل كل ما يريد الإمام المهدي (ع)
تبلغيه إلى الشيخ المفيد ، مما يتخذه من رأي أو يذهب إلأيه من مكان ، بمقدار
المصلحة والإمكان .
ومن هنا قال له : فتعرف بذلك ما نعتمده من الزلفة إلينا بالأعمال . يعنى أن مواصلتك
بالمراسلة ستطلعك على الأعمال نحمدها ونعتبرها صالحة ومقربة إلينا . فهذه العبارة
واضحة الدلالة على عزم الإمام المهدي (ع) على تكرار المراسلة مع الشيخ المفيد ،
ولعل ذلك قد حدث ولم يصلنا خبره ، ولعله لم يحدث لأن الشيخ توفى بعد هذه الرسالة
بعام واحد .
النقطة الثالثة :
فلتكن حرسك الله بعينه التي لا تنام أن تقابل لذلك فتنة ، تسبل نفوس قوم حرثت
باطلاً لاسترهاب المبطلين، يبتهج لذمارها المؤمنون ، ويحزن لذلك المجرمون .
وهو توجيه عام من المهدي (ع) إلى الشيخ المفيد وغيره من إخوانه في كل جيلٍ ... بأن
يقابل أي يقف ضد الفتنة التي تسبل أي تستبيح نفوس قوم حرثت باطلاً ، أي خاضت غمار
الباطل في أرض صالحة لذلك . وهي إنما تستبيح نفوسهم في انصهارهم فيها ، وسيرهم مع
تيارها .
صفحة (166)
وإنما يكون على المفيد أن يقف ضد الفتنة ، من أجل استرهاب المبطلين وتخويفهم لأجل
ردعهم عن الباطل وصرفهم إلى طريق الحق . وقوله : لذلك . أي باعتبار ما نعتمده من
الزلفة إلينا من الأعمال .
فيكون المراد لزوم العمل لكفكفة الظلم وردع الفتن التي تؤسس الأراضي الصالحة لنمو
المفسدين والمجتمعات المنحرفة التي تربي المنحرفين . ليكون ذلك من الأعمال الصالحة
التي يعتبرها ويحمدها بصفتها من أعظم المقربات إلى الله ، وأحسن التطبيقات للعدل
الإسلامي .
وإنما سمي الظلم فتنة ، باعتبار أنه محك الامتحان الإلهي لنفوس البشر وإيمانهم ،
لكي يمحصوا به ويميزوا ، فيحيى من حيى عن بينة ويهلك من هلك عن بينة . وقد ذكرنا أن
هذه الفتن والظلم ، كما توجب قوة انحراف المنحرفين توجب الظلم مما يوجب تزايد قوة
الإرادة والوعي لدى المؤمنين المخلصين ويصعد معنوياتهم ، مما يعجل بتحقيق شرط
الظهور . ومن هنا نرى المهدي (ع) يأمر الشيخ المفيد وسائر إخوانه من الأجيال ، بهذا
الجهاد الإيماني الكبير .
ومن هنا نفهم ان الفتنة المذكورة في هذا التعبير ، ليست إشارة إلى حادثة تاريخية
معينة حتى نبحث عنها في التاريخ العام ... كما عملنا في الرسالة السابقة . وإنما هي
عبارة عن الانحراف العام الذي يصيب المجتمع على مر الأجيال خلال عصر الغيبة الكبرى
، ذلك الانحراف الذي يزيله المهدي (ع) بعد ظهوره .
ثم أن المهدي (ع) في رسالته يذكر : أن الجهاد ما يؤثره من استرهاب المبطلين وردعهم
عن باطلهم ... يبتهج لذمارها – أي لدفعها ومحاربتها –(1) المؤمنون ويحزن لذلك
المجرمون .
____________
(1) كما هو أحد معاني الذمار في اللغة ، وهو الحث على الحرب والدعوة إليها قد
استعمل هنا مجازاً .
صفحة (167)
النقطة الرابعة :
إعطاء المهدي (ع) علامة من علامات ظهوره وإمارة من إمارات حركته .
وهي : أنه ينتج من هذه اللوثة – وهو تعبير عن الفتنة – حادثة عظيمة مؤسفة وجرم كبير
، من رجس منافق مذمم ، مستحل للدم المحرم . يعمد – أي يتعمد – بكيد أهل الإيمان ،
ولا يبلغ بذلك غرضه من الظلم والعدوان .
والمراد : أنه ينتج من هذه الفتنة التي يعيشها المجتمع ، أن أحد المنحرفين
المنافقين ، يريد أن يتعمد إلى أهل الإيمان بالكيد والضرر ، فيغتال أحد المؤمنين ،
بهذا القصد . وبالرغم من أن هذا المؤمن سوف يذهب إلى ربه ، إلا أن القصد الأساسي
لذلك المجرم سوف لن يتحقق ، وسيبقى المؤمنون على أمنهم واستقرارهم نتيجة للطف
المهدي (ع) ودعائه لهم بدفع الشر ، ذلك الدعاء الذي لا يحجب عن ملك الأرض والسماء .
ونتيجة لذلك يقول المهدي (ع) في رسالته : فلتطمئن بذلك من أوليائنا القلوب ،
وليثقوا بالكفاية منه ، وان راعتهم بهم الخطوب ...
ولهذه الفقرة ، معنى آخر محتمل ، يختلف قليلاً عما ذكرناه ، وهو أن لا تكون الحادثة
الموعودة من قبل الظالمين، هي حادثة قتل ، وإنما هو تخطيط اجتماعي ، لا يقاع
المؤمنين في الضرر الضيق ، يقوم به شخص منافق مذمم، مستحل للدم المحرم . ولا يكون
استحلاله للدم في هذه الحادثة بالتعيين ، بل المراد أن من شأنه ذلك أو له فيه سوابق
. إلا أن هذا التخطيط ، سوف لن يصل إلى هدفه ، نتيجة لدعاء المهدي (ع) .
وعلى أية من المعنيين ، لم نستطع أن نتبين الحادثة المشار إليها في هذه الفقرة ...
من التاريخ العام أو الخاص . فإن ما أكثر الشهداء المغتالين في سبيل الله تعالى
كالشهيد محمد بن مكي الملقّب بالشهيد الأول والشهيد زين الدين العاملي الملقب
بالشهيد الثاني والقاضي نور الله التستري الملقب بالشهيد الثالث في ألسنة البعض ...
وغيرهم ... وما أكثر المؤامرات الفاجرة التي تحاك ضد المجتمع المؤمن ، ولا يكون
فشلها إلا بدعاء الإمام عليه السلام وعمله.
صفحة (168)
وقد سبق أن قلنا أن الدعاء النافذ المستجاب ، يعتبر من أحسن الأعمال النافعة الخيرة
على الصعيدين الفردي والاجتماعي ، ومن أبعدها أثراً وأفضلها نتيجة .
وبذلك ينجو المؤمنون من المكائد ، فليطمئنوا وليثقوا بدعاء إمامهم – كما أمر إمامهم
– ، فإن عاقبتهم ستكون إلى خير ... إذا التزموا بالسلوك الصالح والعمل الصحيح .
النقطة الخامسة :
إيصاؤه عليه السلام بالإصلاح الشخصي للنفس ، الذي هو الحجر الأساس لإصلاح المجتمع ،
ولنجاة الفرد والمجتمع من الفتن المظلمة المضلة ، ونجاحه المؤزر في الامتحان الإلهي
الكبير . وبدون ذلك يكون الفرد قد خسر أساسه الإيماني الصحيح ، وانحرف انحرافاً
حاداً يخسر به دنياه وآخرته .
ومن هنا نرى المهدي (ع) يؤكد على وجوب دفع الحقوق المالية الإسلامية إلى مستحقيها ،
ومن أمر الله تعالى بصلته وهم الفقراء والمحتاجون . وإنما خصها بالذكر لعلمه عليه
السلام بأن قواعده الشعبية تؤدي – عادة – الفرائض الإسلامية العملية كالصلاة والصوم
والحج ... فلم يبق لهم من الفرائض ، إلا الحقوق المالية التي قد تشح بها بعض النفوس
، وتحتاج في أدائها إلى تضحية أكبر .
قال عليه السلام : أنه من اتقى ربه من إخوانك في الدين وأخرج مما عيه إلى مستحقيه ،
كان آمناً من الفتنة المبطلة ومحنها المظلمة المضلة . ومن بخل منهم بما أعاده الله
من نعمته على من أمره بصلته ، فأنه يكون خاسراً بذلك أولاه وآخرته .
ومن هنا نفهم أن الأداء الكامل للفرائص الإسلامية ، هو المحك في النجاة عن الانحراف
الجارف الذي يودي بالكثيرين خلال عصر الغيبة الكبرى . والسر الأساسي في ذلك : هو أن
أداء الفرائص كاملة ، مع الارتداع عن جميع المحرمات ، مضافاً إلى أنه يمثل السلوك
الشخصي الصالح ، فإنه – بما يوجبه للفرد من صبر وتضحية على مستوى معين من المصاعب
في سبيل الله عز وعلا – يحدث في الفرد قوة في الإرادة والتحمل في مجابهة التيار
الظالم وما يستلزمه من إغراء ومخاوف . مما يوجب نجاته منها وبعده عنها ، ومن ثم
نجاحه في الامتحان الإلهي الكبير , وبذلك يحرز سعادته في الدنيا والآخرة . وبخلاف
ذلك ، سوف يكون فاشلاً في الامتحان الإلهي "خاسراً بذلك أولاه وآخرته" .
صفحة (169)
مضافاً إلى نقطة أخرى في دفع الحقوق المالية ، هي : أن خير ما ينقذ القواعد الشعبية
المهدوية في المجتمع المنحرف ، وأحسن تخطيط يمكن به كفكفة جماح ما يفرض عليهم من
قبل الظالمين من حصار اقتصادي واجتماعي ... هو أن يكفل بعضهم بعضاً ويحمل بعضهم همّ
بعض ، وذلك بالالتزام بدفع الحقوق الإسلامية المالية التي فرضها الله تعالى ، فأنها
كافية لتنفيذ هذه الكفالة ووافية بهذا الضمان . وبهذه الحقوق – أيضاً – يمكن وضع
البرامج الاجتماعية الوقتية لدفع ظلم أو لتربية جيل أو لقضاء بعض الحاجات .
النقطة السادسة :
إيصاؤه بالإصلاح العام الذي هو أكبر وأهم من الإصلاح الشخصي ، والذي به يتحقق شرط
الظهور ، ويجعل الأمة على مستوى المسؤولية التي يؤهلها للتيمن بلقاء الإمام المهدي
عليه السلام ، وتحمل مسؤوليات ظهوره .
وهذا الإصلاح العام ، يعبر في حقيقته عن ضرورة اجتماع أشياعه – وهم أتباعه – ...
عقلاً وقلباً ... عقيدة وعاطفة وسلوكاً ، في الوفاء بالعهد المأخوذ عليهم ، في
إطاعة أوامر الإسلام ونواهيه ، وامتثال قادة الإسلام ومتابعتهم . ومن الواضح أن هذا
الاجتماع على الطاعة هو أوسع وأهم من الطاعة الفردية ، وأكثر انتاجاً بشكل غير قابل
للمقايسة . وهو الذي يمثل العمل المشترك لتبليغ الإسلام وتطبيقه ، والجهاد المشترك
ضد أنحاء الظلم والطغيان والعدوان .
وهذا الاشتراك والتضامن ، لهو أقوى الأسباب لتحقق الإرادة لدى الأفراد ، ولتربية
الوعي والشعور بالمسؤولية فيهم ... وهو الشرط الأساسي للظهور ...
ومن ثم نرى المهدي (ع) يرتب على هذا الاجتماع أثره الحقيقي ، ويستنتج منه نتيجته
الطبيعية ... فإنه لو كان متحققاً : "لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ، ولتعجلت لهم
السعادة بمشاهدتنا" . تلك السعادة الناتجة من العدل الكامل الذي يتكفل المهدي (ع)
تطبيقه على العالم كله .
صفحة (170)
"على حق المعرفة وصدقها منهم بنا" . وهذه العبارة تدل على أطروحة خفاء العنوان ،
التي اخترناها ، باعتبار أن المهدي (ع) خلال غيبته معروف بالشخص مجهول الهوية
والحقيقة ، وإنما هو معروف بشخصيته الثانية . وأما بعد الظهور فتصبح المعرفة حقاً
وصدقاً ، يعني سوف يعرف الناس شخصه وحقيقته وانطباع العنوان على الشخص بوضوح .
ولو كانت أطروحة خفاء الشخص صادقة ، لكانت هذه العبارة في غير محلها ، ولكفت
البشارة بحدوث المشاهدة بعد انعدامها عند الظهور .
"فما يحبسنا عنهم" أي يؤخر الظهور "إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره عنهم" من
المعاصي والتقصيرات وعدم الشعور بالمسؤولية الإسلامية .
وهذا يدل على أمرين مهمين ، سبقت الإشارة إليهما ، ولكن يكون في هذا الكلام من
المهدي (ع) زيادة في الاستدلال عليهما :
الأمر الأول : كون المهدي (ع) مطلعاً على الأخبار مواكباً للأحداث يشعر بآلام وآمال
أمته وقواعده الشعبية.
الأمر الثاني : إناطة الغيبة بذنوب الناس وعصيانهم . فمتى لم يكن هناك ذنب ، لم يكن
للغيبة سبب ، فتتحول إلى الظهور . وهو معنى ما قلناه من أن الفرد إذا كان عالياً في
الوثاقة كاملاً في تطبيق الإسلام ، فإن المهدي (ع) لا يحتجب عنه مرة أو مراراً ، بل
قد يكون ذلك على الدوام ، كما سبق أن فصلناه .
صفحة (171)
القسم الثاني
في تاريخ الإنسانية في عصر الغيبة الكبرى
فيما يرجع إلى الحوادث والصفات التي تكون للإنسانية عامة أو للمجتمع المسلم أو
للقواعد الشعبية الإمامية خاصة. من حيث مقدار تمسكهم بالدين وما يترتب على ذلك من
نتائج ... وما هو تكليفهم الواعي الصحيح أثناء الغيبة الكبرى .
وينقسم الكلام في هذا القسم إلى ثلاثة فصول رئيسية :
أولها : في تمحيص الأخبار الواردة في هذا الصدد ، وفرزها عما سواها من حيث المورد
والمفهوم ... وإعطاء القواعد العامة في فهمها .
وثانيها : فيما دلت عليه الأخبار من حوادث وصفات للناس ، تخص مقدار تمسكهم بالدين
وبتعاليم الإسلام.
وثالثهما : فيما هو التكليف الواعي للناس خلال عصر الغيبة الكبرى .
صفحة (173)
الفصل الأول
في تمحيص الأخبار التي نريد الاستشهاد بها في هذا القسم ، وتمييزها عما سواها من
حيث المورد والمفهوم ، وإعطاء القواعد العامة في فهمها . وذلك قبل الدخول في سر
تفاصيلها في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى
وينبغي أن يقع الكلام حول ذلك في عدة جهات :
الجهة الأولى :
في تمحيص هذه الأخبار ، وتشخيص حاجتنا في الاستدلال بها .
فإننا إذ نريد أن نعرف المستوى الديني ، لأي مجتمع ، في أي عصر ، نرجع – عادة – إلى
تاريخ ذلك العصر لاستعراض ما فيه من حوادث وآثار تدل على ما كان عليه المجتمع من
مستوى ديني وشعور بالمسؤولية الدينية . وهذا طريق صحيح ، لو استطاع التاريخ أن
يسعفنا بما نحتاجه من حقائق ومستمسكات .
ولكن ما نعرفه – عادة – من تأريخ ، يتصف بالنقص – حتماً – بما لا يقل عن ثلاث جهات
:
الجهة الأولى :
إسقاطه لبعض الحوادث التاريخية ، وعدم التعرض لها ، بأي دافع من الدوافع ...
وتاريخنا الإسلامي مليء بمثل هذه الفجوات .
الجهة الثانية :
عدم الموضوعية في شرح الحادثة . ووجود الاحتمال على أقل تقدير – في أن يكون المؤرخ
قد غير منها شيئاً لكونه يميل عقائدياً أو عاطفياً مع أحد الأشخاص التاريخيين دون
الآخر .
صفحة (175)
الجهة الثالثة :
عدم التعرض لحوادث المستقبل . وهذا ضروري الوقوع في كل تاريخ ، لأن المستقبل مجهول
، إلا بنحو الحدس أو علم الغيب .
أما الجهتين الأولى والثانية ، فيمكن دفع تأثيرهما والحد من ضررهما ، إلى حد كبير ،
لدى المقارنة بين مصادر التواريخ وأقوال المؤرخين ، حتى يحصل للفرد البحث وثوق
وقناعة بحصول الحادثة أو عدم حصولها . وخاصة بعد استيعاب سائر وجهات نظر المؤرخين
ومذاهبهم .
وأما الجهة الثالثة : فيستحيل – عادة – مَلْؤُهَا في التاريخ الاعتيادي للبشر أياً
كانوا ... فيبقى المستقبل المجهول ، فجوة تاريخية شاغرة أمام الناظر يحار في
تشخيصها وترتيبها .
وهنا ينفتح وجه الحاجة إلى الروايات التي نحن بصددها ، فإنها تتنبأ عن حوادث
المستقبل مروية عمن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ، وعن خلفائه المعصومين
عليهم السلام ... بطرق متواترة لا يقبل مجموعها التشكيك ... وإن كانت كل رواية منها
ظنية على أي حال ، وقابلة للمناقشة أحياناً . كما سمعنا مثل ذلك في أخبار المشاهدة
، مع فرق مهم هو أن الروايات الواردة في المقام أضعاف روايات المشاهدة ، على ما
سنعرف صورة منه في الفصل الآتي .
على أن جملة منها يحتوي على التنبؤ بحوادث قد حدثت فعلاً خلال الزمان ، على ما
سنعرف ، وقد صدر التنبؤ بها قبل حدوثها بزمن طويل ... وهو شاهد على صدقها وصدق
قائلها وعلى ارتباط القائل بالله عز وجل بشكل وآخر ، فإن كل علم غيب لا بد أن يكون
مستقى من علام الغيوب .
صفحة (176)
ومعه فتكون هذه الروايات ، صالحة لملء الفجوات التاريخية التي أهملها التاريخ ، أو
لم يكون موضوعياً تجاهها. ولكنها – على أي حال – تحتوي على بعض المصاعب ، لا بد من
استعراضها ، واستعراض ما يمكن أن يكون منهجاً لتذليل تلكم المصاعب .
مصاعبها :
تتلخص المصاعب في نقطتين رئيسيتين ، من حيث أن الطعن تارة يتوجه إلى السند أي إلى
وثاقة الرواة وصدقهم . ويتوجه إلى الدلالة ، أي إلى ما نفهمه من النص المروي تارة
أخرى .
النقطة الأولى :
فميا يرجع إلى السند . ولئن كانت القاعدة العامة في الروايات هي التأكد من وثاقة
الراوي والتزامه الصدق في المقال قبل قبول روايته ... فإن الروايات التي نحن بصددها
أشد خطراً في هذا المجال ، من أشكال الروايات الأخرى. من حيث أن احتمال الوضع
والتحريف أكثر بكثير مما هو في سائر الروايات . وذلك باعتبار عدة أمور :
الأمر الأول :
احتمال الوضع . فإن الكاذب قد يخشى الوضع عندما يخاف الافتضاح ، عند وضوح عدم
مطابقة روايته للواقع . وخشية الافتضاح متوفرة – عادة – في سائر موارد الروايات ،
إلا أنها في روايات التنبؤ أقل منها في غيرها من عدة نواحٍ :
الناحية الأولى :
إن هذه الروايات تتنبأ عن حوادث مغرقة في المستقبل السحيق الذي لا يمكن أن تتأكد من
صدقه الأجيال . ومعه تبقى الرواية محتملة الصدق دهراً طويلاً جداً ، أكثر مما يطمع
به الكاذب . وفي كل جيل إن لم تحدث الحادثة الموعودة يقال : لعلها في الأجيال
القادمة ، ومعه يبقى كذب الرواي سراً غير قابل للكشف .
الناحية الثانية :
إن جملة من هذه الروايات – على ما سنسمع – ذو بيان رمزي وعبارات ذات درجة كبيرة من
السعة والإبهام ، بحيث يمكن أن تنطبق العبارة على عدة حوادث محتملة . ومعه فيقول كل
جيل : لعل المقصود هذه الحادثة ولعل المقصود حادثة أخرى آتية ... ويبقى الكذب سراً
غير قابل للكشف .
صفحة (177)
الناحية الثالثة :
إن جملة من هذه الروايات ، يحتمل – على أقل تقدير – أن تكون قد وضعت بعد حدوث
الحوادث ، ونسبت إلى قائل سابق على الحدوث . ومعه قد يجدها الفرد الباحث مطابقة
للواقع ، مع أنها مكذوبة . ومن الطبيعي أن يكون شعور الكاذب بمطابقة روايته للواقع
ما يهوّن لديه خوف الافتضاح إلى حد كبير .
الأمر الثاني :
النقل بالمعنى . وهذا ليس محتملاً فحسب ، بل هو معلوم التحقق في كثير من الأخبار .
والنقل بالمعنى ، لا يكاد يكون مضراً في الروايات الاعتيادية ، كالروايات المتعرضة
إلى الفقة والفلسفة ... فإن اللفظ أو مرادفه ، والجملة ومثيلتها ، يعطيان معنى
متشابهاً إلى حد كبير ... واحتمال اختلاف المعنى يكون ملغى ومدفوعاً إذا كان الراوي
معلوم الضبط والوثاقة .
وأما في روايات التنبؤ بالمستقبل ، فليس الأمر فيها على هذا الغرار . فأنها تصدر في
الأعم الأغلب عن قائلها : النبي (ص) أو غيره رمزية غير واضحة المعنى ، بحيث يحتاج
فهمها إلى تدقيق . ومن المعلوم أن التعبير عن اللفظ الرامز بلفظ آخر يمسخه مسخاً
ويغير معناه تغييراً كلياً أو يكاد .
وهذا الاحتمال لا يدفعه العلم بالوثاقة والضبط في الراوي ، بعد جواز النقل بالمعنى
شرعاً ، واحتمال عدم فهم الراوي للمعنى المرموز إليه ، كي يختار المرادف الصحيح
لألفاظ الراوية .
الأمر الثالث :
احتمال الإسقاط من ألفاظ الرواية في أثناء تناقلها من قبل الرواة .
فإن القواعد العامة في سائر الروايات ، تقتضي إلغاء هذا الاحتمال ، باستظهار كون
الراوي ناقلاً لجميع الألفاظ ، أو لجميع ما يتعلق بالمضمون الواحد من قرائن
وخصوصيات . إذا كان الراوي ثقة ، إذ لو كان قد أسقط بعض ذلك لكان قد أخل بنقله
وبوثاقته في نهاية المطاف . ومعه تكون وثاقته دليلاً على أنه نقل إلينا كل ما يتعلق
بالمضمون المعطى في الرواية .
صفحة (178)
إلا أن ذلك ليس بذي فائدة في روايات التنبؤ بالمستقبل ، وذلك من ناحيتين :
الناحية الأولى :
إذا احتملنا وجود قرينة لفظية أو غيرها ، لم يفهم الراوي كونها قرينة مغيرة للمعنى
أو مؤثرة فيه ، فحذفها . والراوي الثقة إنما يتعهد نقل ما يفهم تأثيره من القرائن
بطبيعة الحال ، دون غيرها . ومعه لا تكون وثاقة الراوي نافية لهذا الاحتمال .
ومثل هذا الاحتمال ، لا يكاد يكون موجوداً في الروايات الاعتيادية ولكنه موجود بكل
وضوح في الروايات الرمزية ، التي قد تخفى معاني ألفاظها ، فضلاً عن قرائنها الدقيقة
.
الناحية الثانية :
إذا احتملنا أن الرواية كانت متضمنة لنقل أكثر نم حادثة واحدة ، واحتملنا أن نقل
الحادثتين معاً ، له تأثير في الفهم الدقيق والصحيح لإحداهما أو لكليهما . في حين
لم تكن الرواية التي وصلتنا حاوية إلا لحادثة واحدة .
وهذا الاحتمال لا يمكن إلغاؤه بالعلم بوثاقة الراوي ، فإن غاية ما يتعهد به الراوي
الثقة هو أن ينقل كل ما له ارتباط بالمضمون الواحد ، وأما إذا كان الإمام (ع) أو
النبي (ص) قد أعرب عن مضمونين ، فقد يختار الراوي نقل أحدهما دون الآخر ، ولا يكون
في ذلك اختلال في وثاقته .
واحتمال أن يكون لنقل المضمونين أو الحادثتين معاً دخلاً في المعنى ... غير موجود
عادة في سائر الرويات . ولكنه موجود في الروايات التي نحن بصددها ... بل هو ليس
احتمالاً فقط ، وغنما نحن نعلم بذلك لعدة أسباب ، أهمها : أننا نحتاج في بحثنا إلى
الربط بين الحوادث وتشخيص تسلسلها الزمني ، ومعرفة اتجاهات أصحابها ، ومعرفة
التخطيط الإلهي الذي يقتضي كلا منها . فإذا اطلعنا على الحادثة وحدها لم يكن إلى
فهم شيء من ذلك سبيل . وأما إذا اطلعنا عليها منضمة إلى غيرها ، أمكننا أن نتوصل
إلى ذلك .
صفحة (179)
إذن فلا بد لنا أن نضع منهجاً لتمحيص هذه الجهات السندية وتذليل مصاعبها ، وذلك ما
سنعرضه فيما يلي :
منهج التمحيص السندي :
وهو يتضمن جانبين : جانب إيجابي وجانب سلبي ، فالجانب الإيجابي يقتضي بالأخذ ببعض
الروايات والجانب السلبي يقتضي رفض الأخذ بالبعض الآخر منها .
أما الجانب الإيجابي ، فهو الأخذ من الروايات بوقوع الحادثة وصحة النقل . وبكل
مضمون مستفيض لفظاً أو معناً ، بحيث يوجب الاطمئنان من تجمع الروايات بصحة النقل
ووقوع الحادثة . وبكل مضمون اقترنت به القرائن العامة أو الخاصة ، التي توجب العلم
أو الاطمئنان بالصدق . وهذا يستدعي – في كثير من الأحيان – تجميع العديد من
الروايات والقرائن على صحة مطلب أو وقوع واقعة .
وهذا ما سنعمله في ما يلي من هذا التاريخ .
وأما الجانب السلبي : فيتلخص بضرورة رفض كل رواية لم تكن من ذاك القبيل ، وإن كانت
مما يؤخذ بها عادة بحسب الموازين العامة في سائر الروايات ، كما لو كانت الرواية
ذات سند موثوق ... فإننا لا نقبلها ما لم تقم القرائن على صحتها أو تؤيدها غيرها من
الروايات .
وبهذا التشدد السندي نستطيع أن نتلافى كل الصعوبات السابقة . إذ مع العلم أو
الاطمئنان بصدق المضمون، لا يبقى لاحتمال الوضع أثر ، كما لا يبقى لاحتمال النقيصة
في المعنى أو اللفظ أو لاحتمال تغير المعنى عند تغير اللفظ ، أي أثر . فإن كل ذلك
إنما هو حديث عن رواية واحدة لو لوحظت باستقلالها ، وأما لو انضمت إلى غيرها فلا
معنى لهذا الاحتمال .
كما أن هذا الانضمام يرفع الناحية الأخيرة التي أشرنا إليها ، وهو الجهل بترابط
الحوادث . فإن الانضمام يجعلنا عالمين بهذا الترابط كما هو واضح .
صفحة (180)
النقطة الثانية :
من مصاعب هذه الروايات : مصاعب الدلالة .
تتصف روايات التنبؤ بحوادث المستقبل ، بشكل عام ، بصعوبات في الدلالة والمضمون ،
بعد الغض عن السند ... تلك الصعوبات الناشئة من عدة مناشئ رئيسية ، يحتمل وجود واحد
منها أو أكثر في كل رواية مروية في هذا الصدد ،على ما سنرى .
وينبغي أن نتحدث أولاً ، عن السبب الذي أوجب صدور هذه الروايات عن قائليها بشكل
رمزي صعب الفهم إلى حد كبير . ثم نتحدث ثانياً عن أسباب الصعوبة بالنسبة إلى فهمنا
الخاص بعد أن تكون الروايات قد وصلت إلينا . ومن هنا يقع الحديث في ناحيتين :
الناحية الأولى :
في التحدث عن الأسباب التي دعت النبي (ص) والأئمة (ع) للتكلم عن حوادث المستقبل
بشكل أقرب إلى الغموض والإبهام . وترك السير – بتعمد واضح – في طريق التوضيح
والتفصيل .
وما يمكن أن نتصوره من أسباب ذلك ، بحسب ما نستطيع تشخيصه الآن ، يمكن إيراده ضمن
عدة أمور :
الأمر الأول :
قانون : خاطب الناس على قدر عقولهم .. هذا القانون الذي سبق أن ذكرنا إنه عرفي
وصحيح ، وقد مشى عليه النبي (ص) والأئمة (ع) في سائر كلماتهم .
فلئن كان النبي (ص) أو الإمام (ع) على مستوى إدراك الواقع التاريخي المتحقق بعد ألف
عام أو عدة آلاف من السنين ، بحيث يرى المستقبل ببعد نظره وتوفيق ربه ، كما يرى
الحاضر .. فإن البشر لم يكونوا في أي عصر من العصور على هذا المستوى من الفهم على
الإطلاق . وغاية ما نرى الحكومات الحاضرة على كثرة مفكريها ودقة سياساتها ،إنها
تستطيع أن تخطط لخمس سنوات أو عشر سنوات ، على نحو محتمل غير مضمون التطبيق الكامل،
في الأغلب .
صفحة (181)
وأما التخطيط وبعد النظر إلى مئات وآلاف السنين ، فهو خاص بالله عز وجل ومن ارتضى
من رسول ومن علمه الرسول (ص) من هذا العلم . وهو علم ضروري للأئمة المعصومين (ع) ،
كي يستطيعوا أن يأخذوا بالتخطيط الإلهي إلى حيز التنفيذ ، كما سمعنا طرفاً منه ،
وسنسمع طرفه الآخر فيما يأتي وعلى أي حال ، فالناس قاصرون دائماً عن إدراك مثل هذا
العلم وتقبل مثل هذه الأخبار ، إذن فلا بد للإمام أخذاً بقانون التفاهم العرفي أن
يببرز للناس من الحقيقة ما لا ينافر أفهامهم وما يتناسب مع واقع حياتهم . وحيث أن
الواقع المعبر عنه ، أوسع وأعمق مما يستطيعون فهمه ، إذن فلا بد من اللجوء إلى
الرمز والغموض في التعبير ، حفظاً لمستوى التفاهم العام .
الأمر الثاني :
إن هناك مصلحة مهمة في جعل الفرد المسلم منتظراً لظهور المهدي (ع) في كل حين ،
ومستعداً نفسياً لتلقي هذا النبأ الكبير ... ومن المعلوم أن النبي (ص) أو الإمام
(ع) ، لو أخبر عن الحوادث بشكل واضح ومفصل ، فإن هذا الجو النفسي يتغير إلى حد كبير
. فإن الناس سوف يصبحون عالمين بعدم قيام المهدي (ع) وظهوره ما دامت تلك الحوادث لم
تحدث .
وينحصر المحافظة على مستوى الانتظار المطلوب ، إذا كان الأخبار بالحوادث مشوباً
بالغموض والتعميم وإهمال تحديد التاريخ . بحيث يحتمل حدوث الحادثة الموعودة في أي
عصر ، فيحتمل حينئذٍ ظهور المهدي (ع) بعدها في ذلك العصر .
الأمر الثالث :
إننا نحتمل – على الاقل – أن الحوادث لو كانت قد عرضت مفصلة ، لأوجبت فشل التخطيط
الإلهي للإعداد لظهور المهدي (ع) ، لإمكان استغلال المستغلين لها قبل حدوثها ،
وإمكان تلافي ما يتوقع أن تنتجه من الظلم ، واستدرار ما يمكن أن تدره من ربح . وهذا
ليس فيه مصلحة . بل إنما يكون التخطيط ناجحاً إذا جاءت الحادثة عفوية وعلى طبق
التطور الطبيعي للتاريخ .
إذن فالإغماض عند عرض الحوادث ، يعتبر مشاركة فعلية من قبل النبي (ص) والإمام (ع)
في إنجاح المخطط الإلهي ، لإيجاد شرائط الظهور .
صفحة (182)
الأمر الرابع :
إن النبي (ص) أو الإمام (ع) إنما يذكر بعض حوادث المستقبل لمحل الاستشهاد أوعبرة أو
موعظة أو نحو ذلك . إذن فلا بد له أن يقتصر على المقدار الذي يوفي المطلوب ، ويكون
من المستهجن – عادة – الاستمرار في سرد تفاصيل الحوادث أكثر من ذلك . شأنه شأن
القرآن الكريم نفسه ، الذي اقتصر من تفاصيل القصص على موضع العبرة ومورد التربية
للسامعين ، وترك سائر التفاصيل . فكذلك الحال بالنسبة إلى النبي (ص) أو الإمام (ع)
حين يعرب عن حادثة من حوادث المستقبل .
يستثنى من هذا الوجه ، الروايات التي تكون بصدد بيان حوادث المستقبل مباشرة كذكر
أشراط الساعة أو علامات الظهور . فإن لا يكون من المستهجن في مثلها الاستمرار في
بيان الحوادث . ومعه يكون الغموض مستنداً إلى الوجوه الأخرى .
الأمر الخامس :
أمر فلسفي عقائدي ، يعود إلى النبي (ص) أو الإمام (ع) بأن يخبر بما لا يدخله المحو
والإثبات ، ويهمل ما يحتمل أن يدخله ذلك ، لاحتمال ظهور عدم مطابقته للواقع .. على
تفصيل وتحقيق ليس له مجال في المقام.
فإذا عرفنا هذه الأسباب الرئيسية للغموض والإجمال في مداليل الروايات التي نتكلم
عنها .. نستطيع أن ندخل ، ونحن على بينة من أمرنا ، في البحث عن تشخيص المناشئ
الرئيسية اللفظية او المعنوية للغموض ، لكي نعود بعدها إلى تشخيص ما يمكن أن يكون
ميزاناً لتلافي هذه المناشئ ، والخروج عن مصاعبها ، وفهم الروايات فهماً مستقيماً
صحيحاً .
مناشئ الغموض :
ويمكن عرض أهم هذه المناشئ ، فيما يلي :
المنشأ الأول :
الرمزية . والمراد بها استعمال المعنى التركيبي أو الجملي ، وإرادة معنى آخر ، غير
ما يفصح عنه اللفظ بوضوح.
وهذا هو الذي يميز الرمز عن الكناية والمجاز ، فإنها لا تكون إلا في مفردات الألفاظ
أو النسب الكلامية ، بخلاف الرمز فإنه يكون – عادة – في الجمل التركيبية .
صفحة (183)
ومن هنا يمكن أن يكتب الفرد صفحة أو عدة صفحات من الكلام ذات معان معينة ، ولكن لا
يريد الكاتب أي واحد من المعاني على التحديد ، وإنما يرمز بها إلى معان أخرى ، لا
يمكن التوصل إليها إلا عن طريق قرائن خاصة أو قرائن عامة متفق عليها .
وهذا النحو من الرمز وجد في الكلام العربي القديم . وهو شائع في هذه العصر في الأدب
، وخاصة في مدرسة (الشعر الحر) . وهو الذي يفسر لنا عدداً من موارد الغموض في تلك
الروايات .
مثاله : التعبير في الروايات بمثل قوله : تفقأ عين الدنيا أو قوله : تخرج من اليمن
نار تضيء لها أعناق الأبل في بصري . فإن كل ذلك ليس على وجه الحقيقة ، وإنما هو رمز
عن حوادث أو حركات تاريخية معينة لإيراد التصريح بها أو عرضها بشكل تفصيلي .
ومن المؤسف أن الناس حين غفلوا عن هذا المنشأ ، حملوا مثل هذه التعبيرات على
معانيها المباشرة الحقيقية . وبعدها انقسموا إلى قسمين : فهناك من الناس من يصدق
بما يسمعه ويفهمه من هذه الروايات ، ويحملها على المعجزات وخوارق العادات وإن كان
يجهل مناشئها ومصالحها . وهناك من الناس من هو مكذب لهذه المعاني ساخط عليها ، بل
على كل روايات التنبؤ بالمستقبل .
مع إن كلا المسلكين ، مما لا حاجة إلى الالتزام به . إما المسلك الأول : فلأن
المعجزات لا تكون إلا بقانون – كما سبق أن عرفنا – فلا بد من تطبيق الروايات عليه ،
قبل الالتزام بمضمونها جملة وتفصيلاً . على إننا لا يمكن أن نحمل مضمون الرواية على
المعجزة ما لم نتأكد من فهمها أولاً . وقد عرفنا إنه من المحتمل – على أقل تقدير –
أن يراد بها معان أخرى غير ما هو ظاهرها ، وقد يكون ذلك معنى لا يمت إلى المعجزة
بصلة . ولعل استبعاد الفهم الإعجازي في عدد من الحالات ، يكون قرينة على الرمزية ،
وإمكان حملها على ذلك .
صفحة (184)
وأما المسلك الثاني : فهو باطل أيضاً ، باعتباره منطلقاً من الاعتقاد بتشويش هذه
الروايات وغرابة مضامينها ، ونحن بعد أن نثبت تنظيمها وصحة مداليلها ، لا يكون لها
المسلك أي موجب . مضافاً إلى أن كثرة هذه الروايات إلى حد تفوق حد التواتر ، يمنع
من إنكارها جملة وتفصيلاً كما هو واضح .
نعم ، يبقى البحث عن الأمر المرموز إليه بهذا الرمز أو ذاك . ما هو ؟ ويكف نعرفه ؟
فهذا ما سنبحثه بعد قليل .
المنشأ الثاني :
استعمال مفاهيم معينة ذات مداليل ومصاديق خاصة ، بحسب ما يعيشه الناس في عصر صدور
الرواية . ومن المؤكد أنهم لم يفهموا منه إلا ذلك . إلا أن النبي (ص) أو الإمام (ع)
أراد منها مصاديق أخرى ، هي المصاديق والتطبيقات التي تكون لهذا المفهوم في عصر
حدوث الحادثة التي يخبر عنها .
مثال ذلك : قولهم عليهم السلام : إن المهدي (ع) يقوم بالسيف . والمراد به قوة
السلاح المناسب لعصر الظهور . على حين لم يفهم المعاصرون للنبي أو الإمام إلا السيف
نفسه .. ولعلهم أضافوا إليه في مخيلتهم الدرع والرمح أيضاً ..!
ومثاله الآخر : إخبارهم عن جيش يخسف به في البيداء ، فإنه من المؤكد أنه لم يفهم
الناس ، حين سماعهم هذا الخبر لأول وهلة ، إلا كونه جيشاً محارباً بالسيف على
الغرار القديم . مع أن مثل هذا التخيل مما لا موجب له ، بل إن الجيش محارب بسلاح
عصره لا محالة .
المنشأ الثالث :
الحذف وعدم التعرض إلى التاريخ المحدد تارة وإلى المكان أخرى وإلى أسماء الأشخاص
ثالثة .. وإلى أهداف ومناهج وإيديولوجيات الحركات الموعودة في التاريخ ، رابعة ..
وغير ذلك من الأمور . مما يجعل العلم المفصل بالحوادث متعذراً إلى حد كبير .
مثاله : التعبير بالنفس الزكية وبالسفياني ، وعدم التعرض إلى أسمائهم صراحة .
والأخبار بخروج رايات سود من خراسان ، أو بوجود طائفتين متحاربتين ودعوتهما واحدة
.. مع عدم التصريح بأن دعوة هؤلاء الناس قائمة على حق أو على باطل .. إلى غير ذلك
من الأمثلة .
صفحة (185)
المنشأ الرابع :
سبب نفسي من المطلعين على هذه الروايات من الباحثين ، يحمل الفرد على عدم الإذعان
والتصديق أو صعوبته بتحقق الحادثة أو صدق الرواية ، وإن توفرت فيها شرائط السند ،
وزالت المناشئ الثلاثة الأولى لغموض الدلالة .
وهذا الاتجاه النفسي له عدة مناشئ .. أهمها ما يلي :
أولاً : احتمال الحذف أو التغيير خلال النقل . فإن اختلال الحرف الواحد بل النقطة
الواحدة ،فضلاً عن الكلمة والأكثر، مما يخل بالمقصود ويغير المعنى .. وبخاصة في مثل
هذا الحقل من المعرفة الإنسانية .
ثانياً : استبعاد وقوع كل الحوادث المخبر بها في مجموع الروايات . فإن كثرة هذه
الروايات ، كما تجعلها متواترة نعلم بصدق عدد مهم منها .. كذلك تجعلنا نعلم أو نظن
– على الأقل – بكذب عدد آخر منها . ومن المعلوم أننا لا نستطيع أن نشخص المعلوم
الصدق من معلوم الكذب . فإن كل رواية لو أخذناها لرأيناها محتملة الصدق والكذب .
ثالثاً : عدم التأكد من مطابقة عدد من المعجزات المروية في هذه الروايات ، مع قانون
المعجزات الذي ذكرناه .. أي عدم التأكد من أن هذه المعجزات واقعة في طريق إقامة
الحجة . ومن المعلوم أنها لو لم تكن واقعة في هذا الطريق، فمقتضى القاعدة نفيها
وتكذيب راويها .
وعلى أي حال فهذه هي المناشئ المهمة للغموض والتشكيك في دلالة هذه الروايات . وهناك
مناشئ أخرى تكون في مورد دون مورد ... لا حاجة إلى التعرض لها .
منهج التمحيص الدلالي :
بعد أن عرنا هذه المناشئ الرئيسية للغموض والإبهام في روايات التنبؤ عن المستقبل ،
لا بد لنا أن نعرض منهجاً يذللها وإسلوباً من الفهم يبسط محتواها ويربط بين أجزائها
، لكي نتلافى تلك الصعوبات إلى أكبر حد ممكن .
ونبدأ أولاً بمناقشة المنشأ الرابع ، لكونه خاصاً بالسامع ، أي بأسلوب وصول
صفحة (186)
الفصل الثاني
فيما دلت عليه أخبار التنبؤ من حوادث وصفات للأفراد والمجتمع ، فيما يخص مقدار
تمسكهم بالدين وشعورهم بالمسؤولية الإسلامية عقائدياً وسلوكي
ونتكلم في هذا الفصل عن ناحيتين رئيسيتين ، من حيث استفادة التفاصيل المطلوبة من
القواعد العامة تارة ومن الأخبار الخاصة تارة أخرى .
الناحية الأولى
فيما تقتضيه القواعد العامة من شكل أوضاع المجتمع ومصيره إلى الإنحراف ،ومقدار
حاجته إلى ظهور المهدي(ع) لنشر الحق والعدل فيه .
ويتم بيان ذلك بكشف القناع عن التخطيط الالهي لليوم الموعود ، مدعماً بفلسفة ذلك
ومناشئه وآثاره . ويتوقف بيان ذلك على عدة جهات :
الجهة الأولى :في مناشيء التخطيط الالهي :
ويمكننا أن نعرض ذلك ضمن عدة نقاط:
النقطة الأولى :
إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق متفضلاً ، ولم يخلقهم عبثاً ولم يتركهم هملاً . بل
خلقهم وهو غني عنهم ، لأجل حصولهم على مصالحهم الكبرى ووصولهم إلى كمالهم المنشود ،
المتمثل بإخلاص العبادة لله تعالى . قال عز من قائل : ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلاّ
ليعبدون ﴾ (1).
صفحة (201)
إذن فالغرض من الخليقة هو الحصول على هذا الكمال العظيم المتمثل بتوجيه العقيدة
والمفهوم إلى الله عز وجل ، وقصر السلوك على طاعته وعدله في كل حركة وسكون . وإذا
نظرنا إلى حقيقة هذا الكمال من جوانبه المتعددة ، واستطعنا تحصيل الفكرة المتكاملة
عنه ، عرفنا الهدف الالهي المقصود الذي أصبح هدفاً لإيجاد الخليقة .
الجانب الأول :
إيجاد الفرد الكامل . من حيث أن قصر الإنسان نفسه على التربية بيد الحكمة الالهية
الكبرى وتحت إشرافها وتدبيرها ، يوجد فيه الإنسان العادل الكامل ، الذي يعيش محض
الحرية عن إنحرافات العاطفة والمصالح الضيقة ، والمساوق في إنطلاقه مع إنطلاقة
الكون الكبرى إلى الله عز وجل .
الجانب الثاني :
إيجاد المجتمع الكامل ،والبشرية الكاملة المتمثلة من مجموعة الأفراد الذين يعيشون
على مستوى العدل والإخلاص، والتجرد من كل شيء سوى عبادة اله تعالى ، تلك العبادة
التي تتضمن تربية الفرد والمجتمع ، والارتباط بكل شيء على مستوى العدل الالهي .
الجانب الثالث :
إيجاد الدولة العادلة التي تحكم المجتمع بالحق والعدل ، بشريعة الله الذي لا تخفى
عليه خافية في الأرض ولا في السماء . وتكون هي المسؤولة الأساسية عن السير قدماً
بالمجتمع والبشرية نحو زيادة في التكامل في الطريق الطويل غير المتناهي الخطوات .
فهذا هو معنى العبادة المقصود في الآية ، وكل ما كان على خلاق ذلك فهو تقصير في
العبادة الحقيقية تجاه الله عز وجل ، ولا يمكن أن نفهم من الآية هذا المعنى القاصر
بطبيعة الحال .
(1) الذاريات 51 / 56
صفحة (202)
النقطة الثانية :
إن الآية واضحة الظهور في أن الغاية الأساسية والغرض الأصلي من إيجاد البشرية هو
إيجاد هذه العبادة الكاملة في ربوع البشرية ، أو إيصالها إلى هذا المستوى الرفيع .
وذلك بقرينة وجود التعليل في قوله تعالى : ليعبدون ، مع الحصر المستفاد من الآية من
وقوع أداة الاستثناء (إلا) بعد النفي حين قال عز من قائل : ﴿ وما خلقت الجن والإنس
إلاّ ليعبدون ﴾ .
إذن فهذا هو الهدف الوحيد المنحصر الذي لا شيء وراءه من خلقة البشرية ، المعبر عنهم
بالإنس . وهذا الهدف ملحوظ ومخطط بشكل خاص منذ بدء الخليقة ، ويبقى ـ بطبيعة الحال
ـ مواكباً لها ما دامت البشرية في الوجود .
وهذا بالضبط هو ما نعنيه حين نقول : أن الله تعالى لم يخلق البشرية لأجل مصلحته ،
فأنه غني عن العالمين ، وإنما خلقهم لأجل مصلحتهم . وأي مصلحة يريدها الله لعباده
غير كمالهم ورشدهم وصلاحهم المتمثل بالعبادة المخصلة والتوجه إليه بالخيرات نحوه عز
وعلا .
النقطة الثالثة :
إن الغرض الالهي من خلق البشرية ، ما دام هو ذلك ، إذن فلا بد أن يشاء الله تعالى
إيجاد كل ما يحققه والحيلولة دون كل ما يحول عنه ... شأن كل غرض إلهي مهم .... فإن
الحكمة الأزلية حيت تتعلق بوجود أي شيء ، فإن تخلفه يكون مستحيلاً ، وتكون إرادة
الله تعالى متعلقة بإيجاده لو كان شيئاً آنياً فورياً ، أو التخطيط لوجوده لو كان
شيئاً مؤجلاً ومحتاجاً إلى مقدمات من الضروري أن توجد قبله .
وقد برهنا في رسالتنا الخاصة بالمفهوم الإسلامي للمعجزة أن الغرض الالهي المهم إذا
تعلق بهدف من الأهداف ، فإنه لا بد من وجود ذلك الهدف ، ولو استلزم بوجوده أو ببعض
مقدماته خرق قوانين الطبيعة ، وإيجاد المعجزات . فإن القوانين الطبيعية إنما أوجدها
الله تعالى في كونه لأجل تنفيذ أغراضه من إيجاد الخلق . فإذا توقفت تلك الأغراض على
انخرام تلك القوانين وحدوث المعجزات أحياناً أو في كثير من الأحيان .... كانت تلك
القوانين الطبيعية قاصرة عن الممانعة والتأثير .
صفحة (203)
وهذا هو الذي يلقي الضوء على الفكرة الأساسية التي يقوم عليها ( قانون المعجزات )
الذي أشرنا إليه .... ونؤجل الغوص في تفاصيل ذلك إلى رسالتنا الخاصة بها .
النقطة الرابعة :
أننا نجد بالوجدان القطعي أن هذا الغرض الالهي المهم الذي نطقت به الآية بالمعنى
الذي فهمناه ، لم يحدث في تاريخ البشرية على الإطلاق منذ وجودها إلى العصر الحاضر .
إذن فهو باليقين سوف يحدث في مستقبل عمر البشرية بمشيئة خالقها العظيم . وهذه هي
الفكرة الأساسية التي ننطلق فيها إلى التسليم بالتخطيط الالهي لليوم الموعود .
ولئن كان المنطق الأساسي في هذا البرهان هوقوله تعالى : ﴿ وما خلقت الجن والإنس
إلاّ ليعبدون ﴾...فإنه يمكن الإنطلاق إلى نفس النتيجة من آيات قرآنية أخرى نذكر
منها آيتين ، مع بيان الوجه في الاستدلال مختصراً ،ونحيل التفصيل إلى الكتاب الخامس
من هذه الموسوعة الخاص بإثبات وجود المهدي (ع) عن طريق القرآن الكريم .
الآية الأولى :
﴿ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ، كما استخلف
الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا
يعبدونني لا يشركون بي شيئاً . ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ﴾(1) .
فهذا وعد صريح من الله عز وجل ، و ﴿ إن الله لا يخلف الميعاد ﴾(2) للبشرية المؤمنة
الصالحة التي قاست الظلم والعذاب في عصور الإنحراف وبذلت من التضحيات الشيء الكثير
... بأن يستخلفهم في الأرض ، بمعنى أنه يوفقهم إلى السلطة الفعلية على البشرية
وممارسة الولاية الحقيقية فيهم .
(1) سورة النور 24 / 55 .(2) آل عمران 3 / 9 والرعد 13 / 31 وغيرهما بألفاظ مشابهة
.
صفحة (204)
فإذا استطعنا أن نفهم من (الأرض ) كل القسم المسكون من البسيطة ، كما هو الظاهر من
الكلمة والمعنى الواضح منها حملاً للأم على الجنس بعد عدم وجود أي قرينة على
انصرافها إلى أرض معينة . ومعنى حملها على الجنس : إن كل أرض على الإطلاق سوف تكون
مشمولة لسلطة المؤمنين واستخلافهم وسيحكمون وجه البسيطة .
وهذا هو المناسب مع الجمل المتأخرة في الآية الكريمة ، كقوله تعالى : ﴿ وليمكنن لهم
دينهم الذي ارتضى لهم ﴾. فإن التمكين التام والاستقرار الحقيقي للدين ، لا يكون إلا
عند سيادته في العالم أجمع . وكقوله تعالى : ﴿ وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً ﴾ ....
بعد أن نعرف أن المؤمنين كانوا قبل الاستخلاف يعانون الخوف في كل مناطق العالم
لسيادة الظلم والجور في العالم كله . فلا يكون الخوف قد تبدل إلى الأمن حقيقة إلا
بعد أن تتم لهم السلطة على وجه البسيطة كلها .
فإذا تم لنا من الآية ذلك ، ولاحظنا وجداننا الذي ذكرناه وهو أن هذا الوضع
الإجتماعي العالمي الموعد ، لم يتحقق على مدى التاريخ منذ فجر البشرية إلى عصرنا
الحاضر . إذن فهو مما سيتحقق في مستقبل الدهر يقيناً طبقاً للوعد الالهي القطعي غير
القابل للتخلف أو التمييع .
الآية الثانية :
قوله تعالى : ﴿ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره
المشركون ﴾(1) .
وهي تعطينا بوضوح ، الغاية والغرض الرئيسي من إرسال رسول الإلسام صلى الله عليه
وآله بالهدى ودين الحق. يدلنا على ذلك قوله تعالى ليظهره ، حيث دلت لام التعليل على
الغاية ، والسبب في إنزال شريعة الإسلام وهو أن يظهره أي يجعله منتصراً ومسيطراً
على غيره من الأديان والقائد كلها . وذلك لا يكون إلا بسيطرة دين الحق على العالم
كله .
وإذا كان هذا غاية من إرسال الإٍسلام ،إذن فهو يقيني الحدوث في مستقبل الدهر . لأن
الغايات الالهية غير قابلة للتخلف .
(1) التوبة : 9 / 23 والصف : 61 / 9 وانظر سورة الفتح : 48 / 28
صفحة (205)
ولئن دلت هاتان الآيتان على نفس المطلوب ... إلا أن قوله تعالى : ﴿ وما خلقت الجن
والإنس إلا ليعبدون ﴾، أهم في مقام الاستدلال على ذلك ، لأنها تدلنا على الغرض
الأسمى لخلق البشرية أساساً ذلك الغرض الذي كان موجوداً منذ بدء الخلق . بخلاف
الآيتين الأخيرتين ، فإنهما مختصتان بمضامين محدودة نسبياً ، كما يتضح لمن فكر في
مدلوليهما .
وإن هاتين الآيتين في الواقع ، من تطبيقات ذلك الغرض الأسمى الذي نطقت به ، الآية
الكريمة الأولى ، كما سيتضح بعد قليل عند معرفتنا بتفاصيل التخطيط الالهي لليوم
الموعود .
النقطة الخامسة :
إن تكامل الفرد ، وبالتالي تكامل المجتمع البشري ، يتوقف ـ بعد أن وهبه الله عز
وعلا العقل والاختيار ـ على عاملين : عامل خارجي وعامل داخلي أو قل : عامل موضوعي
وعامل ذاتي .
أما العامل الخارجي الموضوعي ، فهو إفهام الفرد ـ وبالتالي المجتمع ـ معنى العدل
والكمال الذي ينبغي أن يستهدفه والمنهج الذي يجب عليه أن يتبعه في حياته ويقصر عليه
سلوكه .
وهذا الإفهام لا يمكن صدوره إلا عن الله عز وجل ، بعد البرهنة على عدم إمكان توصل
البشرية إلى كمالها ومعرفتها بالعدل الحقيقي إذا عزلت فكرياً عن الحكمة الأزلية
الالهية ، كما صح البرهان عليه في بحوث العقائد الإسلامية . ومن ثم لا يمكن أن
يتحقق الغرض الالهي المهم في هداية البشرية وإيجاد العبادة الكاملة في ربوعها ، إذا
أوكلت البشرية إلى نفسها وفكرها القاصر ، وألقي حبلها على غاربها . إذن ، فلا بد من
أجل التوصل إلى ذلك الغرض الكبير من أن يفهمها الله تعالى معنى العدل والكمال
وتفاصيل السلوك الصالح الذي يجب اتخاذه .
وحيث أن إفهام البشرية من قبل الله تعالى بالمباشرة والمواجهة مستحيل ، كما صح
البرهان عليه في بحوث العقائد الإسلامية ، احتاجت البشرية إلى أن يرسل الله تعالى
إليها أنبياء مبشرين ومنذرين . وأن يكون إرسالهم وإثبات صدقهم طبقاً لقانون
المعجزات . لأن هذه المعجزات تقع في طريق هداية البشر والوصول إلى إيجاد الغرض
المهم من إيجادهم .
صفحة (206)
ومنه نستطيع أن نلاحظ ، كيف أن خط الأنبياء الطويل ، والأعداد الكبيرة منهم ، إنما
كان باعتبار التقديم والتمهيد للغرض الكبير . باعتبار أن البشرية حين أول وجودها
كانت قاصرة عن فهم تفاصيل العدل الكامل ، فلم يكن في الإمكان إيجاد المجتمع العادل
الكامل الموعود في ربوعها لأول وهلة . بل كان لا بد أن تتربى البشرية تدريجياً إلى
أن تصل إلى المستوى اللائق الذي يؤهلها لمجرد فهم العدل الكامل الذي يريد الله
تعالى تطبيقه في اليوم الموعود .
ومن هنا نعرف أن الأنبياء إنما تعددوا وتكثروا من أجل إعداد البشرية وتربيتها
للوصول إلى هذا المستوى اللائق ... لكي يتم لها هذا العامل الخارجي الأساسي وهو
إفهامها العدل الكامل والأطروحة النظرية التامة للعدل التشريعي الذي يريد الله
تعالى تطبيقها على وجه الأرض ، والتي بها تتحقق العبادة الكاملة التي يرضاها الله
تعالى لخلقه ، وبها يتحقق الهدف الأساسي لإيجاد الخليقة .
وأما العامل الداخلي الذاتي ، فهو الشعور بالمسؤولية تجاه الأطروحة العادلة الكاملة
، باعتبار أنها إنما تضمن العدل فيما إذا أطاعها الأفراد وطبقت في حياتهم ،وهي إنما
تضمن الطاعة التامة،مع وجود الشعور بالمسؤولية،إذن فلا بد من أجل وجود العدل أن
يوجد هذا العامل الداخلي الذاتي في الإنسان .
وإنما يوجد الشعور بالمسؤولية وينمو ، نتيجة لأسباب ثلاثة ، مقترنة :
السبب الأول :
إدراك العقل لأهمية طاعة الله والخضوع له والإنصياع إلى أوامره ونواهيه ، باعتباره
مستحقاً للعبادة مع غض النظر عن أي اعتبار آخر .
السبب الثاني :
الشعور بأهمية طاعة الله تعالى ، باعتبارها الضامن الحقيقي للعدل المطلق ، على
المستويين الفردي والإجتماعي، أو بتعبير آخر : تربية الإخلاص الذاتي لطاعة الله
باعتبار المعرفة الواضحة بضمانها للعدل المطلق .
صفحة (207)
السبب الثالث :
العامل الأخروي المتمثل بالطمع بالثواب الذي رصده الله تبارك وتعالى للمطيعين ،
والخوف من العقاب الذي توعد به العاصين والمذنبين .
وهناك فرق أساسي في طرق إيجاد هذه الأسباب . فالسببان الأول والأخير يوجدان
بالتربية النظرية فقط ، ويتحققان بمجرد الفات الفرد إليهما وتصديقه بصحتهما . وأما
السبب الثاني ، فالبرهنة النظرية عليه غير كافية بطبيعة الحال، بشكل ينتج الإخلاص
والوعي الحقيقيين والاستعداد للتفاني في سبيل العدل المطلق .... في سبيل الله تعالى
. بل يحتاج ذلك إلى تمرين طويل الأمد وتجربة وممارسة .
ومن هنا تنبثق أهمية هذه التجربة والممارسة في تربية الإخلاص بشكل خاص ، والتكامل
بشكل عام ... بصفة إحدى المقدمات الأساسية والأسباب الرئيسية لإيجاد المجتمع العادل
، الذي يتحقق فيه الغرض الأساسي لإيجاد البشرية .
النقطة السادسة :
إن التجربة والممارسة التي عرفنا أهميتها في تربية الإخلاص والإندفاع إلى الطاعة ،
إذا لاحظناها على أساس فردي لم تكتسب أهمية أكثر من انتاج الإخلاص والتكامل للفرد
الواحد . وأما إذا لاحظناها على أساس عام ، وقلنا أن المجتمع بصفته مكوناً من أفراد
، والأمة بصفتها مكونة من مجتمعات ، يجب أن تمر بدور التربية والتجربة التي تنمي
فيها روح الإخلاص والطاعة تجاه تعاليم الله عز وجل .
إذن تكتسب تربية الأمة والتجربة التي يجب أن يمر بها الأمة نفس الأهمية الكبرى ،
باعتبارها مقدمة حقيقية للغرض الالهي الكبير من إيجاد الخليقة . فإذا علمنا ـ كما
سبق ـ أن الله تعالى يفعل أي شيء يكون مقدمة لوجود غرضه الأساسي .... إذن فهو ـ بكل
تأكيد ـ سوف يخطط لتربية الأمة على هذا الطريق .
وقد يخطر في الذه هذا السؤال : إن هذه التربية حين تكون مقدمة للغرض الالهي ، ويكون
الغرض مهماً بحيث عرفنا أنه يمكن إقامة المعجزات في سبيل التمهيد إليه . فلماذا لا
توجد هذه التربية في ربوع الأمة دفعة واحدة عن طريق المعجزة ؟
صفحة (208)
والجواب على هذا السؤال يكون من وجوه ثلاثة :
الوجه الأول :
إن إيجاد الإيمان والإخلاص في أنفس الأفراد بطريق المعجزة ، يؤدي بنا إلى القول بأن
الله تعالى يجبر الأفراد على الطاعات وترك المعاصي وهذا مبرهن على بطلانه وفساده في
بحوث العقائد الإسلامية .
الوجه الثاني :
إن هذا الأسلوب المقترح من المعجزة ينافي قانون المعجزات ، إذن فلا يمكن وجود مثل
هذه المعجزة .
والسبب في ذلك هو أن قانون المعجزات ، كما عرفناه ، يقضي بعدم قيام المعجزة ما لم
يكن قيامها طريقاً منحصراً لإقامة الحجة وهداية البشرية . وأما إذا كانت للنتيجة
المطلوبة أساليب طبيعية غير إعجازية ، كان عدم قيام المعجزة حتمياً ، وأوكل الله
تعالى إيجاد النتيجة إلى أسبابها الطبيعية نفسها ، مهما طال الزمن بهذه الأسباب
والنتائج. فإن الله تعالى طويل الانات ولا يفرق في ذاته مرور الزمان .
فإذا طبقنا ذلك على مورد حديثنا ، وجدنا أن لتربية الأمة أسباب طبيعية سوف نعرض لها
في النقطة الآتية ، يمكن أن تنتج نتائجها خلال زمان طويل . ومعه يكون عدم قيام
المعجزة لإيجاد تلكم النتائج الحتمية .
الوجه الثالث :
أننا لو تنزلنا ـ جدلاً ـ عن الوجهين السابقين. وقلنا بإمكان تربية الأمة عن طريق
المعجزات . فيكون الأمر دائراً ومردداً بين تربية الامة عن هذا الطريق أو تربيتها
عن الطريق الطبيعي . عندئذ يمكن القول : أن الأهداف التربوية التي يمكن إيجادها
بالطرق الطبيعية أفضل بكثير من الأهداف التربوية التي يمكن إيجادها بالمعجزات . ولا
تتحقق العبادة الكاملة المطلوبة لله عز وجل إلا باختيار أفضل الفردين . ومن هنا لا
بد من الالتزام بعدم قيام المعجزات لأنها الطريق الأردأ في تربية الأمة .
صفحة (209)
والسبب في ذلك : هي أن التربية إن وجدت بطرقها الطبيعية ، كانت متضمنة لمرتبة عالية
من الرشد والنضج من الناحية السلوكية والعقائدية ، لأن من الطرق الطبيعية للتربية ـ
على ما سنعرف ـ التمحيص والاختبار ، والمرور بالتجارب القاسية . فإذا خرج الفرد من
التمحيص والتجربة ناجحاً منتصراً ، كان إخلاصه قد اكتسب نضجاً ورشداً لم يكن في
السابق ، باعتبارأن الفرد أصبح يعرف ما هي ردود الفعل المطلوبة تجاه المصاعب ، وما
هي قيمة العدل في حل مشاكل البشرية بإزاء الحلول الأخرى الفاشلة التي عرضها الآخرون
. وكل ذلك لا يكون إلا خلال ردح طويل من الزمن .
بخلاف المعجزة ، فإنها إن أحدثت المجتمع الصالح ، فإنها لا يمكن أن توجد نضجه ورشده
بأي حال ، بل سوف يكون مجتمعاً فجاً وعدلاً صورياً بطبيعة الحال . ما لم تفترض أمور
أخرى إضافية كنزول الوحي على كل أفراد الأمة ... أو نحو ذلك مم الم تقم عليه الدعوة
الالهية على طول خط التاريخ الطويل .
النقطة السابعة :
في محاولة التعرف على الأسباب الطبيعية للتربية وإيجاد الإخلاص .
تتوقف التجربة والممارسة التي يجب أن تمر بها الأمة في تربيتها الطويلة ... على أحد
عاملين :
العامل الاول :
التطبيق الفعلي الحي للمجتمع العادل المطلق ، حتى يراه الناس ويحبوه ويقدموا مصالحه
العامة على مصالحهم الخاصة . فإن شعور الناس بوجود العدل المطلق مبطقاً على وجه
الأرض ، يكفي بمجرده في توجيه عواطف الناس وصهر إخلاصهم إلى حد بعيد .
صفحة (210)
العامل الثاني :
مرور الأمة خلال تربيتها بعوامل صعبة وظروف ظالمة عسرة ، تجعلها تتوفر شيئاً فشيئاً
على التعمق الفكري والعاطفي ، وتصوغ منها في نهاية المطاف أمة شاعرة بالمسؤولية
قوية الإرادة والعزم على تطبيق الأطروحة العادلة الكاملة .
وذلك بعد أن تعيش الأمة الشعور بأمرين مقترنين :
أحدهما : الشعور بأفضلية الأطروحة العادلة ، لا بشكل نظري فحسب ، بل بشكل حسي معاش
. بعد أن تمت المقارنة لدى الأمة بكل وضوح بين هذه الأطروحة وبين سائر النظم
والقوانين والنظريات المخالفة لها . وثبت بالتجربة فشل سائر النظم والنظريات ،
وأدائها إلى أنواع مختلفة من الظلم والتعسف . باعتبار النقص الذاتي الموجود في سائر
النظم ، ذلك النقص الذي تبرأ منه وتعلو عليه الأطروحة الكاملة .
ثانيهما : الشعور بأهمية التضحية الحقيقية على مختلف المستويات في سبيل الأطروحة
الكاملة التي يؤمنون بها . والإحساس المباشر بلزوم الصبر والمثابرة والصمود أمام
القوى الظالمة تمسكاً بالحق .
وبالرغم من صحة العاملين كليهما وأثرهما الأكيد في تربية الأمة . إلاّ أننا إذا
فرضنا كلاً منهما معزولاً عن الآخر، نجد أن العامل الثاني أهم من الأول من جهتين
أساسيتين :
أولاً : إن محبة الأطروحة العادلة والإخلاص لها عند تطبيقها ، أمر موافق للهوى
والمصالح الشخصية ، لأنها تضمن للإنسان سعادته ورفاهه الفردي والإجتماعي .
وأما محبة الأطروحة العادلة في ظروف الظلم والتضحية ، فهي محبة واعية عميقة تدفع
الإنسان إلى المكافحة والجهاد في سبيل إيجاد الواقع الإجتماعي العادل .
ومن المعلوم أن المحب المخلص على الشكل الأول ، إذا لم يمر بتجارب التضحية ، يكون
مهدداً بالإنحراف والإرتداد عند مواجهة أول صعوبة يجابهها ، يشعر خلالها بالتنافي
بين مصالحه الخاصة والمصالح العامة . فإذا كانت هذه الظاهرة عامة بين الأفراد ...
لم يكن ذلك التطبيق قابلاً للاستمرار والبقاء . ولا يمكن أن تكون هذه الظاهرة عامة
بأي حال لو كان الإخلاص ناتجاً عن تضحية وصمود .
صفحة (211)
ثانياً : نعرف مما تقدم أن العامل الثاني يجب أن يكون متقدماً زماناً على العامل
الأول ، باعتبار توقف التطبيق الحقيقي عليه . فإن العدل لا يكون عميقاً وأساسياً في
المجتمع ، ما لم يكن كل الأفراد أو جلهم ـ على أقل تقدير ـ ممن شحذت اخلاصه التجارب
ورفعت إيمانه وإرادته التضحيات ، فإنهم يكونون أقدر على العمل وأسرع انتاجاً وأكثر
تحملاً للصعوبات ، مما يجعل العدل أعمق أثراً وأضمن للبقاء والاستمرار .
إذن فالغرض الالهي في إيجاد البشرية ، يتوقف وجوده على الإخلاص المنصقل بالتجارب
والتضحيات . ومن المعلوم أن هذا الصقل لا يمكن حصوله إلا بالمرور في تيار التجارب
والتضحيات نفسه . وهذا التيار ليس إلا الظروف الصعبة والأزمنة المظلمة الظالمة التي
تمر بها البشرية خلال الأجيال .
إذن يتبرهن بكل وضوح توقف الغرض الالهي في هداية البشر وإيجاد مجتمع العبادة
الكاملة ... على مرور البشرية في ظروف صعبة ظالمة ، ليكونوا عند ابتداء التطبيق على
مستوى المسؤولية المطلوبة للعدل ، ويستطيعون بجدارة القيام به وبسهولة الانسجام معه
.
النقطة الثامنة :
أنه من هذا المنطلق بالذات نعرف أهمية التمحيص والاختبار الذي دلت عليه الأخبار ،
كما سوف نسمع ، وارتباطه الأساسي بالتقديم للهدف الالهي الكبير :
باعتبار أن ما تعيشه البشرية من ظروف ظالمة من ناحية وأمور مغرية من ناحية أخرى
.... وكم للخوف والإغراء من قوة في الإندفاع ومن تأثير على النفس ... فيكون ذلك
حاملاً للفرد على الإنحراف عن الله تعالى والخروج على تعاليمه العادلة. ويصبح تطبيق
هذه التعاليم على نفسه وغيره من أصعب الامور ، كما قد وصف في بعض الأخبار ، بأنه
كالقبص على الجمر .
ومن هنا تكون هذه الظروف ومحاولة هذا التطبيق محكاً أساسياً لمدى الإخلاص وقوة
الإرادة لدى الأفراد . فينهار العدد الإغلب من البشر في أحضان الظلم والإغرا ،
تبعاً لضعف إرادتهم ، وتقديم مصالحهم الشخصية وراحتهم القريبة على الأهداف الكبرى
والغايات القصوى .
صفحة (212)
ويبقى العدد الأقل صادمين مكافحين ، تشتد إرادتهم وتقوي عزيمتهم ، ويشعرون باللذة
والفخر في مكافحة تيارات الإنحراف والفساد . ولا يزالون في تكامل وصمود حتى يبلغوا
مستوى المسؤولية الكبرى في مواجهة العالم بالعدل المطلق في اليوم الموعود .
ويكون العالم عند تمخض قانون التمحيص هذا عن نتائجه كما نطقت به الأخبار ...
متكوناً من فسطاطين أو معسكرين : فسطاط كفر لا إيمان فيه وفسطاط إيمان لا كفر فيه .
على ما سنسمع في الناحية الثانية من هذا الفصل .
فإن قال قائل : كيف يمكن التوفيق بين ما قلناه قبل قليل من لزوم كون الأمة بشكل عام
، المتمثلة في أكثر أفراده، مخلصة إخلاصاً حقيقياً نتيجة للتجربة والتمحيص . وبين
ما قلناه الآن من أن أغلب الناس سوف ينهارون تجاه الظلم والإغراء ولا يبقى من ذوي
الإخلاص الحقيقي إلا القليل .
نقول في جواب ذلك : أنه يمكن القول أن النتائج الصالحة للتمحيص لا تختص بالقليل من
البشر ، وإن اختص هؤلاء بدرجات رفعية من الإخلاص لا يضارعهم بها غيرهم من الناس .
فإننا يمكن أن نرتفع بنتائج التمحيص ، من الزاوية التي نتوخاها الآن ، إلى أربع
درجات :
الدرجة الأولى :
الإخلاص التام والوعي الكامل . الذي يتمثل باستعداد الفرد بالتضحية بكل عال ورخيص
على الإطلاق في سبيل العدل الالهي وتطبيق تعاليم الرب العظيم وأهدافه الكبرى .
ويكون مثل هذا الفرد مؤهلاً لنيل بعض درجات القيادة والسلطة العسكرية أو المدنية في
اليوم الموعود .
الدرجة الثانية :
الإخلاص الثابت المهم الذي يتمثل في قدرة الفرد على السيطرة بإرادته على كل صعوبة
وإغراء مر به في حياته ، من درجات الخوف والطمع المعروفة . بغض النظر عن أنه لو مر
في حياته بدرجة أعلى من التمحيص والمصاعب فهل يستطيع النجاح أيضاً أو لا . وهذا هو
الذي يفرق هذه الدرجة عن سابقتها .
صفحة (213)
وهذه الدرجة هي التي تؤهل الفرد لأن يكون واحداً من القواعد الشعبية الصالحة لدولة
الحق في اليوم الموعود . أو أن يكون جندياً خلال الفتح العالمي في ذلك اليوم .
الدرجة الثالثة :
الإخلاص الإقتضائي : وهو أن يكون الفرد محباً للحق والعدل الالهي في دخيلة نفسه
ومسايراً لظروف الظلم أو الإغراء إلى حد ما أيضاً .
فإننا نجد في كثير من الأفراد انفكاكاً بين العقيدة والسلوك . فبينما نجد عقيدته
صالحة نجد سلوكه منحرفاً نتيجة لاضطراره وظروفه الشاذة واحتياجه إلى لقمة العيش .
وهو في ذات الوقت من الممكن أن يكون مدركاً لمعنى الظلم وفظاعته ، وللمسؤولية تجاه
تعاليم الله العادلة . ولكنه يشعر بالقصور عن تطبيقها نتيجة لظروف الضغط والظلم
التي يعيشها . ومن ثم فهو يدفن عقيدته ووعيه في قلبه ويساير الظلم والإغراء إلى بعض
الخطوات .
ويمن في حق مثل هذا الفرد ، أنه بمجرد أن ترتفع ظروف الظلم ويبدأ التطبيق العادل
... فإنه سوف ينطلق إخلاصه الاقتضائي الكامن ، بعد أن ارتفع عنه المانع ، ويكون له
حركة فعالة في المشاركة والتعاون في ظروف التطبيق الجديد .
الدرجة الرابعة :
أن لا يوجد الإخلاص بأي درجة من درجاته السابقة . ولكن يكون الفرد قد شعر بوضوح
نتيجة لظروف التمحيص العالمي ، بفشل التجارب التي عشاتها المبادئ والفلسفات التي
ادعت حل مشاكل العالم وتذليل مصاعبه ونشر العدالة والرفاه في ربوعه . فإن هذه
المبادئ بعد أن تعيش التجربة والتطبيق ، وتتمخض عن نتائجها الرئيسية ، سوف يبدو
بوضوح للأعم الأغلب من البشر أنها لم تتمخض إلا عن الفساد والضياع نتيجة لقصورها
الذاتي ، كما سبق أن أشرنا ، وقد أضافت إلى مشكلات العالم لا أنها قد ذللت منها
شيئاً .
عندئذ ينبثق شعور خفي ، في اللاشعور ، بالحاجة العالمية الماسة إلى الحل الناجز
الذي ينقذ العالم من ورطته ويخرجه من وهدته ويوقظه من رقدته .
صفحة (214)
وهذا الحل ، وإن لم يكن ملتفتاً إليه بوضوح أو معروف بتفاصيله . ولكنه على أي حال ،
توقع نفسي غامض يمكن انطباقه على أول دعوة رئيسية جديدة تدعي حل مشاكل العالم
وتذليل مصاعبه . ومن هنا تفوز مثل هذه الدعوة بتأييد كل من يمثل هذه الدرجة من
نتائج ريثما كانت هذه الدعوة محتملة الصدق على أي حال .
فإذا كانت هذه الدعوة هي دعوة الحق ، في يومها الموعود ، فسيكون لهذا الجو النفسي
العالمي أثره الكبير في دعم التطبيق العادل ، في ذلك اليوم .
فهذه هي الدرجات الأربع التي يتمخض عنها التمحيص الالهي الكبير في عصر ما قبل
الظهور . والتي تشارك ، بشكل وآخر في بناء العدل في اليوم الموعود .
ونحن نستطيع أن نلاحظ بوضوح أن هذه الدرجات كلما ارتفعت قلَّ الأفراد المتصفون بها
من البشر ، وكلما نزلت كثر الأفراد المتصفون بها بطبيعة الحال . ومن هنا كان
المتصفون بالدرجة الأولى من الإخلاص قليلين في البشر . وهم الذي سبق أن برهنا على
أن الإمام المهدي (ع) يمكن أن لا يحتجب عنهم خلال غيبته الكبرى . كما كان المتصفون
بالدرجة الرابعة ، هم أكثر البشرية في العصر المباشر لما قبل الظهور . وتختلف
الدرجتان الثانية والثالثة فيما بين هذين الحدين من العدد .
ومن هنا نستطيع أن نقول لمن يوجه السؤال السابق: أن الدرجات الصالحة الناتجة عن
التمحيص الالهي تمثل بمجموعها عدداً كبيراً من البشر ، بل الأعم الإغلب منهم . وليس
العدد قليلاً كما تخيله السائل . وإنما العدد القليل منحصر بالدرجة العليا من
الإخلاص ، وهو مما لا يؤثر على التطبيق العادل الموعود شيئاً ، باعتبار أن الأفراد
الذي يمثلون هذه الدرجة ، سيكونون بالمقدار الكافي الذي يقومون خلاله بمسؤولية
القيادة الناجحة في اليوم الموعود . وليس من المتوقع من كل البشر أن يكونوا قواداً
، بطبيعة الحال ! ....وعلى أي حال ، فقد اتضحت من هذه النقاط الثمان ، المناشئ
الحقيقية للتخطيط الالهي لهداية البشر وتحقيق العبادة التامة في ربوعهم . كما اتضح
البرهان على وجود هذا التخطيط ، حيث يحتاج الأمر إلى مقدمات طويلة وطبيعية غير
اعجازية . كما اتضحت جملة من ملامح هذا التخطيط ، وما يلعبه الظلم والإنحراف الذي
تعانيه البشرية على مدى التاريخ ، من دور في هذا التخطيط الالهي الكبير .
صفحة (215)
وبقي علينا أن نعرف تفاصيل أعمق وأكثر عن هذا التخطيط ، خلال الجهات الآتية ،
شروعاً بما قبل الإسلام وانتهاء بالعصر الحاضر .
الجهة الثانية :
التخطيط الالهي قبل الإسلام .
والمراد به الجزء الذي يعود إلى الفترة السابقة على الإٍسلام من عمر الخليقة ، منذ
دخلت عهد الفهم والإدراك إلى حين بعثة نبي الإسلام صلى الله عليه وآله .
وذلك : إن التخطيط الالهي الشامل لليوم الموعود ، بدأ بوجود الخليقة نفسها ، لأنه
يعبر عن أسلوب تحقيق الغرض الأساسي من إيجادها . إذن فقد كان هذا التخطيط مستمراً
قبل الإٍسلام وبقي مستمراً بعد الإسلام ، وسيبقى نافذاً إلى يوم يتحقق به اليوم
الموعود بتطبيق الأطروحة العادلة الكاملة .
وينبغي أن ننطلق في الحديث عن ذلك ضمن عدة نقاط :
النقطة الأولى :
في مشاركة الأنبياء إجمالاً في هذا التخطيط .
وهو ما سبق أن حملنا عن ذلك فكرة مختصرة ، وينبغي لنا أن نحمل الآن فكرة تفصيلية عن
السر الأساسي لذلك:
إن البشرية في مبدأ أمرها لم يكن يتوفر لديها ، بطبيعة الحال ، الشرط الأول والثاني
، السابقين ، من شرائط تطبيق العدل الكامل (1) . فهي لا تعرف ما هو ما هو العدل
الكامل ، ولا هي مخلصة له أو مستعدة للتضحية في سبيل تطبيقه لو عرفته .
ـــــــــــــ
(1) أما الشرط الثالث وهو معرفة الثواب والعقاب الآخرويين فقد كان متوفراً بشكل
وآخر في دعوات الأنبياء . فالمهم إذن هو الحديث عن الشرطين الأولين .
صفحة (216)
فكان لا بد لها ـ كجزء من التخطيط ـ أن تمر بتربية طويلة الأمد من كلتا هاتين
الناحيتين . فكان أن تكفل الأنبياء هذه المهمة ، وهي تربية البشرية لتكون صالحة
لفهم العدل الكامل . فكان كل نبي يشارك مشاركة جزئية قليلة أو كثيرة في ذلك ، سواء
علم الناس ، بذلك في عصره أو جهلوه . لأن المهم هو تربيتهم الفكرية ، وليس المهم
الفاتهم بوضوح إلى هذا التخطيط .
وهذه التربية قد انتهت ، واستطاعت البشرية ـ في نهاية المطاف ـ أن توفر الشرط الأول
، فأصبحت قابلة لفهم الأطروحة العادلة الكاملة ، فأرسل الله تعالى إليها تلك
الأطروحة متمثلة بالإسلام . وبذلك تحقق الشرط الأول .
ولم تستطع البشرية إلى حد الآن أن توفر الشرط الثاني وهو استعدادها للتضحية في سبيل
تطبيق العدل ، وهي على أي حال في طريق التربية على ذلك .
وكان كل نبي بطبيعة الحال ، بما فيهم نبي الإسلام (ص) يقرن تربيته الفكرية للناس
بالتربية على الشرط الثاني أيضاً بمعنى إيجاد الإخلاص والاستعداد للتضحية في نفوس
البشر . فكانت مشاركة الأنبياء في التربية الأولى متمثلة بما بلغوا من أحكام ،
وكانت مشاركتهم في التربية الثانية متمثلة بما قدموا من تضحيات ودماء .
إلا أن التربية الأولى أنتجت نتيجتها الكاملة ، على حين لم تنتج التربية الثانية
نتيجتها إلا في القليل من الناس . وذلك لمدى الضغط والإغراء الذي يوجهه الناس نحو
الإنحراف من داخل نفوسهم وخارجها ، على طول خط التاريخ، مما يجعل الحق في أفواههم
مراً وتحمل العدل عليهم صعباً .. وينتج في نهاية المطاف بطء التربية على الإخلاص
وصعوبتها .
النقطة الثانية :
لم يكن الأنبياء ليسكتوا عن تبليغ الناس ، بشكل وآخر ، بالغرض الأساسي من إيجاد
البشرية . متمثلاً بإعلامهم أن هناك يوماً يأتي في مستقبل الزمان يسود فيه العدل
الالهي المطلق ويرتفع فيه كل ظلم وجور . ولا زلنا نسمع صدى هذا التبليغ متمثلاً
باعتقاد عدد من الديانات السماوية بذلك وإيمانها به ، وإن اختلفت في تسمية القائد
الذي يتولى ذلك التطبيق الكبير .
صفحة (217)
ولكن حيث لم يكن هذا اليوم الموعود بقريب ، ولم يكن قد تحقق الشيء المهم من شروطه
.. لم يكن من اللازم إعطاء التفاصيل أكثر من هذا المقدار المجمل القليل . ومن هنا
نرى أن التبليغات السابقة على الإسلام لم تكن واضحة وكافية لاجتثاث جذر الخلاف في
ما تعتقده الديانات من تفاصيل اليوم الموعود .
ومعه فمن الممكن القول أن المقدار المشترك بين هذه الأديان من الاعتراف باليوم
الموعود ، أمر حق ناتج عن تبليغات الأنبياء عليهم السلام . وأما التفاصيل المختلف
بشأنها على مستوى هذه الديانات كتسمية القائد وغير ذلك، فهي أمور مضافة غلى تلك
التعاليم من قبل الفكر البشري المنفصل عن إلهام السماء .
ومن هنا نستطيع أن نفسر اتفاق الأديان على ذلك ، منسجماً مع الغرض الأصلي لإيجاد
الخليقة . ونجيب بذلك على ما يذكره بعض المستشرقين المغرضين ، من أن بعض هذه
الاديان عيال على البعض الآخر في ذلك و وأن الاعتقاد باليوم الموعود راجع إلى بعض
الأديان القديمة الموروثة ... وهو اعتقاد كاذب في رأي هؤلاء المغرضين .
بل هو اعتقاد صادق ، اتفقت عليه الأديان باعتبار سبب واحد هو الوحي الالهي . وكلها
تشير إلى أمر واحد هو الغرض الأساسي من إيجاد الخليقة ، الذي عرفنا أن يكون من
الطبيعي وجوده منذ ولادة البشرية ، وتبليغه إلى الناس من أول عهود النبوات .
كما نستطيع بذلك أن نجيب على كلام آخر يقوله بعض المرجفين ، من أن الاعتقاد باليوم
الموعود ، ناشئ من شعور البشرية بالظلم وتوقانها إلى ارتفاعه وسيادة العدل على
الارض .
فإننا عرفنا السبب الحقيقي لوجود هذا الاعتقاد . ومن الواضح أن مجرد التوقان إلى
العدل لا يصلح سبباً له ، لأن الفرد أو المجتمع إذا أمل ارتفاع الظلم عنه ، فإنما
يود أن يحدث ذلك في الزمن المعاصر القريب ، لكي يستفيد منه بشكل وآخر . وأما
الاعتقاد بوجود اليوم الموعود في أجيال غير معاصرة فهذا مما لا يعود بالمصلحة إلى
أي فرد معين ، لكي نحتمل أنه ناشئ من ظروف الظلم والمصاعب . فضلاً عما إذا اقترن
بهذا الاعتقاد كون التقديم إليه لا يكون إلا بمرور البشرية بالمشاكل والمظالم . كما
نريد البرهنة عليه . فأنه في واقعه اعتقاد بزيادة الظلم والمشاكل على البشرية في أي
جيل معاصر ،وليس توقاناً إلى العدل العاجل بأي شكل من الأشكال .
صفحة (218)
ومن هنا انحصر السبب في وجود الاعتقاد القديم باليوم الموعود ، بتبليغ الأنبياء
الناشئ من إلهام السماء .
وإذا طبقنا ذلك على عقيدتنا في المهدي ، كما تم عليها البرهان الصحيح ، استطعنا أن
ندرك بسهولة ووضوح ، كيف أن المهدي (ع) هو القائد المذخور من قبل الله عز وجل
لتحقيق الغرض الأساسي من الخليقة ... وإن عدداً من الأنبياء السابقين قد أخبروا عن
ظهوره ، فضلاً عن نبي الإسلام (ص) الذي تواتر عنه النقل في ذلك . وإنما كان
الاختلاف في تسميته نتيجة لاختلاف اللغات ، أو للانحراف الناشئ عند أهل الأديان بعد
ذهاب أنبيائهم .
النقطة الثالثة :
لم يكن بالإمكان أن يتخذ أي نبي من الأنبياء موقف القائد للتطبيق الأساسي العام
لهداية البشر ، أويتكفل إيجاد اليوم الموعود . ولم يكن ذلك داخلاً في التخطيط
الالهي أصلاً . لعدم توفر أي من الشرطين الأساسيين السابقين :
أما بالنسبة إلى اشتراط أن تكون الأمة على مستوى الإخلاص والاستعداد للتضحية في
سبيل التطبيق العادل ... فعدم توفره في الأمم السابقة على الإسلام واضح جداً .
وحسبنا أن نستعرض النصوص الواردة في الأنبياء المشهورين ، لنعرف حال البشرية في
عصورهم وفي ما بين ذلك من الدهر . فإنه إذا لم يستطع النبي منهم أن يرفع مستوى
الإخلاص إلى الدرجة العليا في زمانه ، فكيف سوف يحدث بعد وفاته ؟
﴿ أما آدم عليه السلام فقد عصى ربه فغوى ﴾ ، كما نص على ذلك التنزيل (1) وقال عنه :
﴿ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماً ﴾(2) . وبدون هذا العزم المطلوب
لا يمكن وجود اليوم الموعود .
ــــــــــــــ
(1) ط . 20 / 121 . (2) نفس السورة : 115 .
صفحة (219)
وأما نوح عليه السلام ، فقد قضى المئات من السنين مرشداً واعظاً ، فلم يؤثر في
الناس أثراً محسوساً حتى شكا إلى الله تعالى قائلاً : ﴿ ربِّ إني دعوت قومي ليلاً
ونهاراً ، فلم يزدهم دعائي إلى فراراً . وإني كلما دعوتهم لتغقر لهم جعلوا أصابعهم
في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكباراً ﴾(1) . حتى اضطر إلى أن يدعو
عليهم بالهلاك ، فاستجاب الله تعالى دعاءه وأغرقهم بالطوفان . وليس هناك وضوح في
النصوص التاريخية في تحديد مقدار ما استطاع نوح عليه السلام اكتسابه من المؤمنين
بعد الطوفان .
وأما إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام ، فقد كان أكثر من سابقيه تأثيراً في توجيه
الناس واكتساب إيمانهم وثقتهم به . ولكنه مع ذلك لم يستطع الوصول بالأمة إلى
المستوى المطلوب في العدل المطلق . حبسنا من ذلك أنه في أول عهده ألقي في النار ولم
يوجد في المجتمع شخص معترض أو مستنكر ولو من الناحية الإنسانية المحضة !... ثم أنه
بعد فترة غير قليلة من نبوته ، وضع زوجته وولده في واد غير ذي زرع ، ولمن يكن لديه
شخص مخلص يضمه إليهما يدفع عنهما ألم الجوع والعطش وخوف السباع والهوام . فاكتفى
إبراهيم (ع) بالدعاء لهما وتركهما وذهب .
فكان الله تعالى حافظاً لهذه الأمانة التي أودعت عنده ، فجعل أفئدة من الناس تهوي
إليهم . ولولا ذلك لكانا من الهالكين .
وأما الامة التي بعث فيها موسى بن عمران عليه السلام ، فحدث عنها ولا حرج ، من حيث
التمرد على نبيها وعدم الشعور بالمسؤولية تجاه دينها . وكان المنطق القائل : ﴿ إذهب
أنت وربك فقاتلا أنّا ههنا قاعدون ﴾(2) . هو المسيطر على أذهانهم ومعنوياتهم .. فهم
على غير استعداد أن يبذلوا أن شيء في سبيل نبيهم وعقيدتهم .
وأما عبادتهم للعجل ردحاً من الزمن ، ومطالبتهم برؤية الله تعالى جهرة ، ومراجعتهم
في شأن البقرة التي أمروا بذبحها ، وغير ذلك من الحوادث ... فهي أوضح من أن تذكر .
ــــــــــــــ
(1) نوح 71 / 5 ـ 7 (2) المائدة : 5 / 34 .
صفحة (220)
وأما المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ، فحسبنا شاهداً على حال أمته ، أن الحواريين
، وهم طلابه وخاصته واجهوه بهذا الكلام : " يا عيسى بن مريم ، هل يستطيع ربك أن
ينزل علينا مائدة من السماء " تشكيك صريح في قدرة الله تعالى .
ومن ثم أجابهم : ﴿ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين . قالوا : نريد أن نأكل منها
وتطمئن قلوبنا ونعلم إن قد صدقتنا ونكون علينا من الشاهدين ﴾(1) . إذن فهم لم
يطمئنوا به بعد ، ولم يعلموا بصدقه . فإذا كان هذا هو مستوى خاصته وطلابه ، فكيف
حال سائر أفراد الأمة والمجتمع .
إذن ، فلم يكن يوجد في الناس على طول التاريخ ، ذلك المستوى العظيم من الإخلاص الذي
يمكن به بناء العدل المطلق في اليوم الموعود ، وإذا كان هذا الشرط غير متوفر ،
فماذا ترى الأنبياء صانعين ، حين يجدون أممهم على هذا المستوى المنخفض من الإخلاص ؟
كيف وقد عرفنا فيما سبق ، أن هذا الشرط غير متوفر إلى حد الآن ،وأن البشرية لا زالت
في طريق التربية ، لكي يتوفر في ربوعها في يوم من الأيام .
وأما بالنسبة إلى الشرط الآخر وهو علم الأمة أو البشرية بالأطروحة العادلة الكاملة
المأمول تطبيقها في اليوم الموعود ... فمن الواضح أن تلك الأطروحة لم تكن ناجزة
،ولمن يكن البشر على مستوى فهمها على الإطلاق . ويمكن أن يتم بيان ذلك ،باستعراض
فترات التاريخ إجمالاً أيضاً .
أما الأنبياء السابقين على موسى بن عمران عليه السلام ، فلم يكن هدفهم إلا ترسيخ
العقيدة الالهية ، وتوضيحها بالتدريج ، من دون أن يكون لهم تعاليم تشريعية كثيرة .
حتى تكللت تلك الجهود بجهود إبراهيم الخليل عليه السلام الذي أوضح عقيدة التوحيد
بشكل مبرهن وصحيح . إذن فلم يكن هناك تشريع مهم فضلاً عن افتراض وجود الأطروحة
العادلة الكاملة التي تتكفل التشريع لكل جوانب المجتمع .
ـــــــــــــــ
(1) نفس السورة : 122 ـ 113.
صفحة (221)
وأما الفترة التي تبدأ بموسى بن عمران عليه السلام وتنتهي ببعثة الرسول الأعظم (ص)
... فلا شك أنها كانت فترة شرائع تفصيلية ، نزلت بها التوارة والإنجيل عن الله عز
وجل . ولكنها كانت شرائع تربوية لأجل الوصول والإعداد إلى فهم البشرية للأطروحة
الكاملة ، ولم تكن ممثلة لتلك الأطروحة نفسها .
ويمكن الاستدلال على ذلك بثلاثة أدلة :
الدليل الأول :
أننا كمسلمين ، نعلم بأن التشريعات السابقة على الإسلام ليست هي الاطروحة الكاملة ،
جزماً . لأن معنى الإيمان بالإسلام ، هو كونه ناسخاً للشرائع السابقة عليه وملغياً
لأحكامها عن مسؤولية البشر . فلو كانت إحدى تلك الشرائع هي الأطروحة الكاملة
المأمولة ، لوجب إبقاءها سارية المفعول إلى حين اليوم الموعود ، لكي يتربى الناس
على تقبلها والتضحية في سبيلها ، على ما سوف نعرف بالنسبة إلى الأطروحة الكاملة .
فلو نسخت تلك الشريعة المفروضة لكان ذلك مخالفاً للغرض الالهي المطلوب ، فيكون
مستحيلاً . ولكنها نسخت فعلاً ، كما نعتقد نحن المسلمين بالبرهان ، إذن فتلك
الشرائع المنسوخة ليست هي تلك الأطروحة العادلة الكاملة المأمولة .
الدليل الثاني :
أنه لا دليل على أن تلك الشرائع كاملة شاملة لكل جوانب المجتمع ، بحيث تصلح
لاستيعاب البشرية بالعدل الكامل . ولعل أوضح دليل على ذلك القول المشهور عن المسيح
عليه السلام : دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر . فإن إيكال ما لقيصر وهو الحاكم
الدنيوي لكي يمارس فيه سلطته وحكمه ، يعني أن الشريعة المسيحية لم تكن لتستوعب
الجانب القضائي والجنائي والاقتصادي للحياة ونحو ذلك . مما يضظر الميسح إلى التصريح
بلزوم إيكال ذلك إلى القانون الدنيوي الوضعي السائد ، لئلا تتشتت أمور الناس وتتميع
مصالحهم .
وهذا الدليل خاص بالمسيحيين وملزم لهم باعتبار اعتقادهم صحة نقل هذه العبارة عن
المسيح ، بعد أو وردت في الإنجيل الموجود في اليد (1) الذي هو الصحيح عندهم .
ــــــــــــ
(1) إنجيل متى ، الإصحاح الثاني والعشرون / 22 .
صفحة (222)
وأما نحن كمسلمين ،فلا نؤمن بكل ما ورد في الإنجيل السائد ، كما يبرهن عليه في بحوث
العقائد عادة . كما أننا لا نستطيع أن نؤكد نقص الشريعة الواقعية النازلة على
المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ، وإن كان ذلك محتملاً على أي حال ، بحسب المصالح
الزمنية التي توخاها الله تعالى لخلقه في تلك الفترة من الزمن .
الدليل الثالث :
أنه لا دليل على أن تلك الشرائع عالمية وعامة لكل البشر ، إذ من الممكن القول ، من
وجهة نظر أصحاب هذه الديانات : أنها شرائع اقليمية خاصة ببني إسرائيل . ومن هنا نرى
كتب العهدين تؤكد على أهمية هذا العشب بالخصوص ، وأنه شعب الله المختار . ومن هنا
نرى اليهود إلى الآن لا يقبلون يهودية شخص لا يكون من بني إسرائيل ، لاعتقادهم
الراسخ أن اليهودية دين إسرائيلي على التعيين .
فإذا كانت تلك الشرائع على هذا الغرار ... فهي إذن ليست تلك الأطروحة الكاملة
الشاملة للبشرية جمعاء . بل تكون قاصرة بطبيعتها عن أن تحقق الغرض الالهي الكبير .
وهذا الدليل باطل عندنا ، كمسلمين ، باعتبار الاحتمال ـ على أقل تقدير ـ بتجدد
الإقليمية في عصر منحرف متأخر عن عصور دعوتهم الأولى ، حتى أصبحت بعد ذلك من
العقائد الأساسية في دينهم . إلا أن هذا الدليل على أي حال ، ملزم لمن يعتقد
بالديانتين : اليهودية والنصرانية ، وبخاصة اليهود ، باعتبارهم أشد تطرفاً في
الإقليمية من المسيحيين .
وعلى أي حال ، فقد تبرهن عدم وجود الأطروحة الكاملة العادلة قبل الإسلام ، وستأتي
بعد قليل بعض الإيضاحات لذلك . إذن فلم يكن كلا الشرطين الاساسيين لتحقق اليوم
الموعود والعدل العالمي المطلق ، موجوداً . فكان من المتعذر أن يتصدى أي واحد من
الأنبياء لتولي القيادة الرائدة لتحقيق ذلك الغرض الكبير.
صفحة (223)
الجهة الثالثة :
التخطيط الالهي بعد الإسلام .
ونعني به ذلك الجزء من التخطيط الالهي الذي يبدأ بظهور الإسلام ، وينتهي باليوم
الموعود . وينبغي أن نرى موقف الإسلام من هذا التخطيط ، وموقف قادته منه ،وأثرهم
فيه .
النقطة الأولى :
الإسلام هو الأطروحة العادلة الكاملة ،المذخورة للتطبيق في اليوم الموعود .
يدلنا على ذلك : الادلة القطعية الدالة على أن الإسلام آخر الشرائع السماوية ، وأنه
لا نبي بعد نبي الإسلام وإن " حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم
القيامة " . فلو كان ناقصاً لما حقق الغرض الالهي الكبير، ولوجب على الله تعالى
تحقيق غرضه المهم بإيجاد أطروحة أخرى كاملة ينزل بها نبي آخر . وهو خلاف الدليل
القطعي بأنه لا نبي بعد نبي الإسلام .
مضافاً إلى الأدلة القطعية الدالة على عالمية الدعوة الإسلامية واستيعابها لكل
المشاكل والأحكام ،وأنه " ما من واقعة إلا ولها حكم " ، مما يجعل لها الصلاحية
الكاملة ، لتكون هي الأطروحة العادلة في اليوم الموعود .
ومن الملحوظ بوضوح أن هذه الأدلة القطعية ، منطلقة من زاوية إسلامية ، وأما إذا
أردنا الإنطلاق من زوايا أخرى، فيجب البدء بإثبات صحة الإسلام وصدقه أساساً ، وهذا
موكل إلى محله من بحوث العقائد .
وقد يقول قائل : فلماذا لم تنزل تعاليم الإسلام قبل عصر نزولها ، لتكون هي الأطروحة
المتوفرة منذ العصر الأول .
وجواب ذلك متوفر فيما قلناه من قصور البشرية في الأزمنة السابقة على الإسلام عن فهم
الأطروحة الكاملة . وأن الأنبياء السابقين جاهدوا في تربية البشرية لجعلها قابلة
لهذا الفهم . ولا يمكن أن يرسل الله تعالى تلك الأطروحة لمن لا يفهمها ولا يستطيع
استيعابها ، لانها لا تنتج حينئذ أي أثر .
صفحة (224)
إذن فلا بد لنا الآن من إيضاح معنى قصور البشرية عن تلقي تعاليم الإسلام في العصور
السابقة عليه .
وفي الحق أن عدداً مما جاء به الإسلام من تعاليم ، كان متعذراً جداً أن يستوعب
البشر معناها يومئذ استيعاباً كافياً... إلى حد ستكون الدعوة إلى تلك الأحكام منشأ
للغرابة في ذلك العصر ، مما يجعل مجرد الإيمان بها صعباً فضلاً عن استيعابها الدقيق
، فضلاً عن تطبيقها الشامل . وحسبنا في هذا الصدد استعراض جوانب أربعة :
الجانب الأول :
إن مستوى العقيدة الالهية التي جاء بها الإسلام من التجريد والتوحيد الخالصين ، لم
يكن موجوداً بوضوح في الشرائع السابقة . وإنما كانت هذه العقيدة في تطور مستمر ، في
ألسنة الأنبياء على مرور الزمن ، إذ يعطي كل نبي من تلك العقيدة ما يناسب المستوى
الثقافي والفكري الذي وصلت إليه البشرية في خطها التربوي الطويل .
وهذا واضح جداً لمن استعرض دعوات الأنبياء المتسلسلين . فنرى الأنبياء السابقين على
موسى بن عمران لا يكادون يذكرون من صفات الله تعالى إلا ما كان ظاهراً من آثاره
وأفعاله عز وجل . من أنه ﴿ يرسل السماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال وبنين ويجعل
لكن جنات ويجعل لكن أنهاراً . ما لكن لا ترجون الله وقاراً ، وقد خلقكم أطواراً.
ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً وجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس سراجاً
﴾(1) .
إلا ما كان من محاولة إبراهيم الخليل عليه السلام من محاولة البرهنة على التوحيد ،
على شكل بسيط النتائج بالنسبة إلى ما جاء به الإسلام من صفات .
ثم أننا نجد اليهود الآن يؤمنون ببعض أشكال التجسيم ، ونجد المسيحيين يؤمنون ببعض
أنحاء التعدد . وهذه بالرغم من أنها عقائد باطلة نعلم باليقين أنها لم ترد في
شرائعهم وتعاليم أنبيائهم . إلا أنهم ، على أي حال ، لم يجدوا في ما بلغهم عن
أنبيائهم ما ينافي ذلك ، أو يكون دليلاً صريحاص على بطلانه . وإلا لم يكونوا
ــــــــــــــــ
(1) نوح : 71 / 11 ـ 16 .
صفحة (225)
ليلتزموا بهذه العقائد بطبيعة الحال . ومعنى ذلك أن موسى وعيسى عليهما السلام لم
يوضحا بصراحة التجرد الكامل والتوحيد المحض لله عز وجل ، مواكبة مع المستوى العقلي
والثقافي للبشرية في تلك العصور .
الجانب الثاني :
إن فكرة الدعوة العالمية التي قام عليها الإسلام ، لم يكن ليسيغها المجتمع الذي كان
يرزخ في عواطف قبلية وعنصرية وقومية ، لمدة عدة مئات من السنين .
ومن هنا جاءت فكرة " شعب الله المختار " واختصاص الدعوتين اليهودية والمسيحية في
أنظار المؤمنين بها ببني إسرائيل دون سائل الناس .
الجانب الثالث :
إن فكرة الدولة النظامية التي جاء بها الإسلام ومارسها الرسول الأعظم (ص) ،وحاول
تطبيقها من جاء بعده إلى الحكم من الخلفاء . أن هذه الفكرة لم يكن ليفهمها الناس
قبل الإسلام ، بأي حال ، كيف وهم يعيشون الجو القبلي والعنصري ، حتى أن الملوكية في
تلك العصور كالسلطة الفرعونية أو القيصرية ، لم تكن إلا توسيعاً لفكرة السلطة
القبلية والإقطاع الذي يدعي لنفسه ملكية الأراضي والفلاحين جميعاً ، وهم يمثلون
الأعم الأغلب من الشعب يومئذ.
ومن هنا لم يكن في الإمكان أن تتكفل الديانات السابقة بإيجاد النظام الإداري أو
الحكومي ، بأي حال . وإنما كان الأنبياء وأوصياؤهم يضطلعون بقيادة شعوبهم بشكل فردي
مع الحفاظ على السلطة الدنيوية في عصورهم .
الجانب الرابع :
أننا نجد في الإسلام دقة في فهم الأحكام وفي تنظيمها ، في العبادات والمعاملات
والعقوبات والأخلاق ، ما لا يكاد يفقهها الناس السابقون ... كما يتجلى ذلك بوضوح
لمن راجع الأحكام الإسلامية المعروضة في الكتاب الكريم والسنة الشريفة ، واطلع
أيضاً على تفاصيل الأحكام المعروضة في التوراة والإنجيل ، وتوفر للمقارنة بينهما .
إذن ، فكيف تصلح الشرائع السابقة ، لأن تكون هي الأطروحة العادلة الكاملة ... وكيف
يصلح أهل العصور الأولى لتعقل هذه الأطروحة المتمثلة بأحكام الإسلام . ومعه يتضح
بجلاء أنه لم يكن في الإمكان نزول أحكام الإسلام قبل العصر الذي نزل فيه .
صفحة (226)
النقطة الثانية :
بُعث نبي الإسلام (ص) بالأطروحة التشريعية العادلة الكاملة ، بعد أن أصبحت البشرية
في مستواها العقلي والثقافي العام قابلة لفهمها واستيعاب أحكامها ، لتكون هي
الأطروحة المأمولة في اليوم الموعود .
ولكنه ـ مع شديد الأسف ـ لم يكن في الإمكان أن يتكفل التطبيق العالمي الموعود ،
لعدم توفر الشرط الثاني من الشرطين الأساسين لوجود هذا التطبيق .... ولا زال هذا
الشرط غير متوفر إلى حد الآن .
فبينما كان المانع بالنسبة إلى الأنبياء السابقين عن هذا التطبيق ، هو عدم توفر كلا
الشرطين ... نجد أن المانع بالنسبة إلى نبي الإسلام هو عدم توفر شرط واحد منهما ،
بعد أن تمت تربية البشرية على الشرط الآخر على أيدي الأنبياء السابقين .
ولسائل أن يقول : فلماذا تمت تربية البشرية على أحد الشرطين ولم تتم تربيتها على
الشرط الآخر ؟ بالرغم من جهود الأنبياء في الخط التاريخي الطويل .
ويمكن الإنطلاق إلى الجواب من زاويتين :
الزاوية الأولى :
أن توفير الشرط الأول ، وهو إيجاد المستوى اللائق في البشرية من الناحية العقلية
والثقافية لفهم العدل الكامل ... أسهل بكثير من توفير الشرط الثاني وهو الوصول
بالبشرية إلى المستوى العالي من الإخلاص والتضحية .
فإن تربية الفكر والثقافة لا تواجه عادة من الموانع والعقبات ما تواجهه التربية
الوجدانية من ذلك ، متمثلة في الشهوات والمصالح الخاصة ، وظروف الظلم والإغراء ،
فمن الطبيعي أن تحتاج التربية الأولى إلى زمن أقصر بكثير من الزمن الذي تحتاجه
التربية الثانية . ومن الطبيعي أن يكون البشر لدى أول نضجهم الفكري في التربية
الأولى غير ناضجين وجدانياً في التربية الثانية ، لأن هذه التربية لم تكن قد آتت
أكلها بعد ، وإنما تحتاج إلى توفير زمان آخر طويل حتى تتوفر نتائجها بوضوح .
صفحة ( 227)
ومن هنا أمكن وصول البشر إلى الحد الثقافي المطلوب ، فاستحقت عرض الأطروحة الكاملة
عليها وإفهامها إياها ... على حين لم تكن قد وصلت إلى الحد المطلوب من الناحية
الوجدانية ، لتستطيع تحمل القيادة العالمية بين يدي النبي (ص) .
الزاوية الثانية :
إن البشرية مهما كانت قد تطورت من الناحية الوجدانية ، على أيدي الأنبياء السابقين
... فإنه على أي حال غير كاف لإيجاد الأخلاص المطلوب الذي به يكون تحمل مسؤولية
العدل العالمي الكامل في اليوم الموعود . باعتبار ضرورة أن تتربى البشرية على
الأطروحة بعد نزولها ومعرفتها ، بما فيها من دقة وعمق . فأنه إذ يكون المطلوب هو
تطبيق هذه الأطروحة ، يكون الشعور بالإخلاص نحو الهدف ككل ، ذلك الإخلاص الناتج من
جهود الأنبياء السابقين .
فكان لا بد لأجل ضمان نجاح التطبيق في اليوم الموعود ، أن تمر البشرية بظروف معينة
، تكفل لها التربية على الإخلاص على الشكل الدقيق للأطروحة الكاملة المتمثلة
بالإسلام . وقد قلنا أن الهدف الالهي الأسمى ، هو فوق كل الاعتبارات ، فيتعين على
الأمة الإسلامية أن تعيش الظروف التي تربيها وتمحصها من جديد .
وبدأت الظروف الطارئة بالحدوث والتواتر و متمثلة في عدة أمور :
الأمر الأول :
انقطاع الوحي بموت رسول الإسلام (ص) .
الأمر الثاني :
انقطاع التطبيق الناجح للشريعة الكاملة ، بموت النبي (ص) أو بانتهاء الخلافة الأولى
.
الأمر الثالث :
ابتناء الحكم في البلاد الإسلامية على أساس من المصالح السياسية الظالمة المنحرفة .
صفحة (228)
الأمر الرابع :
ضعف المستوى الأخلاقي لدى الناس بشكل عام ، وتقديمهم مصالحهم الشخصية على اتباع
تعاليم دينهم سواء على الصعيد الفردي أو الإجتماعي .
ويكاد كل واحد من هذه الأمور ، فضلاً عن مجموعها ، أن يكون موجباً لياس الفرد
العادي والشعور بالتحلل والابتعاد عن الإسلام .
ومن هنا كان الشخص محتاجاً في استمراره على إخلاصه وإيمانه ، إلى قوة الإرادة وشعور
بالمسؤولية الإسلامية، أعلى من المستوى المطلوب . وكان الأشخاص الممثلين لهذا
الاخلاص ، قد نجحوا في عملية التمحيص والاختبار الالهية ، بهذا المقدار .
إلا أن هذا المقدار غير كاف في إبجاد الإخلاص الذي يتطلبه القيام بمسؤولية اليوم
الموعود ، فكان لا بد أن تمر الأمة بتمحيص ضخم وعملية غربلة حقيقية ، حتى ينكشف كل
فرد على حقيقته ، فيفشل في هذا التمحيص كل شخص قابل للانحراف ، لأجل أي نقص في
إيمانه أو عقيدته أو إخلاصه .
وكان هذا التمحيص الضخم متمثلاً بطرفين مهمين تمر بهما الأمة الإسلامية بل البشرية
كلها إلى العصر الحاضر .
الظرف الأول :
غيبة الإمام المهدي عليه السلام ، تلك الغيبة التي توجب للغافل عن البرهان الصحيح ،
الشك بل الإنكار .
الظرف الثاني :
تيار الردة عن الإسلام ، وأقصد به التيارات المعادية للإسلام ، والتي تحمل بين
طياتها معاني الخروج عنه والتبري من عقيدته . بما فيها تيار التبشير المسيحي
الاستعماري ، وتيار الحضارة الغربية المبني على التحلل الخلقي وانكار المثل العليا
.
والتيارات المادية الصريحة كالشيوعية والوجودية وغيرها .... تلك التيارات التي
استطاعت أن تصطاد من أمتنا الإسلامية ومن العالم كله ، ملايين الأفراد .
صفحة (229)
وتحت هذين الظرفين ، كان التمسك بالإخلاص العالي ، عمل جهادي في غاية الصعوبة
والتعقيد ، ويحتاج إلى مضاعفة الجهود في سبيل المحافظة على مستواه فضلاً عن الصعوبة
وتكميله فكان " القابض على دينه كالقابض على جمرة من النار " وكان المخلصون على
المستوى العالمي ، في غاية القلة والندرة بالنسبة إلى مجموع سكان العالم .... وإن
كنا لو لاحظنا مراتب الإخلاص الثلاثة أو الأربعة السابقة ، فإن النسبة تتسع عن هذا
المقدار الضيق بكثير .
ولا زالت البلايا والمحن تتضاعف ، وظروف التمحيص والاختبار الالهي تتعقد وتزداد ...
حتى أصبح الفرد يقهر على ترك دينه والتمرد على تعاليم ربه ، بمختلف أساليب الخوف
والترغيب . ولعل المستقبل ـ إن لم يأذن الله تعالى بالفرج والظهور ـ كفيل بأن نواجه
أشكالاً من الخطر والبلاء على ديننا ودنيانا هي أهم وأصعب مما حصل إلى حد الآن .
فليفهم كل مسلم موقفه ، وليلتمس درجة إيمانه ويشخص مقدار قابليته على الصمود ، قبل
أن يسقط في هاوية الإنحراف . لكي يوطن نفسه على الصبر والجهاد على كل حال ليكون له
فخر المشاركة في بناء العدل العالمي في اليوم الموعود .
وقد يخطر في الذهن : إن ما قلناه من أن ظروف الظلم دخيلة في التمحيص والاختبار
الالهي ، يلزم منه أن يكون الله تعالى راضياً بوجود الظلم والانحراف ، وهذا خلاف
الأدلة القطعية في الإسلام .
ويمكن الجواب على ذلك من زاويتين نذكر احداهما ونؤجل الأخرى إلى حين اتضاح مقدماتها
في مستقبل البحث .
والزاوية التي نود الإنطلاق إليها الآن هي أن الأدلة القطعية في الإسلام قامت على
أن الله تعالى لا يريد الظلم ، بمعنى أنه لا يجيزه تشريعاً ، فليس في شريعة الإسلام
حكم ظالم ، وليس أي ظلم مما يقع يكون مجازاً من قبل الشريعة ، بل يتصف بالحرمة
والشجب حتماً . إذ من الواضح أن الإسلام إنما شرع ليخرج للبشرية من ظلمات الظلم إلى
نور العدل ، بل هو ـ كما عرفنا ـ يمثل العدل الكامل من جميع الجهاد ، بشكل لم يتحقق
في أي تشريع آخر على مدى التاريخ .
وأما بحسب التدبير التكويني لله تعالى في مخلوقاته ، فمن الواضح الضروري أن الله
تعالى سمح بوجود الظلم ، ولم يسبب الأسباب إلى قمعه قهراً وعلى كل حال ، إذ لو كان
الله تعالى لا يريد الظلم ـ بهذا المعنى ـ لما وجد الظلم على سطح الأرض .
صفحة (230)
إلا أن سماحته بوجود الظلم ، لا يعني قهر الظالمين على إيجاد الظلم ، بل الظلم يوجد
باختيار الظالمين وبمحض إرادتهم ، بعد أن وفر الله تعالى لهم فرص الطاعة وهداهم
النجدين وعرفهم حرمة الظلم من الناحية التشريعية . فانحرفوا باختيارهم وأوجدوا
الظلم باختيارهم ، من دون أن يكون لله عز وجل أي تسبيب إلى إيجاده .
إذن فالظلم غير مراد لله تعالى ، لا تشريعاً لأنه حرّمه في شريعته ونهى الناس عنه ،
ولا تكويناً ، لأنه عز وجل لم يقهر الناس عليه . وإنما غاية ما هناك أنه سمح من
الناحية التكوينية بوجود الظلم في خليقته ناشئاً من اختيار الظالمين ، وذلك للتوصل
إلى هدفين مهمين .
الهدف الأول :
المحافظة على الاختيار ونفي الجبر الذي قام البرهان على استحالته على الله عز وجل .
فإنه لو قهر عباده على ترك الظلم لم يكن الاختيار متوفراً كما هو واضح .
الهدف الثاني:
إجراء قانون التمحيص والاختبار . الذي يفيد من الناحية الفردية، بالنسبة إلى كل فرد
من البشرية على الإطلاق ﴿ ليقضي الله أمراً كان مفعولاً ليهلك من هلك عن بينة ويحي
من حيّ عن بينة ﴾ (1) . ويفيد من الناحية العامة باعتبار أن له أكبر الأثر في تحقق
الهدف الأساسي من إيجاد الخليقة نفسها . فإن المجتمع الموعود ، لا يمكن أن يحدف ما
لم تسبقه فترة من التمحيص لتوفير شرطه الثاني الذي عرفناه .
وفي ما يلي من البحوث ما يزيد ذلك جلاء ووضوحاً .
ـــــــــــــ
(1) الأنفال : 8 / 42 .
صفحة (231)
النقطة الثالثة :
كما شارك الأنبياء السابقون عليهم السلام في التبشير باليوم الموعود ، استمر نبي
الإسلام صلى الله عليه وآله وخلفاؤه المعصومون عليهم السلام وكثير من صحابته في هذا
التبشير . وكان تبشيرهم أهم وأوسع . باعتبار أنهم يحملون إلى العالم نفس الأطروحة
العادلة التي سوف تأخذ طريقها إلى التطبيق في اليوم الموعود . فهم أقرب إلى ذلك
اليوم وألصق به من الأنبياء السابقين ... وأشد مسؤولية بالتمهيد له وإيجاد المقدمات
المؤدية إليه .
فكان أن اضطلع النبي (ص) ومن بعده بتهيئة الذهنية العامة للأجيال ، عن ذلك بالتركيز
على ثلاث قضايا مهمة :
القضية الأولى :
الأخبار بوجود الغرض الالهي الكبير ، والتبشير بتحقق اليوم الموعود الذي يأخذ فيه
العدل الكامل طريقه فيه إلى التطبيق . ويكفينا من ذلك أن القرآن الكريم نفسه شارك
في هذا التبشير حين قال : ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلاّ ليعبدون ﴾ (1) أو حين قال :
﴿ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ﴾ .... الخ الآية
(2) . أو حين قال : ﴿ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ﴾
(3) إلى غير ذلك من الآيات .
القضية الثانية :
التأكيد على أن القائد الرائد لانجاز ذلك الغرض الكبير ، هو الإمام المهدي (ع) كما
ورد في النصوص المتواترة عن النبي (ص) وهي أيضاً متواترة عمن بعده . ولإثبات هذا
التواتر مجال آخر . وحسبنا أنها أخبار مروية ومعترف بصدقها وتواترها من قبل
الفريقين .
وإنما كان هذا التأكيد لكي تكون الأمة على علم بمستقبل أمرها من ناحية ، ومطلعة على
اسم قائدها العظيم من ناحية أخرى . فإنه لا ينبغي أن تفاجأ الأمة بالظهور من دون
إخبار سابق . ولكي لا تكون هذه القيادة ممكنة الانتحال والتزوير ،ولو في حدود ضيقة
، من قبل أشخاص آخرين . على ما سنوضحه في الجهة الآتية إن شاء الله تعالى .
ـــــــــــــــــ
(1) الذاريات : 51 / 56 . (2) سورة النور : 24 / 55. (3) التوبة : 9 / 33 والفتح :
48 / 28 والصف :61 / 09.
صفحة (232)
القضية الثالثة :
الإخبار بما سيقع في هذا العالم من ظلم وفساد ، كما وردت بذلك الأعداد الضخمة من
الأخبار ، على ما سنسمع في الفصل الآتي . وكان هذا الإخبار مشفوعاً بذكر التكليف
الإسلامي وأسلوب العمل الواعي في هذه الظروف ... حتى يكون الفرد على بصيرة من أمره
عارفاً بضرورة الصمود تجاه تيار الانحراف والفساد ، لكي يكتب له النجاح في التمحيص
الإلهي ، فيكون من المخلصين الممحصين الذين يكون لهم شرف المشاركة في ترسيخ قواعد
العدل العالمي في اليوم الموعود .
وأما الذي يسير مع تيار الإنحراف ، فلا يهمه ـ بطبيعة الحال ـ أن يفهم التكليف
الإسلامي الواعي و ومعه يكون من الفاشلين في التمحيص والاختبار .
ومن هنا نستطيع أن نفهم بوضوح ، ارتباط كل هذه القضايا التي بُلغت إلى الأمة ،
بالتخطيط الإلهي لليوم الموعود .... لتشارك في إعداد أكبر عدد ممكن من المخلصين
الممحصين على طول الخط ، بتهيئة الذهنية العامة لهذه الحقائق وإقامة الحجة عليها ،
حتى يكون الفرد المسلم على بينة من أمره وبصيرة من دينه ، فيختار سبيل الرشاد بين
تيارات الإنحراف ، كما هو مطلوب .
النقطة الرابعة :
وقد رأينا المهدي (ع) نفسه في البحوث السابقة يشارك بتهيئة الذهنية العامة للأمة
لليوم الموعود ، تلك التهيئة التي توفر له شروطه الأساسية . وذلك باتخاذ خطوات ثلاث
:
الخطوة الأولى :
إقامة الحجة على وجوده بتكرار المقابلات مع عدد من الناس كبير نسبياً ، خلال الغيبة
الصغرى والغيبة الكبرى معاً. وبذلك يؤسس للمسلمين أساس الصمود ضد واجهة كبرى للشك
في وجوده .
صفحة (233)
الخطوة الثانية :
إعطاء الأطروحة التامة لفكرة غيبته وظهوره . كما سمعنا ذلك في عدد من مقابلاته
وتوقيعاته ، في غيبته الصغرى، كمقابلته مع علي بن مهزيار وتوقيعه للأسدي (1) .
وبذلك يعطي الثقافة الكافية التي تعطي الدفع الأساسي للفرد المسلم للصمود والثبات
عن بصيرة وتفهم حقيقي للهدف المنشود .
الخطوة الثالثة :
العمل على إزالة الظلم والطغيان ، في الحدود التي سبق أن ذكرناها في القسم الأول من
هذا التاريخ .
وبذلك يعطي الفرد المسلم فرصة أكبر للنجاح في التخطيط والتمحيص الالهيين ، باعتبار
قلة الموانع والتعسفات نسبياً ، ضد الإيمان والإخلاص ، حينئذ .
مما يفسح مجالاً أوسع للعمل على طبق الإخلاص وتبليغ مؤداه إلى الآخرين . فالمهدي
(ع) في كل هذه الخطوات ، يسير في خط التخطيط الالهي العام لليوم الموعود ، كما سبق
أن سار سلفه الصالح المتمثل بالأنبياء والأئمة عليهم السلام . وكيف لا يكون كذلك ،
وهو القائد العظيم المذخور لذلك اليوم العظيم .
الجهة الرابعة :
أهمية القيادة في التخطيط الالهي .
ويمكن أن ننطلق إلى الحديث في هذه الجهة من عدة نقاط :
النقطة الأولى :
لا بد لكل حركة من قيادة ولكل دولة من رئيس . ولا شك أنه كان على رأس كل حركة ناجحة
في التاريخ قائد محنك مقدام استطاع أن يسير بها قدماً إلى الأمام :
ـــــــــــــــ
(1) انظر مثلاً تاريخ الغيبة الصغرى ، ص 577 وغيرها .
صفحة (234)
وهذا أساساً ، مما لا بد منه ، بحيث يستحيل عادة وجود حركة ما من دون قيادة وتوجيه
مهما كانت الحركة ضئيلة والقيادة مبسطة . فإن الجماعة ـ أياً كانت ـ بصفتها مكونة
من عدد من الأفراد مختلفين في التدبير ووجهات النظر، لا تكاد تستطيع أن تحفظ
مصالحها في حاضرها ومستقبلها ، إلا بشخص أو عدة أشخاص يأخذون فيها مركز القيادة
والتوجيه . فكيف إذا تضمنت الحركة إصلاح العالم برمته وضمان تطبيق العدل الكامل على
البشرية جمعاء . ومباشرة التطبيق من حكم مركزي واحد ودولة عالمية واحدة .
ونحن نرى أن الدول كبيرها وصغيرها ، بالرغم من تضامن أفرادها وتدقيقهم في الأمور
السياسية والإجتماعية والإقتصادية ، لاجل قيادة جزء من العالم ... فإنه يظهر على مر
الزمن فشلها وسوء تصرفها ، وأخذها بالمصالح الخاصة للقادة لا بالمصالح العامة للناس
. فكيف بقيادة العالم كله .
إذن ، فلا بد ، من أجل ضمان تحقق الغرض الالهي الكبير ، من إيجاد شخص مؤهل من جميع
الوجوه ، لأجل الأخذ بزمام القيادة العالمية في اليوم الموعود . ولأجل هذا وجد
المهدي عليه السلام .
النقطة الثانية :
لا شك أن النبي (ص) والأئمة المعصومين (ع) بعده كان لهم القابلية الكاملة للقيادة
العالمية . لضم مقدمتين نذكرهما هنا مختصراً ونحيل تفاصيلهما إلى موطنه من أبحاث
العقائد الإسلامية .
المقدمة الأولى :
إن كل شخص يعينه الله تعالى للقيادة ، لا بد أن تكون له القدرة على تلك القيادة .
إذ يقبح على الله تعالى أن يعين شخصاً لمهمة وهو قاصر عن آدائها . فمثلاً إذا كان
نبي مرسل إلى هداية مدينة واحدة كان لا بد أن يبه القدرة على أداء مسؤوليته ، وإذا
كان مرسلاً إلى هداية منطقة كبيرة من العالم فلا بد من أن يكون له القدرة على ذلك
وهكذا . ولا يمكن أن يوكل الله تعالى شيئاً من المهام إلى شخص غير قابل لأدائها .
بل أما أن يكون الشخص قابلاً لذلك قبل إيكال المهمة إليه ، أو أن يهبه الله تعال
تلك القابلية بعد إيكال المهمة إليه . وعلى أي حال يكون حال تصدية لأداء مهمته على
أتم القابلية والاستعداد .
صفحة (235)
المقدمة الثانية :
إن دعوة النبي (ص) عالمية ، كما أن المسؤوليات التشريعية المنوطة بقيادته معقدة
وكبيرة .
إذن يتعين القول بأن الله تعالى أعطى النبي (ص) القابلية الكاملة للدعوة والدولة
العالميتين . وحيث أن الأئمة (ع) منصوبون بتعيين من الله تعالى ، ليقوموا مقام
النبي (ص) في الأخذ بزمام مسؤولياته بعد وفاته ، من وجهة النظر الأمامية ، إذن فلا
بد أن يكون الله تعالى قد أعطاهم القابلية الكاملة للقيادة العالمية .
وبهذا الدليل يتعين أن يكون للمهدي (ع) مثل هذه القابلية ، والأهلية بصفته أحد
الأئمة المعصومين الاثني عشر عليهم السلام من زاوية النظر الأمامية ، أو بصفته
خليفة النبي (ص) في آخر الزمان المنصوص عليه من قبل النبي (ص) .
كما يعترف به كل المسلمين . وعلى أي حال ، فالمهدي (ع) يوجد قابلاً للقيادة
العالمية ، قابلية متناسبة مع سعة دعوته ومسؤولياته في إنجاز العدل الكامل وتنفيذ
الغرض الالهي الكبير .
النقط الثالثة :
وكان لا بد للغيبة أن تشارك في التخطيط الالهي . لان الإرادة الالهية بعد أن تعلقت
بأن يكون الإمام محمد بن الحسن العسكري عليهما السلام مهدياً للأمة ، كما يذهب إليه
الإمامية وعدد من العامة ... كان لا بد من الحفاظ عليه إلى أن يتحقق الشرط الأساسي
لتنفيذ ذلك الغرض الكبير .
فإننا إن قلنا بأن المهدي يولد في زمانه ، كان هذا خلاف هذا الاعتقاد .وإن قلنا
بوجوده متقدماً كان لا بد من اختفائه حفاظاً على حياته ، حتى يظهر الله أمره وينفذ
وعده ، وهو معنى الغيبة .
فإن قال قائل : يمكن أن نلتزم أن المهدي (ع) ولد في الزمان المتقدم ، ثم يموت ، ثم
يحييه الله تعالى للقيام باليوم الموعود .
صفحة (236)