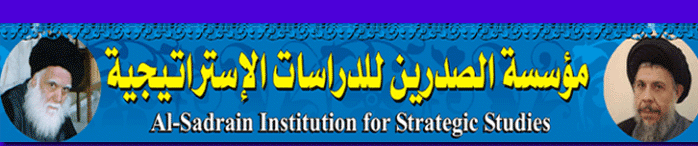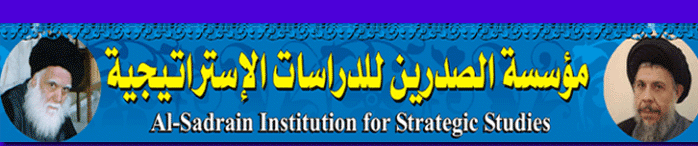وكان الشمال الإفريقي مستقلاً ـ إلى حد كبير ـ
تحت امرة آل الأغلب، إبتداء بزيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب،
وبعده أخوه الأغلب(1) ، وانتهاء بزيادة الله بن أبي العباس بن عبد
الله (2) الذي زال ملكه بسيف أبي عبد الله الشيعي الذي مهد لسلطان
المهدي الإفريقي جد الفاطميين ، على ما يأتي في تاريخ القسم الثاني
من هذا الكتاب . وفي كل ذلك لا تكاد تجد للخلافة في سامراء أو في
بغداد أي رأي أو تصرف .
وأما بلاد فارس وما وراء النهر، فقد كانت في عهد المعتصم مسرحاً
للقتال ، ففي منطقة زنجان وأردبيل وأذربيجان ، حصل صدام مسلح بين
بابك الخرمي من ناحية وبين حيدر بن كاوس وبغا الكبير من ناحية أخرى
عن السلطان . وذلك من عام 221هـ حتى عام 223 هـ حيث قدم الأفشين
إلى سامراء ومعه بابك وأخوه عبدالله ، فقتله المعتصم ، وأرسل رأسه
إلى خراسان وصلب بدنه بسامراء (3) .
وفي سنة 224هـ أظهر مازيار بن قادن الخلاف على المعتصم بطبرستان
(4) ، وكان قد اصطنعه المأمون (5) .
ــــــــــــــــــــــ
(1) الكامل جـ 5 ص 252 . (2) المصدر ص 123 جـ 6 .
(3) المصدر جـ 5 ص 246 . (4) الكامل جـ 5 ص 253 .
(5) المروج جـ 3 ص 473 .
صفحة (64)
وفي سنة 223 هـ، كان باذربيجان قلاقل وحروب ،
استمرات ثمانية أشهر ، قادها محمد بن البعيث بن الجليس وجماعته .
حتى أخضعهم بغا الشرابي من قبل السلطان ، وفتح المدينة (1) . ثم
استقدم ابن البعيث إلى سامراء وحبس فيها وجعل في عنقه مئة رطل ،
فلم يزل على وجهه حتى مات (2) .
وفي عام 238هـ ، كان قتال في تفليس بين بغا وقواده الأتراك من
ناحية وبين إسحاق بن إسماعيل من ناحية أخرى. وأحرق بغا المدينة،
فاحترق فيها نحو خمسين ألف انسان، واسروا من سلم من النار وسلبوا
الموتى(3).
وفي عام 253هـ في عهد المعتز ، حدث قتال في همدان ، بين عبد العزيز
بن أبي دلف ، في أكثر من عشرين ألف من الصعاليك وغيرهم ، وبين جيش
الخليفة ، بقيادة موسى بن بغا (4).
وكانت بلاد فارس ، والعراق أحياناً (5) ، مسرحاً خصباً لجيوش يعقوب
بن الليث الصفار وحروبه ، من سنة 253هـ إلى أن توفى عام 265 هـ
وخلفه أخوه عمرو بن الليث ، إلا أنه اصبح موالياً للخلافة (6) .
ــــــــــــــــــــــ
(1) الكامل جـ 5 ص 281 . (2) المصدر ص 284 .
(3) المصدر ص 292 . (4) المصدر ص 335 .
(5) المروج جـ 4 ص 112 وما بعدها . (6) الكامل جـ 6 ص 24 .
صفحة (65)
على أن يعقوب كان يجد من مصلحته إظهار الولاء للدولة ، وإن كان
بمنزلة لا تقوى الدولة على قمعه ، فكان الخليفة يستميله ويترضاه
(1) اتقاء لشره ولم يبرز مكنونة إلا في فراش الموت حيث قال لرسول
الخليفة إليه : قل للخليفة إنني عليل ، فإن مت ، فقد استرحت منك
واسترحت مني ، وإن عوفيت فليس بيني وبينك إلا هذا السيف (2) .
ومنذ عام 261هـ استقل ـ إلى حد كبير ـ نصر بن أحمد الساماني. ببلاد
ما وراء النهر ، وهي تتمثل بمناطق بخارى وسمرقند إلى خراسان (3) .
حتى توفى عام 279 هـ ، وولي بعده أخوه اسماعيل بن أحمد (4) .
وأما مصر فقد استقل بها أحمد بن طولون ـ وهو من الأتراك ـ استخلفه
عليها بابكيال التركي عام 254هـ في عهد المعتز (5) وحين ولي
المهتدي وقتل بابكيال صارت مصر لياركوج التركي ، وكان بينه وبين
أحمد بن طولون مودة متأكدة ، فوسع ولايته على الديار المصرية كلها
، فقوى أمره ودامت أيامه (6) . حتى توفى مبطوناً عام 270هـ (7)
وكان قد استغنى من ملكه عن الإرتباط بالخلافة (8) وإن لم يناجزها
العداء فعلاً .
ــــــــــــــــــــــ
(1) المصدر ص 21 . (2) نفس المصدر والصفحة .
(3) المصدر ص 21 . (4) المصدر ص 74 .
(5) الكامل جـ 5 ص 339 . (6) المصدر والصفحة .
(7) الكامل جـ 6 ص 55 . (8) انظر مثلاً المصدر ص 13 .
صفحة (66)
ولم تكن الأطراف القريبة من العاصمة ، بأحسن حالاً من الأطراف
البعيدة . فقد كانت أيضاً مسرحاً لمصالح العمال والقواد من ناحية ،
ومسرحاً لنشاط الخوارج والزنج ثم القرامطة على ما نشير إليه ، من
ناحية ثانية .
فمكة والمدينة ، كانت تتعرض أحياناً للمصطادين بالماء العكر. فقد
أصبحت المدينة عام 230هـ وما بعده، مسرحاً لغارات الأعراب
المجاورين ، حتى ناجزهم بغا الكبير القتال(1) . وقتل عام 251هـ
ثلثمائة رجل من مكة وغلت الأسعار فيها بسبب شغب مشابه (2) .
و أما لو راقبنا سوريا في تلك الفترة ، بما فيها حمص وحلب ودمشق ،
لوجدناها مسرحاً للاطماع وساحة للقتال . ففي عام 227هـ في أول
خلافة الواثق ، كانت دمشق مسرحاً لعصيان مسلح ، انتج قتل ما يقارب
الألفي شخص ، من جيش الخليفة والثائرين(3) . وفي عام 240هـ وما
بعده ، كانت حمص مجالاً لسوء تصرف العمال والولاة ، مما أوجب ثورة
الأهالي واضطرابهم (4) . وتكررت عين المشكلة عام 250هـ.
ــــــــــــــــــــــــ
(1) الكامل جـ 5 ص 270 . (2) المصدر ص 330 .
(3) الكامل جـ 6 ص 56 . (4) الكامل جـ 5 ص 293 و 294 .
صفحة (67)
إلا أن هذا العصيان كان أكبر من سابقه ، فوجه المستعين إليها موسى
بن بغا فحاربها ، وقتل من أهلها مقتلة عظيمة ، وأحرقها وأسر جماعة
من أعيان أهلها (1) .
ولم تسلم سوريا حتى بعد أن احتلها أحمد بن طولون ، عام 264هـ (2)
من الحروب . إذ بمجرد أن توفى ابن طولون عام 270هـ(3) تحركت نحوها
الأطماع ، استضعافاً واستصغاراً لخلفه ابنه خمارويه . فسير إليها
أبو طلحة الموفق بن المتوكل ، قائدين من قواده الموالى ، وهما :
اسحاق بن كندايق وابن أبي الساج ، لاحتلاها ، فدخلوها وفتحوا دمشق
بعد قتال عظيم (4). فسار إليها خمارويه بنفسه من مصر واحتلها مرة
أخرى بقتال جديد (5) . وتكرر القتال عام 274هـ و 275هـ (6) .
وإذا نظرنا إلى الموصل وما حواليها من البلدان ، ومن في تلك
المنطقة من الأكراد ، لم نجدهم أقل بلاء من سائر بلاد الإسلام .
فقد تعرضت عام 253هـ لقتال ونهب(7) وفي عام 260هـ تعرضت لتعسف
العامل عليها من قبل الخليفة ، وهو اذكوتكين التركي ، فإنه اظهر
الفسوق وأخذ الأموال ،
ـــــــــــــــــــــــــــ
(1) المصدر ص 318 . (2) المروج جـ 4 ص 123 .
(3) الكامل جـ 6 ص 56 . (4) المصدر والصفحة .
(5) المصدر ص 58 . (6) المصدر ص 62 .
(7) الكامل جـ 5 ص 336 .
صفحة (68)
فقاتلوه قتالاً شديداً حتى أخرجوه عن الموصل ونهبوا داره(1) وتعرضت
في العام الذي يليه لحروب أيضاً بسبب رفضهم لعاملين عينهما اساتكين
التركي عن الخليفة ، واختاروا لهم عاملاً آخر (2) .
وتعرضت الأكراد لهجوم وصيف التركي عام 231هـ ، وحبس منهم نحو
خمسمائة ، وحصل وصيف على هذا العمل ، جائزة مقدارها خمس وسعبون ألف
دينار . وتعرضوا أيضاً لقتال موسى بن اتامش التركي عام 266هـ (3) .
وفي عام 281هـ حاربهم الخليفة المعتضد بنفسه (4) .
ولعلنا نستطيع أن نعتبر هذه القلاقل جميعاً ، هدؤا نسبياً ، وبرداً
وسلاماً ، إذا قسناه إلى الجحيم الذي أوجد صاحب الزنج على العراق
في عهد سامراء ، والقرامطة في العهد الذي يليه ، على ما سنذكره .
الخامس: من خصائص هذا العصر ، وليست من مختصاته على كل حال ، هو
وجود الخوارج ، وما يسببونه باستمرار من شغب وحوادث . فكان وجودهم
شجى في حلق الدولة وحجر عثرة أمام اطمئنان الأمة .
ــــــــــــــــــــ
(1) المصدر ص 371 . (2) المصدر ص 274 .
(3) الكامل جـ 5 ص 273 . (4) الكامل جـ 6 ص 24 .
(5) الكامل جـ 6 ص 77 .
صفحة (69)
ويبدأ نشاطهم الملحوظ في هذه الفترة ، عام 252هـ حين قام مساور بن
عبد الحميد بن مساور الشاري البجلي الموصلي ، قائد الشراة ، وهم
الخوارج الذين يدعون إنهم شروا الآخرة بالدنيا .
واستولى مساور على أكثر أعمال الموصل وقوي أمره. فقاتله والي
الخليفة على الموصل قتالاً شديداً ، فاندحر، فاشتد أمر مساور وعظم
شأنه وخافه الناس(1) . وذلك عام 245هـ. وكان أن صلى بالمسجد الجامع
بالموصل صلاة الجمعة بالناس وخطبهم (2). وفي عام 255هـ قاتله عسكر
الخليفة فانتصر مساور أيضاً وانهزم عسكر الخليفة (3) .
وفي عام 256هـ ، ثار بوجه مساور الشاري أحد الخوارج ، بسبب اختلاف
بينهما في بعض المسائل الكلامية، فاقتتلوا اقتتالاً شديداً أدى إلى
فوز مساور وانهزام الخارجي الآخر ، وقتل أكثر جيشه (4) .
وبلغ مساور من السيطرة والقوة أن استولى على كثير من العراق ومنع
الأموال عن الخليفة فضاقت على الجند أرزاقهم (5) . وبقي على مثل
هذه الحال إلى أن مات عام 263هـ (6) .
ـــــــــــــــــــــــــ
(1) الكامل جـ 5 ص 339 . (2) المصدر ص 246 .
(3) المصدر ص 350 . (4) المصدر ص 354 وما بعدها .
(5) المصدر 355 . (6) المصدر جـ 6 ص 15 .
صفحة (70)
واختلف الخوارج إلى من يرجعوا بعده ، وحدث لذلك بينهم قتال ، حتى
تم أمرهم على هارون بن عبد الله البجلي الشاري(1) .
السادس: من خصائص هذا العصر ولعله أبعدها خطراً وأعمقها أثراً،
ويختص بالقسم الثاني من خلافة سامراء، عند ازدياد ضعفها وتفسخها ،
وذلك في عهد المهتدي والمعتمد. وهو ظهور صاحب الزنج الذي قتل
الألوف من النفوس وهتك الآلاف من الأعراض ، احرق عشرات المدن وسبب
بشكل غير مباشر إلى أمرين مهمين :
أحدهما : ضعف الخلافة في عهد المعتمد ، وبقاء الخليفة صورة بلا
واقع لا حل له ولا عقد .
ثانيهما : ترسخ قوة الخليفة في عهد المعتضد ، وذلك بعد انهيار
الزنج وزوال سامراء كعاصمة للخلافة .
وصاحب الزنج هو الرجل الذي ثار في البصرة عام 255هـ(2) اسمه علي بن
محمد ، وزعم أنه علوي ، يتصل نسبه بزيد بن علي بن الحسين بن علي بن
أبي طالب عليهم السلام . ولم يكن كذلك ، على ما يذكر التاريخ ، فإن
نسبه في عبد قيس ، وأمه من بني أسد بن خزيمة (3) .
واستمر يعيث في المجتمع فساداً خمسة عشر عاماً ، إلى أن قتل عام
270 هـ (4) .
ـــــــــــــــــــــــ
(1) الكامل جـ 6 ص 15 .
(2) المصدر ص 346 جـ 5 وابن الوردي جـ 1 ص 233 .
(3) نفس المصدر والصفحة .
(4) المصدر جـ 6 ص 51 .
صفحة (71)
وعمدة ما ارتكز عليه في ثورته ـ مضافاً إلى دعواه الانتساب بالنسب
العلوي ـ أنه وجد دعوته بشكل رئيسي إلى العمال والطبقة الكادحة من
الشعب ، وخاصة العبيد المماليك منهم ، تلك الطبقة التي تلاقي من
ارهاق مستخدميها ومالكيها ومن ضغط الدولة أنواع الذل والشقاء . ومن
ثم سمى صاحب الزنج أي قائد العبيد . فبدأ بعبيد أهل البصرة ودعاهم
للاقبال إليه للخلاص من الرق والتعب ، فاجتمع عنده منهم خلق كثير ،
فخطبهم ووعدهم أن يقودهم ويملكهم الأموال وحلف لهم بالإيمان أن لا
يغدر بهم ولا يخذلهم . فأتاه مواليهم وبذلوا له على كل عبد خمسة
دنانير ليسلم إليه عبده ، فأمر من عبده من العبيد فضربوا مواليهم
أو وكلاءهم ، كل سيد خمسمئة سوط (1) . وكان هذا أول الشر. واكتسب
العبيد بذلك قوة واندفاعاً وحماساً مضاعفاً ، استطاعوا أن يكتسحوا
بها منطقة ضخمة من البلاد .
واتسع شرهم من البصرة إلى عبادان وإلى الأهواز(2) ودستميسان (3)
وواسط (4) ورامهرمز(5) وما بينهما من البلدان والمناطق . وحين
احتلوا البصرة ، حاربوا أهلها بجيش من الزنج والإعراب ثلاث أيام .
ـــــــــــــــــــــ
(1) الكامل جـ 5 ص 347 . (2) المصدر ص 359 .
(3) المصدر جـ 6 ص 8 . (4) المصدر ص 16 .
(5) المصدر ص 23 .
صفحة (72)
ثم أنه امنهم استجابة لإبراهيم بن يحيى المهلي ، ونادى مناديه من
أراد الأمان فليحضر إلى دار إبراهيم . فحضر أهل البصرة قاطبة حتى
ملؤا الرحاب . فلما رأى صاحب الزنج اجتماعهم ، انتهز الفرصة لئلا
يتفرقوا ، فغدر بهم وأمر أصحابه بقتلهم ، فكان السيف يعمل فيهم
وأصواتهم مرتفعة بالشهادة ، فقتل ذلك الجمع كله ولم يسلم إلا
النادر منهم . وأحرق الجامع ، واحترقت البصرة في عدة مواضع مها ،
وعظم الخطر ، وعمها القتل والنهب والإحراق ، فمن كان غنياً أخذوا
ماله وقتلوه ، ومن كان فقيراً قتلوه لوقته (1) . ومثل ذلك عمل
الزنج بعبادان الأهواز والأبله (2) وأبي الخصيب(3) .
وحين رأت الدولة ذلك منه ، ناجزته القتال ببعض قوادها كسعيد الحاجب
(4) ومحمد المولد(5) وموسى بن بغا (6) إلا أنهم لم يؤثروا شيئاً ،
وكان يستظهر عليهم صاحب الزنج ، وكانت اليد الطولى في محاربته
ومصابرته والقضاء عليه في النتيجة ، لأبي احمد الموفق طلحة بن
المتوكل (7) ، بمعونة ولده أبي العباس المعتضد الذي أصبح أول خلفاء
بغداد بعد أفول نجم سامراء .
ـــــــــــــــــــــــــــ
(1) الكامل جـ 5 ص 362 . (2) المصدر ص 359 .
(3) المصدر ص 358 . (4) المصدر ص 361 .
(5) المصدر ص 363 . (6) المصدر ص 367 .
(7) الكامل جـ 5 ص 395 ، وانظر العبر جـ 2 ص 15 .
صفحة (73)
والتحق لمعونته أخيراً عام 269هـ لؤلؤ غلام أحمد بن طولون الذي
انشق على مولاه ، وسار إلى الموفق وهو يقاتل الزنج (1) وكان له يد
طولى في القضاء على حركة الزنج في آخر آيامها (2) حتى قيل في عسكر
الموفق (3) :
كيفما شئتم فقولوا إنما الفتح للولو
ولم يكن لجيش الموفق تجاه الزنج رحمة ، وإنما كانت الحرب معهم حرب
إبادة ، وقد أعمل معهم سائر أنحاء القتل من الإحراق والإغراق
والمطاردة وغير ذلك(4).واستنفذوا ما لا يحصى من النساء والصبيان
والمساجين(5).
واستأمن إلى الموفق عدداً من قواد الزنج قبل قتله وبعده(6) ، وقد
كان لقتله والقضاء على حركته أثر كبير على سائر الناس بالشعور
بالسرور والأمن ، وقيلت في ذلك أشعار كثيرة (7) .
وقد أثرت مواقف الموفق هذه على سيطرته التامة على الأمور كلها في
الدولة ، على الجيش والتعامل مع ولاة الأطراف وجباية الأموال وعزل
وتنصيب الوزراء (8) ،
ــــــــــــــــــــــــ
(1) الكامل جـ 6 ص 49 . (2) المصدر ص 51 .
(3) المروج جـ 4 ص 124 . (4) انظر مثلاً ص 46 جـ 6 من الكامل
وغيرها .
(5) انظر المصدر ص 47 . (6) المصدر ص 53 .
(7) المصدر ص 53 ـ 54 . (8) المصدر ص 17 .)
صفحة (74)
حتى لم يبق لأخيه المعتمد من الخلافة إلا اسمها ، ولا ينفذ له
توقيع لا في قليل ولا في كثير (1) حتى قال :
أليس من العجائب أن مثلي يرى ما قل ممتنعاً عليه
في ثلاث أبيات ، سبقت .
وبقي الموفق على ذلك حتى مات عام 278هـ (2) . فاجتمع القواد
وبايعوا ابنه أبا العباس بولاية العهد ، ولقب المعتضد بالله (3)
ولا يخفى ما اكتسابه القوة والسيطرة أثناء حربه للزنج ، وتمرسه على
أنحاء القتال والقيادة ، في تولي الخلافة في العام الذي يلي، أي
عام 279هـ ، بعد المعتمد ، فكان أول خلفاء بغداد ، بعد أفول نجم
سامراء .
السابع : من خصائص هذا العصر. وليست من مختصاته ، حصول ثورات
متعددة في الأطراف داعين إلى الرضا من آل محمد (ص) ، أو متمردين
على الظلم والعسف الذي كان ينال المجتمع بشكل عام ، وينالهم بشكل
خاص .
والفكرة الأساسية التي كانت تقوم عليها الدولة ، وقتئذ بجميع
أجهزتها وطبقاتها ، هو النفرة من العلويين ، ومطاردتهم والضغط
علهيم .
ــــــــــــــــــــــ
(1) المصدر ص 49 .
(2) المصدر ص 67 وما بعدها .
(3) المصدر ص 69 .)
صفحة (75)
لا يختلف في ذلك الخليفة عن القواد عن الوزراء عن العامة أنفسهم .
ولما كانت الدولة تعاني التفكك والضعف ، كان مجرد وجود أي شبح
للحركة العلوية أو تهمة في ذلك ، يثير الرعب لدى الخليفة واتباعه
ويتصدى القواد الأتراك ومن اليهم بإنزال أقصى العقوبات بالثائرين .
ونستطيع أن نستشهد من تاريخنا العام لهذا الحقد ، بعدة أمور :
منها : ما كان المتوكل يستشعره من الكراهية تجاه علي (ع) والعلويين
، وكان آل أبي طالب ـ على ما ينص التاريخ ـ في أيامه في محنة
عظيمة، قد منعوا من زيارة قبر الحسين عليهم السلام والغري من أرض
الكوفة. وكذلك منع غيرهم من شيعتهم حضور هذه المشاهد ، وأمر بهدم
قبر الحسين عليه السلام ومحو أرضه وإزالة أثره وأن يعاقب من وجد به
(1) وحدث به وزرع فيه ، وكان يقصد من يبلغه عنه أنه يتولى علياً
وأهله ، بأخذ المال والدم (2) ولم تزل الأمور كذلك إلى أن استخلف
المنتصر ، فأمن الناس وأمر بالكف عن آل أبي طالب وترك البحث عن
أخبارهم . وأطلق حرية زيارة قبر الحسين عليه السلام ، وغيره من آل
أبي طالب (3) .
ـــــــــــــــــــــــــ
(1) المروج جـ 4 ص 51 .
(2) الكامل جـ 5 ص 287 وانظر المقاتل اللاصبهاني ص 424 .
(3) المروج جـ 4 ص 51 وانظر المقاتل ص 450 .)
صفحة (76)
وسنذكر ما فعله المتوكل من إزعاج الإمام علي بن محمد الهادي (ع)
وأشخاصه إلى سامراء من المدينة . لكي يكون تحت رقابته وفي قبضته.
وكان يستدعيه إلى قصره بين الفينة والفينة، معداً له مؤامرة القتل
فتفشل، وتضطره هيبة الإمام عليه السلام إلى احترامه وإكرامه (1) .
ومنها : قتل المعتمد للإمام الهادي عليه السلام ، على ما ذكره ابن
بابويه الصدوق (2) .
ومنها : مراقبة الخلفاء للأئمة (ع) على ما سنذكر ، وقضائهم على كل
ثورة علوية .
ولم يكن القواد الأتراك بأحسن من الخلفاء حالاً من هذه الناحية. بل
هم أقل منهم ضبطاً وأكثر تهوراً كموسى بن بغا الذي قضى على ثورة
الحسن بن إسماعيل العلوي (3) وعلى بن أوتامش(4) وصالح بن وصيف (5)
وأحمد بن عبيد الله بن خاقان (6) وسعيد الحاجب (7) ، ونحوهم ممن
يمت إلى الدولة بخوف أو طمع أو حاجة .
في هذا الجو المكهرب العاصف ، كان يرى بعض العلويين الذين يتوسمون
في أنفسهم القوة والأصحاب ، وجوب الثورة على الظلم والفساد ،
وإظهار كلمة الحق أمام المجتمع السادر في غفلته البعيد عن روح
الإسلام وتعاليم القرآن.لعل ذلك يكون سبباً من اسباب توعية الامة
وإيقاظ ضميرها. والتفاتها إلى واقع حياتها وواجبات دينها .
ـــــــــــــــــــــــ
(1) انظر المروج جـ 4 ص 10 . (2) مناقب آل أبي طالب جـ 3 ص 506 .
(3) المروج جـ 4 ص 69 . (4) إعلام الورى 359 .
(5) المصدر ص 360 . (6) المصدر ص 357 .
(7) المصدر ص 345 وانظر المروج .)
صفحة (77)
وكان الغالب منهم يدعو إلى ( الرضا من آل محمد ) ، ويعنون بذلك :
الشخص الذي هو أفضل آل محمد (ص) في ذلك العصر . وليس ذلك إلا أحد
أئمتنا عليهم السلام الذين كان يعتقد هؤلاء الثوار بامامتهم .
وإنها لالفتاتة بارعة : أن يدعو الثائر إلى الرضا من آل محمد (ص)
بهذا العنوان العام ، ولا يدعو إلى إمام زمانه بالخصوص . وذلك :
لئلا يوقف الثائر إمامه الذي يدعو إليه ، موقف الحرج تجاه السلطات
الحاكمة ، وهو يعلم أن الإمام عليه السلام ، أمام سمع الدولة
وبصرها ، وليس أهل عليها من أن تتهمه بإثارة الحركة والعصيان ، مما
يؤدي إلى قتله وخسارة المجتمع المسلم لوجوده. ومعه ، فيفكر هذا
الثائر أنه إن نجحت ثورته نجاحتً كبيراً يجعلها أهلاً لمناصرة
امامه عليه السلام ، فهو المطلوب ، وإلا كان وصحبه فداء لإمامه
ولدينه .
وأئمتنا عليهم السلام ـ في عصورهم المتأخرة ـ كانوا لا يعيشون في
الحياة إلا قليلاً ، ويصعدون إلى بارئهم في ريعان الشباب . فالإمام
الجواد محمد بن علي عليه السلام عاش خمساً وعشرين سنة (1) والإمام
الهادي علي بن محمد عليه السلام عاش إحدى وأربعين (2) والإمام
العسكري الحسن بن علي عليه السلام عاش ثمانياً وعشرين عاماً (3) .
ــــــــــــــــــ
(1) انظر الإرشاد ص 307 . (2) المصدر ص 314 .
(3) المصدر ص 325 .)
صفحة (78)
مما يدل على سعي الخلفاء في القضاء عليهم وكتم أنفاسهم ، ولو
بالطريق غير المباشر ، مع أنهم لم يستطيعوا أن يحصلوا منهم على أي
مستند أو دلالة على مشاركتهم في أي حركة وقيامهم بأي نشاط . فكيف
إذا عرفوا منهم ذلك ، وحصلوا منهم على شك في ثورة أو تمرد .
لكن ، لعلنا نستطيع القول ، بأن الأئمة عليهم السلام ، شاركوا من
قريب أو بعيد ، بقيام بعض هذه الثورات أو قسم منها ، أما مباشرة أو
بحسب عموم تعاليمهم وروح إرشاداتهم التي كانت تؤثر في نفوس مواليهم
أثر النار في الحطب والنور في الديجور ، مما يؤدي بهم إلى إعلان
العصيان المسلح على الدولة ، ولكن الأئمة (ع) استطاعوا بلباقة تامة
وحذر عظيم ، إخفاء أي نوع من المستندات والدلالات على مثل هذا
التأثير على الدولة القائمة.وكانوا يستعملون الرموز والمعاني
البعيدة والأعمال غير الملفتة للنظر، في قضاء بعض الحاجات الخطرة
في منطق الدولة . كما هو غير خفي على من راجع رواياتهم ، وسنعرف
بعض ذلك فيما يلي من البحث .
ولعل هناك سبباً آخر ، في عدم دعوة ثوار العلويين إلى شخص الإمام
عليه السلام ، وهو أن الثأر منهم ، إن لم يكن على اتصال مسبق
بالإمام عليه السلام ، فإنه يحتمل أن لا يكون الإمام موافقاً على
ثورته ، لأنه لا يجد فيها المصلحة الكافية والأهلية الكاملة
للتأييد . أما لسوء توقيت الزمان ، أو لسوء اختيار المكان ، أو
لضعف نيات هذا الثائر وأصحابه وقلة إخلاصهم ، أو لضعف الثورة في
نفسها ، بحيث لا أمل فيها للبقاء.)
صفحة (79)
وغير ذلك من المحتملات التي يأخذها التأُر بعين الاعتبار من رأي
إمامه عليه السلام ، فلا يدعو إلى شخصه ، وإنما يدعو إلى عنوان عام
ينطبق عليه : الرضا من آل محمد (ص) .
ونحن ـ لأجل الدقة والموضوعية في البحث ـ لا نستطيع أن نقول : إن
كل الثوار العلويين ، كان ثائراً بالمعنى الذي يقوم على أساس الوعي
الإسلامي ، وهو : الدعوة إلى تطبيق أحكام الإسلام برئاسة الإمام
المعصوم عليه السلام . فإنه وإن كان المعتقد أن غرض أكثر الثوار هو
ذلك ، إلا أن أفراداً منهم ربما كان منحرفاً عن ذلك أو غير واع له
. فكانت ثورته إما للدعوة إلى إمامة نفسه ، أو إمامة شخص آخر غير
الإمام المعصوم عليه السلام ، أو لمجرد التمرد على الظلم ، أو لحب
الظهور والسيطرة ونحو ذلك من الأهداف .
ولعلنا نستطيع أن نضع الحد الفاصل في فهم إخلاص الثائر وعليه ، في
كونه داعياً إلى الرضا من آل محمد (ص) . فإن عرفنا أنه دعى إلى ذلك
، فثورته مخلصة واعية ، وإن لم يدع إلى ذلك ، ينفتح إمامنا فيه
احتمال الإنحراف وعدم الإخلاص .
وقد أحصينا من الثوار العلويين في العصر الذي نؤرخه ، من خلافة
المعتصم إلى نهاية المعتمد ، وهو ما يزيد على نصف قرن ، ثمانية عشر
ثائراً .)
صفحة (80)
أولهم : محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن
أبي طالب ويكنى أبا جعفر ، وكانت العامة تلقبه بالصوفي ، لأنه كان
يدمن لباس الثياب من الصوف الأبيض ، وكان من أهل العلم والفقه
والدين والزهد وحسن المذهب وكان يذهب إلى القول بالعدل والتوحيد ،
ويرى رأي الزيدية الجارودية .
خرج في ايام المعتصم بالطالقان، فأخذه عبد الله بن طاهر ووجه به
إلى المعتصم، بعد وقائع كانت بينه وبينه (1) . وذلك عام 219هـ ،
ودعا إلى الرضا من آل محمد ، ولكن أغراه شخص من خراسان إلى الدعوة
إلى نفسه (2) . وهناك قوم اعتقدوا بأنه لم يمت وأنه يخرج فيملؤها
عدلاً كما ملئت جوراً، وأنه مهدي هذه الأمة (3). أقول : وسيأتي في
بعض بحوثنا إن شاء الله تعالى مناقشة هذه الدعوى وأمثالها .
ثانيهم: يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن
أبي طالب، المكنى بأبي الحسين (4)، وكانت ثورته لذلك نزل به وجفوة
لحقته ومحنة نالته من المتوكل وغيره من الأتراك . وكان ذا زهد وورع
ونسك وعلم (5) .
ـــــــــــــــــــــــــ
(1) المقاتل الأصبهاني ص 411 . (2) الكامل جـ 5 ص 232 .
(3) المروج جـ 3 ص 465 . (4) الكامل جـ 5 ص 314 .
(5) المروج جـ 4 ص 63 .)
صفحة (81)
ثار عام 250 هـ في الكوفة ، وجمع جمعاً كثيراً ، ومضى إلى بيت
المال فيها ليأخذ ما فيه ، وفتح السجون وإخراج من فيها وأخرج عنها
عمال السلطان . اجتمعت إليه الزيدية ، ودعا إلى الرضا من آل محمد ،
فاجتمع الناس إليه وأحبوه. وتولاه العامة من أهل بغداد ، ولا يعلم
أنهم تولوا أحداً من بيته سواه . وبايعه من أهل الكوفة من له تدبير
وبصيرة في تشيعهم .
حاربه الحسين بن إسماعيل بن إبراهيم بن مصعب ، وقتل هذا العلوي في
المعركة (1) . وحمل راسه إلى بغداد وصلب، فضج الناس من ذلك ، لما
في نفوسهم من المحبة له ، لأمر استفتح به أموره ، بالكف عن الدماء
والتورع عن أخذ شيء من أموال الناس ، وأظهر العدل والإنصاف(2) .
وأنشدوا في رثائه شعراً كثيراً حتى قال أبو الفرج :
وما بلغني أن أحداً ممن قتل في الدولة العباسية من آل أبي طالب ،
رثى بأكثر مما رثى به يحيى ، ولا قبل فيه الشعر بأكثر مما قيل فيه
.
أشهرها قصيدة علي بن العباس بن الرومي التي أولها :
أمامك فانظر أي نهجيك تنهج طريقان شتى مستقيم وأعوج
وقد ذكرها أبو الفرج بطولها في المقاتل (3) .
ـــــــــــــــــــــ
(1) الكامل جـ 5 ص 315 . (2) المروج جـ 4 ص 63 .
(3) المقاتل ص 457 .)
صفحة (82)
ثالثهم : الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. بدأت ثورته عام 250هـ أيضاً
بطبرستان ، فغلب عليها ، وعلى جرجان بعد حروب كثيرة وقتال شديد .
وما زالت في يده إلى أن مات سنة 270هـ(1) وخلفه أخوه محمد بن زيد
فيها . وكان هذا الأخوان يدعوان إلى الرضا من آل محمد .
واستولى الحسن بن زيد على آمل وعلى الري(2) وقاتله مفلح وموسى بن
بغا عن الدولة (3) ومحمد بن طاهر (4) حاكمها على خراسان .
وقاتله يعقوب بن الليث الصفار الذي سبق أن سمعنا به .
وكان الحسن هذا عالماً بالفقه والعربية ، وفيه يقول الشاعر :
لا تقل بشرى ولكن بشريان غرة الداعي وعيد المهرجان
رابعهم : الحسن بن علي الحسني المعروف بالأطروش ، حكم طبرستان بعد
محمد بن زيد الحسني ، وخلفه ولده . ثم الداعي الحسن بن القاسم الذي
قتله أسفار بطبرستان(5) .
خامسهم : محمد بن جعفر بن أحمد بن عيسى بن الحسين الصغير بن علي بن
الحسين بن علي بن أبي طالب . ثار في خراسان ، عام 251هـ . فحاربه
حاكمها محمد بن طاهر وأسره (6) وكان يدعو للحسن بن زيد احب طبرستان
(7) .
ـــــــــــــــــــــــــــ
(1) الكامل جـ 6 ص 55. (2) الكامل جـ 5 ص 317 .
(3) المصدر ص 345 . (4) المصدر ص 329 .
(5) المروج جـ 4 ص 68 . (6) الكامل جـ 5 ص 329 .
(7) المروج جـ 4 ص 69 .)
صفحة (83)
سادسهم : ادريس بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن
بن الحسن بن علي بن أبي طالب . ثار بالري مع محمد بن جعفر السابق
الذكر ، عام 251هـ (1) .
سابعهم : أحمد بن عيسى بن علي بن الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن
أبي طالب . دعا للرضا من آل محمد ، ثار بعد محمد بن جعفر وحارب
محمد بن طاهر ، واستولى على الرى (2).
ثامنهم: الحسن بن إسماعيل بن محمد بن عبدالله بن علي بن الحسين بن
علي بن أبي طالب ، الملقب بالكركي. وقيل هو الحسن بن أحمد بن محمد
بن إسماعيل ... الخ (3) . كانت ثورته بقزوين ، فحاربه موسى بن بغا
، وصار الكركي إلى الديلم (4) .
تاسعهم : الحسين بن محمد بن حمزة بن عبد الله بن الحسن بن علي بن
أبي طالب (5) أو الحسين بن أحمد بن حمزة بن عبد الله بن الحسين بن
علي بن أبي طالب (6) .
ــــــــــــــــــــــــ
(1) الكامل جـ 5 ص 329 . (2) المروج جـ 4 ص 69 .
(3) المروج جـ 4 ص 69. ونسبه أبو الفرج بالنحو الأول وقال : المكني
بالحروف . انظر المقاتل ص 469 .
(4) المروج ، الجزء والصفحة السابقين. (5) كما في المروج جـ 4 ص 69
.
(6) كما في الكامل جـ 5 ص 330 .)
صفحة (84)
ثار بالكوفة عام 251هـ ، وأجلى عنها عامل الخليفة ، فسير إليه
المستعين مزاحم بن خاقان فقاتله ، وأطبق على أصحابه فلم يفلت منهم
أحد ، ودخل الكوفة فرماه أهلها بالحجارة فأحرقها بالنار ، فاحترق
منها سبعة أسواق (1) . وقال المسعودي : أنه اختفى لترك أصحابه له
وتخلفهم عنه (2) .
عاشرهم: محمد بن جعفر بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي
بن أبي طالب كان خليفة الحسين بن محمد الحرون السابق الذكر. ثار
بعده بالكوفة ، فكتب إليه ابن طاهر بتولية الكوفة ، وخدعه بذلك،
فلما تمكن بها أخذه خليفة أبي الساج ، فحمله إلى سر من رأى ، فحبس
بها حتى مات(3) .
الحادي عشر : اسماعيل بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الله بن موسى بن
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب . ثار في المدينة
عام 252هـ ، وأصاب أهلها في أيامه الجهد والضيق . وخلفه بعد وفاته
أخوه محمد بن يوسف ، حاربه أبو الساج ولما انكشف من بين يديه ، سار
إلى اليمامة والبحرين واستولى عليها (4).
ــــــــــــــــــــــــــ
(1) المصدر والصفحة . (2) جـ 4 ص 69 .
(3) المقاتل لأبي الفرج ص 470 . (4) المروج ص 94 جـ 4 . وانظر
الكامل جـ 5 ص 335 .)
صفحة (85)
الثاني عشر: علي بن عبد الله الطالبي المسمى بالمرعشي . ثار في
دينة آمل عام 251هـ ، وحاربه أسد بن جندان (1).
الثالث عشر: إنسان علوي ، حصلت ثورته بنينوى عام 251هـ من أرض
العراق . فحاربه هشام بن أبي دلف، في شهر رمضان ، فقتل من أصحابه
جماعة ، وهرب فدخل الكوفة (2) .
الرابع عشر : الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الأرقط
بن محمد بن علي بن الحسين بن علي المعروف بالكوكبي . ثار بناحية
قزوين وزنجان ، فطرد عمال السلطات، عنها عام 251هـ (3) .
وبقي حاكماً على هذه المنطقة حتى عام 252هـ ، حيث شارك في الهجوم
الري مع جستان ، صاحب الديلم وعيسى بن أحمد العلوي . فقتلوا وسبوا
وطردوا وإليها الممثل للسلطة . فصالحهم أهل الري على أن يدفعوا لهم
مليوني درهم ، ويرتحلوا عنها ، ففعلوا (4) .
وفي سنة 253هـ حاربه موسى بن بغا وقضى على حركته باشعال النار في
عسكره بحيلة حربية ، ودخل موسى بن بغا قزوين فاتحاً (5) .
ــــــــــــــــــــــ
(1) الكامل جـ 5 ص 329 . (2) المصدر ص 330 .
(3) المصدر والصفحة . (4) المصدر 335 .
(5) الكامل جـ 5 ص 337 .)
صفحة (86)
الخامس عشر: إبراهيم بن محمد بن يحيى بن عبدالله بن محمد بن علي بن
أبي طالب . ويعرف بابن الصوفي. ثار عام 256هـ في مصر ، واستولى على
مدينة إستا ونهبها ، وعم شره البلاد ، فسير إليه أحمد بن طولون
جيشاً ، فهزمه العلوي ، وأسر المقدم على الجيش ، فقطع يديه ورجليه
وصلبه . فسير إليه ابن طولون جيشاً آخر ، واقتتلوا قتالاً شديداً
فانهزم العلوي وقتل كثير من رجاله ، وسار حتى دخل الواحات (1) .
وبقي مختفياً فيها إلى عام 259هـ ، حيث ظهر ثانياً ودعا إلى نفسه
فتبعه خلق كثير ، وسار بهم إلى الأشمونين . فحاربه أحمد بن طولون
في وقعتين حتى هرب العلوي الصوفي إلى مكة، فقبض عليه وإليها،
وارجعه إلى ابن طولون، فطيف به في البلد ثم سجنه ، وأطلقه ثم رجع
إلى المدينة ، فأقام بها حتى مات (2) .
السادس عشر : علي بن زيد العلوي . كانت ثورته بالكوفة عام 256هـ .
فاستولى عليها ، وأزال عنها نائب الخليفة واستقر فيها ، فناجزته
السلطة القتال عدة مرات ، مرتين بقيادة الشاه بن ميكال ، وثالثة
بقيادة كيجور التركي ، حتى قتل بعكبرا سنة 257هـ (3) .
السابع عشر : عيسى بن جعفر العلوي ، ثار مع علي بن زيد في الكوفة .
قال المسعودي أنه عام 255هـ ، فسرح إليهما المعتز سعيد بن صالح
المعروف بالحاجب في جيش عظيم . فانهزم الطالبيين ، لتفرق أصحابهما
عنهما (4) .
ــــــــــــــــــــــــ
(1) الكامل جـ 5 ص 359 و ص 360 . (2) المصدر ص 369 .
(3) المصدر ص 360 . (4) المروج جـ 4 ص 94 .
)
صفحة (87)
الثامن عشر : ابن موسى بن عبد الله بن موسى بن الحسن بن الحسن بن
علي بن أبي طالب . ظهر بالمدينة بعد إسماعيل بن يوسف السابق الذكر
(1) .
فهؤلاء هم من يعرف بحمل السيف في هذه الفترة ، في وجه السلطات
الحاكمة . وأما الذين قتلوا أو طردوا أو سجنوا فهم أضعاف هذا العدد
، يشير إلى جملة منهم المسعودي في مروجه (2) والاصبحاني في مقاتله
(3) .
ونستطيع أن نستنتج من ذلك أموراً :
الأمر الأول : هو مدى الظلم والعسف الذي كانت تنزله السلطات
الحاكمة على العلويين نسباً وعقيدة . وإلا لم يجد هذا العدد الكبير
خلال نصف قرن ، حاجة إلى هذه التضحيات الكبيرة ، فإنه من المعلوم
أن ازدياد الثورة تتناسب طردياً مع ازدياد الظلم والضغط ، وكلما خف
الظلم وهان الضغط ، قلت الثورة وخف أوارها .
ــــــــــــــــــــ
(1) المصدر والصفحة . (2) المصدر ص 95 .
(3) انظر ص 506 وما بعدها وما قبلها أيضاً .
صفحة (88)
ومن هنا نجد ـ مثلاً ـ أنه في عهد الخليفة المنتصر ، الذي كان يميل
إلى أهل البيت ، خلافاً لأبيه وسلفه المتوكل ، لم تحصل ثورة ولم
يجز منه على أحد من العلويين قتل أو حبس أو مكروه (1) . ولكنه بقي
في الخلافة ستة اشهر فقط !!
الأمر الثاني : إن الخلافة على ضعفها وعجزها في هذا العهد ، وتفاقم
هذا العجز كلما طال الزمان عليها في سامراء. إلا أن هذا لم يكن
بمانع لها عن قمع الثورات العلوية مهما بعدت عن المركز ، ومهما
قويت ، وذلك: لأن الخليفة بنفسه، وإن كان عاجزاً عن تدبير الأمور
العامة ، منصرفاً إلى لهوه وقصفه ، إلا أن مناوأة الفكرة العلوية ،
ليست خاصة به ، وإنما هي عامة على كثير من القواد ـ وبخاصة الأتراك
والموالى والعباسيين ـ ومن الوزراء وحكام الأطراف ، حتى المستقلين
منهم ، كأحمد بن طولون في مصر والسامانية فيما وراء النهر وآل
الإغلب في شمال أفريقيا ، والتاريخ العام والخاص مليء بالشواهد على
ذلك .
الأمر الثالث : إن بعض هؤلاء الثوار كانوا ضيحة تخلف الوعي وسيطرة
المصلحة على أتباعهم وأفراد جيشهم. فإن درجة الوعي عند الأمة كان
منخفضاً جداً ، بمعنى أن ما كان يعيش في أذهانهم دائماً هو الشعور
بالظلم تردي الحال اجتماعياً وسياسياً وثقافياً واقتصادياً ، وهو
ما يدركه كل شخص من زاوية مصلحته وحياته الخاصة . دون شعور واضح
واحساس عميق ، بالمسؤولية الكبرى الملقاة عليه كفرد من الأمة ، في
الدعوة إلى تطبيق ما هو البديل العادل لهذا الظلم والطغيان .
ـــــــــــــــــــــ
(1) المقاتل ص 450 .)
صفحة (89)
ومن هنا كان هؤلاء الثوار يجمعون من الأتباع العدد الكبير نتيجة
طبيعية لشعور الناس بالظلم وأملهم في الثائر الجديد . إلا أن هذا
العدد الكبير كان ينقسم دائماً إلى قسمين :
أحدهما :وهم الخاصة الأقلون، الواعون لأهدافهم الإسلامية ،
الهادفون إلى خدمة امتهم وأداء رسالتهم والباذلون مهجهم في سبيل
عقيدتهم وربهم .
ثانيهما: وهم الأكثر عدداً ، الذين مثلوا المجتمع الذي عاشوه بدرجة
وعيه واحساسه فهم يحسون بالظلم من زاوية شخصية مصلحية ، وحين ظنوا
بالثائر خيراً لمصالهم اتبعوه ذبوا عنه ، ولكنهم حين أحسوا بالموت
أو النوم في سجون السلطات ، وأيسوا من صاحبهم الثائر ، ولوا
منهزمين وتفرقوا عنه وخذلوه كما سمعنا في عدد من الثوار العلويين .
الثامن : من خصائص هذا العصر ، وإن لم يكن من مختصاته ، قيام
الميزان الأساسي والمعيار الغالب ، في تقييم الخلفاء والوزراء
والقواد والقضاة وغيرهم ، ممن بيده السياسة العليا للدولة ، وتحديد
علاقات الصداقة والحرب ، كلها بميزان مادي مالي خالص. لا يختلف في
ذلك من يعيش في العاصمة وما حواليها ممن هو بعيد في الأطراف ، إلا
من شذ وندر.)
صفحة (90)
ويتضح بجلاء ، من استعراض التاريخ ، قيام المجتمع ، بعد انحرافه عن
الإسلام وتناسيه لمسؤوليته الكبرى ، قيامه على أساس الطبقية
الملموسة ، فالأموال تتركز بيد الأقوياء والمتنفذين في السلطة ،
ويحضى الأتراك والقواد الموالى بقسط كبير منها ، على حين يعيش سائر
الناس بالمستوى المتوسط فما دونه ، إلى حال الفقر المدقع ، من دون
ضمان عيش أو أمل حياة.
وإذا أردنا أن نستعرض تفاصيل ذلك لطال بنا المقام ، وخرجنا عن
الغرض ، لكن يكفي أن تعرف طرفا من ذلك:
فالواثق عام 229هـ حبس كتاب دولته ، والزمهم أموالاً عظيمة . أخذ
من أحمد بن إسرائيل ثمانين ألف دينار، ومن سليمان بن وهب ـ كاتب
أيتاخ ـ أربعمائة ألف دينار ، ومن الحسن بن وهب أربعة عشر ألف
دينار . ومن إبراهيم بن رباح وكتابه مائة ألف دينار . ومن أحمد بن
الخطيب مليوناً من الدنانير ، ومن نجاح ستين ألف دينار ، ومن أبي
الوزير مائة وأربعين ألف دينار (1) .
فمن الطبيعي للإنسان أن يتصور أن هؤلاء الكتاب ، كم كان مجموع
ثرواتهم بحيث أمكنهم دفع تلك الضرائب . وإذا كان الكاتب العادي لدى
الوزير حاصل على مثل هذه الثروات فكيف بالوزير نفسه ومن في منزلته
من القواد والقضا والولاة. ولعل من نافلة القول وواضحه ، أن هذه
الأموال إنما تحصل في أيدي هؤلاء ، على حساب الامة الإسلامية ،
وفقر الفقراء ، والمصالح الكبرى التي تفوت بذلك .
ــــــــــــــــــ
(1) الكامل جـ 5 ص 269 .)
صفحة (91)
وأخذ المتوكل من أبي الوليد حين قبض على أبيه أحمد بن دؤاد ، قاضي
القضاة يومئذ ، أخذ منه مئة وعشرون ألف دينار وجواهر قيمتها عشرون
ألف دينار . حملها إلى المتوكل اختياراً . ثم صولح بعد ذلك على دفع
ستة عشر مليون درهم . وأما أبوه الذي كان قاضياً للقضاة ، فصادر
جميع أملاكه وضياعه (1) .
ثم عين المتوكل لقضاة القضاة يحيى بن أكثم ، وذلك سنة 237هـ (2) ،
إلا أنه عزله عام 240هـ وغرمه خمسة وسبعون ألف دينار ، وأربعة آلاف
جريب في البصرة (3) فكم كان هذا الرجل قد حصل عليه من الأموال،
خلال هذه السنوات الثلاث ؟!
ومن المستطاع القول أن مقتل المتوكل(4) وخلع المستعين(5)
والمعتز(6) والمهتدي وقتلهم ، كان بسبب اقتصادي، يعود إلى أطماع
الأتراك ، وعجز الخليفة عن إيفاء مطالب الدولة من الناحية المالية
. ولا يبقى من خلفاء سامراء من مات ـ في هذه الفترة ـ حتف أنفه ،
إلا المنتصر(7) والمعتمد (8).
ـــــــــــــــــــ
(1) الكامل جـ 5 ص 289 . (2) المصدر ص 237 .
(3) المصدر ص 294 . (4) المصدر ص 301 .
(5) المصدر ص 331 . (6) المصدر ص 341 .
(7) المصدر ص 355 . (8) المصدر ص 310.)
صفحة (92)
ومن المستطاع القول ، بأن الحروب المستعرة التي وقعت في بغداد بين
المستعين والمعتز عام 251هـ ، تعود إلى سبب اقتصادي ، مرجعه إلى
سوء تصرف الأتراك بالأموال بعد تسليطهم الكامل عليها . فإن
المستعين كان قد أطلق يد والدته ويد أتامش وشاهك الخادم في بيوت
الأموال ، وأباح لهم أن يفعلوا ما أرادوا ! فكانت الأموال التي ترد
من الأفاق يصير معظمها إلى هؤلاء الثلاثة . فأخذ أتامش أكثر ما في
بيوت الأموال . وكان وصيف وبغا ـ وهما من الأتراك المتنفذين ـ
بمعزل عن ذلك ، فشغبوا عليه وقتلوه وقتلوا كاتبه ونهبوا دوره (1).
ثم كان لهذين مؤامرة في قتل المستعين ، فشلت وانكشفت له ، فقال
المستعين لهما : أنتما جعلتماني خليفة تريدون قتلي(2) . وكان باغر
التركي مشتركاً معهما في المؤامرة ، فتآمرا ضده وقتلاه (3) . وقد
كان قتل باغر الشرارة الأولى التي أشعلت الحرب في بغداد ، تلك
الحرب التي أدت إلى قتل المستعين عام 252هـ (4) .
وقد كان لام المعتز تسبيباً إلى قتله . فإن الأتراك طلبوا منه
المال ، فلم يكن لديه ما يعطيهم ، فنزلوا معه إلى خمسين ألف دينار،
فلم يكن يمكنه الدفع. فأرسل إلى أمه يسألها مالاً ليعطيهم ، فزعمت
أن ليس عندها شيء، فقتله الأتراك شر قتله (5) .
ــــــــــــــــــــــ
(1) الكامل جـ 5 ص 313 . (2) المصدرص 329 .
(3) المصدر ص 318 . (4) المصدر ص 333 .
(5) المصدر ص 241 وما بعدها .)
صفحة (93)
وقد وجدوا عندها ، بعد مقتل ابنها من الأموال مالاً يقدر بثمن .
فمن النقد مليون وثلثمائة ألف دينار . ووجدوا في سفط قدر مكون زمرد
لم ير الناس مثله ، وفي سفط آخر مقدار مكوك من اللؤلؤ الكبار . وفي
سفط آخر قدر كيلجة من الياقوت الأحمر الذي لم يوجد مثله . فحمل ذلك
كله إلى صالح بن وصيف ، فسبها وقال :
عرضت ابنها للقتل في خمسين ألف دينار ، وعندها هذه الأموال كلها.
التاسع : من خصائص هذا العصر ، وليست من مختصاته أيضاً : استمرار
الفتح الإسلامي الذي أوجد بذرته الأولى وركيزته العظمى وروحه
الدافقة ، نبي الإسلام (ص) .
إلا أن النبي (ص) أعطى الفكرة الصحيحة الداعية للفتح الإسلامي ،
فالفتح ليس للقتل ولا الانتقام ، وإنما هو رحمة وشفقة على البلاد
المفتوحة ، وتخليصها من نير العبودية والظلم ، وتطبيق النظام
الإسلامي الأمثل عليها
وإذا كان هذا هو المعنى الواعي للفتح ، فإنه يترتب عليه أمور :
أولاً: أن تقع المنطقة المفتوحة تحت سيطرة الدولة الإسلامية ،
وإشرافها من حيث الناحيتين العقائدية والسياسية، أمنا للدولة
الجديدة عن الإنحراف واطمئناناً من حدوث شغب أو اضطراب أو انحراف
عن تعاليم الإسلام .)
صفحة (94)
ثانياً : أن الفتح لا يكون إلا بإشراف رئيس الدولة الإسلامية وهو
النبي (ص) في حياته ، أو خليفته الشرعي العادل بعد وفاته .
فإن هذا الرئيس هو المطلع على المصالح بشكل أعمق وأدق والممسك بيده
زمام السياسة العليا ، والمستشعر بشكل أوضح وأوعى ، المعنى العظيم
للفتح الإسلامي البعيد عن المصالح الشخصية والمنافع الذاتية . ومن
ثم لم تكن الفتوح الإسلايمة ، في زمن النبي (ص) والخلافة الراشدة
منطلقة إلا بإذن الحاكم الإسلامي الاعلى .
ثالثاً : إن الغنائم ليس لها أهمية تذكر. فإن المقصود إذا كان هو
رفع الظلم عن البلد المفتوح ، فهو حاصل ، سواء غنم الجيش الإسلامي
أو لم يغنم . وإنما تكون الغنيمة من قبيل جوائز التشجيع توزع على
الجيش الإسلامي المنتصر ، رفعاً لمعنوياته وترغيباً له على التكرار
.
رابعاً : إن الوعي إذا كان على هذا المستوى الرفيع ، كان الجيش
الإسلامي هو المندفع والمنتصر دائماً والكاسح لعروش الظلم والفساد
، عروش كسرى وقيصر .
بل أن الشعب المظلوم المتخلف ، وهو يحس بظلامته ، بمجرد أن يفهم أن
الغزاة المسلمين ليسوا طامعين ولا ناقمين ، وإنما قدموا ليطبقوا
النظام العادل ويكفلوا لمجتمعهم السعادة والرفاه ، فإنهم سوف
يكونون قلبياً بل عملياً مع الجيش الفاتح ضد سلطاتهم وحكامهم ،
وعوناً للجيش الإسلامي ضدهم . ومن هنا وجب على الجيش الإسلامي أن
يدعو إلى الإسلام ويعرض محاسنه على أهل البلاد قبل أن يناجزهم
القتال .)
صفحة (95)
فهذه أمور أربعة يقتضيها الجهاد الواعي الذي أسس أساسه النبي (ص) .
وكلها كانت ضئيلة أو منعدمة في الفتح الجاري أثناء العصر الذي نؤرخ
له .
فنحن نسمع مثلاً : أن العباس بن الفضل بن يعقوب ، خرج عام 237هـ
إلى قلعة ابن ثور فغنم وأسر وعاد ، فقتل الأسرى . وتوجه إلى مدينة
قصريانه ، فنهب وأحرق وخرب (1) .
وفي سنة 238هـ خرج حتى بلغ قصريانه ، ومعه جمع عظيم ، فغنم وخرب.
وأتى قطانية وسرقوسة ونوطس ورخوس ، فغنم من جميع هذه البلاد وأحرق
، وفي سنة 42هـ ، سار العباس في جيش كثيف ، ففتح حصوناً جمة.
وفي سنة 243هـ سار إلى قصر يانة فخرج أهلها فلقوه وقاتلوه فهزمهم ،
وقتل فيهم فأكثر . وقصد سرقوسة وغيرهما فنهب وخرب وأحرق . ونزل على
القصر الحديد وحصره وضيق على من به من الروم ، فبذلوا له خمسة عشر
ألف دينار ، فلم يقبل وأطال الحصر ، فسلموا إليه الحصن على شرط أن
يطلق مأتي نفس ، فأجابهم إلى ذلك وملكه وباع كل من فيه سوى مأتي
نفس ، وهدم الحصن(2) .
ــــــــــــــــــ
(1) الكامل جـ 5 ص 289 .
(2) كل ذلك في الكامل جـ 5 ص 289 .)
صفحة (96)
ونسمع أنه في عام 246هـ غزا عمرو بن عبد الله الأقطع الصائفة ،
فأخرج سبعة شعر ألف رأس . وغزا قريباس وأخرج خمسة آلاف رأس . وغزا
الفضل بن قارن في نحو من عشرين مركباً فافتتح حص أنطاكية .
وغزا بلكاجور فغنم وسبى ، وغزا علي بن يحيى الأرمني ، فغنم خمسة
آلاف رأس ومن الدواب والرمك والحمير نحواً من عشر آلاف رأس (1).
ولعل من أعظم الغنائم في ذلك العصر ما غنمه بازمار عام 270هـ ، بعد
أن قتل من الروم ـ فيما قال ـ سبعين ألفاً وعدداً من قوادهم . وغنم
منهم : سبع صلبان من ذهب وفضة ، وصليبهم الأعظم من ذهب مكلل
بالجوهر ، وأخذ خمسة عشر ألف دابة وبغل ، ومن السروج وغير ذلك ،
وأربع كراسي من ذهب ومائتي كرسي من فضة وآنية كثيرة ، ونحواً من
عشرة آلاف علم ديباج ، وديباجاً كثيراً وبزيون وغير ذلك (2) .
ونسمع أنه في سنة 248هـ أغزا المنتصر وصيفاً التركي إلى بلاد
الروم. وكان سبب ذلك : أنه كان بينه وبين أحمد بن الخصيب شحناء
وتباغض ، فحرّض ابن الخصيب المنتصر وأشار عليه بإخراجه من عسكره
للغزو (3)، فنفذ المنتصر ذلك وأمره بالمقام بالثغر أربع سنين يغزو
في أوقات الغزو ، إلى أن يأتيه رأيه .
ـــــــــــــــــــ
(1) المصدر ص 300 . (2) الكامل جـ 6 ص 55 .
(3) الكامل جـ 5 ص 307)
صفحة (97)
ولم يكن محور حركة الفتح الإسلامي واحداً ، بل كانت محاوره متعددة
، فالخلافة العباسية بقوادها الأتراك وغيرهم كانت تشارك فيه ،
والدولة الأموية في الأندلس ، كانت دائمة المناوشة مع الافرنج .
وكان أحمد بن طولون ممن يتولى الغزو أيضاً (1) . ودولة افريقية
برئاسة محمد بن الأغلب وأسرته كانت تتولاه أيضاً (2) .
وبهذا نرى أن حوادث الفتح ، مختلفة اختلافاً اساسياً عن مفاهيم
الفتح الإسلامي الواعي الأصيل ، فالغزو أصبح للتجارة والحصول على
الغنائم ، حتى أن القائد الغانم كان يساوم عليه بخمسة عشر ألف
دينار فلا يقبل.
ولم تكن الدعوة إلى الإسلام قبل البدء بالقتال موجودة ولا متبعة ،
مع أن وجوبها من واضحات الشريعة . كما أن الأسرى كانت تقتل ،
خلافاً لتعاليم الإسلام . كما أن البلاد المفتوحة لم تكن تدخل على
أثر الفتح في مجموعة البلاد الإسلامية . كما أن البلاد المفتوحة لم
تكن تدخل على أثر الفتح في مجموعة البلاد الإسلامية ، بل كان
القواد بمجرد أن يحلوا على أرباحهم يتركون البلاد تنادي بالويل
والثبور ، ويرجعون ، من دون أن يجعلوا عليها والياً إسلامياً ، أو
يطلبوا من أهلها الدخول في دين الإسلام أو دفع الجزية .
ـــــــــــــــــــــ
(1) المصدر جـ 6 ص 14 وما بعدها .
(2) المصدر جـ 5 ص 289 .)
صفحة (98)
كما أن الروم ، وهم عبارة عن الافرنج عامة والبزنطيين خاصة ، حين
كانوا يرون أن الفكرة الأساسية للجهاد في ذلك الحين هو النفعية ،
كانوا هم أيضاً يقومون بنفس العمل ، فيغزن البلاد الإسلامية
ويقتلون جملة من أهلها، ويكسبون الربح التجاري ويرجعون، فهم
كالمسلمين، من حيث العدة والعدد ، فلماذا يمتنعون عن ذلك؟! وماذا
يميز المسلمين عنهم من الوعي المقدس الذي كان قد تبخر وانتفى. ومن
ثم نجد أن الجيش الإسلامي ليس هو الغالب دائماً في هذا العصر الذي
نؤرخه ، بل هناك انتصارات يحرزها الروم ، كما سبق أن سمعنا .
كما أن الفتح كان ، في الأغلب مستقلاً عن خلافة بغداد ، وعن رأيها
واذنها ، وإنما كان القواد وحكام الأطراف يقومون به كل حسب رأيه
ومصلحته. ولم نسمع ارسال الخليفة أحداً للغزو إلا فيما سمعناه من
المنتصر حين أغزى وصيفاً التركي، على أن هذه الحادثة الوحيدة ، لم
تكن في سبيل الله، وإنما كانت إيفاءً للاحقاد والتباغض الذي كان
بين وصيف وأحمد بن الخصيب ، كما سمعناه .)
صفحة (99)
الفصل الثاني
تاريخ الإمام علي بن محمد الهادي (ع)
كانت سامراء عاصمة الدولة العباسية في أوج عزها وعمرانها ، وكان
المتوكل هو تسنم كرسي الخلافة جاء به جماعة من الموالى والاتراك
عام 232هـ . وكان قد تسلم الخلافة حاقداً على أئمتنا (ع) وعلى
اصحابهم حذراً منهم كل الحذر . وهذا واضح لمن يراجع التاريخ كل
الوضوح (1) بلغ في آل ابي طالب ما لم يبلغه أحد من خلفاء بني
العباس قبله ، وكان من ذلك ان كرب قرب الحسين السلام وعفى آثاره .
وفكر المتوكل ان يستقدم الامام علي بن محمد الهادي عليه السلام إلى
سامراء من المدينة ، آخذاً بالأسلوب الذي اخترعه المأمون العباسي
وسار عليه من بعده تجاه الامام الجواد محمد بين علي عليه السلام ،
ومن بعده الأئمة (ع) . فان المأمون حين زوج ابنته أم الفضل للإمام
الجواد عليه السلام ، كان قد وضع الحجر الأساسي للمراقبة الشديدة
والحذر التام من الامام عليه السلام من الداخل ، مضافاً إلى
مراقبته من الخارج .
_________________
(1) انظر الكامل جـ ، ص 304 ، ص 287 جـ 4 ص 51 ومقاتل الطالبين جـ
3 ص 424 .)
صفحة (101)
وكان هذا الزواج وتقريبه إلى البلاط ، أسلوب ناجح الوصول إلى هذه
النتيجة التي يراد بها جعل الامام عليه السلام بين سمع الخليفة
وبصره ، وعزله عن قواعده الشعبية الموالية له ، وكفكفة نشاطه.
وإذ توفي الامام الجواد عليه السلام ، وتولى الامام الهادي عليه
السلام الامامة بعده ، لم يكن ليفوت المتوكل ضرورة تطبيق نفس هذا
الاسلوب عليه ، فهو يرى ان الامام حال وجوده في المدينة ، بعيداً
عنه ، يشكل خطراً على الدولة لا محالة ، اذن فلا بد من استقدامه
إلى سامرا حتى يأمن خطره ويهدأ باله ، ويضعه تحت الرقابة المباشرة
منفصلاً عن قواعده الشعبية .
ومن ثم كانت الوشاية به - وهي ناقوس الخطر - كافيه لحفز المتوكل
على ضعضعة حياة الامام الهادي عليه السلام ، ونقله من موطنه وداره
في المدينة ، إلى العاصمة سامراء ، لكي يبدأ تاريخاً جديداً حافلاً
في موطنه الجديد .
الاتجاه العام للامام الهادي (ع) :
في استقدام المتوكل اياه :
لم يكن من المصلحة في نظر الامام عليه السلام ، اعلان الخلاف ضد
المتوكل ، وكذلك كانت سياسة ابيه وابنائه عليهم السلام بالنسبة إلى
الخلافة العباسية ، حتى تكللت هذه السلبية بغيبة الامام المهدي
عليه السلام
ولعلنا في غنى عن اعطاء الفكرة الكاملة عن سبب هذه السلبية ، بعد
وضوح ان ما يستهدفه الأئمة (ع) انما هو تأسيس المجتمع الاسلامي
العادل الواعي الذي يطبق تعاليم الاسلام بتفاصيلها ، ويتعاون
افراده في انجاح التجربة الاسلامية .)
صفحة (102)
وهذا انما يتوفر بعد وجود عنصرين :
اولهما: وجود الخلافة الاسلامية بالشكل الذي كان يؤمن به الأئمة
عليهم السلام ، وهو توليهم بانفسهم منصب الامامة ورئاسة الدولة
الاسلامية ، أو من يعينونه ويختارونه لذلك .
ثانيهما : وجود المجتمع الذي يملك اكثرية كبيرة أو مئة بالمئة ، لو
تحقق ، من الافراد الواعين المتشبعين بفهم الاسلام نصاً وروحاً ،
ومستعدين للتضحية في سبيله ، ولقول الحق ولو على أنفسهم ، ورفض
مصالحهم الضيقة تجاهه . والذين يبذلون - نتيجة لذلك - الطاعة
المطلقة للحاكم الاسلامي الحق .
ولعلنا نستطيع ان نستوضح أهمية انضمام هذين العنصرين في تكوين
الدولة الدولة الاسلامية ، اذا تصورنا تخلى بعضها عن بعض . في صورة
ما إذا تولى الامام الحق منصب الرئاسة في مجتمع متضارب الآراء
مختلف الاهواء ، يعيش افراده على اللذاذة الآنية والمصلحة الشخصية
، بعيدين عن الاسلام وعن الاستعداد للتضحية في سبيله باقل القليل .
هل يستطيع الامام ان يقدم الخدمات الاسلامية المطلوبة ، لمثل هذا
المجتمع .
كلا ، فان تطبيق العدل الكامل ، يحتاج إلى العمل الدائب والتضحيات
الكبيرة والطاعة المطلقة للرئيس العادل ، وكل ذلك مما لا يمكن
توفره في المجتمع المنحرف وغير الواعي.)
صفحة (103)
ومن الأئمة عليهم السلام ، يرون المصلحة في تولي رئاسة الدولة
الاسلامية في المجتمع المنحرف ، الذي أدى بمن تولى هذا المنصب منهم
إلى المتاعب المضاعفة وإلى القتل في نهاية المطاف. وهم : جدهم
الأعلى امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام ، ومن بعده ابنه
الامام الحسن المجتبى عليه السلام ، إذ لو كان المجتمع واعياً
ومضحياً في سبيل دينه في عصرهما (ع) لكان لهما خاصة وللامة
الاسلامية عامة تاريخ غير هذا التاريخ .
ولم يكن المتجتمع في خلال عصور الأئمة جميعهم بأحسن حالاً من
المجتمع الأول الذي قتل امير المؤمنين وخذل ابنه الحسن وقاتل ابنه
الحسين عليهم السلام . ان لم يكن قد تزايد لهوه وبطره وحرصه على
المصالح واللذاذات ، نتيجة لانكباب الخلفاء انفسهم على ذلك ، فان
الناس بدين ملوكهم ، مع انعدام أو ضآلة المد الكافي لتوعية المجتمع
وارجاعه إلى فهم دينه الحنيف .
ومن ثم لم يكن لهم في الخلافة مطمع، لانهم لم يكونوا يريدون السير
على الخط (الأموي - العباسي) للخلافة، ذلك الخط المنحرف الذي يؤمن
للناس اطماعهم ويقسم المجتمع إلى نعمة موفورة وإلى حق مضيع.
فكان الهدف الأساسي للأئمة عليهم السلام ينقسم إلى أمرين مترابطين
:
أحدهما : حفظ المجتمع من التفسخ والانهيار الكلى ، أو بتعبير آخر :
حفظ الثمالة المشعة من الحق ، المتمثلة بهم وبمواليهم وقواعدهم
الشعبية. ثانيها: السعي إلى تأسيس المجتمع الاسلامي الواعي ، ورفع
المستوى الايماني في نفوس افراده ، تمهيداً لنيل الخلافة الحقة
وتطبيق المنصب الالهي الذي يعتقدون استحقاقه.)
صفحة (104)
وكانوا يعملون على تنفيذ ذلك ، في حدود الامكان الذي يناسب مع
الحذر من الجهاز الحاكم وتجنب شره . إذ لم يكن من المصلحة، ان يقوم
الامام عليه السلام بحركة ثورية عشوائية بجماعة قليلة تؤدي به
وبجميع أصحابه إلى الاستئصال التام ، ولا يتحقق شيء من ذينك
الغرضين.
فهذا هو السر الاساسي للسلبية التي سار عليها الأئمة عليهم السلام
تجاه السلطات الحاكمة ، وهو الذي يفسر لنا - على تفصيل وتحقيق لا
مجال له هنا - اعلان الامام الحسن عليه السلام الصلح مع معاوية.
ورفض الامام الرضا عليه السلام ولاية العهد التي عرضها عليه
المأمون.
وهوالسبب الذي ادى إلى الموقف السلبي للامامين العسكريين عليهما
السلام اللذين نورخ لهما وهو الذي ادى - في نهاية المطاف - إلى
غيبة الامام المهدي عليه السلام ، على ما سنعرف .)
صفحة (105)
سفره إلى سامراء :
وشى عبد الله بن محمد الذي كان يتولى الحرب والصلاة بمدينة الرسول
المنورة ، بالامام المهدي عليه السلام، وكان يقصده بالاذى. فبلغ
إلى الامام خبر وشايته ، فكتب إلى المتوكل يذكر تحامل عبد الله بن
محمد عليه السلام ، وكذبه فيما سعى به (1) .
فنرى كيف ان عبد الله بن محمد يمثل الخط العام للدولة ، في الفزع
من نشاط الامام وتصرفاته ، وكيف وصل به الحال إلى ان يرسل إلى
المتوكل بخبره ، باعتباره حريصاً على مصالح الدولة ، ومنتبهاً على
مواطن الخطر ؟! ولعله التفت إلى بعض النشاطات المهمة التي كان يقوم
بها الامام بعيداً عن السلطات ، فاوجس منها خيفة حدت به إلى هذه
الوشاية.
الا ان المتوكل كان يعلم بكل وضوح ، عدم امكان الحصول على أي مستند
ضد الامام عليه السلام ، فان للأئمة عليهم السلام ، كما سبق ان
قلنا اساليباً من الرمزية والاخفاء يمكنهم خلالها القيام بجملة من
جلائل الأعمال .
_________________
(1) انظر الارشاد 313 .)
صفحة (106)
لعل أهم دلائل الاخفاء ، هو تصديه إلى تكذيب الخبر برسالة يرسلها
إلى المتوكل نفسه ، يكذب فيها التهمة ، وينفي عن نفسه صفة التأمر
على الدولة . فان نشاطه كان مقتصراً في الدفاع عن قواعده الشعبية
وتدبير أمورهم ، وليس له ضد الدولة أي عمل ، وان كان قد أوجب عمله
توهم عبد الله بن محمد لذلك .
والمتوكل هو من عرفناه بموقفه المتزمت ضد الامام عليه السلام وكل
من يمت اليه بنسب أو عقيدة . ولكنه يتلقى رسالة الامام (ع) بصدر
رحب ، ويرسل له رسالة مفصلة كلها اجلال له واعظام لمحله ومنزلته.
يعترف بها ببرائته وصدق نيته ويوعز بعزل عبد الله بن محمد عن منصبه
بالمدينة ، ويدعى الاشتياق اليه ويدعوه ان يشخص إلى سامراء مع من
اختار من أهل بيته ومواليه (1) .
وهذا الطلب، وان صاغه المتوكل بصيغة الرجاء ، الا انه هو الالزام
بعينه ، فان الامام عليه السلام ان لم يذهب حيث امره يكون قد اثبت
تلك التهمة على نفسه واعلن العصيان على الخلافة ، وكلاهما مما لا
تقتضيه سياسة الامام (ع) .
واما عام سفره هذا ، فقد ذكر في الارشاد (2) : ان الرسالة مؤرخة
بجمادى الآخرة سنة ثلاث واربعين ومأتين وليس في هذا ما يلفت النظر
لولا ما ذكره ابن شهر اشوب من ان مدة مقام الامام الهادي عليه
السلام في سامراء من حين دخوله إلى وفاته ، عشرون سنة (3) .
_______________________________
(1) انظر نص الرسالة في الارشاد . الصفحة السابقة وما بعدها .
(2) انظر ص 314 .
(3) المناقب جـ 3 ص 505 .)
صفحة (107)
واذ نعرف انه عليه السلام توفى عام 254هـ (1) ، تكون سفرته هذه قبل
عشرين عاماً من هذا التاريخ أي سنة 234هـ . وهذا انسب بالاعتبار
السياسي ، باعتبار كونه بعد مجيء المتوكل إلى الخلافة بعامين ،
فيكون المتوكل قد طبق منهجه في الرقابة على الامام في الاعوام
الأولى من خلافته بخلافه على الرواية الثانية ، التي تبعد بالتاريخ
عن استخلاف المتوكل أحد عشر عاماً . والله العالم بحقائق الأمور.
اعطى المتوكل رسالته إلى احد صنائعه ، يحيى بن هرثمة ، ليسلمها إلى
الامام في المدينة ، وامره باستقدامه إلى سامراء . فأسمعه يقول في
روايته للحادثة(2) : فلما صرت اليها - يعني المدينة المنورة - ضج
أهلها وعجوا ضجيجاً وعجيجاً ما سمعت مثله . فجعلت اسكنهم واحلف لهم
اني لم أؤمر فيه بمكروه ، وفتشت بيته ، فلم أجد فيه إلا مصحفاً
ودعاء وما أشبه ذلك .
فنعرف من ذلك، مدى اخلاص اهل المدينة لامامهم عليه السلام ، وحرصهم
عليه ، ومدى تأثيره الحسن فيهم، ولم يكن هذا الضجيج الكبير منهم ،
إلا لمعرفتهم بوضوح سوء نية السلطات تجاه الامام وابتغائها الدوائر
ضده.
_________________________
(1) انظر الارشاد ص 307 وابن الوردي جـ 1 ص 232 وابن خلكان ص 435
جـ 2 والطبري جـ 11 ص 157 والعبر جـ 2 ص 5 وابو الفداء جـ ص 254
(2) انظر المروج جـ 4 ص 84 وما بعده)
صفحة (108)
فكان تأسفهم وتأوههم ناشئاً من امرين :
احدهما: انقطاعهم عن الامام عليه السلام ، وحرمانهم من ارشاداته
والطافه ونشاطه الاسلامي البناء . وهذا ما اراده المتوكل ، وقد حصل
بالفعل بمقر الامام ، فانه لم يعد إلى المدينة بعد ذلك .
الثاني: مخافتهم على حياته ، لاحتمال قتله عند وصوله إلى العاصمة
العباسية. وهذا هو الذي فهمه يحيى بن هرثمة من الضجيج - وحاول ان
لا يفهم غيره - فحلف لهم انه لم يؤمر فيه بمكروه.
ولم يثن الضجيج هذا الرجل عن غرضه السياسي في التجسس ففتش دار
الامام ، بالمقدار الذي حلا له ، فلم يجد فيه أي وثيقة تدل على
التمرد أو الخروج على النظام العباسي . وبذلك يكون المتوكل قد فقد
أي مستمسك يؤيد ما سمعه عنه أو خافه منه . واستطاع الامام عليه
السلام ان يحافظ على مسلكه العام في السلبية .
وخرج الامام الهادي عليه السلام ، مصاحباً لولده الامام العسكري
وهو وصي ، مع ابن هرثمة متوجهاً إلى سامراء . وحاول ابن هرثمة في
الطريق اكرام الامام واحسان عشرته . وكان يرى منه الكرامات والحجج
التي تدل على توليه طرق الحق ، وتوضح لهذا الرجل جريمته في ازعاج
الامام وزعزعته والتجسس عليه ، وجريمة من امره بذلك أيضاً .)
صفحة (109)
ويمر الركب ببغداد - في طريقه إلى سامراء - فيقابل ابن هرثمة
واليها - بعد انتقال الخلافة عنها - وهو يومئذ اسحاق بن ابراهيم
الطاهري . وهو ، بمقتضى منصبه ، محل الثقة الكبرى من قبل المتوكل ،
بحيث جعله والياً على عاصمته الثانية وقائماً مقامه فيها . فنرى
اسحاقاً الطاهري يوصى بن هرثمة بالامام مستوثقاً من حياته قائلاً
له : يا يحيى ان هذا الرجل قد ولده رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
والمتوكل من تعلم وان حرضته على قتله ، كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم خصمك .
فيجيبه يحيى : والله ما وقفت له الا على كل امر جميل (1) .
ونحن حين نسمع هذا الحوار بين الرجلين اللذين يمثلان السلطات نفسها
ويعيشان على موائدها ، نعرف كم وصل الحقد والتمرد على النظام
القائم يؤمئذ ، وكيف أنه تجاوز القواعد الشعبية إلى الطبقة العليا
الخاصة من الحكام ، مواضع ثقة الخليفة ومنفذي اوامره. كما نعرف مدى
اتساع الذكر الحسن والصدى الجميل لافعال الامام وأقواله بين جميع
الطبقات ، حتى بين الحكام انفسهم .
وحين يصل الركب إلى سامراء ، يبدأ ابن هرثمة بمقابلة وصيف التركي ،
وقد عرفناه قائداً من القواد الاتراك المنتفعين بالوضع القائم ،
ممن كان يشارك في تنصيب الخليفة وعزله ومناقشته في اعماله ويظهر من
التاريخ ان وصيفاً كان هو الآمر رسمياً على ابن هرثمة ، ومن هنا
قال له وصيف : والله لئن سقطت من رأس هذا الرجل شعرة ، لا يكون
المطالب بها غيري .
______________________
(1) مروج الذهب جـ 4 ص 85 .
صفحة(110)
يقول ابن هرثمة : فعجبت من قولهما ، وعرفت المتوكل ما وقفت عليه
وما سمعته من الثناء عليه ، فاحسن جائزته واظهر برّه وتكرمته (1) .
وقد عرفنا مما سبق ان كل هذا الكرم الحاتمي ، على الامام عليه
السلام ، لم يكن من أجل حفظ حق الامام ، وانما كان تغطية للمنهج
السياسي الذي يريد المتوكل اتباعه ، وهو عزل الامام عن نشاطه
وقواعده الشعبية والحذر مما قد يصدر منه من قول أو فعل .
ومن هنا نرى ، ان المتوكل أمر ان يحجب عنه الامام (2) في يوم وروده
الأول إلى العاصمة العباسية. ونزل الامام في مكان متواضع يدعى بخان
الصعاليك ، فقام فيه يومه (3) .
ومر عليه ، وهو في هذا الخان احد محبيه مقدري فضله ، صالح بن سعيد
، فاحزنه حال الامام عليه السلام ، فقال له : جعلت فداك في كل
الامور ارادوا اطفاء نورك والتقصير بك حتى انزلوك في هذا الخان
الأشنع ، خان الصعاليك .
ويسمع الامام (ع) ما قال ، فيجيب وكأنه قد التفت بعد استغراق تفكير
ونشغال بال : ههنا انت يا ابن سعيد .
ثم يريد الامام (ع) ان يفهم هذا المشفق بان الحال الدينوية ، وان
إلا أن حدوث مثل ذلك ، في ذلك الظرف العصيب ، لم يكن ليصل إلينا
أكثر مما وصل منه فعلاً .
________________________
(1) المصدر والصفحة .
(2) الارشاد ص 314 .
(3) اعلام الورى ص 348 وانظر الارشاد أيضاً نفس الصفحة السابقة .)
صفحة (111)
مضافاً ، إلى أن جملة من الأحداث ، كان في مستطاع أصحاب الإمام
عليه السلام وأعدائه ، كما في مستطاع المؤرخ اليوم، استنتاج رأيه
فيها، بصفته الوجود الممتد لرسول الله (ص) والممثل للقواعد
الإسلامية الصحيحة. فنحن لا نحتاج إلا مزيد تفكير حين نريد معرفة
رأيه باشخاص الخلفاء أو سلوكهم المنحرف أو الوزراء أو القواد ،
ونشاطهم غير القائم على أساس العدل الإسلامي ، أو رأيه في الخوارج
أو في هدم قبر جده الحسين عليه السلام ومنع الزوار عنه. فإن كل ذلك
مما يرفضه رفضاً باتاً ويستنكره أشد الاستنكار . وكذلك الحروب
والمناوشات التي كانت تقع في داخل البلاد الإسلامية ، قائمة على
الطمع والتوسع . وكذلك تنصيب القضاة غير الاكفاء بنظر الإمام (ع)
وجميع ما يصدرون من أحكام .
أما بالنسبة إلى حروب المسلمين مع الاغيار في الحدود الإسلامية ،
فمن المستطاع القول بموافقته عليها ، باعتبارها القضية التي تخص
الإسلام ، الذي يمثل الإمام حقيقته وجوهره . ولو كان الجهاد في ذلك
الزمان في سبيل الله محضاً ـ كما كان على عهد رسول الله (ص) ـ لكان
الإمام أول المبادرين إلى تأييده ، ولكننا أسلفنا في التاريخ العام
أن فكرة الجهاد انحدرت في الأزمان المتأخرة إلى التجارة والمساومة
.
صفحة(121)
فلم تكن هذه الناحية ، من الجهاد ، بمرضية للإمام عليه السلام ،
وبخاصة وأن الاموال المغتنمة ، لم تكن تصرف في مصلحة الدين والأمة
، وإنما كانت : في الأغلب ، تصرف في الشؤون الخاصة للحكام .
وإنما الذي كون مرضياً للإمام عليه السلام ، هو نتيجة الجهاد وهو
سقوط المنطقة الكافرة بين المسلمين ، ودخولها في بلاد الإسلام
وخلاصها من حكم الكفر أو الإلحاد .)
صفحة (122)
الخطوط العامة لمواقف الإمام (ع) :
كان الإمام الهادي عليه السلام في سامراء يمارس وظيفته الاعتيادية
بصفته الإمام والقائد لمواليه والمشرف على مصالحهم والمدافع عن
قضاياهم بمقدار الإمكان ، في تلك الحدود الضيقة التي تحدد بحدود
الضغط والرقابة الموجهة إليه وإلى مواليه .
فكان له في ذلك موقفان :
الموقف الأول: اثبات الحق أو نقد الباطل ، بحسب وجهة نظره ، تجاه
الناس من غير الموالين له ، سواء على المستوى العالي في الجهاز
الحاكم ، أوعلى مستوى القواعد الشعبية العامة .
الموقف الثاني: المحافظة التامة على أصحابه ورعاية مصالحهم
وتحذيرهم من الوقوع في الشرك العباسي، ومساعدتهم في إخفاء نشاطهم ،
وما إلى ذلك ، بحسب الإمكان .
ولعلنا نستطيع أن نتكلم في كل موقف من هذين الموقفين ، بما يوضح
الفكرة ويبسط الأمثلة التاريخية ، ويؤسس الاساس لما نريد التوصل
إليه في نهاية المطاف ، من دون أن نكون مضطرين إلى ذكر كل شاردة
وواردة في ترجمته عليه السلام .)
صفحة (123)
الموقف الأول :
نشاطه (ع) تجاه من لا يعتقد بامامته :
ويتجلى هذا الموقف في عدة نقاط :
النقطة الأولى : النقد السياسي على المستوى الأعلى وهو ما يعبر عنه
بلغة الفقه ، أنها كلمة حق أمام سلطان جائر .
ولعل أول وأوضح ما يندرج في هذا الصدد ، ما ذكره جماعة من المؤرخين
العامة والخاصة ، من أنه سعى به (ع) إلى المتوكل ، وقيل أن في
منزلة سلاحاً وكتباً ، وغيرها من شيعته وأوهموه أنه يطلب الأمر
لنفسه فوجه إليه عدة من الأتراك ليلاً ، فهجموا على منزله على غفلة
، فوجدوه وحده في بيت مغلق وعليه مدرعة من شعر ، وعلى رأسه ملحفة
من صوف ، وهو مستقبل القبلة يترنم بآيات من القرآن في الوعد
والوعيد ، ليس بينه وبين الأرض بساط إلا الرمل والحصى ، فأخذ على
الصورة التي وجد عليها ، وحمل إلى المتوكل في جوف الليل .
فمثل بين يديه والمتوكل يستعمل الشراب وفي يده كاس ، فلما رآه
أعظمه وأجلسه إلى جانبه ، ولم يكن في منزله شيء مما قيل عنه ولا
حجة يتعلل بها.)
صفحة (124)
فناوله المتوكل الكأس الذي في يده . فقال : يا أمير المؤمنين ما
خامر لحمي ودمي قط فاعفني ، فاعفاه ، وقال : أنشدني شعراً استحسنه
فقال : أني لقليل الرواية للشعر ، قال : لا بد أن تنشدني شيئاً .
فأنشده :
باتوا على قلل الأجيال تحرسـهم غلب الرجال فما اغتنـم القـلل
واستنزلوا بعد عز مـن معاقلهم فأودعوا حفراً يابسـاً ما نزلوا
ناداهم صارخ من بعد مـا قبروا أين الاسرة والتيجـان والحلـل
أين الوجوه التي كـانت منعمـة من دونها تضرب الأستار والكلل
فافصح القبر عنهم حين ساءلهم تلك الوجوه عليـها الدود يقتتـل
قد طال ما أكلوا دهراً وما شربوا فأصبحوا بعد طول الاكل قد أكلوا
قال : فاشفق من حضر على علي (ع) وظن أن بادرة تبدر إليه فبكى
المتوكل بكاء كثيراً حتى بلت دموعه لحيته ، وبكى من حضره ثم أمر
برفع الشراب . ثم قال : يا أبا الحسن ، أعليك دين ؟! قال : نعم ،
أربعة آلاف دينار . فأمر بدفها إليه ، ورده إلى منزله مكرماً (1) .
ولعلنا نستطيع أن نفهم من هذه القصة ، عدة أمور:
الأول : مقدار الجو المكهرب الذي كان يعيشه الإمام (ع) تجاه
السلطات ، وكيفية معاملتهم معه ، تلك المعاملة التي كان للأتراك
اليد الكبرى في ارتكابها وتحمل جريرتها.
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر ابن خلكان جـ 2 ص 434 ، وأبو الفداء جـ 1 ص 470 وابن
الوردي جـ 1 ص 232 والمسعودي في المروج جـ 4 ص 11 .)
صفحة (125)
الثاني : أن الإمام هو الذي اراد عن علم وعمد أن يكون في جوف الليل
، على الحالة التي رأوه عندها . فقد علم بنحو غيبي أو بطريق خاص ،
بمثل هذا الهجوم المفاجيء . فأخفى مستنداته بنحو تام وبدأ بقراءة
آيات في الوعد والوعيد ، مما يكون حجة على هؤلاء الأتراك المهاجمين
. وإن تخيل الحكام والمؤرخون أيضاً أن القيام بهذه العملية كان على
حين غرة منه وغفلة.
الثالث : أن الإمام اعطى لهذا المقام مقاله ، بالنحو الذي لا يكون
مهدداً مباشرة للكيان القائم ، مع كونه واقعاً موقع التأثير البالغ
، لكون تذكيراً بالموت والعقاب في وقت التلبس بعصيان أوامر الله
تعالى . وكان له من الشمول لكل موقف سياسي أو شخص منحرف ، ما يكفي
لمتعظ .
الرابع : أن المتوكل كان في لا شعوره وفي مرحلة غامضة من بواطن
نفسه ، يعترف بأمرين أولهما : أن الحق في جانب الإمام ، وأن قضيته
عادلة ، ثانيهما : أن ما يقترفه من الأعمال ، انحراف عن الإسلام
وعصيان لأوامر الله المتفق على ثبوتها بين المسلمين ، فهو يحس بوقع
الجريمة ووخز الضمير . إلا أن كلاً من هذين الإحساسين تغطيها أغشية
المال والملك والمصالح الشخصية ، الذي جعلته في قمة المنحرفين
والمعادين لأهل البيت .)
صفحة (126)
وعلى أي حال فقد استطاع الإمام أن يمس بإنشاده بواطن إحساسه ،
فأبكاه ونجا من الشر والضرر الذي كان يحاوله ضده ، بل زاد المتوكل
على ذلك باعطائه المال وصرفه إلى منزله معززاً مكرماً.
ومن مثل هذا الموقف ما كان من الإمام (ع) مع أحمد بن الخصيب ، ومن
هو ابن الخصيب !؟ هو الذي استوزره المنتصر وندم على ذلك(1) وذلك
لأن ابن الخصيب كان ضيق الصدر بطيئاً في حوائج الناس ظالماً ، ومن
ذلك أنه ركب ذات يوم فتظلم اليه منظلم بقصه ، فأخرج رجله من الركاب
فزج بها في صدر المتكلم فقتله فتحدث الناس في ذلك فقال بعض الشعراء
في أثر ذلك :
قال للخليفة يا ابن عـم محمد اشكـل وزيرك أنه ركال
اشكله عن ركل الرجال فإن ترد مالاً فعند وزيرك الأموال (2) وقد شارك جماعة الأتراك في تنصيب المستعين بعد المنتصر(3) ولكن
المستعين نفاه عام 248هـ إلى اقريطش (اليونان)(4) .
ــــــــــــــــــــــ
(1) المروج جـ 4 ص 48 . (2) المصدر والصفحة .
(3) الكامل جـ 5 ص 3111 والمروج جـ 4 ص48 .
(4) الكامل ص 312 . المروج جـ 4 ص 61 .)
صفحة (127)
قال الراوي : فتحير الحاضرون ، ونهض علي بن محمد (ع) فقال اثناء
وزارته ، وقد قصر أبو الحسن عنه ، فقال له ابن الخصيب : سر جعلت
فداك . فقال له أبو الحسن (ع) : أنت المقدم يقول الراوي : فما
لبثنا إلا أربعة أيام حتى وضع الدهق على ساق ابن الخصيب ، وقتل (1)
.
فهذا من النقد الضمني ، وإلقاء الحجة ، على هذا الوزير المنحرف ،
من حيث لا يعلم ، ولكن الإمام (ع) قال له قولاً صريحاً ، نتيجة
لاعتدائه عليه والحاحه في الانتقال من الدار التي قد نزلها
وتسليمها إليه . قال الراوي: فبعث إليه أبو الحسن : لا قعدن بك من
الله مقعداً لا تبقى لك معه باقية ، فأخذه الله في تلك الأيام .
وهذه هي دعوة المظلوم المستجابة ، وخاصة في مثل شأن هذا الإمام
الممتحن (ع) .
ومن موارد إثبات الحجة على المستوى الحكومي العالي ، ما ورد بشكل
مشهور عن زرافة حاجب المتوكل ، ما حاصله : أن مشعوذاً هندياً أراد
أن يأنس المتوكل بلعبه . وكان الإمام (ع) حاضراً في المجلس فاراد
الهندي أن يخجله ببعض شعوذاته ، ووجد من المتوكل رغبة في ذلك . فما
كان من الإمام إلا أن أشار إلى صورة أسد مرسومة على إحدى الوسائد
فوثبت الصورة على شكل أسد حقيقي فافترس الهندي المشعوذ وعاد إلى
شكله الأول على الوسادة.
ـــــــــــــــــــــــ
(1) الإرشاد ص 311 . والمناقب ص 511 جـ 3 .)
صفحة (128)
قال الراوي : فتحير الحاضرون ، ونهض علي بن محمد (ع) فقال له
المتوكل : سألتك بالله إلا جلست ورددته. فقال : والله لا يرى بعدها
اتسطل أعداء الله على أوليائه ، وخرج من عنده . ولم ير الرجل بعدها
(1) .
النقطة الثانية ـ إثبات الحجة على المستوى الشعبي العام :
وذلك : بالنحو الذي لا ينافي السلبية والحذر ، من السلطة القائمة :
وذلك : على أحمد مستويين ـ أحدهما : المستوى الشخصي والآخر :
المستوى الجماعي .
المستوى الأول : إثبات الحق وإقامة الحجة تجاه أشخاص باعيانهم .
مثل موقف الإمام تجاه ذلك النصراني الذي جاء دار الإمام حاملاً
إليه بعض الأموال . وبمجرد أن وصل أمام الدار خرج إليه خادم أسود .
فقال له : أنت يوسف بن يعقوب. قال: نعم. قال : فانزل . واقعده في
الدهليز ، فتعجب النصراني من معرفته لاسمه واسم أبيه، وليس في
البلد من يعرفه ، ولا دخله قط ، ثم خرج الخادم فقال : المئة دينار
التي في كمك في الكاغذ ، هاتها . فناولها إياه . وجاء فقال: ادخل ،
فدخل ، وكان الإمام وحده . فطالبه الإمام (ع) بالإسلام والرجوع إلى
الحق نتيجة للآيات التي رآها بقوله يا يوسف . ما آن لك ؟ فقال يوسف
: يا مولاي ، قد بان لي من البرهان ما فيه كفاية لمن اكتفى.
ـــــــــــــــــــ
(1) كشف الغمة جـ 3 ص 184 .)
صفحة (129)
فقال: هيهات أنك لا تسلم . ولكنه سيسم ولدك فلان ، وهو من شيعتنا.
يا يوسف إن أقواماً يزعمون أن ولايتنا لا تنفع أمثالك . كذبوا
والله ، أنه لتنفع . امض فيما وافيت له ، فإنك سترى ما تحب . قال
الراوي : فمضيت إلى باب المتوكل فنلت كل ما أردت وانصرفت (1) .
وعلى هذا المستوى موقف الإمام (ع) تجاه سعيد بن سهل البصري المعروف
بالملاح ، الذي كان واقفياً ، فقال له الإمام(ع)، إلى كم هذه
النومة أمالك أن تنتبه منها . قال : فقدح في قلبي شيئاً وغشي علي
وتبعت الحق(2).
انظر إلى هذه الرمزية التي استعملها الإمام (ع) في كلامه ، بحيث لم
يكن يصلح لفهمه إلى المخاطب ، وبذلك أدخله في مواليه وقواعده
الشعبية، بعد أن كان حائداً عنه. إلى غير ذلك من الأمثلة التي
نكتفي منها بما نقلناه.
المستوى الثاني: إثبات الحق أمام جماعة أوجماعات، عند سنوح الفرصة
وتنجز المسؤولية : بشكل هادئ ليس فيه تحد للوضع القائم ، أو مقابلة
الخط الحكام .
ـــــــــــــــــــ
(1) كشف الغمة جـ 3 ص 183 .
(2) المناقب جـ 3 ص 511 .)
صفحة (130)
فمن ذلك : أنه كان لبعض أولاد الخلفاء وليمة دعا إليها الإمام
الهادي عليه السلام . فلما رأوه انصتوا إجلالاً له . وجعل شاب في
المجلس لا يوقره ، وجعل يلفظ ويضحك ، يدعوه إلى ذلك تجاهل وجود
الإمام والتهوين من شأنه أمام جماعة المدعوين . فقال الإمام له :
ما هذا الضحك ملء فيك ، وتذهل عن ذكر الله ، وأنت بعد ثلاثة ايام
من أهل القبور. فكف عما هو عليه . وكان كما قال (1) حيث مات الشاب
في الموعد المحدد . ولم يكن على أحد من المدعوين ، ألا أن يعرف
موعد مدته ، ليعرف حق قول الإمام عليه السلام .
ومن ذلك : أن السلطات خرج في يوم من أيام الربيع ، إلا أنه صائف ،
والناس عليهم ثياب الصيف ، أما الإمام (ع) فعليه لباد وعلى فرسه
ثوب يحميه المطر ، وقد عقب ذنب فرسه. والناس يتعجبون منه ويقولون :
ألا ترون إلى هذا المدني ، وما قد فعل بنفسه . قال الراوي : فلما
خرج الناس إلى الصحراء لم يلبثوا أن ارتفعت سحابة عظيمة، هطلت. فلم
يبق أحد إلا ابتل حتى غرق بالمطر. وعاد عليه السلام ، وهو سالم في
جميعه (2) . وهنا كان يكفي كل واحد من هؤلاء ، قليلاً من الإلتفات
ليروا كرامة الإمام عليه السلام .
وهنا نلاحظ أن مشاركة الإمام (ع) لموكب السلطان في الخروج إلى
الصيد ـ وهو لهو كان مفضلاً عند الخلفاء والوزراء في تلك العصور ـ
ناتجة في الحقيقة عما عرفناه من سياسة الخلافة العباسية في حجز
الإمام (ع) في بوتقة البلاط، وعزله عن قواعده الشعبية ونشاطه
البناء ، لكي يكون دائماً تحت الرقابة والنظر.
ــــــــــــــــ
(1) المناقب جـ 3 ص 517 .
(2) المصدر السابق ص 516 .)
صفحة (131)
النقطة الثالثة ـ جهاده العلمي :
ذلك الجهاد الذي كان يقوم به عليه السلام ، لكي يثبت حقاً أو يدفع
باطلاً ، أو يجيب عن استفتاءات الخليفة له، أو يدفع تحديه عنه.
أما ما كان من إثبات الحق محضاً ، من دون أن يكون مسبوقاً بتحدٍ أو
ازعاج . فمنه ما أجاب به عليه السلام عن سؤال الأهوازيين حين سألوه
عن الجبر والتفويض . وهو بيان مطول بدأه بمقدمة حول إثبات الإمامة
طبقاً للمفهوم الحق الذي يعتقده ، وأتبعه بالجواب الصحيح عن الأمر
بين الأمرين (1).
ومنه ما أجاب به أحمد بن إسحاق حين سأله عن الرؤية وما فيه الخلق
(2).
وأما ما كان من دفعة للباطل ، بعد اشتباه المسألة والتردد فيما هو
الحق عند البعض ، فمنه ما تكلم به عليه السلام مع فتح بن يزيد
الجرجاني ، لإزالة بعض الشبهات الواردة في ذهنه (3) ،
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظره في الاحتجاج جـ 2 ص 251 وما بعدها .
(2) انظره في المصدر والصفحة . (3) انظره في المصدر ص 260 .)
صفحة (132)
وما ورد به على رجل عباسي حين عز عليه تقدم الإمام عليه ، مع
اعتقاده أنه أشرف منه نسباً !! (1) .
وأما المتوكل واستفتاءاته وتحدياته للإمام عليه السلام ، فهو كثير
، فإن المتوكل في الوقت الذي يعوزه الفقه في عدد من الوقائع ، يضطر
إلى الرجوع إلى الإمام لتذليل ما يواجهه من عقبات . ولكنه كان يمزج
استفتاءاته بالتحدي ، فيسأل عن الحكمة أو الدليل بقصد الإحراج لا
بقصد الفهم الصحيح ، على ما سنعرف . وكان الإمام (ع) يجيبه بالشكل
الذي يراه مناسباً مع فهمه وفهم الحاضرين ، وموافقاً للمصلحة مع
كونه مثبتاً للحق في نفس الوقت .
فمن ذلك أنه قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة ، فأراد
أن يقيم عليه الحد ، فأسلم . فقال يحيى بن أكثم ـ وهو قاضي القضاة
يومئذ ـ قد هدم إيمانه شركه وفعله. وقال بعضهم يضرب ثلاثة حدود .
وقال بعضهم يفعل به كذا وكذا .
فلما رأى المتوكل هذا الاختلاف بين الفقهاء. أمر بالكتابة إلى أبي
الحسن العسكري الإمام الهادي عليه السلام، لسؤاله عن ذلك . فلما
قرأ الكتاب كتب عليه السلام : يضرب حتى يموت .
ــــــــــــــــــــــ
(1) انظر الاحتجاج جـ 2 ص 260 .)
صفحة (133)
فانكر يحيى وانكر فقهاء العسكر: سامراء ـ ذلك . فقالوا : يا أمير
المؤمنين ، سله عن ذلك فإنه شيء لم ينطق به كتاب ولم يجيء به سنة .
فكتب إليه : أن الفقهاء قد أنكروا هذا . وقالوا : لم يجيء به سنة
ولم ينطق به كتاب . فبين لنا لم أوجبت علينا الضرب حتى يموت .
فكتب عليه السلام : بسم الله الرحمن الرحيم : فلما رأوا بأسنا
قالوا آمنا بالله وحده ، وكفرنا بما كنا به مشركين . فلن يك ينفعهم
إيمانهم لما رأوا بأسنا (1) . فأمر به المتوكل ، فضرب حتى مات (2)
.
ونستطيع أن نفهم من ذلك ، بوضوح ، أمرين :
الأول : أن المتوكل بالرغم من افتقاره إلى الرجوع إلى فتوى الإمام
عليه السلام لحل مضلته ، لم يكن على استعداد لتنفيذ ما أمره الإمام
إلا بعد مراجعته والتأكيد عليه في طلب الدليل .
الثاني : أننا نفهم من سياق الآية التي استشهد به الإمام ، طريقة
فهمه عليه السلام للموقف ، وهو : أن الإسلام الذي أظهره هذا
النصراني ليس إيماناً صحيحاً ، وإنما هو لقلقة لسان أظهرها للتهرب
من إقام الحد والنجاة من العقاب . وكل من أظهر الإيمان خوفاً من
العدل الالهي ، لا يكون الإيمان نافعاً له ، ويكون مستحقاً لمثل
هذا العقاب الذي أمر به عليه السلام .
ــــــــــــــــــــــ
(1) المؤمن 84 ـ 85 . (2) المناقب جـ 3 ص509.
صفحة (134)
وقد يكون موقف المتوكل تجاه الإمام موقف التحدي صرفاً ، لا لأجل
الحاجة إلى تطبيق الفتوى، ولا لأجل الحاجة إلى فهم الحق في المسألة
، ولا لأجل إثبات جدارة الإمام عليه السلام توخياً للإيمان به ، بل
لمجرد التحدي.فمن ذلك أن المتوكل يقول لابن السكيت: أسأل ابن الرضا
مسألة عوصاء بحضرتي! فيسأله ابن السكيت عن بعض ما يراه صعباً
ومشكلاً ، فيخرج الإمام (ع) ظافراً من هذا التحدي ، ويجيب بما هو
الحق الصريح. وإذ ينتهي الكلام مع ابن السكيت يبتدر يحيى بن أكثم ،
فيقول : ما لابن السكيت ، ومناظرته ، وإنما هو صاحب نحو وشعر
ولغة،ورفع قرطاساً فيه مسائل ، فأملى علي بن محمد عليه السلام ،
على ابن السكيت جوابها (1) .
انظر إلى تعليق ابن أكثم حين قرأ جواب الإمام ، تجده قد تخوف من
عمق أجوبته ودقة علمه ، من أن يشارك في الدعاية له وتأكيد صدق
قضيته ، وبالنهاية توسيع وتقوية قواعده الشعبية ، قال يحيى بن أكثم
للمتوكل : ما تحب أن تسأل هذا الرجل عن شيء بعد مسائلي هذه. وأنه
لا يرد علي بشيء بعدها إلا دونها. وفي ظهور علمه تقوية للرافضة (2)
.
فهذه عدة نقاط من الموقف الأول للإمام في العاصمة العباسية .
ـــــــــــــــــــ
(1) المناقب جـ 3 ص 507 . (2) المصدر ص 509 .)
صفحة (135)
الموقف الثاني :
موقفه مع أصحابه ومواليه .
وهو ما يرجع إلى المحافظة عليهم وحمايتهم من الإنحراف ومن الإرهاب
العباسي . ومساعدتهم على قضاء حوائجهم بحسب الإمكان . ويندرج في
هذا الموقف عدة نقاط :
النقطة الأولى :
حماية أصحابه وذويه من الإنحراف ، وبيع الضمير للحكام بأرخص
الأثمان .
ولعل أهم وأوضح موقف وقفه الإمام (ع) في هذا الصدد ، موقفه في ردع
أخيه موسى بن محمد بن علي بن موسى على آبائه الصلاة والسلام ، عن
الإجتماع مع المتوكل في المجلس الذي كان يريده المتوكل له ، وهو
مجلس اللهو والشراب، ليتوصل بذلك إلى هتك أخيه الإمام الهادي عليه
السلام ، والتشهير به . ولكن الله تعالى أتم نوره ، ولم يتوصل
المتوكل إلى مقصوده فإن المتوكل ، تحت سورة من الحقد والغضب ، قال
لأصحابه في بعض مجالسه : ويحكم قد أعياني أمر ابن الرضا(1) وجهدت
أن يشرب معي وأن ينادمني ، فامتنع ، وجهدت أن أجد فرصة في هذا
المعنى فلم أجدها . فقال له بعض من حضر المجلس : إن لم تجد من ابن
الرضا ما تريده من هذا الحال ، فهذا أخوه موسى قصاف عزاف ، يأكل
ويشرب ويعشق ويتخالع ، فأحضره واشهد به . فإن الخبر يشيع عن ابن
الرضا بذلك . فلا يفرق الناس بينه وبين أخيه . ومن عرفه اتهم أخاه
بمثل فعاله .
ـــــــــــــــــــ
(1) يعنى الإمام الهادي عليه السلام .
صفحة (136)
وجاء هذا الاقتراح مناسباً مع اتجاه المتوكل وبلسماً على جرح قلبه
. فأمر باستقدامه إلى سامراء مكرماً ، وأمر له باستقبال فخم يحضر
فيه جميع بني هاشم والقواد وجماهير الناس. وكان عازماً على أنه إذا
قدم اقطعه أرضاً وبنى له فيها ، وحول إليها الخمارين والقيان ـ أي
الجواري والمغنيات ـ وأمر بصلته وبره . وزاد على ذلك ـ لأجل تحقيق
غرضه ـ أن أفراد له منزلاً سرياً يصلح أن يزوره فيه .
وإلى هنا ، حاول المتوكل ، بسلطته على شؤون الدولة ، أن تكون
مؤامرته على هتك الإمام بواسطة التشهير بأخيه ، تامة. إلا أن ذلك
مما لا يمكن أن يفوت الإمام خبره ، ولا يمكن أن يتغاضى عنه . لأنه
هو المقصود بالذات ، في هذا التخطيط ، والعمل ضده عمل ضد الدين وضد
سيد المرسلين ، باعتبار أنه يعتقد أنه الممثل الاساسي الأكمل لهذا
المبدأ المقدس ، فوقف الإمام (ع) ضد هذه المؤامرة موقفه الحاسم .
خرج عليه السلام مع المستقبلين ، فتلقى أخاه في قنطرة وصيف ، وهو
موضع يتلقى فيه القادمون . فسلم عليه ووفاه حقه . ثم جاء دور
تحذيره من المؤامرة وتنبيهه على ما ينبغي أن يتصرف . بالنحو الذي
يقتضيه رضاء الله تعالى وتعاليم الإسلام .)
صفحة (137)
فقال له الإمام : أن هذا الرجل (1) قد أحضرك ليهتكك ويضع منك ، فلا
تقر له أنك شربت نبيذاً قط . واتق الله يا أخي أن ترتكب محظوراً .
فقال له متجاهلاً : وإنما دعاني لهذا ، فما حيلتي . قال له الإمام
(ع) : فلا تضع من قدرك ولا تعص ربك ولا تغفل ما يشينك ، فما غرضه
إلا هتكك .
وهنا بدأ الأعراض والتشكيك من موسى أخيه ، إذ لعله كان يحسن الظن
بالمتوكل وينكر مؤامرته ، أو لعله يدركها وليس لديه منها مانع ،
بالرغم مما فيها من الهتك له ولأخيه ولدينه. فكرر عليه أبو الحسن
القول والوعظ ، وهو مقيم على خلافه . فلما رأى أنه لا يجيب ، وجد
الإمام عليه السلام أن آخر الدواء الكي ، وأنه لا بد أن يقول قوله
الحاسم ، مستمداً من وراء الغيب ، فقال له : إما أن المجلس الذي
تريد الإجتماع معه عليه لا تجتمع عليه أنت وهو أبداً .
ثم انظر كيف يتم الله نوره ، ويأخذ بيد الإمام (ع) ... أن المتوكل
لأسباب مجهولة ، تحول من ذلك الحماس العظيم للاجتماع مع موسى في
درا منفردة في مجلس اللهو والطرب ، تحول إلى محاولة إبعاده وحجبه
عنه وعدم الإجتماع به. حيث أقام موسى ثلاث سنين ، يبكر كل يوم إلى
باب المتوكل ، فيقال له : قد تشاغل اليوم ، فيروح ، ويبكر ، فيقال
له : قد سكر فيبكر ، فيقال له : قد شرب دواء . فما زال على هذا
ثلاث سنين حتى قتل المتوكل (2) . ولم يجتمع معه على شراب (3) .
ـــــــــــــــــــــــ
(1) يعني المتوكل العباسي . (2) نعرف من ذلك أن هذه الحادثة وقعت
عام 244 .
(3) الإرشاد ص 312 وغيره .)
صفحة (138)
النقطة الثانية :
حمايته لأصحابه من الإرهاب العباسي . وذلك بمقدار إمكنه ، ولا
ينافي خطه السلبي العام .
ولعل أوضح موقف يروى من ذلك ، هو موقف الإمام مع محمد بن الفرج
الرخجي ، إذ كتب إليه محذراً : يا محمد اجمع أمرك وخذ حذرك . فلم
يفهم ماذا أراد الإمام بكلامه هذا ، ولو كان قد فهم لدفع عن نفسه
شراً مستطيراً. يقول هذا الراوي: فأنا في جمع أمري لست أدري ما
الذي أراد بما كتب ، حتى ورد عليّ رسول حملني من وطني مصفداً
بالحديد ، وضرب على كل ما أملك ، وكنت في السجن ثماني سنين .
ثم انظر إلى لطف الإمام عليه السلام به مرة أخرى ، حيث كتب إليه
وهو في السجن : يا محمد بن الفرج لا تنزل في ناحية الجانب الغربي
قال الراوي : فقرأت الكتاب وقلت في نفسي : يكتب إلى أبو الحسن بهذا
وأنا في السجن أن هذا لعجب . فما لبث إلاّ أياماً يسيرة حتى فرج
عني وحلت قيودي وخلى سبيلي (1) .
ويندرج في مساعدته لهم بطريق الدعاء. وهو الطريق الغيبي المتوفر
دائماً ، للانقاذ من المصاعب وحل المشاكل . فكان الإمام عليه
السلام يلجأ إليه حين يجد المصلحة في ارتفاع الصعوبة عن هذا الطريق
.
ـــــــــــــــــــ
(1) إعلام الورى ص 342 .)
صفحة (139)
فمن ذلك ما حدث به أحد المعاصرين لذلك العصر المتضررين من الحكم
العباسي ، حيث بقول : قصدت الامام يوماً فقلت: أن المتوكل قطع
رزقي. وما أتهم في ذلك إلا علمه بملازمتي لك. فينبغي أن تتفضل علي
بمسألته... ولم يتفضل الامام بالوساطة الى المتوكل - كما طلب -
وانما تفضل عليه السلام بالوساطة مع الله تعالى ، وهو غاية المأمول
ونهاية المسؤول ذو القوة المتين. فقال الرجل : تكفى ان شاء الله،
يقول هذا الراوي : فلما كان الليل طرقني رسل المتوكل رسول يتلو
رسولاً . فجئت اليه فوجدته في فراشه. فقال : يا أبا موسى يشتغل
شغلي عنك وتنسينا نفسك. أي شئ لك عندي به . فقلت : الصلة الفلانية،
وذكرت أشياء. فأمر لي بها وبضعفها.
وإلى هنا تأكد في ذهن هذا الرجل بان الامام قد نفذ وساطته المطلوبة
... فبدر إلى الوزير الفتح بن خاقان وقال له مستفهماً : وافي علي
بن محمد إلى ههنا ، أو كتب رقعة ! فأجاب الوزير بالنفي.
قال: فدخلت على الأمام . فقال لي : يا أبا موسى هذا وجه الرضا.
فقلت ببركتك يا سيدي، ولكن قالوا : انك ما مضيت ولا سألت. فأجابه
الامام عليه السلام ... انظر إلى جوابه إذ يسند النتيجة إلى
الارادة الألهية والعون الألهي حيث لا يوجد المعين . فأن أهل البيت
عليهم السلام قد أجابوه إلى كل ما يريد فأجابهم عز وجل إلى كل ما
يريدون. وكل من كان كذلك حصل على هذه النتيجة الكبرى.)
صفحة (140)
لا محالة . قال الإمام عليه السلام : إن الله تعالى علم منا أنا لا
نلجأ في المهمات إلا إليه . ولا نتوكل في الملمات إلا عليه .
وعودنا ـ إذا سألناه ـ الإجابة . ونخاف أن نعدل فيعدل بنا (1) .
ويشبه هذا الموقف ، موقفه عليه السلام مع أيوب بن نوح ـ وهو من
ثقات أصحابه (2) ـ حين تعرض له بالأذى قاضي الكوفة السائر في خط
الجهاز الحاكم ، المدعو بجعفر بن عبد الواحد القاضي . فكتب إلى
الإمام يشكو إليه ما ناله من الأذى. قال الراوي : فكتب إلي : تكفي
أمره إلى شهرين . فعزل عن الكوفة في شهرين . واسترحت منه (3) .
ولعلنا في غنى عن التعليق على هذا الموقف من الإمام بأمرين :
أحدهما: إن الإمام عليه السلام اطلع بطريق سري غيبي أو طبيعي على
قرار عزل هذا القاضي قبل شهرين من صدوره .
ثانيهما : أن الإمام عليه السلام استعمل في الجواب عبارة غامضة ،
يمكن أن تخفى على الرقيب . فإنه لم يكن يمكن أن يفهم أحد أن
المقصود هو قاضي الكوفة غير أيوب بن نوح .
ـــــــــــــــــــــ
(1) المناقب جـ 3 ص 514 . (2) فهرست الشيح الطوسي ص 40 .
(3) كشف الغمة جـ 2 ص 176 .)
صفحة (141)
النقطة الثالثة :
قضاء الإمام لحوائج أصحابه بحسب الإمكان. لعلنا قد تم لدينا ـ إلى
حد الآن ـ التعرف على ما كان يعانيه أصحابه وقواعده الشعبية من ضيق
في الحالة الإجتماعية والإقتصادية معاً ، نتيجة لإبعادهم عن المسرح
العام سياسياً واجتماعياً ، وقد كان الإمام عليه السلام يتوخى من
وراء مساعدتهم عدة فوائد :
أولاً : قضاء حوائجهم الخاصة.
ثانياً : تركيز ثقتهم به ، بصفته قائدهم الأعلى ومأملهم الأسمى عند
الظروف القاسية ، والمعين عند عدم وجود المعين.
ثالثاً : تجديد نشاطهم الإجتماعي ، بحسب ما يراه لهم عليه السلام
وتقتضيه سياسته في ذلك العصر . وهي ـ على ما عرفنا ـ : العمل في
سبيل الله والعدل الإسلامي بشكل لا يثير الحقد والخطر عليهم .
وأهم ما يندرج في هذا الموقف : أنه دخل على الإمام جماعة من أفضل
أصحابه وأوجههم عنده وعند قواعده الشعبية وهم : أبو عمرو عثمان بن
سعيد العمري وأحمد بن إسحاق الأشعري وعلي بن جعفر الهمداني . فشكا
إليه أحمد بن إسحاق ديناً عليه . فقال عليه السلام لعثمان بن سعيد
، وكان وكيله : يا أبا عمرو ، ادفع إليه ثلاثين ألف دينار وإلى علي
بن جعفر ثلاثين ألف دينار وخذ أنت ثلاثين ألف دينار ويعلق على ذلك
علماؤنا: بان هذه معجزة لا يقدر عليها إلا الملوك ، وما سمعنا بمثل
هذا العطاء (1) .
ــــــــــــــــــــ
(1) المناقب جـ 3 ص 512.
صفحة (142)
وأما نحن فيمكننا أن نكتشف من وراء ذلك ... الموقف القيادي المركزي
الذي كان يقوم به الإمام بين قواعده الشعبية ومواليه . ذلك الموقف
الذي كانت تحاول الدولة العباسية الحيلولة دونه ... ولم تكن موفقة
في ذلك إلى حد كبير. فالإمام يستلم الأموال الطائلة ـ بالطرق
السرية أو العلنية الممكنة ـ مما يكون لدى مواليه من الضرائب
الإسلامية كالخراج والزكاة والخمس. وهذا ما يتضح أيضاً لمن راجع
تاريخ آبائه عليهم السلام ، وسيأتي في تاريخ ولده الإمام الحسن
العسكري عليه السلام ما يشبه ذلك .
وإنما يتم تسليم هذه الأموال لكي تصرف في المصالح الإسلامية
الإجتماعية العامة ـ بعيداً عن العاصمة العباسية ـ في تلك المهام
التي تقتض صرف عشرات الآلاف من الدنانير . ونحن مهما بلغ بنا
الخيال ، لا يمكن أن نتصور وصول الدين ، في قضاء الحوائج الشخصية ،
إلى ثلاثين ألفاً . إلا أن يكون ديناً في عمل إجتماعي واسع أكبر من
المصالح الشخصية والمسؤولية العائلية .وخاصة في أمثال هؤلاء من
الفقاء والورعين ، مضافاً إلى أننا رأينا الإمام عليه السلام يعطي
الاثنين بدون طلب أو شكوى في دين .وعلى أي حال فهذه هي الخطوط
العامة لسياسة الإمام (ع) ، فيما تمثله من موقفيه الرئيسيين تجاه
مواليه وتجاه الآخرين .
صفحة (143)
موقف الخلافة العباسية من الإمام :
أشرنا فيما سبق أن موقف الخلفاء العباسيين ، يتجلى ـ فيما وصل
إلينا من النقل التاريخي ـ في خصوص المتوكل ، ولا يبدو لغيره أثر
يذكر. وقد ذكرنا ما يمكن أن يكون سبباً لذلك . فمن هنا ينحصر
عنواننا في المقام في موقف المتوكل من الإمام عليه السلام .
ونستطيع أن نلخص موقفه في عدة نقاط :
النقطة الأولى : تحديه من الناحية العلمية ، كما سبق . وقد رأينا
كيف يخرج الإمام ظافراً من هذا التحدي .
النقطة الثانية : تقريبه من البلاط ودمجه في حاشية الخلافة بمقدار
الإمكان ، ليكون الإمام على طول الخط بين سمعهم وأبصارهم فلا
تفوتهم منه شاردة ولا واردة . وقد رأينا مقدار نجاحهم الضئيل في
ذلك .
وقد سبق أن لاحظنا أن هذا كان هو الهدف الأساسي من استقدام الإمام
إلى العاصمة العباسية . وكان الإمام يعطي من نفسه بإزاء ذلك وكأنه
يوافق الدولة العباسية على سياستها تجاهه . فكان يحضر موائدهم
ويخرج في مواكبهم كما سمعنا . ونستطيع أن نفهم موقف الإمام (ع) هذا
، لا على أساس التنازل أو التسامح مع الدولة ، فإن هذا مما لا يمكن
أن يكون من شخصية كشخصية الإمام المبدأية الإسلامية القائدة
لجماهير قواعده الشعبية من المسلمين . )
صفحة (144)
وكان أي تنازل منه يعني السعي ضد المصالح الإسلامية لهذه الجماهير
، وهو ما لا يخفى ما فيه من قبح وخيانة على الشخص الإعتيادي فضلاً
عن القائد العام. مضافاً إلى أنه لو تنازل لشعرت الدولة بتنازله
... فكان في الإمكان أن ينال عندها أقصى الحظوة والمنزلة والراحة
... ولارتفع ما كان محاطاً به من المراقبة والضغط مع أنه كان
يتزايد باستمرار ، حتى أن المتوكل في آخر أيامه انتهى به الأمر إلى
زج الإمام في السجن على ما سنسمع.إذن فلم يكن موقفه متضمناً لشيء من التنازل ، وإنما كان ناشئاً من
المصالح والمبررات الآتية :
أولها : الضغط والإكراه : فإن السياسة العباسية حيث استقرت على دمج
الإمام بالبلاط ، كان مقتضى رفض هذه السياسة والإنصراف عن إجابة
دعواتهم والحضور في مجالسهم .... إعلاناً صريحاً للمعارضة ... أو
على الأقل إثارة لشك الحكام بأن الإمام متصد للمعارضة وخارج على
الدولة ، وكل ذلك مما لا يريده الإمام (ع) بمقتضى سياسته السلبية
تجاه الدولة .....
ثانيهما : أن الإمام (ع) كان حذراً من براثن الدولة عليه وعلى
مواليه . فكأنه أراد التصريح بشكل عملي بعدم وجود ما تخشى منه
الدولة عنده ، وهذا ما يؤثر نفسياً في تخفيف الشك ضده ... ومعه فقد
ينفتح مجال جديد لنشاط جديد.)
صفحة (145)
ثالثها : أن الإمام حين يعيش بين أكناف حكام الدولة مع من يحيطهم
من القواعد والبطانة والمنتفعين والخدم وغيرهم من مختلف الطبقات
..فإنه عليه السلام يستطيع بلباقة تامة واحتراس شديد وبمقدار
الفرصة السانحة.. أن يقول الحق بينهم ويدافع عن قضيته بين ظهرانيهم
... وهناك احتمال كبير - يؤيده احترامهم لشخص المهدي وإكبارهم
لعلمه ونسبه:- أن يصل كلامه إلى قلوب بعضهم ، فإن السياسي مضافاً
إلى كونه حاكماً مصلحياً ، هو في عين الوقت إنسان ذو عقل وقلب.
وقول الحق يجد طريقه في العقل والقلب من أضيق طريق.
وبذلك يكتسب الإمام العطف على قضيته في المستويات العليا من
الدولة. وقد سبق أن حملنا فكرة عن مقدار نجاحه في ذلك ، ولعل فيما
يأتي من البحث ما يضيف إلى ذلك شواهد أخرى .
رابعها : إن الكيان الحكومي يومئذ كان قائماً بالصراحة على
المحسوبية ، تؤثر فيه المصالح الشخصية وتجد فيها الواسطات طريقها
المستقيم.
وهذا وإن كان دالاً على انحدار الأمة إلى حضيض لا تغبط عليه على أي
حال ، وغير ملائم مع اتجاهات الإمام ومثله ...إلا أنه هو الواقع
..ومن الممكن الإستفادة من هذا الواقع بما ينفع الناس ويكون مصلحة
لهم، لإذن فإتصال المهدي بالحكام مثل هذا الإتصال الوثيق يفتح
أمامه فرصة أوسع للتوسط في تيسير حوائج اصحابه ومواليه وتخفيف ضرهم
ودفع الأخطار عنهم ... بحسب ما يراه من المصلحة.
صفحة (146)
ولعلنا نستطيع أن نستوضح ملامح الموقف اللين الذي كان يقفه الإمام
(ع) تجاه المتوكل من المثال التالي: فإن المتوكل ابتلي بقرحة وخراج
أشرف على الموت ، وكان داؤه عند أطباء عصره منحصراً بأن يمس الجرح
بحديدة فلم يجسر أحد أن يقوم بذلك لإحتمال أن المتوكل سوف يأمر
بقتل من يقوم بذلك لما سيجده من الألم.
ووجلت أمه وجلاً شديداً ...وكانت تعتقد بالإمام (ع) وقربه من الله
تعالى ...فنذرت أنه إذا عوفي أبنها المتكل فإنها تحمل إلى أبي
الحسن الهادي عليه السلام مالاً جليلاً من مالها . ونبهها الفتح بن
خاقان على أن تطلب من الإمام أن يصف دواء للمتوكل ..فأرسلت رسولاً
بهذا الشأن إلى ألإمام . فقال عليه السلام : خذوا كسب الغنم فديفوه
بماء الورد وضعوه على الخراج فإنه نافع بإذن الله .أقول : ولا يخفى
ما في ذلك من ترطيب للجرح خفي سره على الطب القديم الذي كان يداوي
الدمل بإمرار الحديد عليه !!
وعلى أي حال فقد هزأ من حضر مجلس المتوكل من هذا الدواء باعتباره
لم يسمع من طبيب . فينبري الفتح بن خاقان مدافعاً عن اقتراحه
قائلاً : وما يضر من تجربة ما قال ... فوالله إني لأرجو الصلاح به.
فأحضروا هذا العقار ووضع على الخراج فانفتح وخرج ما كان فيه.
وبشرت أم المتوكل بعافية ولدها . فحملت إلى أبي الحسن عليه السلام
عشرة الآف دينار مختومة بختمها ،من دون علم ولدها المتوكل .
صفحة (147)
ويحافظ الإمام (ع) على البدرة - وهي حزمة المال - غير مفضوضة
الخاتم ولا مستعملة ..أياماً ، حتى حصلت كبسة سعيد الحاجب على داره
بأمر المتوكل ، على ما سنذكر في النقطة التالية ، فيجد عنده البدرة
المختومة ، فينقلها مع كيس آخر مختوم وسيف إلى المتوكل ، فلما نظر
المتوكل إلى خاتم أمه على البدرة بعث إليها وسألها فذكرت له نذرها
عند مرضه ، وقالت هذا خاتمي على الكيس ما حركه ... وفتح الكيس
الآخر فإذا فيه أربعمائة دينار ...فأمر لأن يضم إلى البدرة بدرة
أخرى وقال لسعيد الحاجب: احمل ذلك إلى أبي الحسن .. واردد عليه
السيف والكيس بما فيه. قال سعيد : فحملت ذلك إليه واستحييت منه ،
فقلت له : يا سيدي عزّ علي دخولي دارك بغير إذنك . ولكني مأمور !
فقال ليّ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون (1).
انظر إلى الإحترام والتقديس الذي يتمتع به ألإمام (ع) في البلاط ،
وإلى المكاسب التي حصل عليها فيه ، ولا ينبغي أن تفوتنتا المبررات
السابقة لسياسة الملاينة التي ينتهجها الإمام ، بالرغم من انه يتلو
حين يدق ناقوس الخطر قوله تعالى : "وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب
ينقلبون".
النقطة الثالثة : اضطهاد المتوكل لللإمام الهادي عليه السلام حيث
أمر بكبس منزل الإمام (ع) عدة مرات .
ــــــــــــــــــــ
(1) الإرشاد ص310 ، والمناقب ص517
صفحة (148)
فإن السعايات والوشايات التي كانت ترتفع إلى المتوكل ضد الإمام بين
آونة وأخرى .. كانت توقظ شكوكه وتثير شكوكه توجسه الكامن في نفسه،
تجاه الإمام . ولعلنا نستطيع القول : بان شخصاً من الضالعين بركاب
الحكم، يطلع صدفة على بعض آثار نشاط الإمام (ع) في سبيل مصالح
مواليه، فيبالغ هذا الشخص فيه ، تملقاً للدولة، ويجعله خطراً يهدد
كيانها القائم ، مع أننا عرفنا أن مثل هذا النشاط - بشكله المبالغ
فيه - لم يكن موجوداً لدى الإمام علي عليه السلام. وعلى أي حال
يثير هذا الساعي كوامن الخوف والتوجس في نفس المتوكل ، فيغريه ذلك
بكبس دار الإمام للتأكد من صدق الوشاية أو كذبها .
والملاحظ في هذه العمليات أمران :
أحدهما: أن الوشاية دائماً كانت تبوء بالفشل ويرجع جواسيس الخليفة
مؤكدين أنهم لم يجدوا في دار الإمام ما يثير التوجس . مما يوجب عود
المتوكل إلى هدوئه واستمراره على إظهار احترام الإمام وتقديره.
وقد سبق أن أرجعنا ذلك ، إلى أن الإمام أفلح ، لطريق غيبي أو طبيعي
، في إخفاء مكامن الشك عن الدولة بالرغم مما كان يرده من الأموال
والكتب ما كان يقوم به من إتصالات، وقد أطلعنا على صور موجزة
للأساليب الرمزية التي كان يستعملها الإمام حين يريد التعبير عن
أمر محظور في نظر الدولة.
صفحة (149)
ثانيهما : أن ألإمام وإن كان يظهر - عند الكبس على داره - سخطه
بتلاوة أية من القرآن كالذي سمعناه من قوله تعالى: وسيعلم الذين
ظلموا أي منقلب ... الآية .إلا أنه كان يعين الشرطي المتجسس على
مهمته.. فيسرج له الضياء ويدله على غرف الدار ... توخياً في
الإيضاح العملي للدولة بانه لا يملك أي تشاط غريب، على انه لو أظهر
أي مناوءة لمثل هذه المحاولة لكان مثيراً جديداً للشك .. هو في غنى
عنه ، ومنافياً لسياسة الإمام السلبية تجاه الدولة.
وقد حدثت عدة حوادث كبس على داره عليه السلام ، فمن ذلك ما سبق أن
نقلناه عن ابن خلكان وجمهور من المؤرخين الخاصة والعامة ، من كبس
داره في نصف الليل وحمله إلى المتوكل وهو على مجلس الشراب ،
واستنشاده الشعر ، فأنشد الأبيات التي اولها :
باتوا على قلل الأجيال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل
ومن ذلك كبسة لدار الإمام نتيجة لسعاية البطحاني به إلى المتوكل
وزعمه : أن عنده أموالاً وسلاحاً . فأمر المتوكل سعيد الحاجب أن
يهجم عليه ليلاً ويأخذ ما عنده من الأموال والسلاح ويحمله إليه ،
فأخذ سعيد معه سلماً وذهب إلى دار الإمام وصعد عليها من الشارع إلى
السطح ونزل خلال الظلام فلم يدر كيف يصل إلى الدار. قال سعيد :
فناداني أبو الحسن عليه السلام من الدار : يا سعيد مكانك حتى يأتوك
بشمعة . أقول: انظر إلى مساعدته عليه السلام لهذا المتجسس .. وإلى
علمه بشخصه قبل رؤيته .. وإنما ناداه بذلك لإثبات الحجة عليه ،
أثناء تلبسه بالجرم...
صفحة (150)